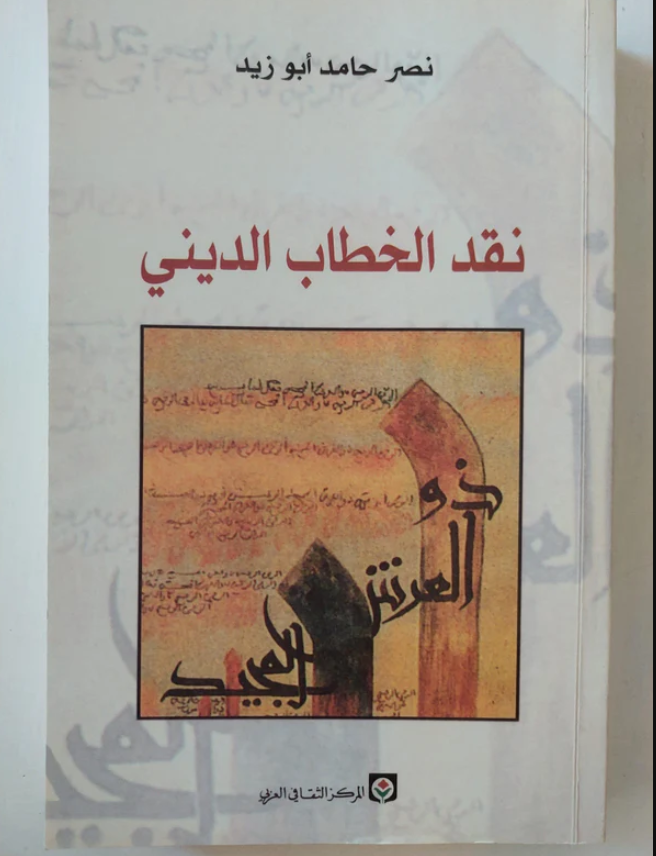كتاب «نقد الخطاب الدينى».. الاستخدام النفعى للدين كما بيّنه نصر أبو زيد

- هناك أهمية كبرى للفصل بين آراء النبى واجتهاداته الخاصة وما يبلغه عن ربه وحيًا
- الخطر يكمن فى ذلك الفهم السقيم للإسلام الذى من شأنه أن يرسخ سلطة رجل الدين
من أهم التحديات التى تواجهها مجتمعاتنا العربية فيما يتعلق بالإسلام، ذلك الاستخدام الأيديولوجى النفعى للإسلام لتحقيق مصالح وغايات ذات طبيعة فئوية أو سياسية أو شخصية، وسواء تم هذا الاستخدام من جانب جماعات سياسية بعينها، أو من جانب أنظمة وسلطات سياسية فاقدة للمشروعية الاجتماعية والسياسية والقانونية، فالنتيجة واحدة، وهى تحويل الإسلام إلى أداة من الأدوات واختزاله فى وظائف وغايات ذات طبيعة دنيوية متدنية.
ولننظر مثلًا فى مقولة إن الإسلام دين شمولى، من أهم أهدافه ووظائفه تنظيم شئون الحياة الإنسانية الاجتماعية والفردية فى كل صغيرة وكبيرة، بدءًا من النظام السياسى، نزولًا إلى كيفية ممارسة الفرد لنظافته الذاتية فى الحمام.
هذه المقولة تفترض أن دخول الفرد فى الإسلام بالميلاد والوراثة أو بالاختيار الواعى، يعنى تخلى الإنسان طواعية أو قسرًا عن طبيعته الإنسانية الفردية التى تسمح له باتخاذ القرار بشأن كثير من التفاصيل الحياتية، التى من شأنها أن تتضمن اختيارات عديدة.
أصبح السؤال المتكرر هنا وهناك لا يتعلق بمدى ملاءمة هذا الاختيار أو ذاك بالنسبة للمجال الذى يتعين على الإنسان الاختيار فيه، وإنما صار يتعلق بمدى سلامة هذا الاختيار أو ذاك من الوجهة الدينية والشرعية، وحين تأخذ أسئلة الحياة هذا المنحى يتحتم أن تتوقع الإجابات الصحيحة من رجل الدين لا من رجل الخبرة والاختصاص فى الشأن المعنى.
وقد عهدنا رجال الدين فى كل عصر من العصور إذا سُئلوا عن رأى الدين فى شأن من الشئون أن يَصْعُبَ على الواحد منهم أن يقول مثلًا «هذا أمر لا شأن للدين به»، ذلك أن مثل هذا الجواب من شأنه أن يزعزع مقولة الشمولية التى يستند الخطاب الدينى إليها فى ممارسة سلطته.
وحين تواجه الواحد من هؤلاء بأن نبى هذا الدين ومتلقى وحيه من الله عز وجل بواسطة الروح القدس جبريل لم يجد غضاضة، حين لم ينجح اقتراحه فى تأبير النخل، أن يعلن أن هذا كان رأيًا ارتأه ولم يكن وحيًا من عند الله- حين تواجه الواحد منهم بهذه الواقعة التى أرست مبدأ «أنتم أدرى بشئون دنياكم»، تجده يستجيب على مضض، لكنه لا يلبث، حين تشرح له دلالة الفصل بين شئون الدين وشئون الدنيا، بل أهمية الفصل بين آراء النبى واجتهاداته الخاصة، وبين ما يبلغه عن ربه وحيًا، أن يلقى فى وجهك مباشرة ودون تفحّص بقول الله «وما ينطق عن الهوى»، ولو تفحص الآية الكريمة فى سياقها، وكذلك لو تفحص سياق قوله تعالى «والله يعصمك من الناس» لأدرك أن عظمة نبى هذه الأمة لا تكمن فى عصمته وارتفاعه عن أفق البشر- وما العظمة فى هذا إذا كان الأمر محض اختيار وترتيب إلهيين لا تعليل لهما بقدر ما تكمن فى ارتفاعه هو بجهده واختياره إلى آفاق المسئولية الكونية دون أن يفارق بشريته.
لكن ما هو الخطر فى ذلك؟
الخطر إنما يكمن فى ذلك الفهم السقيم للإسلام الذى من شأنه أن يرسخ سلطة رجل الدين والمؤسسات الدينية، لتصبح سلطة شاملة ومهيمنة فى كل المجالات.
ومن شأن هذا الاستفحال والامتداد السلطوى أن يخلق وضعًا نعانى منه الآن أشد المعاناة اجتماعيًا وسياسيًا وفكريًا.
فبرغم كل الادعاءات والدعاوى العريضة، والفارغة من المضمون، عن عدم وجود سلطة دينية فى الإسلام تشبه سلطة الكنيسة فى المسيحية، فالواقع الفعلى يؤكد وجود هذه السلطة، بل وجود محاكم التفتيش فى حياتنا. والسلطة هذه تجمع السياسى والدينى فى قبضة واحدة، فيصبح المخالف السياسى مارقًا خارجًا عن الإجماع ومهددًا لوحدة الأمة، وبالمثل يقول رجل الدين إن من يغير دينه يجب التعامل معه بوصفه خائنًا للوطن.
إن اتحاد الدين والوطن يجد تعبيره فى كل الدساتير السياسية التى تحصر الوطن فى دين، وتختزل الدين فى الوطن، وهنا يُخْتَزَلُ الوطن فى الدولة، وتُخْتَزَل الدولة فى نظامها السياسى، ويجد المواطن نفسه حبيس أكثر من سجن، إن مقولة الإسلام دين شمولى تبدأ من الفكر الدينى لتخترق مجال السياسة والمجتمع، أو تبدأ من الفكر السياسى لتأسر الدين فى أيديولوجيتها، والنتيجة واحدة.
فأى خطر أشد من هذا وأى بلاء!
إن الإسلام تجربة تاريخية علينا الاستفادة منها، لأنها تعلمنا الكثير.
إنها تعلمنا مثلًا أن التمسك به كدين ومعتقد دون العمل على تجديده من أجل أن يلبى طموحات هذه المجتمعات ويجيب على التحديات التى تواجهها من شأنه أن يؤدى إلى مثل هذا الاختزال الذى نشكو منه الآن، الاختزال المسئول عن هذا الاستفحال السرطانى لسلطة الخطاب الدينى/ السياسى أو السياسى/ الدينى الذى يسجن الفرد باسم دين الحرية فى سلاسل من القهر والامتثال والإذعان تحت زعم «طاعة الله»، الذى يمثله خليفة أو سلطان أو أمير أو جماعة تحتكر الإسلام ومغفرة الرب.
نحن بحاجة إلى تثوير فكرى لا مجرد تنوير، وأقصد بالتثوير تحريك العقول بدءًا من سن الطفولة، فقد سيطرت على أفق الحياة العامة فى مجتمعاتنا، سواء فى السياسة أو الاقتصاد أو التعليم - حالة من الركود طال بها العهد حتى أوشكت أن تتحول إلى موت.
هذه الظاهرة مشهودة فى أفق الحياة العامة، ولا تغرنك مظاهر حيوية جزئية هنا أو هناك، فى الفنون والآداب بصفة خاصة، فستجد أن بؤر الحيوية تلك مثل بقع الضوء التى تكشف المساحات الشاسعة للظلمة، فإذا وصلنا إلى مجال الفكر، فحدث عن اغتراب الفكر وغربة المفكرين.
هل تحتاج مجتمعاتنا إلى تنوير فقط؟
التنوير يفترض وجود فكر يحتاج إلى قدر من الاستنارة، ونحن للأسف مخاصمون للفكر، وما يسمى فكرًا ظلاميا لا يمت لأفق الفكر ولا لمجاله بأى معنى من المعانى، إنما هو فى أفضل أحواله ترديد المقولات وعبارات، لا يعرف مرددوها أنفسهم أصل مولدها، ولا سياق منشئها وتطورها، فضلًا عن غايتها ومغزاها.
سل أصحاب هذا الفكر وممثليه مثلًا: هل يعلمون أن قضية «قدم» القرآن و«حدوثه» كانت من القضايا التى حسمتها السلطة السياسية، لا الحوار الفكرى الحر، حين تدخلت مرة باسم العقلانية فاضطهدت القائلين بأن القرآن «قديم» لأنه «كلام الله الأزلى وصِفَةٌ من صفات ذاته الأزلية القديمة»، ثم تدخلت مرة أخرى، ولكن بحجة درء الفتنة، وناصرت أصحاب نظرية «القدم» واضطهدت القائلين بأن القرآن مُحْدَثُ مخلوق لأنه أصوات وكلام ولغة حادثة، لا يجوز أن تتصف الذات الإلهية بها؛ فكلام الله إذن صفة من صفات أفعاله لا من صفات الذات؟
هل يعلمون أن ما يتصورونه من حقائق العقيدة المنزلة فيكررون أنه معلوم من الدين بالضرورة، ليس إلا قرار سلطة سياسية، لا تقل فى ديكتاتوريتها وعدائها للفكر عن السلطة التى سبقتها واضطهدت الفكر باسم العقلانية؟
وهل يعلمون أن موقف «الأشاعرة»، الموقف الوسطى الذى لا يكلون أبدًا من الادعاء بأنه صحيح الإسلام، قد ميّز بين صفة الكلام النفسى القديم وبين محاكاته فيما نتلوه نحن من قرآن حادث؟
وهل يعلمون أن الأشاعرة اضطربوا اضطرابًا عظيمًا فى تحديد أين يقع «الإعجاز»، أهو واقع فى الكلام النفسى القديم، وفى هذه الحالة: ما معنى تحدى العرب أن يأتوا بمثله؟ وإن كان التحدى واقعًا فى المحاكاة الحادثة وليس فى الكلام القديم، فالإعجاز إنسانى وليس إلهيًا؟
وهل يعلمون أن الذى استطاع أن يطرح للإعجاز تفسيرًا يتجاوز ثنائية الكلام النفسى القديم والمحاكاة الحادثة» هو «عبدالقاهر الجرجانى» صاحب نظرية «النظم» الذى أفاد من إنجازات المعتزلة كما أفاد من إنجازات اليونان؟
وهل يعلمون أنه اشترط «دراسة الشعر» من أجل اكتشاف قوانين الكلام البليغ التى لا يمكن فهم الإعجاز إلا بها؟
ثم أخيرًا ألا يدركون أن «المنهج الأدبى» هذا الذى يطرحه عبدالقاهر هو الأساس المعرفى للمنهج الأدبى الحديث والمعاصر فى فهم القرآن وتفسيره، مضافًا إليه إنجازات علوم اللغة والبلاغة والنقد الأدبى فى العصر الحديث؟
إن حالة مخاصمة الفكر تلك، والتنكر له تنكرًا تامًا، هى المسئولة عن شيوع نهج التكفير فى حياتنا. ولا أقصد التكفير الدينى فقط، وإن كان أخطر أنماط التكفير، ولكننى أشير أيضًا إلى التكفير السياسى والعرقى والثقافى، وكل أنماط الاستبعاد والإقصاء.
إن التكفير هو النهج الكاشف عن مخاصمة «التفكير» والانقلاب ضده، ولا غرابة فى ذلك فالمفردتان اللغويتان «فكَّر» و«كفَّر» تنتميان إلى مادة لغوية واحدة من حيث أصل الاشتقاق، إنها مادة الفاء والكاف والراء «فكَّر» تم قلبها بتقديم الكاف على الراء مع بقاء التضعيف بالشدَّة على الحرف المتوسط فى الحالتين، وهكذا انقلب التفكير إلى تكفير.
وتثوير الفكر الذى نحتاج إليه يتطلب السعى إلى تحريك العقول بالتحدى والدخول إلى المناطق المُحرَّمة، وفتح النقاش حول القضايا التى تفتح إمكانات التفكير، وتُدخل النور إلى المناطق المعتمة التى يعتبرها الفقهاء من اختصاصهم وحدهم، وأن قولهم فيها هو القول الفصل، وليس فقط اجتهادًا من بين اجتهادات.
وأهم من ذلك التخلص من ذلك الجدار العازل الذى طال وجوده فى ثقافتنا بين العامة والخاصة، فتلك الدعوات التى تتردد بين الحين والآخر عن حصر النقاش فى بعض القضايا الدينية داخل دائرة أهل العلم، حتى لا تتشوش عقائد العامة أو يصيبها الفساد، دعوات فى ظاهرها الرحمة والحق وفى باطنها السوء والباطل.
كيف يمكن فى عصر السماوات المفتوحة التى تنقل العالم إلى غرف النوم، وفى عصر اكتساح ثورة المعلومات لكل الحدود، حتى شاهد العالم كله بالصوت والصورة أسرار الحياة الجنسية للرئيس الأمريكى، كيف يمكن فى عصر كهذا أن يطالب البعض بحماية «العامة» من خطر الفكر العلمى فى القضايا التى تمس حياتهم. إنه للأسف منطق «الوصاية» يتذرع باسم الحماية لممارسة ديكتاتورية فكرية وعقلية لا تقل خطرًا عن الديكتاتورية السياسية فى مجتمعاتنا.