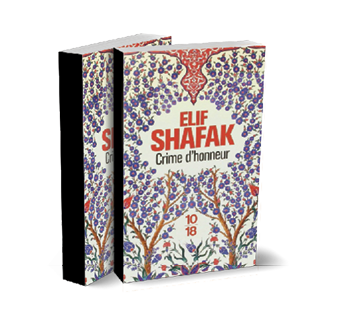أليف شافاك تتحدث عن «الأدب فى عصر القلق»

- الكتاب يمكنهم الحفاظ على شعلة السلام والتعايش والتعاطف مشتعلة
- أعتقد أن هذا العالم سيصبح مكانًا أكثر خطورة وانكسارًا إذا أصبح عصر اللا مبالاة
«عقل الأديب لا يمكن أن يكون منعزلًا عما حوله».
إنه وقت غريب لنكون فيه أحياء، ووقت غريب لنكون فيه كتّابًا.
فى عالم لا يزال منقسمًا بدرجة كبيرة، ومسيّسًا لحد مؤلم، وممزقًا بعدم المساواة والحروب، وبالقسوة التى يمكننا أن نمارسها على بعضنا البعض على هذه الأرض.. منزلنا الوحيد. فى بيت أو عالم مضطرب كهذا، أى شىء يمكن للكتّاب والشعراء أن يأملوا فى تحقيقه؟، ما المكان الذى يمكن للقصص والخيال التواجد فيه فى هذا العالم.. عندما تتحدث القبلية والتدمير والتهميش بصوت أعلى وأجرأ؟
إذا سمحتم لى أن آخذكم إلى الماضى، فإننا، من كان منا فى سنٍ تكفى، سنتذكر لحظة مختلفة فى التاريخ، ليست ببعيدة، كان هناك شعور ملموس بالتفاؤل يملأ الأجواء. سقط جدار برلين. انهار الاتحاد السوفيتى. كان الناس يتحدثون عن «انتصار الديمقراطية الليبرالية». وأصبح هناك افتراض بأن التاريخ من الآن فصاعدًا سيتحرك فى خط مستقيم إلى الأمام. «أما بالنسبة لنا نحن رواة القصص، فالزمن لا يتحرك فى خط مستقيم؛ عندما تكتب القصص، تشعر بأن الزمن يمكنه أن يعود إلى الوراء، وأيضًا أن يتقدم، وأحيانًا يرسم دوائر». فى أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، كان المتفائلون بانتشار وتقدم التكنولوجيا. يقولون لنا إن انتشار التكنولوجيا الرقمية سيجعل المعلومات تنتشر بسهولة فى كل مكان، وإن الناس سيصبحون أكثر علمًا، وسيقومون باتخاذ قرارات مستنيرة، مرجعها العقل، بالتالى ستسود الديمقراطية فى كل مكان.
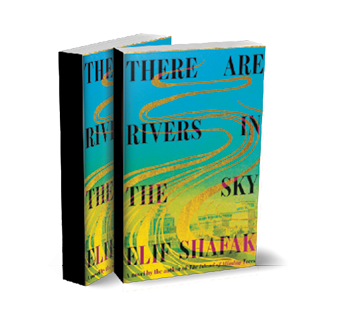
لكن وجود المعلومات لا يعنى المعرفة، والمعرفة لا تعنى الحكمة.
اليوم، نعيش فى عالم يحتوى على كم هائل جدًا من المعلومات، ولكن فى المقابل توجد معرفة قليلة وحكمة أقل. تتساقط علينا مقتطفات من المعلومات كل يوم. ونحن نتصفح لأعلى ولأسفل، أكثر من مجرد عادة، ليس لدينا وقت لمعالجة ما نراه، ولا وقت لاستيعابه أو التفكير فيه أو الإحساس به. تعطينا فرط المعلومات وهم المعرفة. والحقيقة أننا فقدنا القدرة منذ زمن على قول «لا أعرف». لا ننطق بهذه الكلمات بعد الآن. إذا لم نعرف الإجابة عن شىء ما، يمكننا ببساطة أن نبحث عنها فى «جوجل»، ونقول بضع كلمات حولها، لكن هذا ليس معرفة.
للحصول على المعرفة الحقيقية، علينا أن نبطئ وتيرتنا. نحن بحاجة إلى مساحات ثقافية، إلى مهرجانات أدبية، إلى تبادل فكرى صادق ومفتوح. نحتاج إلى الصحافة الثقافية الكلاسيكية. نحتاج إلى الكتب.
أما الحكمة، فهى تتطلب منا أن ندخل قلوبنا فى عملنا وفى محادثاتنا. نحتاج إلى بناء ذكاء عاطفى. نحتاج إلى التعاطف. نحتاج إلى الأدب.
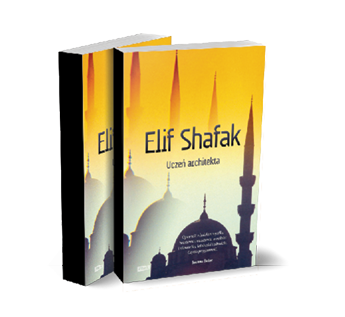
أنا لا أدعى أن الكتّاب أشخاص حكماء؛ بالتأكيد نحن لسنا كذلك. ما أدعيه هو أن الكتابة الروائية تربطنا بشىء أكبر منا، وأقدم منا، وأكثر حكمة منا. وهذا الشىء هو فن السرد القديم. إنه عالمى. لا ينتمى إلى أى قبيلة أو منطقة أو دين. لا يمكن حصره ضمن أى حدود.
بصفتى روائية، أنا مهتمة بشدة بالإيكوفيمينية، التى تهدف إلى ربط النقاط بين قضايا تبدو منفصلة. على سبيل المثال، من بين أكثر عشر دول تعانى نقص المياه فى العالم، سبع منها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أنهارنا تجف. النساء فى جميع أنحاء العالم يحملن الماء. عندما لا يكون هناك مصدر ماء قريب، تزداد المسافة التى يجب على الشابة قطعها، وللأسف يزيد ذلك من احتمال تعرضها للعنف القائم على النوع. لذلك إذا كنا نهتم بنقص المياه، فعلينا أن نهتم بعدم المساواة بين الجنسين، وإذا كنا نهتم بعدم المساواة بين الجنسين، فعلينا أن نهتم بعدم المساواة العرقية، وهكذا.
فن السرد كله يتعلق ببناء الروابط.
نحن ككتّاب نعشق القصص، بالطبع، ولكن يجب أن نكون مهتمين بالصمت بنفس القدر. كل من تم محو قصته، ودفعه إلى الهامش وتم نسيانه، كل من شعر بأنه «الآخر».. المنبوذ. تتحرك قلوبنا وأقلامنا بشكل لا إرادى فى اتجاهه.
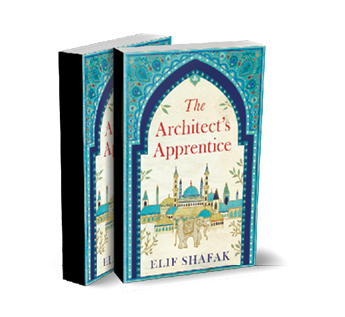
الأدب يجلب من هم فى الهامش إلى المركز ويعيد إنسانية من تم تجريده من إنسانيته. لهذا السبب، يعد رواد القصص حُماة للذاكرة.
بالنسبة للروائية تونى موريسون، كان الصراع، المعركة الشرسة بين التذكر والنسيان، هو ما يحفزها على الكتابة. كانت تكتب عن «التاريخ مقابل الذاكرة، والذاكرة مقابل انعدام الذاكرة».
معظم التاريخ الذى يتم تدريسه لنا فى تركيا هو «تاريخه» «أى تاريخ قلة من الرجال فى مواقع السلطة»؛ مثل السلاطين. كيف كانت الحياة فى الإمبراطورية العثمانية للنساء؟ أين قصص النساء؟ صمت. كيف كانت الحياة للأقليات؟ للفلاح الكردى، لصانع الفضة الأرمنى، لطاحن الحبوب اليهودى، للمزارع العربى، للبحار اليونانى.. صمت. لذا، ككتّاب علينا أن ننقب بعمق فى طبقات التاريخ المنسى لاستكشاف القصص التى لم تروَ.
علينا أيضًا أن نربط بين الثقافات المكتوبة والشفوية.
فى عصر المعلومات السريعة، والإشباع الفورى، والاستهلاك السريع، وتدمير المناخ، يمثل الأدب- ويجب أن يمثل- عملًا من أعمال الأمل. ومقاومة. مقاومة ليست بالقوة، بل بقدرته على تذكيرنا بإنسانيتنا المشتركة.
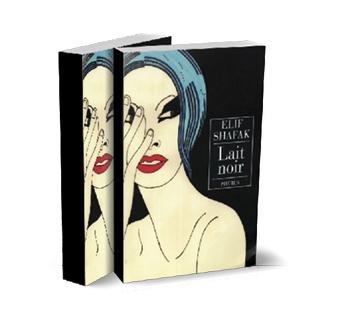
وصفت الكاتبة دوريس ليسينج الأدب ببلاغة بأنه «تحليل بعد الحدث». أفهم ذلك. تحدث الأمور ويحتاج الكتّاب إلى وقت لمعالجتها، ثم نكتب بأثر رجعى، بعد فوات الأوان.
لكن اليوم دخلنا عالمًا جديدًا. فى هذا الوقت ونحن نشهد الانهيار البيئى والحروب، والاستقطاب المتزايد وتزايد الفجوات، وحظر الكتب، وعجزنا عن التعلم من التاريخ، فى هذا المنعطف المهم، يجب أن يكون الأدب ليس فقط تحليلًا بعد الحدث، بل تحليلًا أثناء الحدث.
لكن كيف يمكننا أن نجد الإرادة لمواصلة كتابة القصص فى هذا عصر القلق؟ كيف يمكننا أن نثق بالكتب وقدرتها على تغيير العالم؟ لأن الإرادة يمكن أن تضيع بسهولة. أينما نظرتم، شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا، ستجدون أن الناس يشعرون بالقلق. الشباب والكبار. الجميع متأثرون بالقلق الوجودى، والفرق الوحيد هو أن بعض الناس أفضل فى إخفائه.
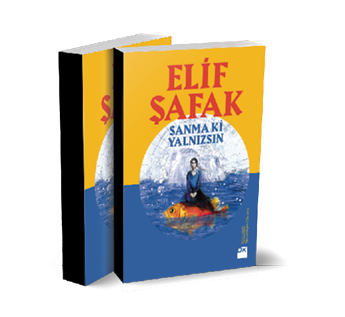
إذًا هناك القلق، الغضب، الإحباط، الاستيا.. إنه عصر تسود فيه العواطف.. التى تعمل السياسة على تضليلها. كل هذا يمثل تحديًا، ولكن إذا كان هناك شعور يخيفنى، فهو غياب كل المشاعر. إنه الخدر.
أعتقد أن هذا العالم سيصبح مكانًا أكثر خطورة وانكسارًا إذا أصبح عصر اللا مبالاة. اللحظة التى نتوقف فيها عن الاهتمام والكتابة والحديث عما يحدث اليوم فى غزة، فى أوكرانيا، فى السودان.. اللحظة التى نصبح فيها غير مبالين، منقسمين، لا مبالين. هذا ما حذرتنا منه الفيلسوفة حنة أرندت.
الأدب هو الترياق للخدر. الكتّاب لا يمكنهم إيقاف الحروب. لا يمكنهم جعل الكراهية تختفى. ولكن يمكنهم الحفاظ على شعلة السلام والتعايش والتعاطف مشتعلة. قوة الأدب تكمن فى تذكيرنا بقدرتنا ليس فقط على التدمير والانقسام، بل أيضًا على الجمال، والتضامن، والأخوّة، والحب.