محمود أبورية.. سيرة مجدد عظيم
دين الله واحد.. كشف الستار عن المعنى الحقيقى للإسلام

تحرك محمود أبورية لتأليف هذا الكتاب «دين الله واحد على لسان الرسل» من تجربة عملية مر بها.
كان يجلس فى مجلس يضم بعض رجال الدين، فدخل عليهم أحد المحامين الشرعيين وقال فى أسى: لقد مات اليوم فلان، رحمه الله، وما إن نطق باسم الميت وكان محاميًا قبطيًا حتى قامت صيحات من بعض من كانوا معه تستنكر على أخيهم أن يطلب الرحمة من الله لهذا القبطى، فبُهت المحامى ولم يستطع أن يجيب بشىء.

تعجب محمود أبورية مما حدث، وقال لهم: ماذا فيما قاله الأستاذ المحامى؟
فأجابوا: كيف يطلب الرحمة لنصرانى وهو كافر، والرحمة لا تنال الكافرين؟
فقال لهم: إذا كان حكمكم على الكافر صحيحًا، فإن النصرانى ليس بكافر.
أصر الموجودون على رأيهم.
فقال لهم: إذا كان النصرانى كافرًا، فكيف يباح للمسلم أن يتزوج بالنصرانية، والآية الكريمة تقول «ولا تمسكوا بعِصم الكوافر».
أجاب بعضهم: إن هذا لا يجوز.
فرد أبورية: لقد جهلت دينك، إن للمسلم أن يتزوج النصرانية، وعليه أن يرافقها فى أيام الآحاد والأعياد إلى كنيستها؛ لتسمع المواعظ من قسيسها.
لم يُسلم الموجودون بكلام أبورية، ونهض أحدهم فقال: إن النصارى مشركون.
فقال: إن الأمر فى هذه كالأمر فى تلك، لأن الآية تقول «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن».
أصر بعضهم على أن النصرانى لا تشمله رحمة الله.
فقال لهم أبورية: يا هذا.. ألم يكن النصرانى من بنى آدم؟ وألم يكن من الناس؟ فقالوا جميعًا: بلى، فقال: إذن اقرأوا هاتين الآيتين الكريمتين «يا بنى آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» و«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير»، فكل من يتقى الله ويصلح فلا خوف عليه، والأساس الأول هو التقوى.
وهنا انتفض أحد الموجودين، وقال: إن التقوى خاصة بالمسلمين، والمتقون هم المسلمون.
فقال أبورية: يا مولانا الشيخ إن تقوى الله مطلوبة فى كل مخلوق، وأهل الكتاب قد أمروا قبلنا بتقوى الله، ووصاهم الله بها كما وصانا، فقال تعالى «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله».

قال أحدهم: كأنك تجعل النصارى من أهل الكتاب؟
فأجابه أبورية: لست أنا الذى أجعلهم من أهل الكتاب، وإنما الذى جعلهم هو الله سبحانه، وقد أمر الله محمدًا، صلى الله عليه وسلم، أن يخاطبهم على أنهم أهل كتاب، وذلك فى قوله تعالى: «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون».
فقال مُحدثه: وهل تنال رحمة الله أهل الكتاب كما تنال المسلمين؟
فرد أبورية: إن باب رحمة الله مفتوح على مصراعيه لكل عباده، واقرأ إذا شئت قوله تعالى «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»، فكل من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحًا فهو ناجٍ بفضل الله إن شاء الله، ذلك بأن هذه الصفات الثلاث هى أركان الدين الأساسية على لسان كل رسول، فمن اتبع أحكامها وأقام أصولها من أى دينٍ كان، فاز برضوان الله، ومن أخل بشىء منها واتبع هواه، فأمره إذن إلى الله، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه، وهو سبحانه غفور رحيم، لا يُسأل عما يفعل.
لم يكن هذا هو الموقف الوحيد الذى حرك أبورية فى اتجاه كتابه، كان هناك موقف آخر، سأتركه هو يحكى لكم عنه.
يقول: لا أنسى جدالًا قام بين شيخ مسلم وبين أحد إخواننا الأقباط، قال فيه هذا الشيخ عندما احتدم الجدال: حقًا لقد صدق الله العظيم حيث يقول «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم»، فكدت أتميز من الغيظ لجهل الشيخ بما فى كتابه، فقلت له: يا سيدنا الشيخ كيف تفترى على الله، وتستشهد بآية لا تفهم معناها؟ إن الله سبحانه لم يقل ذلك، فركبته الحماقة وقال: كيف ترمينى بالافتراء على الله والآية ثابتة فى المصحف، فقلت له: اقرأ ما قبلها وما بعدها يتجلى لك معناها.
ويضيف أبورية: ولما قرأ ما قبلها وما بعدها وعلم أن الذين قالوا ذلك هم اليهود بُهت، ولما أدركه الحصر قلت له: حرام عليكم يا مولانا أن تفتروا على الله، وأن تأخذوا ما فى المصحف الشريف وتفهموه على ما يقضى به علمكم، وتوقدوا بذلك نار الفتنة بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب وبخاصة النصارى، والذين أشار إليهم القرآن بأنهم أقرب الناس مودة للمسلمين، وذلك فى الآية الكريمة «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانًا وأنهم لا يستكبرون»، وجاءت الوصية الكريمة من محمد، صلوات الله عليه، صريحة بالوصية بالقبط فقال: «استوصوا بالقبط فإن لهم ذمة ورحمًا».
يدخل أبورية من هذين الموقفين إلى صلب موضوعه، فهو أمام حالة سيئة، يقول عنها: أعرقت هذه الحالة فينا على مدى الأجيال، ونال العالم منها ما ناله من الضرر والوبال لتدعو العقلاء والمفكرين وأهل الرأى إلى أن يتداركوها، وأن يطبوا لها ما استطاعوا، وإن أنجع دواء لهذه العلة المزمنة هو أن يعرف أهل الكتب السماوية جميعًا أن دين الله واحد على ألسنة جميع رسله، وأن هؤلا الرسل الكرام إخوة متحابون لا عداء بينهم ولا خصام، وأن الغرض من رسالتهم واحد، وأن الذى بعثهم جميعًا بأصول هذا الدين واحد، وأن هذه الأصول لا تخالف فيها ولا تباين، فإذا عرفوا ذلك تقطعت بينهم أسباب الخلاف وارتبطت القلوب بأواصر المحبة والائتلاف.
ويوضح لنا أبورية دافعه إلى البحث فى وحدة الأديان، يقول: لقد قضيت حياتى كلها فى الدعوة إلى اتحاد رجال الأديان كما اتحدت أصول الأديان، وأن ينبذوا ما نشأ من خلاف بينهم يكرهه الله مالك الملك، وأن يعتصموا بحبل الله جميعًا وألا يتفرقوا، وأن يعقدوا الخناصر على القيام بنشر ما يدعو إليه الدين الحق من كرائم الآداب وأمهات الفضائل، ويكونوا قدوة حسنة لمن ورائهم من المتدينين، وبذلك يسعد الناس جميعًا ويعيشون فى هناء وصفاء لا حقد بينهم ولا بغضاء.

وعن نشر دراسته يقول أبورية: وقد استخرت الله فى أن أنشر هذه الرسالة الموجزة لأبين لإخوتى المخلصين من أهل الأديان أجمعين أن دين الله على ألسنة رسله كما قرأناه فى كتبهم واحد، وصادر من إله واحد، أراد به سبحانه وتعالى هداية خلقه على اختلاف أجناسهم وألوانهم، فى كل زمان ومكان، معتمدًا فى ذلك على أقوى الأدلة التى يرضى عنها العلماء المخلصون، من صحيح النقل وصريح العقل، وقد سلكت فى وضعها الطريق الصحيح، والمحجة البيضاء مبتعدًا ما استطعت عن مثارات الخلاف التى لا يهب منها إلا ريح الجدل العقيم الذى لا نفع منه ولا جداء، وإنما يزيد فى مدى الفرقة والشقاء، وما الذى يعود بالخير علينا إذا ظلت القلوب على ما فيها من بغضاء ولبثت بعض الصدور تحمل ما تحمل من شحناء، إن فى ذلك ولا ريب لبلاء أى بلاء.
ويؤكد أبورية أهمية بحثه عندما يقول: إننا الآن فى حياتنا الجديدة لفى أشد الحاجة إلى هداة مخلصين من كل ملة ودين ينشرون الألفة، ويدعون إلى المحبة بين الناس أجمعين، ومن رأيى أن كل من يعمل على إثارة الخلاف فى البلاد، وبث روح التفرقة الخبيثة بين الناس، لا يكون مخلصًا فى إيمانه الدينى ولا صادقًا فى ولائه الوطنى.
يدخل بنا محمود أبورية بعد ذلك فى الموضوع مباشرة.
فدين الله واحد فى الأولين والآخرين، لا يختلف إلا فى صوره ومظاهره، وأما روحه وحقيقته وهو ما طولب به العالمون أجمعون على ألسن جميع الأنبياء والمرسلين فلا يتغير، وهو إيمان بالله الواحد الأحد، وإخلاص له فى العبادة، وأن يتعاون الناس فى معاشهم على البر والتقوى، وألا يتعاونوا على الإثم والعدوان.
هذا هو دين الله الذى أرسل به الرسل فى كل أمة، ولكل قوم على مدى الدهور والأزمان، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
وقد علم من بيان الأديان الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، أن أول رسول أرسل إلى الناس بعد آدم هو نوح عليه السلام، ولذلك جاءت الآية القرآنية «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه».
وفى حديث نبوى: «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم فى الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة أمهاتهم شتى ودينهم واحد».. وفى حديث آخر: «إنا معشر الأنبياء ديننا واحد».
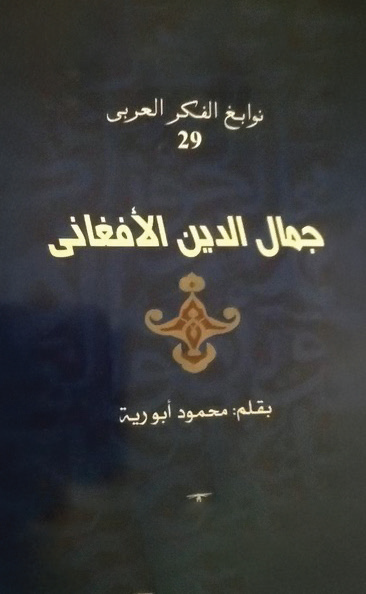
يقول البخارى فى تفسير ما جاء من أن دين الأنبياء واحد، إن دين الله الإسلام الذى أخبر الله أنه دين أنبيائه ورسله، من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بمنزلة الأب الواحد، وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف، فهى بمنزلة الأمهات الشتى، وكون الأم بمنزلة الشريعة، والأب بمنزلة الدين، وأصالة هذا وتذكيره وفرعية الأم وتأنيثها، واتحاد الأب وتعدد الأم ما يدل على أنه معنى الحديث.
ويقول ابن كثير فى تفسير «شرع لكم من الدين»: الدين الذى جاءت به الرسل هو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» أى القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم، قال الله تعالى «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا»، ولهذا قال تعالى هنا «أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه»، أى أوصى الله تعالى جميع الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، بالائتلاف والاتفاق، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف.
ويقول الإمام محمد عبده فى رسالة التوحيد: صرح الإسلام تصريحًا لا يحتمل الريبة أن دين الله فى جميع الأزمان وعلى ألسن جميع الأنبياء واحد، قال الله تعالى «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورًا».
ومعنى أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح إلخ، أى أمثاله فى جنسه وموضوعه، والغرض منه أنهم يصدرون عن نبع واحد، وخص منهم أشهر أنبياء بنى إسرائيل المعروفين عند أهل الكتاب.
ويشير أبورية إلى أن دعوة رسل الله جميعًا كانت مبنية على أصل واحد، أن يبينوا للناس أنه لا إله إلا هو، ليؤدوا له ما يجب من العبادة الخالصة التى يستحقها سبحانه.
قال تعالى «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون».
وقال «ولقد بعثنا فى كل أمة رسولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت».
وقال تعالى عن أول الرسل نوح «ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون».
وقال عن هود «وإلى عاد أخاهم هودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره».
وقال عن صالح «وإلى ثمود أخاهم صالحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره».
وقال عن إبراهيم «وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون».

دين الله إذن واحد، وأساس دعوة رسل الله مبنية على أصل واحد، وأصول هذا الدين ثابتة لا تتغير بتغير الأزمان، وإنما الذى يتغير الشرائع والمناهج، فلكل رسول شرعة ومنهاج، وهذه الأصول هى الإيمان بالله والعمل الصالح.
فى سورة البقرة يقول الله تعالى «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون».
وعن هذه الآية يقول الأستاذ الإمام محمد عبده: إن الرسل، عليهم السلام، كانوا متفقين فى الدعوة إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل الصالح، وإنما كانوا يختلفون فى تفصيل الأعمال الصالحة والشرائع المصلحة، حسب اختلاف استعداد أممهم، وقد طرأت على أتباعهم من بعدهم بدع وثنية وخرافية، وضاعت أكثر تعاليمهم من الأمم القديمة، وإنما بقيت بقيّة صالحة عند المتأخرين من اليهود والنصارى فيها من الشوائب، وكذلك بقيت من جميع الأديان القديمة آثار تاريخية تدل على توحيد الله تعالى، كما نراه فى تاريخ قدماء المصريين والفرس واليونان ووثنيى الهند واليابان والصين.
ويقول أيضًا: أحاط القضاء فى الآية السابقة باليهود فلم يدع منهم حاضرًا ولا غائبًا فألزم الذل باطنهم وكسا بالمسكنة ظاهرهم، وبوأهم منازل غضبه، وجعل أرواحهم مسقط نقمة، فذلك الله الذى يقول «وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله»، سجلت الآية عليهم هذا العذاب الشديد بما كسبت أيديهم، واستشعرت قلوبهم من كفر بآيات الله، وانصراف عن العبرة، واستعصاء على الموعظة، وخروج عن حدود الشريعة، واعتداء على أحكامها، اقترف ذلك سلفهم وتبعهم عليه خلفهم، فلو قر الخطاب عندها ولم ينلها من رحمته ما بعدها، لحق على كل يهودى على وجه الأرض أن ييأس، وأن لا يبقى عنده للأمل فى عفو الله متنفس، بل كان ذلك القنوط لازمًا لكل عاص، قابضًا على نفس كل مُعتد، لا فرق بين اليهود وغيرهم.
وسبب ما نزل باليهود هو عصيانهم، واعتداؤهم حدود ما شرع الله لهم، وسنن الله فى خلقه لا تتغير وأحكامه العادلة فيهم لا تتبدل، لهذا جاء قوله تعالى «إن الذين آمنوا» بمنزلة الاستثناء من حكم الآية السابقة.
وإنما ورد على هذا الأسلوب البديع متضمنًا جميع من تمسك بهدى نبى سابق، وانتسب إلى شريعة سماوية ماضية، ليدل على أن الجزاء السابق، وإن حكى على أنه من خطأ اليهود خاصة لم يصبهم إلا لجريمة قد تشمل الشعوب عامة، وهى الفسوق عن أوامر الله، وانتهاك حرماته، فكل من أجرم كما أجرموا سقط عليه من غضب الله ما سقط عليهم، وعلى أن الله جل شأنه لم يأخذهم بما أخذهم لأمر يختص بهم، على أنهم من شعب إسرائيل أو من ملة يهود، بل بما عصوا وكانوا يعتدون.
وأما أنساب الشعوب وما تدين به من دين، وما تتخذه من ملة، فكل ذلك لا أثر له فى رضا الله ولا غضبه، ولا يتعلق به رفعة شأن قوم ولا وضعتهم، بل عماد الفلاح، ووسيلة الفوز بخيرى الدنيا والآخرة، إنما هو صدق الإيمان بالله تعالى بأن يكون التصديق به سطوعًا على النفس من مشرق البرهان، أو جيشانًا فى القلب من عين الوجدان، فيكون الاعتقاد بوجوده وصفاته خاليًا من شوب التشبيه والتمثيل واليقين فى نسبة الأفعال إليه خالصًا من وساوس الوهم والتخيل، ويكون المؤمن قد ارتقى بإيمانه مرتقى يشعر فيه بالجلال الإلهى، فإذا رفع بصره إلى الجناب الأرفع أغضى هيبته وأطرق إلى أرض العبودية خشوعًا، وإذا أطلق نظره فيما بين يديه مما سلطه الله عليه شعر فى نفسه عزة بالله ووجد فيها قوة تصرفه بالحق فيما يقع تحت قواه لا يعدو حدًا ضرب له، ولا يقف دون غاية قدر له أن يصل إليها، فيكون عبدًا لله وحده سيدًا لكل شىء بعده.
وقوله تعالى «إن الذين آمنوا» مراد بذلك المسلمون الذين اتبعوا محمدًا، صلى الله عليه وسلم، والذين سيتبعونه، وكانوا يسمون المؤمنين والذين آمنوا.

وقوله «والذين هادوا والنصارى والصابئين» يراد به هذه الفرق من الناس التى عرفت بهذه الأسماء أو الألقاب، من الذين اتبعوا الأنبياء السابقين، وأطلق على بعضهم لفظ «اليهود والذين هادوا» وعلى بعضهم لفظ النصارى وعلى بعضهم لفظ «الصابئين».
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا، هذا بدل مما قبله، أى من آمن منهم بالله إيمانًا صحيحًا، وآمن باليوم الآخر كذلك، وعمل صالحًا تصلح به نفسه وشئونه، ومع من يعيش معه، وما العمل الصالح بمجهول فى عرف هؤلاء الأقوام، وقد بينته كتبهم أتم بيان «فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون».
أى أن حكم الله العادل سواء وهو يعاملهم نسبة واحدة لا يحابى فيها فريقًا، ولا يظلم فريقًا، وحكم هذه السنة أن لهم أجرهم المعلوم بوعد الله لهم على لسان رسولهم، ولا خوف عليهم من عذاب الله يوم يخاف الكفار والفجار مما يستقبلهم، ولا هم يحزنون على شىء فاتهم، وقد تقدم هذا التعبير فى هذه الآية.
فالآية بيان لسنة الله تعالى فى معاملة الأمم، تقدمت أو تأخرت، فهو على حد قوله تعالى «ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءًا يجز به ولا يجد له من دون الله وليًا ولا نصيرًا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرًا».
ويظهر بذلك أنه لا إشكال فى حمل من آمن بالله واليوم الآخر على قوله «إن الذين آمنوا» ولا إشكال فى عدم اشتراط الإيمان بالنبى، صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام فى معاملة الله تعالى لكل الفرق أو الأمم المؤمنة بنبى ووحى بخصوص الظانة أن فوزها فى الآخرة كائن لا محالة، مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو صابئية مثلًا، فالله يقول: إن الفوز لا يكون بالجنسيات الدينية، وإنما يكون بإيمان صحيح له سلطان على النفس وعمل يصلح به حال الناس، ولذلك نفى كون الأمر عند الله حسب أمانى المسلمين أو أمانى أهل الكتاب، وأثبت كونه بالعمل الصالح مع الإيمان الصحيح.
ويرسم أبورية مشهدًا دالًا وموحيًا بكل ما يريد أن يقوله من خلال رواية أخرجها ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى.
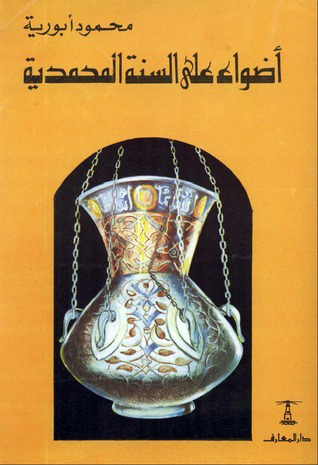
فقد التقى ناس من المسلمين واليهود والنصارى.
قال اليهود للمسلمين: نحن خير منكم، ديننا قبل دينكم.. وكتابنا قبل كتابكم.. ونبينا قبل نبيكم ونحن على دين إبراهيم، ولن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى.
وقالت النصارى مثل ذلك.
فقال المسلمون: كتابنا بعد كتابكم ونبينا بعد نبيكم وديننا بعد دينكم، وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم، فنحن خير منكم، نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ولن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا.
وبسبب هذه الواقعة نزل قوله تعالى «ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءًا يجز به ولا يجد له من دون الله وليًا ولا نصيرًا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرًا ومن أحسن دينًا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفًا واتخذ الله إبراهيم خليلًا ولله ما فى ما السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شىء محيطًا».
ومن بين ما تطرق إليه محمود أبورية اقتحامه لما يقال من أن الدين عند الله هو الإسلام المحمدى فقط.
يقول: الدين فى اللغة هو الجزاء والطاعة والخضوع، أى سبب الجزاء ويطلق على مجموع التكاليف التى يدين بها العباد لله، فيكون بمعنى الملة والشرع، والإسلام مصدر أسلم وهو يأتى بمعنى خضع واستسلم، وبمعنى أدى، يقال: أسلمت الشىء إلى فلان إذا أديته إليه، وبمعن دخل فى السلم بمعنى الصلح والسلامة، وبالتحريك الخالص من الشىء ومنه قوله تعالى «ضرب الله مثلا رجلًا فيه شركاء متشاكسون ورجلًا سَلمًا لرجل».
ويضيف أبورية: وتسمية دين الحق إسلامًا يناسب كل معنى من معانى الكلمة فى اللغة.
قال تعالى «ومن أحسن دينًا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن»، وقد علم بذلك أن الحصر فى قوله «إن الدين عند الله الإسلام» يتناول جميع الملل التى جاء بها الأنبياء، لأنه روحها الكلية الذى اتفقت فيه على اختلاف بعض التكاليف وصور الأعمال فيها، وقد أخبر القرآن فى غير موضع أن الأنبياء كلهم دينهم الإسلام.
فقال نوح عليه السلام «فإن توليتم فما سألكتم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين».
وقال عن إبراهيم عليه السلام «ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين».
وقال يوسف عليه السلام «فاطر السموات والأرض أنت وليى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلمًا وألحقنى بالصالحين».
وقالت ملكة سبأ «رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين».

وقال موسى عليه السلام «يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين».
وقال سَحرة فرعون «وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين».
وقال الحواريون لعيسى عليه السلام «فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون».
وقال الله تعالى «أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعًا وكرهًا وإليه يرجعون».
وما يخلص إليه أبورية: أن المعنى، أيتولون عن الإيمان بعد هذا البيان، وهو أن دينه واحد، وأن رسله متفقون فيه، فيبتغون غير دين الله الذى هو الإسلام، وله أسلم من فى السموات والأرض، أى والحال أن جميع من فى السموات والأرض من العقلاء قد خضعوا له تعالى، وانقادوا لأمره طائعين وكارهين، وقد اختلفوا فى بيان إسلام الطوع والكره، فذهب بعضهم إلى أن الإسلام هنا متعلق بالتكوين والإيجاد والإعدام، وبالتكليف أى أنه تعالى هو المتصرف فيهم، وهم الخاضعون المنقادون لتصرفه.
ويستند أبورية إلى ما قاله الإمام محمد عبده من أن الإسلام هو تقرير حقيقة الدين، ذلك أن العرب كانت تدّعى أن لها دينًا خاصًا بها، وأنه الحق، وإن اختلفت فيه القبائل والشعوب، ومنهم من كان ينتمى إلى إبراهيم على وثنيتهم، وكذلك اليهود والنصارى كل يدعى دينًا خاصًا به وأنه الحق، فدين الله تعالى واحد فى حقيقته، وروحه التوحيد والاستسلام لله تعالى، والخضوع والإذعان لهداية الأنبياء، وبهذا كان يوصى أولئك النبيون أبناءهم وأممهم، فبيّن أن دين الله تعالى واحد، دين كل أمة، وعلى لسان كل نبى.
أما من أين جاءت الفرقة فى الدين؟
فيجيب أبورية على ذلك بقوله: جاءت من الجهل والتعصب للأهواء، والمحافظة على الحظوظ والمنافع المتبادلة بين المرءوسين والرؤساء، فالقرآن يطالب الجميع بالاتفاق فى الدين والاجتماع على أصليه: العقلى وهو التوحيد والبراءة من الشرك بأنواعه، والقلبى وهو الإسلام والإخلاص لله فى جميع الأعمال.







