ننفرد بمقدمة الطبعة الثانية لكتاب جابر عصفور «مواجهة الإرهاب»
الرواية والإرهاب.. كيف صنع الإخوان التطرف؟.. وكيف تخاذل المثقفون؟

- ظاهرة الإرهاب الدينى انفجرت فى زمن الرئيس السادات
- أحكام فقهية قديمة من قبيل أن المسلم لا يؤخذ بدم الذمى لا تزال تُشجع ا لإرهاب
- الإرهاب لن يكف عن التصاعد ما لم نستطع أن نواجهه مواجهة جذرية
- الإرهاب الدينى كالـفيروسات الفتاكة لا تهاجم إلا الأجساد الضعيفة المنهكة
- ارتفعت هجمات الإرهاب الدينى فى الرابع عشر من أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصام رابعة
- لا بد من وقفة جذرية إزاء همجية التتار الجدد الذين أفرخوا فى ليل المؤامرات الممتدة كى يختفى الشعراء والأدباء وأصحاب العقول النيرة
كان الدكتور جابر عصفور، ولا يزال، فى طليعة محاربى الإرهاب، بقلمه، وقد أمضى حياته لتأدية هذه الرسالة السامية، وكان لها اسهامات قيمة لعل أبرزها كتابه «مواجهة الإرهاب: قراءة فى الأدب المعاصر»، الذى يتضمن قراءات لإبداعات أدباء مصريين وعرب واجهوا أفكار الإرهاب والتطرف وفى طليعتهم نجيب محفوظ، يوسف إدريس، أحمد عبدالمعطى حجازى، فتحى غانم، عبدالحكيم قاسم، الجزائرى الطاهر وطار، السورى سعد الله ونوس.
وقد مضى الدكتور عصفور وترك كتاباته لتواجه العنف والتطرف، وفى معرض الكتاب المقبل تصدر الطبعة الثانية من «مواجهة الإرهاب: قراءة فى الأدب المعاصر».
«حرف» حصلت على مقدمة الطبعة الثانية، غير المنشورة، وتقدمها لقرائها فى هذا العدد.

فى شهر مايو سنة ٢٠٠٣، فرغت من كتابة الطبعة الأولى لكتابى «مواجهة الإرهاب: قراءة فى الأدب المعاصر»، وكانت هذه الطبعة تعتمد بالدرجة الأولى على قراءة نجيب محفوظ لكى أتتبع التحول فى تصويره للانتقال من شخصية المثقف التقليدى إلى شخصية المتطرف الدينى، فضلًا عن رواية «الزلزال» للكاتب الجزائرى الطاهر وطار، وقصة قصيرة ليوسف إدريس بعنوان «اقتلها»، ورواية صغيرة لعبدالحكيم قاسم بعنوان «المهدى»، ورواية «الأفيال» لفتحى غانم، ومسرحية سعد الله ونوس «منمنمات تاريخية»، ثم قراءات سريعة فى فيلم «الإرهابى» لعادل إمام تمثيلًا ولينين الرملى كتابة، ومسرحية «الزهرة والجنزير» لمحمد سلماوى، وأخيرًا رواية «الشمعة والدهاليز» للكاتب الطاهر وطار الذى افتتحت الكتاب بروايته «الزلزال» التى كنت أعدها أولى الروايات العربية التى واجهت الإرهاب الدينى، وحاولت أن ترسم صورة نفسية لشخصية الأصولى بالمعنى الدينى أو الإرهابى بالمعنى السياسى. وكان صدور الكتاب سنة ٢٠٠٣، احتجاجًا على الأحداث الكارثية للإرهاب باسم الدين، ولكن هذه الأحداث لم تتوقف والفجائع الدينية لم تنته، فقد توحش الإرهاب الدينى، وامتد أخطبوطه المريع حول الكرة الأرضية كلها، مؤكدًا أنه قد تعولم، وأنه لم يعد أحد فى العالم كله بمنجى عن أحداثه الوحشية أو جرائمه المرعبة التى تتناقض كل التناقض والدين الإسلامى السمح الذى أصبح البشر الأبرياء يغتالون باسمه، دون فارق كبير، بين الصغار والكبار.
لقد اقترن شيوع ظاهرة الإرهاب الدينى بمجموعة من العوامل المتضافرة، أدت إلى تولدها فى زمن السادات «سبتمبر١٩٧٠ - أكتوبر١٩٨١» وانفجارها فى آنٍ. وأول هذه العوامل سياسى، مرتبط بما يلازم وجود الدولة التسلطية من نزوع معادٍ للحريات والديمقراطية فى آنٍ، ومتحالف مع رجال الدين ومجموعات الإسلام السياسى فى الوقت نفسه؛ تحقيقًا لمصالح متبادلة، وتغطية لمظاهر الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى بأقنعة دينية مخايلة، تؤدى دورًا أيديولوچيًا فى التخييل للمواطنين بسلامة التوجه السياسى الذى يحقق دولة العلم والإيمان، أو الصورة المعاصرة للدولة البطريركية التى يقودها رب العائلة، إذ تعلو أخلاق القرية القديمة على لوازم المدينة الصناعية المحدثة، ويجرى تجريف المدينة أو تزييفها لحساب هذه الأخلاق، فتشيع المحسوبية، وينحدر التعليم الحديث، وتتبادل التبعية السياسية والاتباع الفكرى الوضع والمكانة، وتنتشر طبائع الاستبداد فى موازاة أنواع التعصب، ويوازى شيوع نزعات التدين تدنى النظرة إلى المرأة بما يجعل منها عورة لا بد من سترها أو تنقيبها، ويقابل القرب من الجماعات الدينية «سياسية الهدف، بطريركية البناء» البعد عن مؤسسات المجتمع المدنى بأهدافها التى تقترن بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

هكذا تحول المجتمع المصرى من بنية قيم موجبة «فى مجملها رغم تحفظات غياب الديمقراطية» إلى بنية قيم سالبة مضادة، معادية لمبادئ الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى استبدل بها النظام الساداتى مبادئ بنية قيم بطريركية استبدادية، تتمسح بالإسلام، وتقبل أسلمة القوانين التى لا تتناقض أصلًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وكانت النتيجة أن أصبحت جماعات الإسلام السياسى قوة، بل قوى نزاعة إلى التعصب، ميالة إلى العنف فى التعامل مع خصومها، منتقلة من العنف اللفظى إلى العنف المادى، مستبدلة بالمجادلة بالتى هى أحسن المجادلة بالتى هى أقمع. وهو وضع يقود إلى الإرهاب الذى وقع على خصوم المتأسلمين ورموزهم أولًا، وعلى المواطنين الأبرياء ثانيًا. ومع الأسف اقترن هذا الإرهاب بتمييز دينى ضد المواطنين المسيحيين، فأصبح إرهابًا ينسف مبدأ المواطنة الذى تقوم عليه دساتير مصر الحديثة، ابتداءً من دستور ١٩٢٣ إلى دستور ٢٠١٤.
وتعددت صور هذا الإرهاب الذى يؤكد معنى طائفيًّا، هو وصمة فى جبين الدولة الدستورية التى لا ينبغى أن تعرف التمييز بين مواطنيها. ومع الأسف، لا تزال تشجع على هذا الإرهاب أحكام فقهية قديمة، من قبيل أن المسلم لا يؤخذ بدم الذمى. وهى أحكام يؤسس لها فقه قديم، لا بد من تغييره، إذا أردنا بناء دولة مدنية أو وطنية حديثة، لا مكان فيها لهذا الوصف القبيح لغير المسلمين بأنهم أهل ذمة، بدل استخدام كلمة المواطنين التى تؤكد مساواتهم الكاملة بإخوانهم المسلمين فى الحقوق والواجبات التى نص عليها الدستور. ولكن جماعات الإسلام السياسى لا تعترف بالدستور والقوانين، ولا تؤمن إلا بالحاكمية وما تقدمه من تفسيرات لها، كأنها تشيع مبادئ التمييز فى المجتمع، فيعلو المسلم على المسيحى، والرجل على المرأة، والغنى على الفقير، والعسكرى الذى يمثل سلطة الدولة على المواطن الذى لا يملك سوى الخضوع للدولة التسلطية فى أغلب الأحوال.
وقد انبثقت ظاهرة الإرهاب الدينى فى زمن السادات نتيجة ذلك كله، واستمرت فى زمن حكم مبارك «أكتوبر١٩٨١ - فبراير٢٠١١» الذى لم يستجب إلى كل ما كتبناه عن ظاهرة الإرهاب الدينى وكيفية مواجهتها أو علاجها علاجًا جذريًّا. لذلك استمرت الظاهرة التى لم تتوقف فى زمن محمد مرسى «٣٠ يونيو ٢٠١٢ - ٣٠ يونيو ٢٠١٣» إلا لتبدأ مرة أخرى، بعد تحالف جماعات الإخوان المسلمين مع غيرها من الجماعات الدينية المتطرفة التى عولمت الإرهاب الدينى، والتى أوصلتنا إلى الوضع الذى أصبحنا عليه؛ خصوصًا بعد كارثة مسجد الروضة فى شمال سيناء «٢٤ نوفمبر ٢٠١٧». وهى كارثة تؤكد تفاقم الحال وتصاعده إلى درجة مخيفة؛ فالجناة هذه المرة مسلمون يمارسون جريمتهم ضد مسلمين، نتيجة خلاف مذهبى، لكن فى بيت من بيوت الله الإسلامية، هو مسجد لا يقل قداسة عن الكنيسة، فكلها بيوت الله، وساحاتها تكون للتسامح والتراحم لا القتل الذى يجاوز ضحاياه ثلاثمائة شخص.

والحق أنه لا يمكن مواجهة ظاهرة الإرهاب إلا جذريًّا، تحتل الثقافة والتعليم الأولوية المطلقة فيه، متضافرة مع غيرها من وسائل المقاومة المناقضة لكل ما أدى إلى الظاهرة من أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية.
لكن تبقى الحقيقة المؤكدة، وهى أن المبدع العربى لم يقصر فى مواجهة هذه الظاهرة، فمنذ صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة ٢٠٠٣ والمبدع العربى- كالمثقف العربى المستنير- لم يتوقف عن مواجهة الإرهاب الدينى؛ فقد امتدت المواجهة إلى أغلب أقطار الوطن العربى، وعيًا من مبدعى هذا الوطن الممتد من المحيط إلى الخليج بضرورة محاربة الإرهاب الدينى والتصدى له، إبداعًا وفكرًا فى كل مجال، فالمبدعون دائمًا هم الذين يشعرون بالخطر قبل غيرهم، ويتصدون دائمًا فى شجاعة لقول كل ما لا يجرؤ غيرهم على أن يقوله؛ دفاعًا عن المستقبل الواعد، ورفضًا للظلم القائم، مؤمنين دائمًا بأنوار العقل ومبادئ الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، فالكتابة عندهم موقف فى الحياة، ولأجل الحياة، وضد هؤلاء الذين:
قالوا لوردة الربيع لا تفوحى
لليمامات التى على الغصون لا تبوحى
ولنجمة العشية تلفعى بالغيم، أو فاحتجبى
وأسكتوا الصبية، قالوا لها: لا تكملى الأغنية!
قالوا لنا: لا تعبدوا الله كما ترونه
بل اعبدوه مثلما نراه نحن
إننا حجابه ونوابه فى أرضه
نحن رعاتكم هنا، وأنتم الرعية!
هذا هو منطق الإرهاب الدينى على نحو ما وصفه الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى الذى وقف مع أقرانه المبدعين ضد كل أشكال الإرهاب الدينى، مؤكدًا دائمًا قيمة الإنسان الحر والعقل المستنير اللذين يرفضان دائمًا كل أشكال القمع، بما فيها قمع الإرهاب الدينى الذى لا يزدهر إلا فى أزمنة القمع التى تستفز دائمًا روح المقاومة، فالإبداع دائمًا ضد كل قمع، أيًّا كان نوعه، وضد كل إرهاب مهما كانت صفته.
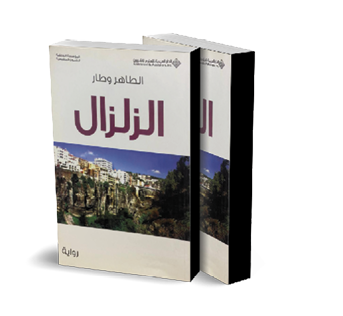
هكذا كرت الشهور والأعوام حاملةً معها كوارث تبدأ من كارثة تفجير برجى التجارة العالمية فى نيويورك فى الحادى عشر من سبتمبر سنة ٢٠٠١، مرورًا بهجمات مدريد التى وقعت فى الحادى عشر من مارس عام ٢٠٠٤، وتسببت فى مقتل ١٩١ شخصًا وجرح ما يزيد على ١٧٥٠ آخرين. وهجمات لندن الإرهابية، التى وقعت فى السابع من يوليو عام ٢٠٠٥، فقد شن «إرهابيون متشددون» عمليات انتحارية، بتزامن، استهدفت قطارات الأنفاق، وأسفرت عن مقتل ٥٠ شخصًا وإصابة ما لا يقل عن ٧٠٠ آخرين. وهجمات متزامنة فى مومباى العاصمة الاقتصادية للهند، إذ استهدف مسلحون فى السادس والعشرين من نوفمبر عام ٢٠٠٨ فنادق ومطاعم ومحطات قطارات أسفرت عن مصرع ١٩٥ شخصًا وإصابة مئات بجروح، وهجمات باريس فى ١٣ نوفمبر ٢٠١٥ التى استهدفت ستة مواقع مزدحمة فى العاصمة الفرنسية باريس، من بينها ملعب رياضى وقاعة حفلات ومطاعم وحانات، فقد شملت عمليات إطلاق نار جماعى وتفجيرات انتحارية واحتجاز رهائن، وأسفرت عن مقتل ما يزيد على ١٢٠ شخصًا، وانتهاءً بتفجير جريدة «شارلى إبدو» فى قلب العاصمة الفرنسية باريس فى ٧ يناير سنة ٢٠١٥ وقد واكب ذلك عمليات الإرهاب الدينى الذى شهدته مصر، وأذكر منها: الانفجارين اللذين حدثا فى التاسع من أكتوبر من عام ٢٠٠٤، وأوديا بحياة ما لا يقل عن ٣٤ شخصًا وإصابة أكثر من ١٥٠ بجراح، أغلبهم إسرائيليون، فى منتجعين سياحيين بطابا قرب الحدود مع إسرائيل. وتعرض منتجع شرم الشيخ عام ٢٠٠٥ لهجمات إرهابية من إحدى خلايا سيناء تزامنت مع احتفالات العيد القومى الرئيسى فى مصر ٢٣ يوليو، فقتل ٨٨ شخصًا، معظمهم مصريون، وجرح ما يزيد على ٢٠٠ شخص. وبعد ذلك بأقل من عامين فى ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد خلال عام ٢٠٠٧، وقع هجوم مسلح على «كنيسة العذراء» بالدخيلة أدى إلى سقوط نحو أربعة قتلى.
خلال عام ٢٠٠٩، كانت «كنيسة إمبابة» محطة جديدة للإرهاب، فقد تعدى عليها مجهولون بالقنابل والمولوتوف، واحترقت الكنيسة تمامًا، واستهدف التفجير أيضًا «الكنيسة الرسولية» بشارع البصراوى، و«كنيسة نهضة القداسة» بشارع الوردانى، والتى التهمت النيران جميع محتوياتها. وفى ليلة ٧ يناير عام ٢٠١٠، وقع تفجير دام بجانب مطرانية «نجع حمادى» فى محافظة قنا، راح ضحيته ٦ أقباط وعدد غير معلوم من المصابين، ووقعت المجزرة بواسطة عربات مجهولة فتحت النيران عشوائيًّا بكثافة على تجمعات الأقباط أمام المطرانية، والذين كانوا فى طريقهم إلى قداس الاحتفال بعيد ميلاد المسيح. وفى عام ٢٠١١، تزامنًا مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، استهدفت كنيسة «القديسين» بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية وراح ضحية الانفجار ٢٤ قبطيًّا ومئات المصابين.

والغريب أن كل هذه الجرائم توقفت فجأةً، خلال فترة حكم الإخوان المسلمين، الأمر الذى يدل على أنه كان لهم يد فيها قبل ذلك. ومع ذلك وبعد أن ثار الشعب المصرى على حكم الإخوان فى الثلاثين من يونيو ٢٠١٣ تواصلت الأحداث الإرهابية، التى بدأت باقتحام مبنى دار الحرس الجمهورى فى الثامن من يوليو ٢٠١٣، وقد ارتفعت هجمات الإرهاب الدينى فى الرابع عشر من أغسطس ٢٠١٣ بالتزامن مع فض اعتصام رابعة؛ إذ توجه آلاف من عناصر الإخوان إلى محيط قسم حلوان وحاولوا اقتحامه، الأمر الذى أسفر عن استشهاد ثلاثة ضباط وأفراد شرطة قسم حلوان ومقتل مواطنين تصادف مرورهم فى مكان الأحداث. وقد أحدث أفراد الجماعة ضررًا كبيرًا فى مبنى القسم وأحرقوه كله مع تحطيم نوافذه وإتلاف وتدمير عشرين سيارة تابعة للقسم وثلاث سيارات تابعة للمواطنين تصادف وجودها بالقرب من القسم، وذلك أثناء اقتحام الإخوان له. وتبع ذلك أيضًا الهجوم على ضباط وأفراد قسم كرداسة فى ١٧ أغسطس ٢٠١٣، وراح ضحيته أحد عشر ضابطًا من قوة القسم، وخلال المحاصرة ألقى عدد من الإخوان عددًا من زجاجات المولوتوف على واجهة المبنى؛ ما أسفر عن اشتعال النيران به، أثناء وجود ضباط وأفراد الشرطة داخله. وقد أسفر الاقتحام عن استشهاد العميد محمد جبر، مأمور القسم، ونائبه العقيد عامر عبدالمقصود، ومحمد فاروق معاون المباحث، والملازم أول هانى شتا، الضابط بالقسم، وثلاثة مجندين، وأصيب عدد آخر من رجال الأمن ما بين ضباط ومجندين، وأُحرق القسم بالكامل مع الاستيلاء على محتوياته من أوراق وأسلحة. وفى الشهر ذاته «أغسطس ٢٠١٣» اقتحمت عناصر تابعة للإخوان مركز شرطة أبوقرقاص، عقب فض قوات الجيش والشرطة اعتصامى رابعة والنهضة.
وأضيف إلى ذلك ما وقع فى المنصورة فى ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر ٢٠١٣، من تفجير مديرية أمن الدقهلية، إذ قتل ١٦ شخصًا، وجرح نحو ١٥٠ آخرين، حسب بيان وزارة الداخلية، وأصدر تنظيم أنصار بيت المقدس بيانًا أعلن فيه رسميًّا مسئوليته عن التفجير، وأعلنت السلطات يومها مسئولية الإخوان عن الحادث وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد امتد الأمر إلى تفجير مديرية أمن القاهرة فى الرابع والعشرين من يناير ٢٠١٤، قبل يوم من ذكرى ثور ة ٢٥ يناير ٢٠١١ قتل فيه ٤ أشخاص، وأصيب ٧٦، وفق بيانات وزارة الصحة. كما دمر جزء من مقر الشرطة المصرية فى العاصمة. وأعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» مسئوليتها عنه، فى تغريدة تضمنت تسجيلًا صوتيًّا. وقد وقع فى ذلك اليوم مقتل ٣ وإصابة ١٣ فى الفيوم ومقتل ٢ فى حوش عيسى ومقتل شخص آخر فى المنيا. وواكب ذلك إحراق الكنائس وتفجيرها، عقب فض اعتصامى ميدان رابعة والنهضة، فقد فجرت جماعة الإخوان المسلمين وأتباعها الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية فى صباح الأحد الموافق ١١ ديسمبر ٢٠١٦، وقد بلغ عدد الوفيات ٢٩، و٣١ مصابًا «تنظيم داعش- ولاية سيناء»، وفى أسيوط سنة ٢٠١٣ تعرضت كنيسة القديس «مار يوحنا» للتدمير الكامل، فقد ألقوا عليها النيران؛ ما أدى إلى التهام النيران الثلاثة طوابق التابعة لها، وكنيسة «الملاك ميخائيل» بشارع النميس؛ إذ انتزعوا الصليب من أعلى الكنيسة وسط صيحات وإطلاق وابل من الأعيرة النارية. وفى العام نفسه تحديدًا فى الحادى والعشرين من أكتوبر ٢٠١٣ شهدت كنيسة «العذراء» بمنطقة الوراق حادث تفجير آخر، وقع فى أثناء زفاف عروسين داخل الكنيسة، والاحتفال بمراسم الزواج، وبعد انتهاء الحفل خرج الحضور من الكنيسة، فاستقبلهم مسلحان يركبان دراجة بخارية ويحملان سلاحًا آليًّا، وأطلقا الرصاص بطريقة عشوائية على الموجودين، ما تسبب فى وفاة ٨ أشخاص وإصابة آخرين. وقد كان التركيز بعد ذلك على سيناء، فحدثت تفجيرات واستهداف للمنشآت الأمنية فى أكتوبر ٢٠١٣.
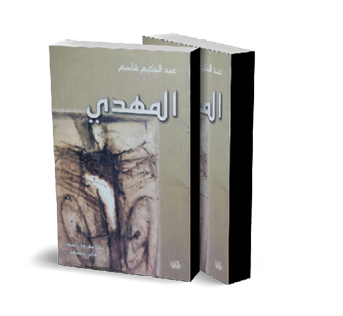
وجاء بعد ذلك استهداف انتحارى فى ١٦ فبراير ٢٠١٤ حافلة سياحية فى طابا، إذ فجر نفسه داخلها؛ ما أسفر عن مصرع ثلاثة سائحين كوريين وسائق الحافلة وإصابة خمسة عشر آخرين.
وتوالت الأعمال الإرهابية التى نفذها أنصار الإخوان وتنظيماتهم المسلحة لتشهد جامعة القاهرة ثلاثة انفجارات أدت إلى استشهاد العميد طارق المرجاوى وإصابة خمسة ضباط آخرين، ثم الاعتداء بقنبلة على كمين الجلاء أمام قسم الدقى، وانفجار فى ميدان لبنان أسفر عن استشهاد رائد بالإدارة العامة لمرور الجيزة. ووصل الإرهاب ذروته فى هجوم انتحارى على كمين كرم القواديس بالشيخ زويد بشمال سيناء، تلاه هجوم بسيارات الدفع الرباعى وقذائف «الأر بى جيه» أسفر عن استشهاد ٢٨ من رجال القوات المسلحة. ولقد حرصت على تسجيل ما عرفت من جرائم الإرهاب الدينى، ليكون ما سجلته قائمة عار فى تاريخ من ارتكبوه، وحافزًا على مقاومة هذه الجرائم، ومحاولة منعها قبل حدوثها. وكانت ذروة الجرائم هى كارثة الهجوم على أحد المساجد فى شمال سيناء بحجة أنها تتبع الصوفية هذه المرة، الأمر الذى يكشف أن الإرهاب الدينى قد اتخذ عباءة سلفية حنبلية متشددة معادية للتصوف فى الوقت نفسه، فتجسد ذلك فى الهجوم البشع الذى انتهى إلى القتل غيلة للمصلين المدنيين العزل، من الأطفال وكبار السن فى مسجد «الروضة»، بمركز بئر العبد فى العريش، وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٧، وترتب عليه وفاة أكثر من ثلاثمائة رجل وطفل من المصلين الأبرياء الذين اغتيلوا، وهم فى المسجد بين أيدى ربهم.

ولقد كان لهذه الكارثة تحديدًا وقعها الخطر على ذهنى، وبدت وكأنها نقطة انقطاع معرفى فى وعيى جعلتنى أتذكر السياقات التى لم أتردد فيها من التحذير من الإرهاب القادم كالطاعون الأسود مع تصاعد أحداث الإرهاب الدينى، وأن هذا الإرهاب لن يكف عن التصاعد ما لم نستطع أن نواجهه مواجهة جذرية. والمواجهة الجذرية لا يمكن أن تتحقق إلا بالقضاء على الفقر الذى يدفع الإنسان إلى الحاجة، والنفس البشرية إلى الضعف الذى يجعلها خاضعة لغواية دعاة الإرهاب الدينى الذين يبشرونهم بجنان وهمية يستحقونها نظير قتل المسلمين الأبرياء الذين يصورهم مشايخ الإرهاب على أنهم فاسقون، مارقون، كفار، يسيرون وراء طواغيت الأرض من أهل الحكم الجاهلى الذى عمت شروره على امتداد الدنيا الحديثة التى أصبحت جاهلية حديثة تمتد أذرعها ومفاسدها على امتداد الأرض. ويضاف إلى الفقر أنواع التسلط السياسى التى تسلب الإنسان، فضلًا عن المثقفين، الحرية التى هى أسمى القيم الإنسانية، وتحجر على العقل الذى هو أسمى ما خلقه الله فى الإنسان، والثقافة التى ترتقى بالوعى الإنسانى؛ فلا تجعله وعيًا مذعنًا يستجيب لداعى الشر إذا دعاه، بل يضع كل شىء من الآراء والأفكار موضع المساءلة، فلا يندفع كالأعمى وراء دعاة الجاهلية المعاصرة أو أساطين الإرهاب الدينى الذين يغوون البسطاء بارتكاب أفظع الشرور باسم القيم النبيلة للدين الذى هو دعوة للحق والخير والإخاء بين بنى الإنسان فى كل مكان.
وكان امتداد عمليات الإرهاب الدينى، عبر عهود متتابعة، وأنظمة حكم متوالية، دالًّا على الأسباب المؤدية للإرهاب التى لا تزال قائمة، تمتد من عهد إلى عهد، ومن قطر إلى قطر، دون محاولات جذرية لإيقافها أو القضاء عليها، بل على النقيض من ذلك، استغلتها بعض دول النفط الثرية لتصفية حساباتها مع الدول الشقيقة المعادية لسياساتها، مستغلة قوى الإرهاب الدينى الموجهة بأموال النفط لدعم قتل عشرات، بل مئات من العرب المسلمين والمسيحيين تصفية لحسابات يدفع ثمنها الأبرياء من دمائهم، وتنتهك أعراضهم عيانًا بيانًا باسم دين برىء من كل هذه الجرائم الوحشية. وقد ظهر هذا النوع من جرائم الإرهاب منذ مطالع الألفية الثانية. الأمر الذى أوجعنى بوصفى إنسانًا ومواطنًا، ودفعنى إلى المقاومة بالكتابة التى كان من نتيجتها المقالات التى أضفتها إلى ما سبق أن كتبته فى الطبعة الأولى من كتابى «فى مواجهة الإرهاب»، لكى أرفع صوتى بالاحتجاج فى مواجهة التكاسل الدينى للأزهر الذى كان قد توقف عن مواجهة الانحرافات الدينية فى عقول الناس، وعن مواجهة الفكر الإرهابى بالفكر الدينى السمح الذى هو دعوة إلى أنوار العقل وليس ظلماته، ومنارة للتسامح وليس التعصب، وانفتاح على المدنية والحضارة بكل أنواعهما المتقدمة، كما علمنا الإمام محمد عبده، وعلى فهم العقل بوصفه الأصل فى التفكير الذى هو فريضة إسلامية، كما علمنا العقاد، وأضيف إلى ذلك الاستبداد السياسى الذى يقضى على قيم الحق والعدل والحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، تاركًا الناس فريسة لغوايات الفساد الاجتماعى والإرهاب الدينى والجهالة الثقافية التى تساعد على نشر الإرهاب الدينى وتولده المستمر عبر الأقطار والأجيال والدول والأمم. وكانت هذه هى الخلفية التى دفعتنى إلى العودة مرة أخرى كى أشارك مع أقرانى المثقفين فى مواجهة الإرهاب الدينى، سلاحنا فى ذلك الوعى المفتوح والعقل المستنير، والوعى الدينى المتجدد الذى لا ينغلق بالإنسان على نفسه ولا يحول بينه وبين معارف العصر المتجددة، ومن ثم الانفتاح على الكون وإحياء سنة الله التى تأمر بتوسيع آفاق الاجتهاد وعدم الخوف منه ما دامت النوايا صالحة، مقصدها الخير لا الشر، وهدفها مصلحة أغلبية الناس الذين يعانون الفقر والجهل والظلم والتعصب. وكان هذا يعنى العودة إلى كتيبة المثقفين التى فرضت على نفسها الاستمرار فى المقاومة بالكتابة، «وهو العنوان الذى اتخذته عنوانًا لكتابى «المقاومة بالكتابة.. قراءة فى الرواية المعاصرة» الذى صدر بالقاهرة عن الدار المصرية اللبنانية سنة ٢٠١٥»، وكان هذا كله يعنى العودة إلى مواجهة الإرهاب الدينى، وهذه المواجهة تتخذ- فى حالتى- مسلكين: الأول المواجهة بتحليل المفاهيم الزائفة والكشف عن فسادها للناس فى كتاباتى الفكرية، والثانى: التعريف فى أعمالى النقدية بالأعمال الإبداعية التى تهدف إلى مواجهة الإرهاب الدينى، وتتولى تشريحه أو تحليله وتفسيره على السواء، وذلك بواسطة التحليل النقدى للأعمال الإبداعية التى لا تتوقف عن مواجهة الإرهاب الدينى الأسود أو الدموى وإدانته.
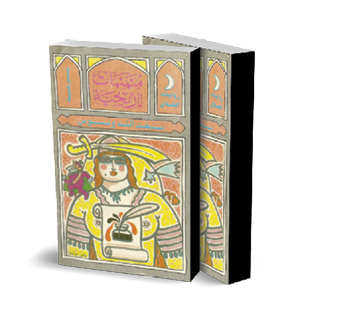
والحق أن مثقفى الاستنارة المصرية والعربية لم يقصروا فى ذلك، فمنذ أن كتب الطاهر وطار روايته «الزلزال» فى السبعينيات، لم تتوقف الأقلام عن المقاومة بالكتابة، وذلك على مستوى كل الأقطار العربية التى تبدأ من مصر وتعود إليها؛ لتأكيد الموقف التنويرى نفسه، والكشف عن ظلمات العقل السلفى والأصولى الذى يشيع الفساد بواسطة أفعال الشر أو عزازيله ويحيل السلفية إلى شيطان للشر وداعية بالتى هى أقتل، كما يصوغ من المنمنمات التاريخية جنازير ومتفجرات للإطاحة بالغد الوردى المفعم ببراعم المستقبل، فلا يبقى سوى الشر الذى يستشر فى ملكوت الله أو هؤلاء الذين وصفهم شاعرنا الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى بأنهم:
يداهمون عصرنا بالأسلحة
يفتشونه عن اليوم الذى انتهى ومات!
أتوا ولا نعلم من أين أتوا
أتوا من الموت وقد طالت لحاهم
ونسوا أسماءهم فيه.. نسوا وجوههم فى المقبرة
وأقبلوا يحملقون فى نهار الأمس.. لا يرون غير ليله م يطاردون فيه ما يفر من أشباحه م ويصرخون صرخات منكرة!
هكذا غزا أمثال هؤلاء العزازيل الأزهر الشريف، وانتقلوا منه إلى غيره من المؤسسات الدينية على امتداد العالم الإسلامى؛ كى يشيعوا فيها الأعين المركبة فى الأقفية، والعقول التى لا تعرف سوى القياس على الماضى، والقلوب الفظة الغريبة التى لا تعرف معنى الرحمة أو التسامح، فانحرفت بالقيم النبيلة التى تبنى عليها المؤسسات الدينية ومعاهدها التى هى مصابيح ينبغى أن تشع نورًا فى الظلام، واستبدلوا بها فتاوى جماع الوداع، وإرضاع الكبير، وبول الأنبياء، وعذاب القبور، وعدم مؤاخذة المسلم بدم الذمى أو تحقيره أو طرده من مسكنه، ناهيك عن أكشاك الفتوى الدالة على انتشار الجهالة الدينية أو المخايلة بها، وذلك فى مناخ يشيع فيه تكفير المؤمن بلا ذنب ولا جريرة، وقتل الأبرياء عقابًا على جرائم لم يرتكبوها والتنافس على الثروات وأفعال الشر التى تشترى الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. ولم تخلف أعمال شرهم سوى أزهر عاجز غير قادر على تكفير السفاحين القتلة، أو مواجهة النقل بالعقل، أو التقليد بالاجتهاد، أو الظلم بالعدل، فكان الأزهر كغيره من المعاهد الدينية عونًا للسلفيين والظلاميين على المجتهدين الذين يحررون العقل من قيوده، كى يستحق المكانة التى تليق به عندما جعله العقاد فريضة إسلامية.
وهكذا توقف الأزهر أو تكاسل، كما فعلت مثله مؤسسات دينية، على امتداد العالم الإسلامى، عجزت عن تجديد الخطاب الدينى تجديدًا ثوريًّا، كما فعل الإمام محمد عبده، والسكوت عن الذين يغطون بثيابهم السوداء سماءنا المضيئة، وعن الذين يوارون أطفالنا ونساءنا فى النقاب كأنهم عورة، كى نفر إلى الصحارى ونصير قرى بائدة، يصرخ فيها الجن والمشعوذون، ويصلب المسيح فى ساحاتها وتختفى الطفولة فى انفجارات القنابل ودوى المفرقعات وشظايا الألغام التى تطارد الحياة فى ليل المؤامرة الطويل الذى لا ينتهى.

وليس من سبيل أمامنا، نحن الذين منحنا الله نعمة الكتابة، والوعى النقدى للعقل المستنير، سوى أن نستفيد من هذه النعمة بما يحول بين وجودها الحى المنير ونقيضها الداعى إلى الموت والاغتيالات والقتل الذى لا ينجو منه حتى الأطفال الأبرياء، ولذلك لا مفر من أن نعاود شجاعة الكتابة ضد جمود العقل والتكاسل إزاء تجديد الخطاب الدينى وتذبذب الدولة فى مواقفها من تجديد الفكر الدينى وخطابه، ومن ثم تشمير الأذرع عن الأقلام كى تعاود الكتابة الجارحة والصدق الشجاع فى مواجهة الإرهاب بالعقل والاجتهاد المفتوح والإبداع الذى لا يحد، والذى يفتح أبواب المواجهة على أوسع مصاريعها، دفاعًا عن المستقبل الذى لا بد أن يأتى من وراء الغيب، وعن شمس الحقيقة التى لا بد أن تشرق على أرض الله، وعن المجارى المتدفقة اللامحدودة، كى تغزو الصحارى التى يصرخ فيها الجن والمشعوذون ويصلب المسيح فى ساحاتها وتختفى الطفولة.
أعنى أنه لا بد من وقفة جذرية إزاء همجية التتار الجدد الذين أفرخوا فى ليل المؤامرات الممتدة كى يختفى الشعراء والأدباء وأصحاب العقول النيرة فلا يبقى سوى المتوحشين والظلاميين والطغاة. والمؤكد أنه لن تفشل المؤامرة إلا بواسطة المقاومة بالكتابة والعودة إلى إحياء الفن المقاتل بالصورة والحركة والكلمة والنغمة، وبالتقاليد الحية فى مقاومة الإرهاب الدينى التى يشترك كتاب العالم العربى كله ومبدعوه فى تأسيسها فى كل مجال إبداعى من المحيط إلى الخليج، كى ينبهوا المواطن البسيط ورجل الدين الذى قد يغفل عن المجادلة بالتى هى أحسن، والسلطة السياسية التى قد تختلط عليها الأمور، والمتلقى البسيط الذى قد يستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير، والذى ينبغى أن نخاطب كل قواه الظاهرة والباطنة، كى يكون أكثر يقظةً فيما ينبهه له مبدعوه، بل كل إبداع عربى أو غير عربى؛ ذلك لأن الإبداع فى النهاية هو موقف ومواجهة. أعنى موقفًا من العالم والمجتمع، ومواجهة لكل ما هو شر وفساد. والإرهاب الدينى هو ذروة الشر والفساد.
والحق أن الإرهاب الدينى كالـڤيروسات الفتاكة لا تهاجم إلا الأجساد الضعيفة المنهكة التى أوهنها الفقر والجهل والمرض، وتنجو منها الأجساد السليمة العفية القادرة على مواجهة الـڤيروسات الضارة. وتفقد الأمم درع مناعتها حين تخترقها سهام التقاليد البالية والخطاب الدينى المتخلف وثقافة التسلية والترفيه وإلغاء العقول أو تخدير الأفهام، والتعليم العاجز عن مواكبة العصر وملاحقة أحدث منجزاته.
وكل ما فى هذا الكتاب من نقد أدبى هو لأعمال وإبداعات كتبت تعبيرًا عن موقف من انحراف الفكر الدينى ومواجهة للإرهاب الدينى الذى أصبح ساريًا فى الهواء الذى نتنفسه أو نشمه. ولذلك أرجو أن يقرأ القارئ هذا الكتاب أو يشاهد الأعمال الإبداعية التى كتب عنها فى هذا الكتاب تقديرًا لموقف أصحابها، وتأكيدًا لإيمانهم العميق والنبيل بضرورة الدفاع عن كل مبادئ التقدم والاستنارة، حتى من قبل الجريمة البشعة التى حدثت فى مسجد «الروضة» فى العريش بشمال سيناء يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠١٧، والتى لا تزال متواصلة إلى اليوم حولنا، ولن تتوقف إلا إذا وقفنا جميعًا فى مواجهة الإرهاب الدينى وما يعينه علينا- بشكل مباشر أو غير مباشر- فى كل مجال.
الدقى: يناير ٢٠١٨
يصدر عن دار «بتانة» قريبًا




