محمود أبورية.. سيرة مجدد عظيم
أضواء على السنة المحمدية.. الغامض والواضح فى تدوين أحاديث الرسول

لم يكن هذا العنوان وحده هو ما أراد محمود أبورية أن يضعه على كتابه، فقد أضاف إلى «أضواء على السنة المحمدية» عنوانًا آخر هو «أو دفاع عن الحديث»، والمعنى الظاهر بالنسبة لى وللجميع أيضًا أن أبورية ما أقدم على ما فعله إلا من أجل الدفاع عن النبى وعن الحديث وعن السنة النبوية.
طه حسين عن الكتاب: هذا كتاب بذل فيه مؤلفه من الجهد ما لا يبذل مثله إلا الأقلون
قدم الدكتور طه حسين لهذا الكتاب بقوله: هذا كتاب بذل فيه مؤلفه من الجهد ما لا يبذل مثله إلا الأقلون، والذين يقرأون هذا الكتاب قراءة المتدبر المستأنى سيلاحظون مقدار هذا الجهد العنيف الذى مكّن المؤلف من أن يصبر نفسه السنين الطوال على قراءة طائفة ضخمة من الكتب التى لا يكاد الباحثون يطيلون النظر فيها لكثرة ما يتعرضون له من كثرة الأسانيد وتكرارها وتعدد الروايات واضطرابها وإعادة الخبر الواحد مرات كثيرة فى مواطن مختلفة.
ويضيف العميد: وموضوع الكتاب إذن خطير قيّم، وهو نقد ما وصل إلينا من الحديث الذى يحمل عن النبى، صلى الله عليه وسلم، وتمييز الصحيح من غيره ليطمئن المسلمون إلى ما يروى لهم عن رسول الله، وقد فطن المحدثون القدماء لهذا كله واجتهدوا ما استطاعوا فى التماس الصحيح من الحديث وتنقيته من كذب الكذابين وتكلف المتكلفين، وكانت طريقتهم فى هذا الاجتهاد إنما هى الدرس لحياة الرجال الذين نقلوا الحديث جيلًا بعد جيل حتى تم تدوينه، وأنا بعد ذلك أجدد اعترافى للمؤلف بجهده العنيف الخصب فى تأليف هذا الكتاب وإخلاصه الصادق للعلم والحق فى بحثه عن الحديث.
أبورية: غرضى هو الدفاع عن السنة القولية وحياطتها مما يشوبها
انتهى محمود أبورية من كتابة مقدمة كتابه يوم السبت ٧ ديسمبر ١٩٥٧، وهى المقدمة التى أوضح فيها ما يريده من دراسته.
يقول أبورية: لأن الحديث لم يبدأ تدوينه إلا فى القرن الثانى، وكتبه المشهورة بين جمهور أهل السنة، وهى البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى، لم تظهر إلا فى القرنين الثالث والرابع، وما فيها من الأحاديث قد روى من طريق الآحاد الذى لا يعطى إلا الظن، فإن علماء الأمة لم يتلقوا أحاديثها بمحض التسليم والإذعان، كما تلقوا ما جاءهم من آيات القرآن، ولا اعتبروها من الأخبار المتواترة التى يجب الأخذ بها، ولا يجوز لأحد أن يخالف عن أمرها وإنما طاروا عليها بددا، واختلفوا فيها طرائق قددًا.
ويضيف أبورية: وهذا البحث كانت دراسته واجبة قبل النظر فى كتب الحديث والتفسير والفقه والأصول والتأريخ والنحو وكل ما إليها مما يتصل بالدين الإسلامى، وكان يجب أن يفرد بالتأليف منذ ألف سنة عندما ظهرت كتب الحديث المعروفة بعد انتشار المذاهب الفقهية بين المسلمين حتى توضع هذه الكتب فى مكانها الصحيح من الدين، ويعرف الناس حقيقة ما روى فيها من أحاديث ليكونوا منها فى أمرهم على يقين، ولو أننى ألفيت أمامى فى المكتبة العربية على سعتها كتابًا قد انطوى على هذا الأمر الخطير الذى يجب على كل مسلم أن يحيط به علمًا، لانحط عن كاهلى هذا العبء الثقيل، الذى احتملته فى سبيل البحث والتنقيب بين مئات الكتب والأسانيد التى اطلعت عليها، ورجعت إليها.
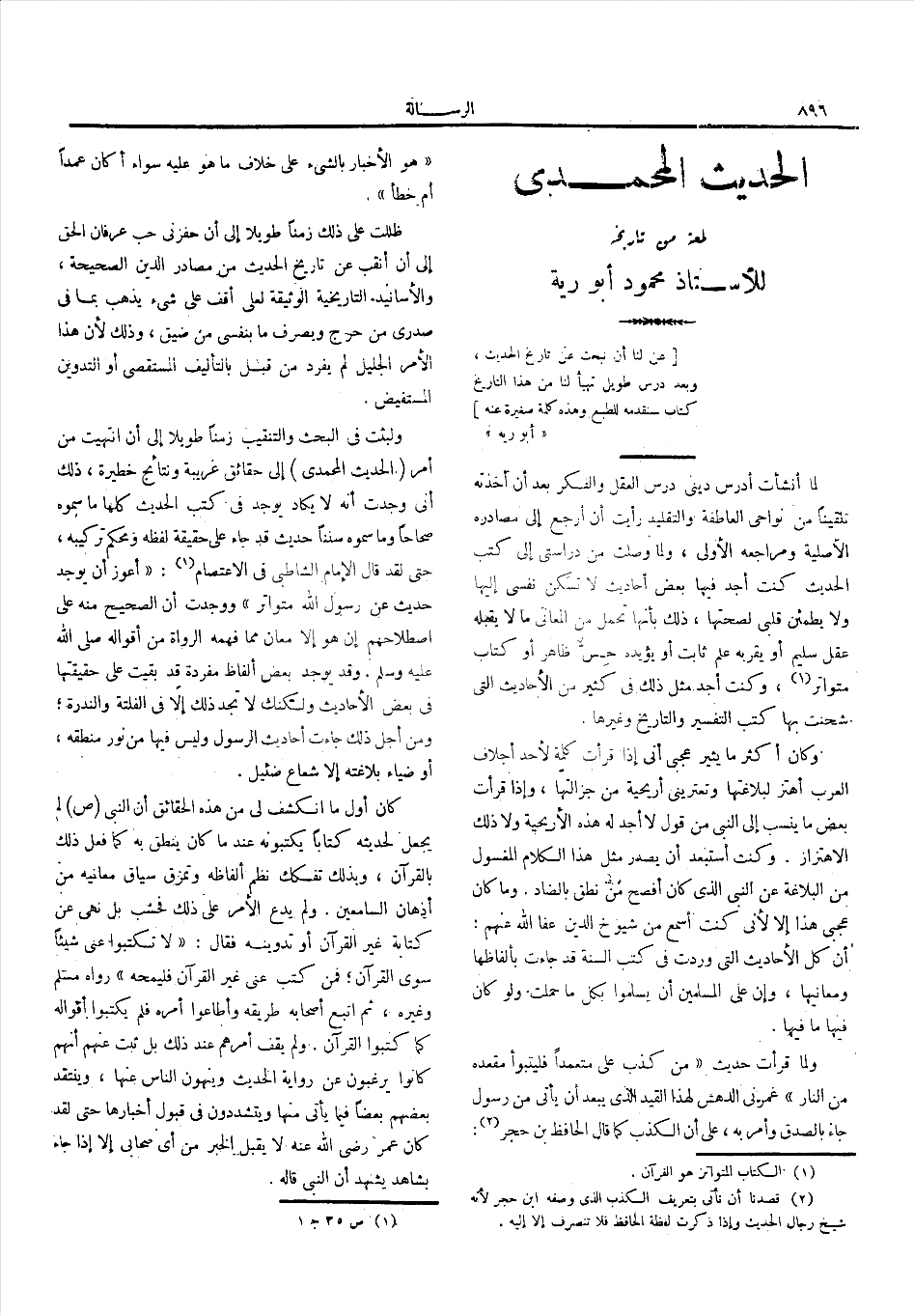
إننى أصدق محمود أبورية فيما قاله عن غرضه من هذه الدراسة.
يقول: الغرض الذى بذلت من أجله، وأنفقت من عمر وتعب فى سبيله، وهو الدفاع عن السنة القولية وحياطتها مما يشوبها، وأن يصان كلام الرسول من أن يتدسس إليه شىء من افتراء الكاذبين أو ينال منه كيد المنافقين وأعداء الدين.
توجه أبورية بعمله- كما أقر هو- بعد الله سبحانه إلى المثقفين من المسلمين خاصة، وإلى المهتمين بالدراسات الإسلامية عامة، لأن هؤلاء وهؤلاء هم الذين يعرفون قيمته ويدركون قدره.
ويختم تقديمه بدعاء: أدعو الله أن يجدوا فيه جميعًا ما يرضيهم ويرضى العلم والحق معه، وأتضرع إليه سبحانه أن يجعل عملى هذا خالصًا لوجهه، وأن يكتب له توفيقًا وتأييدًا من عنده، حتى يبلغ ما أرجوه له من خدمة الدين وإظهار الحق ونفع الناس أجمعين، إنه سميع الدعاء.
صال وجال محمود أبورية حتى وصل إلى محطة تدوين الحديث، وفيما أعتقد أن هذه هى المحطة الأهم فى الكتاب، وأعتقد أن التعرض لها بشكل مستفيض مهم فى هذا السياق، لأنه يمثل القيمة العليا لهذه الدراسة.
فعندما شرعوا فى تدوين الحديث دونوه على الهيئة التى وصل بها إليهم، فجمع كل منهم ما جمع مما رواه الرواة بالأسانيد التى رووه بها، وبعد ذلك بحثوا عن أحوال هؤلاء الرواة لكى يعرفوا من تقبل روايته ومن ترد.
وعلى أنهم قد بذلوا فى هذه السبيل ما بذلوا، لكنهم لم يصلوا إلى الغرض المرجو منه، ولا بلغوا مستقر اليقين الذى تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب من أن ما دونوه هو نفسه ما نطق النبى به بحيث لا يدنو منه شك أو يعروه شبهة.
وأنى لهم أن ينفذوا إلى دخائل النفوس وبواطنها حتى يطلعوا على حقيقتها؟
ومن أجل ذلك جاءت كتبهم كلها، وليس فيها مما جاء عن رسول الله حديث يعتبر متواترًا، بل نجدها قد جمعت بين ما هو صحيح فى نظر الرواة، وما هو موضوع لا أصل له، ولا يخلو من ذلك كتاب حتى التى سموها الصحاح وهى البخارى ومسلم لأنها لم تسلم من سهام النقد التى وجهها إلى كتب الحديث أئمة الحديث وعلماء الأصول وعلم الكلام.
ويشير أبورية إلى جمع القرآن الكريم فى عهد أبى بكر الصديق.
يقول: جمع الصحابة القرآن فى موضع واحد، مما كان قد كتب فى حياة الرسول، صلوات الله عليه، وما حفظ فى الصدور، وإنهم قد عنوا بذلك عناية فائقة.
وينتقل من هذه الإشارة إلى أحاديث الرسول.
يقول عنها: أما أحاديث الرسول فإنهم لم يكتبوها ولم يجمعوها لأنها لم تكتب فى عهد النبى كما كتب القرآن، إذ كان النبى قد نهى عن كتابتها، وكانت صدورهم هى التى تحملها، ومن أجل ذلك كانوا ينشرونها بالرواية، إما بنفس الألفاظ التى سمعوها من النبى- إن بقيت فى أذهانهم وهذا نادر جدًا- وإن وقع ذلك ففى بعض الأحاديث القصيرة، أو بما يؤدى معناها إذا غابت عنهم، وهذا كان غالب أمرهم، ولم يروا حرجًا من ذلك، لأن المقصود من الحديث عندهم- كما قالوا- هو المعنى ولا يتعلق فى الغالب حكم بالمبنى، بخلاف القرآن فإن لألفاظه مدخلًا فى الإعجاز، فلا يجوز إبدال لفظ بلفظ آخر، ولو كان مرادفًا له، خشية النسيان مع طول الزمان، فوجب أن يقيد بالكتابة ولا يكتفى بالحفظ، وإعجازه قائم ولا جرم على تأليف ألفاظه.
ويقول الشيخ أبوبكر بن عقال الصقلى فى فوائده على ما رواه ابن بشكوال: إنما لم يجمع الصحابة سنن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فى مصحف كما جمعوا القرآن، لأن السنن انتشرت وخفى محفوظها من مدخولها، فوكل أهلها فى نقلها إلى حفظهم، ولم يوكلوا من القرآن إلى مثل ذلك، وألفاظ السنن غير محروسة من الزيادة والنقصان كما حرس الله كتابه ببديع النظم الذى أعجز الخلق عن الإتيان بمثله، فكانوا فى الذى جمعوه من القرآن مجتمعين، وفى حروف السنن ونقل نظم الكلام نصًا مختلفين، فلم يصح تدوين ما اختلفوا فيه.
ظل الأمر هكذا فى رواية الحديث، تفعل فيه الذاكرة ما تفعل، لا يكتب ولا يدون طوال عهد الصحابة وصدر كبير من عهد التابعين، إلى أن حدث التدوين- على ما قالوا- فى آخر عهد التابعين.
يقول الهروى فى «إرشاد السارى بشرح القسطلانى»: لم يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث، إنما كانوا يؤدونها لفظًا ويأخذونها حفظًا، إلا كتاب الصدقات والشىء اليسير الذى يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء، حتى خيف عليه الدروس، وأسرع فى العلماء الموت، أمر عمر بن عبدالعزيز أبا بكر الحزمى، فيما كتب إليه: انظر ما كان من سنة أو حديث فاكتبه.
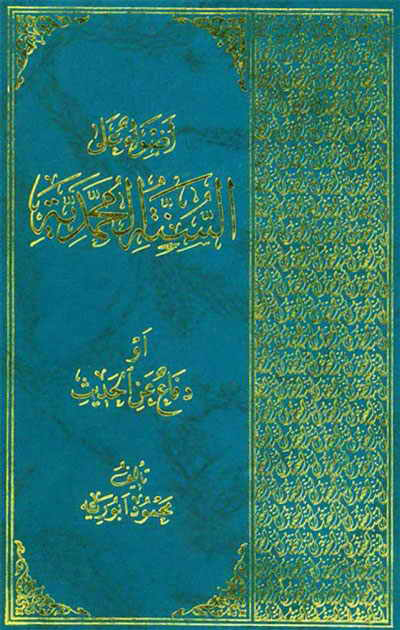
وينقل أبورية من موطأ مالك رواية محمد بن الحسن، والتى فيها إن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى أبى بكر بن حزم أن أنظر ما كان من حديث رسول الله أو سننه فاكتبه لى، فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء، وأوصاه أن يكتب له ما عند عمرة بنت عبدالرحمن الأنصارية- وكانت تلميذة السيدة عائشة رضى الله عنها- والقاسم ابن محمد بن أبى بكر.
كان أمر عمر بن عبدالعزيز على رأس المائة الأولى من عمر الإسلام، ويبدو أنه لما عاجلته المنية انصرف ابن حزم عن كتابة الحديث، وبخاصة عندما عزله يزيد بن عبدالملك عندما تولى بعد عمر بن عبدالعزيز سنة ١٠١ هجرية، وكذلك انصرف كل من كانوا يكتبون مع أبى بكر وفترت حركة التدوين.
وعندما تولى الخلافة هشام بن عبدالملك سنة ١٠٥ هجرية، جد فى تدوين السنة ابن شهاب الزهرى، وقيل إن هشام أكرهه على تدوين الحديث لأنهم كانوا يكرهون كتابته، ولكن لم تلبث هذه الكراهية أن صات رضا، ولم يلبث ابن شهاب أن صار حظيًا عند هشام، فحج معه وجعله معلم أولاده، إلى أن توفى قبل هشام بسنة.
مات هشام سنة ١٢٥ هجرية، وبموته تزعزع ملك بنى أمية ودب فيه الاضطراب، ثم شاع التدوين فى الطبقة التى تلى طبقة الزهرى، وكان ذلك بتشجيع العباسيين.
بهذا يمكننا أن نعتبر ابن شهاب الزهرى هو أول من دون الحديث، ولعل سبب ذلك أخذ بنى أمية عنه، هذا رغم وجود آخرين غيره.
ففى «تذكرة الحفاظ» أن خالد بن معدان الحمصى لقى ٧٠ صحابيًا، وكان يكتب الحديث وله مصنفات فيه، ولكن لم يأتِ لهذه المصنفات ذكر فى كتب الحديث، ومات ابن معدان سنة ١٠٤ هجرية، وقال الحافظ ابن حجر فى مقدمة «فتح البارى» بعد أن بيّن أن آثار النبى لم تكن فى عصر أصحابه وكبار تابعيهم مدونة فى الجوامع ولا مرتبة، لأنهم نهوا عن ذلك كما ثبت فى صحيح مسلم، ثم حدث فى أواخر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار، لما انتشر العلماء فى الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض.
ويروى البخارى والترمذى عن أبى هريرة أنه قال: ما من أصحاب النبى، صلى الله عليه وسلم، أحد أكثر حديثًا منى، إلا ما كان من عبدالله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب.
ويؤكد أبورية ما قاله الشيخ مصطفى عبدالرازق من أنه مما أكد الحاجة لتدوين السنن شيوع رواية الحديث وقلة الثقة ببعض الرواة وظهور الكذب فى الحديث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأسباب سياسية أو مذهبية، أما أول التدوين للسنن بالمعنى الحقيقى فيقع ما بين عامى ١٢٠ و١٥٠ هجرية.
ويناقش أبورية مسألة الإكراه فى تدوين الحديث، فيذهب إلى أن من قاموا بذلك كانوا مكرهين، لأنهم لما أمروا بتدوين الحديث لم يستجيبوا للأمر إلا مكرهين، ذلك لأنهم كانوا يتحرجون من كتابته بعد أن مضت سنة من كان قبلهم من الصحابة على عدم تدوينه.

فقد نقل معمر عن الزهرى قوله: كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء، فرأينا ألا نمنعه أحدًا من المسلمين.
ويقول الزهرى أيضًا: استكتبنى الملوك فأكتبتهم فاستحييت الله إذ كتبها الملوك ألا أكتبها لغيرهم.
وذلك لأن المسلمين كان همهم فى أول الإسلام مقصورًا على كتابة القرآن، أما الحديث فقد كانوا يتناقلونه من طريق الرواية معتمدين فى ذلك على ذاكرتهم.
ويصف أبورية التدوين فى عصر بنى أمية بأنه لم يكن منسقًا، لأن العلماء لم يجدوا من آثار هذا العصر كتبًا جامعة مبوبة، وإنما وجدوا أن ما صنعوه إنما كان فى مجموعات لا تحمل علمًا واحدًا، وإنما كانت تضم الحديث والفقه والنحو واللغة والخبر وما إلى ذلك.
يقول أحمد السكندرى فى كتابه «تاريخ آداب اللغة العربية»: انقضى عصر بنى أمية ولم يدون فيه غير قواعد النحو وبعض الأحاديث وأقوال فقهاء الصحابة فى التفسير.
ويروى أن خالد بن يزيد وضع كتبًا فى الفلك والكيمياء، وأن معاوية استقدم عبيد بن سرية من صنعاء فكتب له كتاب «الملوك والأخبار الماضية»، وأن وهب بن منبه والزهرى وموسى بن عقبة كتبوا فى ذلك أيضًا كتبًا، ولكن ذلك لم يقنع الباحثين فى تاريخ العلوم وتصنيفها بأن يعتبروا عصر بنى أمة عصر تصنيف، إذ لم تتم فيه كتب جامعة حافلة مبوبة مفصلة، وإنما كان كل ذلك مجموعات تدون حسب ورودها واتفاق روايتها.
ويقول أبوحامد الغزالى فى كتابه «إحياء علوم الدين»: بل الكتب والتصانيف محدثة لم يكن شىء منهما فى زمن الصحابة وصدر التابعين، وإنما حدث بعد سنة ١٢٠ هجرية، وبعد وفاة جميع الصحابة وجلة التابعين، رضى الله عنهم، وبعد وفاة سعيد بن المسيب فى ١٠٥ هجرية، والحسن فى ١١٠ هجرية، وخيار التابعين، بل كان الأولون يكرهون كتب الحديث وتصنيف الكتب، لئلا يشتغل الناس بها عن الحفظ وعن القرآن وعن التدبر والتذكر، وقالوا: احفظوا كما كنا نحفظ.
ونخلص من ذلك كله أن أول تدوين الحديث قد نشأ فى أواخر عهد بنى أمية، وكان على طريقة غير مرتبة من صحف متفرقة تلف وتدرج بغير أن تقسم على أبواب وفصول، ولعل هذا التدوين كان يجرى على نمط ما كان يدرس فى مجالس العلم فى زمنهم، إذ كانت غير مخصصة لعلم من العلوم، وإنما كان المجلس الواحد يشتمل على علوم متعددة.
ينتقل أبورية إلى الحديث عن تدوين الحديث فى العصر العباسى.
ويرى أن العلماء هبوا إلى تهذيب ما كتب فى الصحف وتدوين ما حفظ فى الصدور، ورتبوه وصنفوه كتبًا، وكان من أقوى الأسباب فى إقبال العلماء على التصنيف فى هذا العصر حث الخليفة أبى جعفر المنصور عليه وحمله الأئمة الفقهاء على جمع الحديث والفقه، وأنه قد بذل على بخله فى هذا السبيل أموالًا طائلة، وذكروا أن عنايته بالعلم لم تقف عند تعضيد العلوم الإسلامية، بل إنه حمل العلماء والمترجمين من السريان والفرس أن ينقلوا إلى العربية من الفارسية واليونانية علوم الطب والسياسة والحكمة والفلك والتنجيم والآداب والمنطق وغيرها.
كان أبوجعفر المنصور أول حاكم ترجمت له الكتب من اللغات الأخرى إلى العربية، على أن عنايته بالحديث وجمعه وتدوينه كانت فائقة، حتى قيل له: هل بقى من لذات الدنيا شىء لم تنله؟ فقال: بقيت خصلة، أن أقعد فى مصطبة وحولى أصحاب الحديث، وهو الذى أشار- طبقًا لبعض الروايات- على مالك بن أنس أن يضع كتابه «الموطأ».
لم يكن غريبًا بعد ذلك أن يكثر رجال الحديث فى عهد المنصور ولا أن يشتد العلماء فى طلب آثار الرسول وفى أن يرغبوا فى جمعها وتدوينها.
ويقول ابن تغرى بردى فى حوادث العام ١٤٣ هجرية ناقلًا عن الذهبى: فى هذا العام شرع علماء الإسلام فى تدوين الحديث والفقه والتفسير، فصنف ابن جريج «التصانيف المكية»، وصنف سعيد بن أبى عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة، وصنف أبوحنيفة الفقه والرأى بالكوفة، وصنف الأوزاعى بالشام، وصنف مالك «الموطأ» بالمدينة، وصنف ابن إسحاق المغازى، وصنف معمر باليمن، وصنف سفيان الثورى كتاب الجامع بالكوفة، ثم بعد يسير صنف هشام كتبه، وصنف الليث بن سعد، وعبدالله بن لهيعة، ثم ابن المبارك، والقاضى أبويوسف يعقوب، وابن وهب.
وكثر خلال هذه السنوات تبويب العلم ورتبت ودونت كتب اللغة العربية والتاريخ وأيام الناس، وقبل هذا العصر كان سائر العلماء يتكلمون عن حفظهم ويروون العلم عن صحف غير مرتبة.
ويقول الحافظان ابن حجر والعراقى: وكان هؤلاء فى عصر واحد فلا يدرى أيهم أسبق، ثم تلاهم من أهل عصرهم فى النسج على منوالهم إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبى خاصة، وذلك على رأس المائتين، ولم يصل إلينا من هذه المجموعات إلا «موطأ مالك»، ووصف لبعض المجموعات الأخرى، وكذلك كان التدوين فى هذا العصر يمزج الحديث بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم، وظل على ذلك إلى تمام المائتين.

فى بداية المائة الثالثة من الهجرة أخذت طريقة تدوين الحديث صورة أخرى، حيث بدأت فكرة أن يفرد حديث النبى خاصة بالتدوين، بعد أن كان مشوبًا بغيره مما ليس بحديث، فصنف عبيدالله بن موسى العبسى الكوفى ٢١٣ مسندًا، وصنف مسدد بن مسرهد المصرى ٢٢٨ مسندًا، وصنف الحميدى ٢١٩ مسندًا، واقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، كالإمام أحمد ٢٤١ مسندًا، وإسحاق بن راهوية ٢٣٧ مسندًا.
ويذهب أبورية إلى أنه لئن كانت هذه المسانيد قد أفردت الحديث وحده ولم تخلط به غيره من أقوال الصحابة ولا غيرهم، فإنها كانت تجمع بين الصحيح وغير الصحيح، مما كان يحمله سيل الرواية فى هذا الزمن من الأحاديث، إذ لم يكن قد عرف إلى هذا العصر تقسيم الحديث إلى ما تعارفوا عليه من صحيح وحسن وضعيف، ولذلك كانت هذه المسانيد دون كتب السنن فى المرتبة، ولا يسوغ الاحتجاج بها مطلقًا، وسنتكلم عن هذه المسانيد فيما بعد وعن منزلتها بين الحديث المعروفة.
استمر التدوين على هذا النمط إلى أن ظهرت طبقة البخارى، ومن ثم أخذ صورة أخرى ودخل فى دور جديد، وهو دور التنقيح والاختيار.
يقول الحافظ ابن حجر: لما رأى البخارى هذه التصانيف ورواها، وانتشق رباها واستجلى محياها، وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف، فلا يقال لغة سمين، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذى لا يرتاب فيه أمين، وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين فى الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلى المعروف بابن راهوية.
يقول البخارى: كنا عند إسحاق بن راهوية فقال: لو جمعتم كتابًا مختصرًا لصحيح سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ فوقع ذلك فى قلبى فأخذت فى جمع الجامع الصحيح.
ويخلص أبورية من هذا الاستعراض التاريخى إلى أن أحاديث رسول الله، صلوات الله عليه، لم تدون فى حياته ولا فى عصر الصحابة وكبار تابعيهم، وأن التدوين لم ينشأ إلا فى القرن الثانى للهجرة فى أواخر عهد بنى أمية، وأنه لم يتخذ طريقًا واحدًا بل تقلب فى أطوار مختلفة.
كان التدوين فى أول أمره جمعًا من رواية الرواة مما وعت الذاكرة من أحاديث رسول الله، وكان ذلك فى صحف لا يضمها مصنف مبوب، وكانت هذه الصحف تضم مع الحديث فقهًا ونحوًا ولغة وشعرًا، مما تقضى به طفولة التدوين، ولم يصل إلينا منه شىء فى كتاب خاص جامع.
وفى الطور الثانى فى عصر العباسيين هذب العلماء ما فى هذه الصحف ورتبوه، بعد أن ضموا إلى ما زادته الرواية فى هذا العصر، وصنفوا من كل ذلك كتبًا كسروها على الحديث وما يتصل به من أقوال الصحابة وفتاوى التابعين، ولم يدخلوا فيها أدبًا ولا شعرًا، وكان كثير من المتقدمين يطلقون اسم الحديث على ما يشمل آثار الصحابة والتابعين.
ثم أخذ التدوين هذا النمط تبعًا لارتقاء التأليف فى العصر العباسى، وتميزت العلوم بعضها من بعض، وجمعت مسائل كل علم على حدة، وظل التأليف يجرى على هذه السنن إلى آخر المائة الثانية، ولم يصل إلينا من الكتب المبوبة فى هذا الطور إلا «موطأ مالك».
الشيعة لهم كتب فى الحديث يعتمدون عليها ولا يثقون إلا بها
وبعد المائة الثانية أخذ التدوين يسير فى طريق أخرى، دخل بها فى الطور الثالث، فأنشأ العلماء يفردون كل ما روى من الأحاديث فى عهدهم بالتدوين بعد أن كان من قبل مشوبًا بأقوال الصحابة وغيرهم، وصنفت فى ذلك مسانيد كثيرة أشهرها أحمد، وهو لا يزال موجودًا بيننا.
كانت هذه المسانيد تحمل الأحاديث الصحيحة والموضوعة، وجرى العمل على هذا النهج حتى ظهر البخارى وطبقته، فانتقل التدوين إلى الطور الرابع وهو طور التنقيح والاختيار، فوضعوا كتبًا مختصرة اختاروا فيها ما رأوا أنه من الصحيح على طريقتهم فى البحث، كما فعل البخارى ومسلم ومن تبعهما، وهذا الطور من التصنيف هو الأخير، إذ أصبحت هذه الكتب هى المعتمدة عند أهل السنة، أما الشيعة فلهم كتب فى الحديث يعتمدون عليها ولا يثقون إلا بها، ولكل قوم سنة وإمامها.
المسلمون كان همهم فى أول الإسلام مقصورًا على كتابة القرآن أما الحديث فقد كانوا يتناقلونه من طريق الرواية
ويخلص أبورية إلى نتيجة مهمة، وهى أنه لما تركت أحاديث الرسول، صلوات الله عليه، بغير تدوين فى عهده ولم ينهض الصحابة من بعده لكتابتها كما كتبوا القرآن، اتسعت أبواب الرواية عن رسول الله لكل ذى هوى زائغ أو دخلة سيئة من غير خوف من ضمير ولا وازع من دين فرووا ما شاءوا أن يرووا.
ولو أن المسلمين الأولين أو من دخلوا فى الإسلام من بعد كانوا طبقة واحدة فى الصدق، ودرجة متساوية فى العدل وكمال السيرة، أو لو أن الرواية قد وقفت على من أطلقوا عليهم اسم الصحبة الصحيحة، وربطت الكتابة ما روى فى عهد الخلفاء الراشدين، لكان عسى أن يكون النقل مقصورًا على ما قاله النبى، صلوات الله عليه، بغير زيادة أو نقصان، ولجاءت الأحاديث كلها صحيحة لا شك فيها، ومن ثم كانت الأمة تتلقاها بالرضا والتسليم، كما تلقت آيات القرآن الحكيم، ويأخذها الخلف عن السلف بألفاظها ومعانيها، ولا يخالف أحد من المسلمين وغير المسلمين فيها، ثم تسير الأمة على نورها وتهتدى بهديها، من غير تمذهب ولا تفرق كما هو الأصل فى الدين الذى يقول كتابه «واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا»، «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم فى شىء»، ولكن الناس هم الناس فى كل عصر، والبشر لهم طباع لا تتغير، وغرائز لا تتبدل، وأهواء لا تتحول، وما كان الصحابة، رضوان الله عليهم، ومن جاء بعدهم من التابعين بدعًا من الناس ولا هم بالعصومين، سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلًا.
وحتى يخلص محمود أبورية من مسألة تدوين سنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، فإنه يعرج أيضًا على تدوين السنة عند الشيعة.
وينقل عن الشيعة قولهم: إن أول من جمع الحديث ورتبه على الأبواب هو أبورافع، مولى رسول الله، وله كتاب السنن والأحكام والقضايا، وقالوا: فلا أقدم منه فى تبويب الحديث وجمعه فى الأبواب.
ويقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء النجفى فى كتابه «المطالعات والمراجعات والردود»: إن أول من دوّن الحديث ابن أبى رافع كاتب أمير المؤمنين على بن أبى طالب، عليه السلام، وخازنه على بيت المال، بل الحق أن أول من دوّنه هو نفسه أمير المؤمنين، عليه السلام، كما يدل عليه خبر الصحيفة فى الصحيحين.







