الفيلسوف الحزيــن.. 10 دقائق مع عبدالغفار مكاوى!

- الابتسامة كانت سلاحه الوحيد والفعّال لهزيمة الأمراض وتقلبات الحياة
فى مساء يوم من أواخر صيف عام 2012، وضعتنى مصادفة عجيبة وجهًا لوجه، أمام فيلسوف وأديب ومثقف مصرى عظيم وأب روحى، هو الدكتور عبدالغفار مكاوى.
كان الاشتباك الثقافى فى مصر حينها على أشده، وقد أُعلنت لتوها أسماء الفائزين بجوائز الدولة فى الآداب، وسط حالة من التفاعل والزخم غير المسبوق، وذهبت رفقة عدد من الأصدقاء إلى متحف ومنزل أمير الشعراء أحمد شوقى على كورنيش النيل بالجيزة، لحضور احتفالية كبرى أقيمت لتكريم الفائزين.
وبينما أقف فى الباحة الخارجية مع قرب ختام الفعاليات، وجدته يخرج من قاعة الحفل، ويسير بحركة بطيئة متأنية، والوقار والأناقة يغلفان هيئته، بدا قصير القامة نحيفًا، وفى رأسه قليل من الشعر الأبيض يتوزع فى شكل هلال، وكانت تبدو عليه مظاهر المرض والشيخوخة، لكن هذه المظاهر كانت تنهار أمام ابتسامته الصافية.
التقطته من أول نظرة، إنه هو الرجل العظيم الذى شكل وعينا، بمجموعة ضخمة من أهم مؤلفات النقد والترجمة والفكر الفلسفى فى التاريخ المعاصر، بما يربو على 60 كتابًا.
باندفاع المراهقين، أوقفته: «دكتور عبدالغفار، أنا محمد هشام، شاعر»، نعم قلتها هكذا بملء الفم «شاعر»، لا أنسى ضحكته الطفولية وبساطته: «أهلًا يا ابنى.. لهجتك بتقول إنك دلتاوى، أنت منين؟»، قلت له: «كفر الشيخ»، فقال لى: «أنت من عندالشهاوى!» «يقصد الشاعر الكبير محمد محمد الشهاوى»، وواصل: «إذا قابلت الشهاوى.. أبلغه أنى زعلان منه جدًا لأنه لم يرسل إلىّ أعماله حتى الآن!».
شعرت بالرجل يريد أن يتحرك، كأنه يرغب فى راحة طويلة أو أبدية، حاولت استدراجه للبقاء والجلوس، إنها فرصة ربما لن تتكرر، إنه الرجل الذى عشت مع كتاباته سنوات، وشكل نظرتى للشعر والأدب والفلسفة بوجه عام، لكنه أصر على المضى، «دكتور.. ممكن أوصل حضرتك»، شىء ما كان يدفعنى للتشبث بهذا الرجل، وسرت معه إلى الخارج، لم أكن أعلم أن الدقائق القليلة التى سأقضيها رفقته، من حديقة المتحف مرورًا بالبوابة الخارجية حتى عبور الكورنيش فى الجهة المقابلة، لإيقاف سيارة تاكسى، ستكون من أطيب وأعذب الذكريات فى وجدانى.
أتذكر هذه الـ١٠ دقائق وكأنها وقعت أمس، أذكر أننى لم أكف عن محادثته لحظة، وكأننى أمام مائدة عامرة وأتناول آخر زاد لى فى الحياة، قد لا أذكر بالضبط كامل تفاصيل الحوار، لكننى ظللت أشعر بما تركه حضوره فى داخلى من تأثير معنوى وإنسانى، وما زالت جملته الأخيرة ترن فى أذنى: «مع السلامة يا ابنى نتقابل قريب»، وأذكر أيضًا كيف حطمنى خبر وفاته بعد أيام قليلة من ذلك اللقاء القدرى، ليفارق عالمنا فى ٢٤ ديسمبر عام ٢٠١٢.
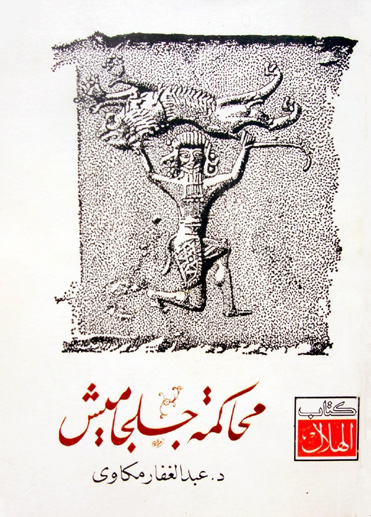
كتاب بـ 7 جنيهات
قصتى مع عبدالغفار مكاوى بدأت قبل ذلك الحدث الفارق بأعوام، حينما نصحنى الشاعر الكبير محمد الشهاوى بقراءة كتابه «ثورة الشعر الحديث.. من بودلير إلى العصر الحاضر»، وشرح لى كيف أنه كتاب يمنح قارئه خريطة تفاعلية ووجدانية ونقدية للشعر الأوروبى منذ بداية القرن التاسع عشر.
وكان أن وقع الكتاب حرفيًا فى طريقى، وأنا أسير ذات يوم فى شارع شمبليون فى وسط البلد، لأجده على فرشة كتب على رصيف، والتقطت الكتاب، كانت طبعة بقطع متوسط، وغلاف أنيق، من مطبوعات مؤتمر أدباء مصر فى الإسكندرية عام ٢٠٠٧، بسعر ٧ جنيهات فقط، ورقه أبيض ناصع وتجليده جيد، والكتاب مكون من جزئين يقعان فى مجلد واحد.
التهمت الكتاب التهامًا، لقد أدخلنى إلى عالم بودلير ومالارميه وفرلين وآرثر رامبو وأراجون وتى إس إليوت ولوركا وغيرهم من عشرات الشعراء الأوروبيين، تحليل نقدى وفنى ووجدانى وإنسانى لمنجز كل شاعر، مع تزويد القارئ بنماذج مترجمة من قصائدهم، ترجمها عبدالغفار مكاوى بقريحة وقلب الفنان الشاعر الأديب، فصارت وكأن اللغة العربية هى لغتها الأصلية.
انتميت إلى هذا الكتاب واعتبرته إنجيلى الخاص لفهم وتكوين رؤية عن الشعر، وطاقته الشعورية ووظيفته المعنوية داخل العقول، وصرت كلما صادفت الكتاب فى أية مكتبة أشترِه، وأُهدِهِ إلى الأصدقاء القريبين كلما احتفلوا بمناسبة أو عيد.
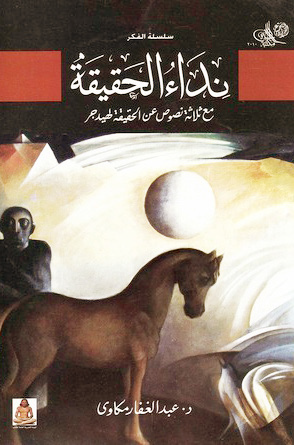
الفلسفة وجبة سهلة الهضم
لم يكن عبدالغفار مكاوى بدعًا من القوم، فهو مثل كل الرواد الذين ولدوا وتلقوا تعليمهم الأساسى وكونوا بذور رؤيتهم المعرفية والفكرية فى حقبتى الثلاثينيات والأربعينيات، وهو الجيل الذى بنى النهضة الفكرية وما زلنا نعيش على تراثه وآدابه ومعارفه.
كان ميلاده فى مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية فى يناير عام ١٩٣٠م، والتحق بالكتاب وهو فى سن ٦ سنوات، ثم التحق بالمدرسة الابتدائية، واستمر فى سلك التعليم حتى حصل على شهادة الثقافة من المدرسة الثانوية فى طنطا عام ١٩٤٧م، وطنطا كانت عاصمة للدلتا كلها، ففيها المكتبات الرئيسية وأسواق الكتب التى تضم أمهات الإصدارات وتضم مدارس لتعليم الموسيقى، كانت طنطا هى القاهرة الصغيرة بالنسبة لجميع مبدعى الأقاليم.
فى هذه المدينة حصل على كل إصدارات العظماء، من كبار الأدباء والشعراء والمترجمين مثل طه حسين، والمازنى، وعباس محمود العقاد وتوفيق الحكيم، ومصطفى لطفى المنفلوطى، وجبران خليل جبران، ثم انتقل إلى القاهرة للدراسة فى كلية الآداب جامعة القاهرة، وفى عام ١٩٥١م حصل على ليسانس الفلسفة، ثم عمل مُفهرسًا فى دار الكتب المصرية بين عامى ١٩٥١ _ ١٩٥٧م، وفى عام ١٩٦٧م انضم للسلك الأكاديمى وعمل مدرسًا بقسم اللغة الألمانية ثم قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة.
هنا بدأت الرحلة إلى العالمية، فمع إتقانه اللغة الألمانية، قرر الدراسة والحصول على الدكتوراه من ألمانيا، ليدرس الفلسفة والأدب الألمانى الحديث من جامعة فرايبورج ﺑ«بريسجاو» فى ألمانيا وكان عنوان رسالته للدكتوراه التى حصل على درجتها عام ١٩٦٢، «بحثٌ فلسفى عن مفهومى المحال والتمرد عند ألبير كامى».
استثمر «مكاوى» وجوده فى ألمانيا، استثمارًا عظيمًا، فقد أتقن عدة لغاتٍ بخلاف الألمانية، مثل الإنجليزية والفرنسية والإيطالية واللاتينية واليونانية القديمة، لكن كان لإتقانه اللغة الألمانية تحديدا دورٌ مهم فى ترجمة العديد من كلاسيكيات الأدب الألمانى، لتكون كنزًا للقارئ العربى، وقد لاحظت أصداء فترة حياته فى ألمانيا واغترابه الطويل بها فى بعض كتاباته، مثل مجموعته القصصية «النبع القديم»، ومجموعته القصصية «أحزان عازف الكمان»، التى تتضمن قصصًا مهداة إلى أصدقائه صلاح عبدالصبور وشكرى عياد وغيرهما.
عمل أيضا مدرسًا فى كلية الآداب بجامعة الخرطوم، وخلال الفترة من ١٩٧٨ لـ١٩٨٢م، أُعير إلى جامعة صنعاء باليمن، ثم عاد إلى التدريس بجامعة القاهرة حتى عام ١٩٨٥م، ثم استقال منها ليلتحق بالتدريس بجامعة الكويت.
عبدالغفار مكاوى ينطبق عليه الوصف الشعبى: «لف الدنيا»، لكنه قضى تلك الرحلات فى مغامرات علمية، منح خلالها كامل إخلاصه لتحصيل المعارف والخبرات، بإرادة صلبة ويقين روحانى عجيب، يذكرنا بمنجزات العارفين الأوائل وأعلام المتصوفة الكبار.
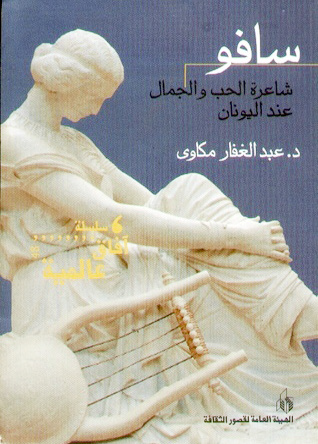
يسأل سائل ما سر هذه الحالة التى صنعها مكاوى؟ سأقول: سرها فى عدم انشغاله إلا بالعمل، فلم يكن مثقفًا يسكن برجه العاجى، بل منخرطًا بكامل كيانه، فى حركة الإنتاج المعرفى الجماهيرى، وانعكس ذلك على حجم ترجماته المرعب، للدرجة التى تشعر معها، بأنه لا توجد قصاصة ورق طبعت فى أوروبا إلا وقرأها الرجل، وانتقى منها ما يخدم القارئ العربى.
ولم يكن مثقفًا نخبويًا ذا تجربة مغلقة على الراسخين فى المعرفة وفقط، بل كتب للناس بلغة أيقونية، وتبسط ما وسعه ذلك فى نقده وشروحه، حتى فى مؤلفاته الفلسفية شديدة التخصص، فتراه وهو يقدم لنا مارتن هيدجر ونصوصه، فى كتاب «نداء الحقيقة»، كأنما يقدم وجبة سهلة الهضم على مائدة عشاء.
ولم يتورط مثل غيره فى الاشتباك المؤسسى، بشكل يستنزف طاقته ويحيد به عن هدفه، فنأى بنفسه منذ بداية مشواره عن كل ما يمكن أن يشغله عن العمل والتعلم وتحصيل المعرفة، كما تحرر من ربقة الوظيفة الثابتة، منطلقًا فى فضاءات التجريب، والعمل فى عدة بلدان عربية وأوروبية ووسط ثقافات مختلفة وثرية.
ومن ينظر إلى حجم كنوزه، يتعجب أشد العجب، من أين أتى الرجل بوقت وزمان وطاقة، ليقدم هذا العدد الهائل من المؤلفات، ما بين مجموعات قصصية عديدة ودواوين شعرية ومسرحيات وكتابات نقدية متنوعة الاتجاهات والسياقات، ناهيك عن الإنتاج الفلسفى الهائل ما بين شروح ونظريات أرسطو فى كتابه «دعوة للفلسفة»، ونصوص أفلاطون فى كتابه «المنقذ»، وأفكار ألبير كامى، وتنظيرات عن شيللر وشيكوف وجوتة، وتنظيراته الأخرى عن الإسلام والمسلمين.
ناهيك عن منجزه الضخم فى الترجمة، خاصة لأعمال الشاعر الألمانى الرائد برتولت بريخت، فضلًا عن اقتحامه للترجمات الكلاسيكية التراثية، وتصديه المبهر لترجمة ملحمة «جلجامش»، وسافو شاعرة الحب والجمال عند اليونان.
ولا أجمل من كتابه «قصيدة وصورة»، الذى يعد أشهر إصدارات سلسلة عالم المعرفة فى تاريخها، والذى يمنح خلاله القارئ العربى شفرة لفهم الأعمال التشكيلية والربط بينها والقصائد التى تحمل نفَسًا تشكيليًا، وهى العلاقة التى طالما رسّخ لها، ولا أنسى السطر الذى كتبه وظل يسكن وجدانى «الشعر هو فن التشكيل».

المغامرات الروحية الكبرى
كل ما علينا أن نترك حواسنا تقرأ البانوراما التى كتبها الشاعر الكبير حسن طلب، فى مقدمة كتاب «بكائيات.. ست دمعات على نفس عربية» لعبدالغفار مكاوى، معنونًا إياها وواصفًا الرجل بـ«شاعر الفلسفة».
يكتب حسن طلب عن الرجل العظيم بقلب التلميذ الذى يتحدث بإجلال عن أستاذه، فيقول: سافر «مكاوى» فى مغامرته الروحية الكبرى عبر العصور، وتقلب بين الأزمنة والأمكنة ينشد ضالته أو معشوقته الأثيرة: الحقيقة، فمن حكمة الرافدين حيث بحث عن «جلجامش» وجذور الطغيان، إلى حكماء الصين القديمة، حيث توقف عند «لاو تزو» ونقل إلى العربية كتابه «الطريق والفضيلة»، الذى يعده أحب الكتب إلى قلبه، ثم إلى الحكماء اليونانيين السبعة وفلاسفة ما قبل سقراط، ومن بعدهم أفلاطون وأرسطو، لينزل فى سلم الزمن إلى العصور الوسطى، ويقف عند «بوئيثيوس A. M. S. Boethius» «٤٨٠–٥٢٤م» فى عزائه للفلسفة، ثم إلى العصور الحديثة ليتأمل أهم نصوص «ليبنتز G. W. Leibnitz» «١٦٤٦–١٧١٦م».
ويواصل: «ينقل إلى العربية كتابه الأهم (المونادولوجيا)، ثم ينتقل إلى (كانط I. Kant) (١٧٢٤–١٨٠٤م) فينقل كتابه (تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق)، الذى ألفه الفيلسوف الكبير عام ١٧٨٥م ليكون تمهيدًا لكتابه الأساسى: (نقد العقل العملى) الذى صدر بعد ثلاث سنوات».

ويكمل: وتستمر الرحلة لتتشعب بها الدروب فى متاهات الفلسفة المعاصرة، فمن الوجودية وأعلامها: «هيدجر» و«كامى A. Camus» «١٩١٣–١٩٦٠م» و«ياسبرز K. Jaspers» «١٨٨٣–١٩٦٩م»، إلى رواد فلسفة الحياة من أمثال «ماكس شيلر M. Sheler» «١٨٧٤–١٩٢٨م» و«دلتى W. Delthey» «١٨٣٣–١٩١١م» و«برجسون H. Bergson» «١٨٥٩–١٩٤١م»، ثم إلى أقطاب «مدرسة فرانكفورت» فى ألمانيا، مع غيرهم من أصحاب النزعة المثالية والميول الصوفية، مثل «شتروفه»، الذى تتلمذ عليه «مكاوى» فى ألمانيا، ونقل إلى العربية فى سبعينيات القرن الماضى كتابه الشيق العميق: «فلسفة العلو- الترانسندنس»، وهو الكتاب الذى أعادت طبعه الهيئة العامة للكتاب.
يقول: «أما لو وقفنا عند ما قدمه «مكاوى» من دراسات وترجمات شعرية وأدبية، فلن نجده أقل أهمية، فهو يضارع كمًا وكيفًا ما قدمه فى مجال الفلسفة الخالصة، بل ويتسع أيضًا زمانيًا ومكانيًا، كما كان الحال فى النتاج الفلسفى، فمن الشاعرة اليونانية «سافو»، إلى «جوته» و«بوشنر» و«بريخت» والرمزيين من أعلام «ثورة الشعر الحديث».
ويختتم بقوله: «رحم الله عبدالغفار مكاوى؛ لقد كان نسيج وحده فى حياتنا الثقافية، لا بنتاجه الفلسفى والأدبى الغزير والأصيل فحسب، وإنما أيضًا بإبداعاته القصصية والمسرحية، وبروحه السمحة وتواضعه الجم، وما أحرانا— نحن تلامذته ومحبوه— أن نعى الدرس الذى لقننا إياه بجده وصبره، وصمته وبعده عن الأضواء، وأن نعيد تقديم تراثه للأجيال الجديدة؛ لتجد فيه المثال الحى على الدقة والعمق والصدق، فى زمنٍ عزت فيه هذه القيم».





