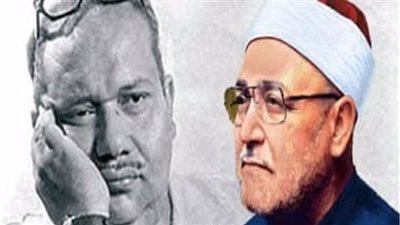مصائر معطلة.. «ليس بعيدًا عن رأس» سمير درويش

فى فضاءٍ سردىّ مفتوح، حيث تتماهى المدينة مع مصير الفرد، ينطلق الشاعر والروائى سمير درويش فى روايته «ليس بعيدًا عن رأس الرجل» من مشهدٍ صادمٍ؛ إذ يُقتل البطل يونس برصاصة قناص أثناء مظاهرة، ليفتح هذا الحدث الباب أمام سرد داخلى متشعب، تتداخل فيه مشاهد الذاكرة مع اللحظة الراهنة، ويصبح الموت ليس مجرد نهاية، بل بوابة لاستعادة تفاصيل الماضى، ما يجعله فى مركز الحكاية. هنا، لا يتعامل الكاتب مع الموت كحدث مفاجئ، بل كرحلة تأملية تتقاطع فيها الذاكرة مع الواقع والحلم.
تمثل رواية «ليس بعيدًا عن رأس الرجل» مثالًا واضحًا على كيف يمكن للشاعر أن يكون روائيًا دون أن يفقد حساسيته الشعرية. لا يكتب سمير درويش الرواية فحسب، بل يعيد تشكيلها بروح الشعر، جاعلًا من اللغة أداة حية تنبض بالموسيقى والصور، ما يمنح النص كثافة خاصة. يمكن القول إن هذه الرواية هى رواية شاعر بامتياز، حيث يتحول السرد إلى امتداد للقصيدة، فنرى الكاتب يوظف جملًا قصيرةً مكثفةً فى بعض المشاهد، بينما يطلق العنان للوصف التفصيلى فى أخرى.
يستخدم سمير درويش الرمزية فى الرواية كما يستخدمها فى شعره، حيث تصبح التفاصيل الصغيرة ذات دلالات كبرى. فالمرايا، الألوان، وحتى طريقة حركة الشخصيات، كلها تحمل أبعادًا تتجاوز المعنى الظاهرى. هذه التقنية أقرب إلى الشعر منها إلى السرد التقليدى، إذ تجعل الرواية متعددة الطبقات، تترك للقارئ حرية تأويل المعانى والرموز كما يفعل مع القصيدة.
كما أن هناك شعريةً للصوت الفردى فى الرواية، نلاحظ ذلك من خلال التدفقات الداخلية للشخصيات التى تأتى بأسلوب شعرى، سواء فى تأملات يونس حول الموت، أو فى حوارات الشخصيات مع ذواتها. هذا المونولوج لا يعبر فقط عن أفكار الشخصيات، بل يصبح كأنه «قصيدة داخل الرواية»، حيث يتلاعب بالإيقاع، والاستعارة، والتكرار، ليخلق نوعًا من التدفق الشعرى فى النص السردى.
يتجلّى كذلك تأثر الكاتب بتقنيات تيار الوعى، فينقل القارئ بين فصول الزمن المختلفة، متنقلًا بين الماضى والحاضر دون مقدمات، ما يعزز الشعور بالفوضى الزمنية، ويؤكد أن الزمن ليس خطيًّا، بل يتشابك ويتكرر داخل العقل الإنسانى. ومن هنا كان الانتقال بين الحياة والموت فى السرد يعكس تساؤلًا وجوديًّا «هل تنتهى حياة الإنسان بلحظة الموت، أم تستمر فى ذاكرته وذاكرة الآخرين؟» من خلال هذه الأسئلة، لا تقدم الرواية إجابات مباشرة، بل تترك المجال للتأمل، ما يجعلها عملًا مفتوحًا على قراءات متعددة.
الحب والجسد بين الرغبة والفقد
فى الرواية، تحضر بقوة شخصيات عزيزة، وئام، ماهيتاب، نجوان، مليكة، وآية، وهن يمثلن أنماطًا مختلفة من النساء اللاتى مررن فى حياة البطل. العلاقة بين الرجل والمرأة ليست مجرد علاقة عاطفية أو جسدية، بل هى أيضًا علاقة سلطة، صراع، وافتقاد، حيث تعكس النساء تحولات شخصية يونس، وهى تحولات فكرية واجتماعية تتوازى مع التغيرات الكبرى فى المجتمع. كذلك، تتقاطع هذه العلاقات مع أماكن الرواية، حيث ترتبط كل شخصية بالمكان الذى تشكّل فيه وعى يونس، سواء كان القرية أو المدينة أو الغربة.
عزيزة هى الجذور الممتدة فى أعماق ذاكرة يونس، أول صورة للحب، وأول أنثى تترك أثرًا عميقًا بداخله. تتحول إلى ذكرى تلازمه طوال حياته، إذ تبقى مثالًا للمرأة التى لا يستطيع نسيانها، رغم تعدد علاقاته بعد رحيله عن قريته. عزيزة الريفية التى رسمت لهما بيتًا بالطباشير، وقالت له «أنت الرجل» وهو بعد طفل يبول على نفسه. فى القرية، كان الحب بريئًا، غير ملوث بصراعات المدينة وتعقيداتها، لكنه كان أيضًا هشًّا، سرعان ما تبعثر مع الزمن.
ثم تأتى وئام سلطان، كوجه أول للمدينة بكل عنفوانها، لتمثل التجربة الجسدية الأولى والصراع بين العاطفة والرغبة. وئام فتاة شعبية تعيش فى حى بين السرايات، تمثل الشريحة الاجتماعية التى تعانى صراعًا بين الغرائز المكبوتة والتقاليد القاسية. وافقت بسرعة على أن تكون موديلًا للوحات يونس، لكنها فى النهاية حرمت نفسها منه انتقامًا، ربما لأنه أراد أن يأخذ منها كل شىء دون أن يمنحها ما تستحقه من التقدير والالتزام. بالنسبة ليونس، فقد كشفت له عن جانب من شخصيته لم يكن يدركه من قبل، جانب الرجل الذى يطلب من المرأة أن تكون مستسلمة، دون أن يكون مستعدًا للمقابل.
إذا كانت وئام قد علمت يونس لغة الجسد، فإن ماهيتاب علمته معنى الشراكة العاطفية الناضجة. هى ابنة الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، المحجبة الممتلئة قليلًا، يعكس حضورها الجانب الغريزى والعاطفى ليونس. والمرأة التى تشعل الشغف والرغبة الآنية، لكنها ليست الحبيبة الدائمة. وعلى عكس عزيزة، ترتبط وئام وماهيتاب بالقاهرة، مدينة المتناقضات، حيث تتحول العلاقات إلى لقاءات عابرة، تسود الرغبة فيها على المشاعر العميقة، والحب نفسه يصبح استهلاكيًّا، مثل كل شىء آخر فى المدينة.
يبدو أن يونس كان موعودًا بلقاء نساء لا تشبه الواحدة منهن الأخرى، وكأن كل امرأة جاءت لتعكس جانبًا مختلفًا من رحلته المتشظية بين الرغبة، الفقد، والبحث عن المعنى. وهكذا، جاءت نجوان سيف الدين، الأرستقراطية التى لم تكن تبحث عن الحب بقدر ما كانت تسعى إلى الاعتراف والقوة. امرأة مستقلة، غنية، مثقفة، لكنها تعيش فى عزلة داخل أبراجها العالية، متحصنة بمكانتها، غير مبالية بالأشياء التى دهستها فى طريقها إلى الأعلى.
على عكس ماهيتاب، لم تكن نجوان تفتش عن العاطفة أو الشغف، بل عن ذلك المكان الذى سيمنحها مزيدًا من النفوذ. علاقتها بيونس كانت جزءًا من لعبة اجتماعية، تفرضها النساء القويات على الرجال الذين يحاولون الاقتراب منهن. هى نموذج المرأة التى حققت كل شىء، لكنها ما زالت غير راضية، لأنها تدرك أن العالم لا يمنح النساء القوة بسهولة، وأن عليها أن تفرض وجودها بأى طريقة.
تأثيرها على يونس لم يكن عاطفيًا بقدر ما كان فكريًا، فقد جعلته يدرك أن هناك نوعًا آخر من النساء، النساء اللواتى لا يبحثن عن رجل يحميهن، بل عن رجل يعترف بهن ككيان مستقل. نجوان ابنة المدينة بامتياز، تجسد قلقها الوجودى، وحدتها فى زحامها، وحيرتها الدائمة بين تحقيق ذاتها العصرية وبين حاجتها للحب.
ثم جاءت مليكة، وهى تجسيد للحب الضائع والصراع بين الرغبة فى الاستقرار والخوف من الارتباط. من خلالها، تطرح الرواية تساؤلًا حول إمكانية الحب فى ظل الفوضى والموت، حيث تبدو العلاقات دومًا محكومة بالسياق السياسى والاجتماعى المضطرب، ما يجعل الحب أشبه بمعركة خاسرة. وعلى عكس النساء الأخريات، ترتبط مليكة بالمنفى، بالغربة، بالحياة المعلقة بين هنا وهناك، حيث يصبح الحب أقرب إلى الحلم المستحيل. الوحيدة بين النساء اللائى التقهن كانت تعكس وجهه الآخر، فهى أيضًا تبحث عن شىء غير واضح، عن انتماء لا تستطيع تحقيقه بالكامل؛ ما جعلها تظل فى ذاكرته كحلم لم يكتمل مثل عزيزة، لكنها حلمٌ فى أرض بعيدة، فى ثقافة مختلفة، لا يمكن استعادتها بسهولة.
أما آية عبدالرحمن، المرأة الأخيرة فى حياة يونس، فلم تكن حبيبة، بل هى أقرب إلى صدمة فكرية، إلى مواجهة مع واقع جديد لا يفهمه. ناشطة سياسية تؤمن بالثورة، ترى أن جيل يونس جيل متخاذل قبل الإهانة لعقود، بينما هى وجيلها من قاموا بتحريره. تمثل الصراع بين الأجيال، بين من يرون التغيير ممكنًا، ومن يرونه وهمًا أو مجرد موجة أخرى ستنتهى كما بدأت.
تأثيرها على يونس لم يكن عاطفيًا، بل كان إدراكيًا، فقد جعلته يرى نفسه من خلال عيون الجيل الجديد، يدرك أنه أصبح جزءًا من الماضى، من جيل فقد القدرة على الحلم. آية ليست امرأة فى حياته، بل هى علامة على نهاية مرحلة وبداية أخرى، على زمن لم يعد فيه الحب هو السؤال الأهم، بل أصبح البقاء نفسه هو التحدى الحقيقى.
النساء فى حياة يونس لا يمثلن مجرد علاقات عاطفية، بل هن مرايا لذاته القلقة، لكل منهن رمزيتها الخاصة ودورها فى تشكيل رؤيته للحياة. بين الرغبة والغياب، بين الجسد والروح؛ يبدو الحب فى الرواية كحالة مؤقتة، لا خلاصًا، حيث لا شىء يكتمل، وكل حب يحمل داخله بذور نهايته.
يونس بين الجذور والتيه
تدور الرواية فى زمن الثورات العربية، تحديدًا فى مشاهد العنف السياسى والمظاهرات التى قادت إلى تغييرات كبرى. يوثق الكاتب هذه الأحداث من منظور فردى، من خلال تجربة يونس الذى يجد نفسه وسط معركة أكبر منه، تتلاشى فيها الفواصل بين الفرد والجماعة، بين الفوضى والنظام، وبين السلطة والمقاومة.
القاهرة ليست مجرد مكان تدور فيه الأحداث، بل هى شخصية قائمة بذاتها. إنها مدينة التناقضات؛ مدينة الحلم والانكسار، الفوضى والنظام، الحرية والقمع. إنها المدينة التى تجعل يونس يرى نفسه فى كل زاوية، لكنه فى الوقت ذاته يشعر فيها بالغربة أكثر ما شعر بها فى قريته.
الرواية لا تقدم صورة رومانسية للمدينة، بل تكشف قسوتها، وكيف تتحول إلى آلة ضخمة تحول سكانها إلى كائنات منهكة وتائهة تبحث عن خلاص لا يأتى. فى القاهرة، تتشكل علاقاته النسائية بعيدًا عن البراءة الأولى التى وجدها فى القرية. كل شىء هنا مؤقت، هش، وغير مكتمل. على الجانب الآخر، تمثل القرية الجذور، الذاكرة، والماضى الذى يظل يطارده. إنها المكان الذى شهد تشكله الأول، لكنها أيضًا المكان الذى لم يعد قادرًا على احتوائه.
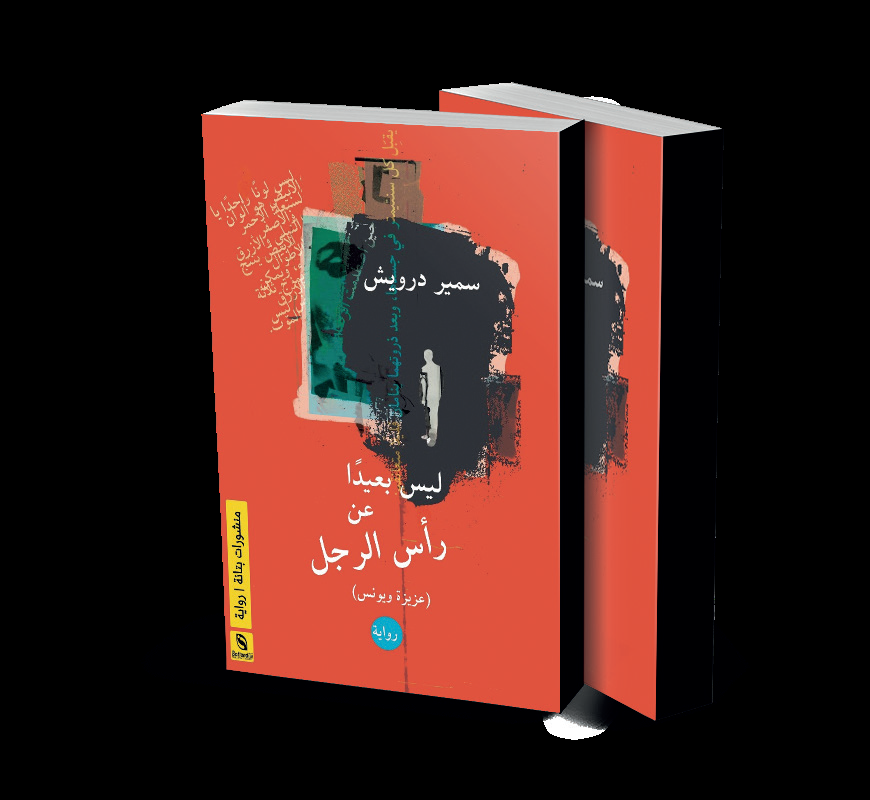
ثم الهجرة إلى الغرب، حيث عاش يونس فى نيويورك، لا تمثل خلاصًا، بل تضيف طبقة أخرى من الضياع. إنه عالق بين عالمين؛ لا هو ابن القرية تمامًا، ولا هو منغمس كليًا فى حياة المدينة الحديثة. هذا الانشطار يجعل سؤاله عن الهوية والانتماء سؤالًا مؤجلًا، بلا إجابة واضحة، كما لو أن وجوده ذاته ظل معلقًا بين محطتين، بلا يقين. السؤال الوجودى «من أنا؟ وإلى أين أنتمى؟» حاضر بقوة فى الرواية، حيث يشعر البطل بعدم الانتماء إلى أى مكان، سواء كان القاهرة، القرية، أو حتى الغرب.
الرواية تتنقل بين القرية، القاهرة، ونيويورك، ما يجعلها عملًا يربط بين التاريخ الشخصى والتحولات الاجتماعية. يونس شخصية ممزقة بين ماضيه فى القرية وحاضره فى المدينة، وبين جذوره المصرية وإقامته فى نيويورك. لكنه، فى الوقت ذاته، يجد نفسه منجذبًا إلى القاهرة دونما غيرها، المدينة التى تعده بالحرية، قبل أن تكشف عن وجهها الآخر؛ وجهها القاسى. يعشق ترابها رغم أنها تبتلع أحلام ساكنيها، وتعيد إنتاج العزلة بأشكال أخرى؛ ربما بشكل ما يحبها لهذا السبب!
«ليس بعيدًا عن رأس الرجل» ليست رواية عن الموت، بل مرثية للحرية الموءودة، وتأمل فى مصير الفرد الذى يظل يركض بين الأمكنة بلا يقين وبلا ملاذ، يونس يمثل مرآة لجيل بأكمله، جيل حمل أحلامًا كبرى بالحرية، لكنه وجد نفسه يطارد سرابًا وسط الخراب. بين القرية، المدينة، والغربة، كان يحاول أن يعثر على ذاته. الغريب أنه فى لحظة سقوطه، يصبح أكثر حضورًا مما كان وهو على قيد الحياة، كأن موته يفتح دائرة من الأسئلة بدلًا من إغلاقها.
لا تمنحنا الرواية إجابات نهائية، بل تتركنا فى مواجهة السؤال ذاته الذى ظل يونس يهرب منه. وبين أزقة القاهرة التى تصنع الثائر ثم تقتله، وفى ذاكرة يونس التى ترحل معه حتى آخر لحظة، تتحول الحكاية إلى تأمل طويل فى الحرية، الفقد، والقدر الذى يطاردنا جميعًا.ش