«نذير الطائف».. البحث عن أمية بن أبى الصلت

- المملكة فى السنوات الأخيرة صار فيها نشاط أثرى ملحوظ
- حاول عدد من الباحثين والمتخصصين فى الأدب الجاهلى جمع ديوان لأُمية بن أبى الصلت
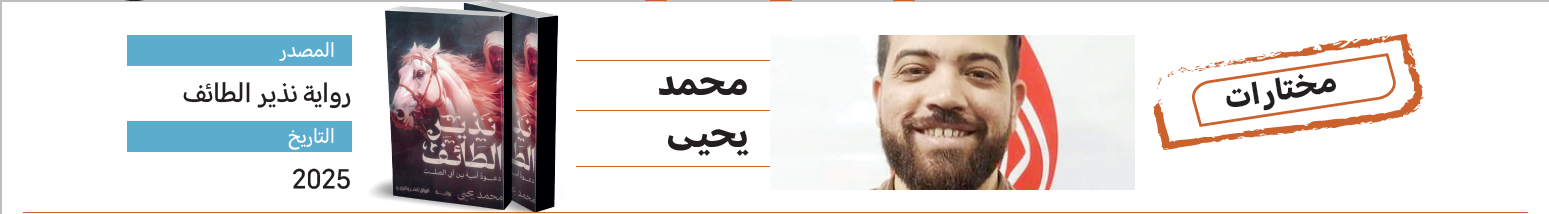
فى أول أسبوع من شهر أكتوبر عام 2020 جلستُ مع صديقى أحمد الذى كان يودعنى لأنه سيغادر البلاد فى الخامس من نوفمبر التالى. كانت تلك الجلسة محاطة بشجون ومشاعر مختلطة، فأحمد يودع بها مصر كلها، ويودع أصدقاءه كلهم فى شخصى، أما أنا فكنتُ أودعه وأودع حياة العزوبية، فقد كان موعد زفافى قد حُدد على أن يكون فى نهاية العام نفسه، إضافةً إلى هذا كله كان كلانا يودع المدينة التى تربينا فيها حتى بلغنا نهاية عقدنا الثالث، وقد كنتُ انتويت أن أتزوج فى مدينة أخرى تناسب ظروف عملى وقتها.
اختلفت تلك الجلسة لهذه الأسباب عن جلساتنا السابقة كلها، لكنها لم تختلف قط فى حوارها وموضوعاتها وطولها، فقد اعتدنا أن يزورنى أحمد مرةً فى الأسبوع على الأقل، نجلس فى سطوح بيتنا نشرب الشاى ونتقلب بين موضوعات مختلفة بمنتهى الرشاقة وبلا ملل، حتى تتسرب الساعات ولا ندرى وكنا نسكن مدينة هادئة لها مناخ مميز ونسيمٌ لطيف، ليلها يسامى ليل المدن الساحلية جمالًا، وسماؤها لا يعكر صفاءها ما يعكر سماء عاصمتنا الموقرة أو غيرها من المدن المزدحمة. ومهما وصفتُ لك إلى أى مدى كانت حواراتنا تبدو أحيانًا حوارات عاقلة بين شابين واعيين مطلعين فلن تصدق، وكذلك ستنكر علىّ لو وصفتُ لك كيف تكون هذه الحوارات عبثية وشاطحة أحيانًا، ففى مرةٍ قطعت موضوعًا كان يتناقل بين ألسنتنا وسألته: هل تعلم أنى كنت على وشك التمكن من قراءة الأفكار؟! فقال لى بمنتهى التلقائية: أتدرى كيف يجب أن تكون الفكرة قوية ومركزة حتى يتمكن المرء من قراءتها؟! ثم عدنا إلى موضوعنا واستأنفناه على هذا كنا نطلق على جلساتنا «بودكاست المغمورين». أما ما ميز تلك الجلسة الأخيرة وجعلنى أذكرها لك الآن هو أننا يومها مررنا فى كلامنا على التاريخ البعيد وما يتركه الأولون من آثار وما يستنبطه الآخرون منها، وبما أن مصرنا هى أهم دول العالم القديم وأسلافنا هم الأعظم أثرًا، فقد سَرَقَ منا هذا الموضوع ما بين العصر والغروب، حتى رمى بنا فى خبر عجيب. إذ أخبرنى صديقى عن خاله الذى يعيش فى المملكة العربية السعودية منذ عشرين سنة تقريبًا، فقال: إن المملكة فى السنوات الأخيرة صار فيها نشاط أثرى ملحوظ، وإن حكومة المملكة فى زمرة انفتاحها أولت هذا الوضوع اهتمامًا كبيرًا حتى صارت تنقب فى مدنها العتيقة عن آثار العالم الذى سبق ظهور الإسلام، وهذا هو الجديد فى توجه المملكة، ففى القرن الماضى كانت تهتم أكثر بالآثار الإسلامية ولا تولى غيرها اهتمامًا مماثلًا، لكن فى عهد الملك سلمان وسياسات ولى عهده الأمير محمد، ظهر هذا التوجه الجديد.
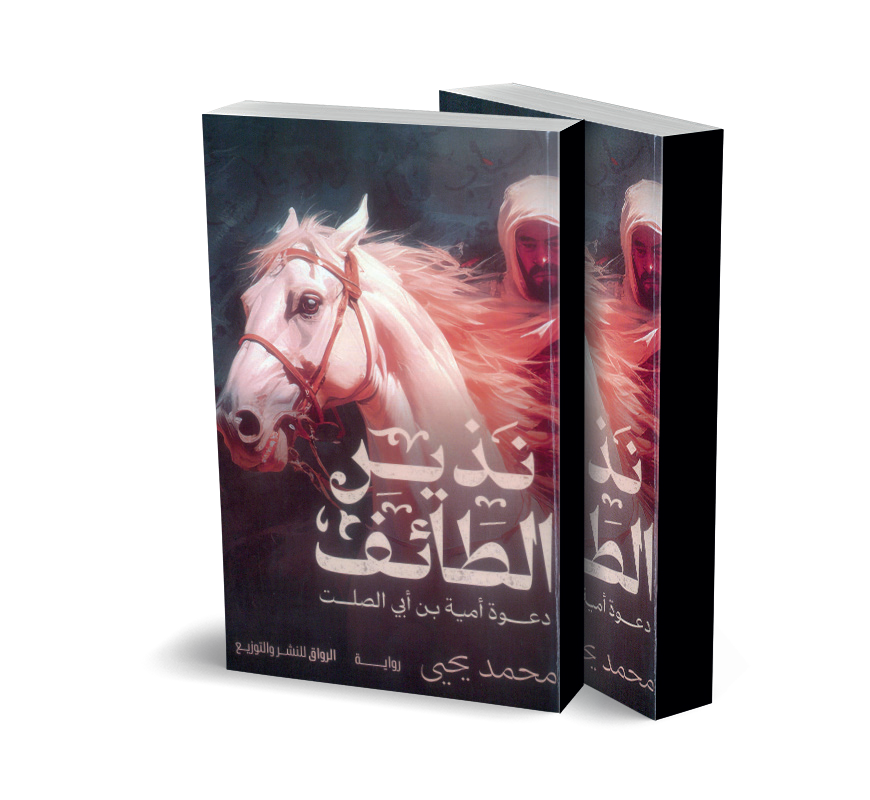
عندما سمعتُ هذا الكلام من صديقى أصابنى ما يصيبك الآن من تساؤل، فمنذ متى كانت المملكة بها من الآثار ما يسترعى الانتباه إذا استثنينا الآثار الإسلامية؟! فلما سألته قال: هذا ما كنتُ أعتقده أيضًا، لكن خالى منذ عامين التحق بالفريق المسئول عن آثار الطائف وأخبرنى أنهم منذ شهور قد وقفوا على كشف عظيم، كشف إسلامى وجاهلى فى الوقت نفسه، وهم الآن يجهزون للإعلان عنه فى الفترة القادمة ووضعه فى المركز الوطنى للوثائق والمحفوظات بالرياض. فقلت له: لم أفهم مما قلت إلا ذلك المركز للوثائق، ما معنى كشف إسلامى وجاهلى فى الوقت نفسه؟! فقال: وجدوا صُحُفًا مكتوبةً فى أواخر عهد الأمويين، لكنها تحكى حكايةً وقعت فى الجاهلية وصدر الإسلام! أثارتنى - جدًا هذه الكلمات القليلة وقد كنت وقتها أكتب كتابًا عن تاريخ العرب القديم، تمهيدًا لسلسلة أريد أن أتناول فيها تاريخ العرب الطويل بعد ظهور الإسلام فطلبت منه أن يوصلنى بخاله فوعدنى أن يفعل.
انتهت جلستنا الوداعية لكن ذلك الموضوع لم يغب عن عقلى ساعةً فى يقظتى، ولم يمض شهر نوفمبر حتى أرسل لى صديقى رسالةً من الخارج وفيها رقم خاله الذى ينتظر منى مراسلته للتعارف.
الدكتور إبراهيم عليان على، أستاذ التاريخ الذى كانت له رسالة مميزة نشرتها جامعة الملك عبدالعزيز عن أثر المكان على التعدد اللهجى عند العرب قبل الإسلام، والذى انتدب قبل ذلك الوقت بسنتين ليعمل فى دار الوثائق والمحفوظات بالرياض، هذا هو خال صديقى أحمد، وقد تعرفتُ إليه وتبادلنا الرسائل، ويبدو أن الدكتور قد أُعجب بلهفتى وكثرة سؤالى واهتمامى بذلك التاريخ البعيد، فصار يفرغ لى ويجود علىّ بوقته، حتى اعتدنا أن نتكلم بالصوت والصورة أسبوعيًا.
بعد شهر ونصف الشهر تقريبًا من اتصالى بالدكتور إبراهيم، أخبرنى أن دار الوثائق قد أعلنت عن كشف الطائف وأنه صار متاحًا للباحثين بشكل رسمى.
تعجبتُ عندما بحثتُ فى الأخبار عن هذا الإعلان فلم أجد ما أتوقع!

لم يتعد الموضوع المنصات المحلية فى المملكة! وحتى هذه أهملت الصحف واهتمت بباقى الاكتشافات، إذ تناولت أخبارًا عن التنقيب والكشوفات فى منطقة العرفاء شرق الطائف، وأشارت إلى أعمال المسح الحجرى التى سجلت رسومًا كثيرة تدل على حيوانات لا تقدر على العيش فى بيئة الطائف أصلًا، وعلى أسلحة ومعارك ونقوش ثمودية وكتابات كوفية... ثم ذَكَرَت فى آخر سطورها اكتشاف صحف وجدَت مدسوسةً تحت سد سيسد المعروف بسد معاوية!
هكذا ذكر اكتشاف الصحف، كلمات قليلة فى ذيل الخبر!
استيقظتُ فى ذلك اليوم وكل ما يشغلنى أن أذهب إلى شيخى، فقد أرسل لى الدكتور إبراهيم صورًا للصحف كما طلبت منه، وهذه الصور ستحالفنى على شيخى لأدفع فضوله للانشغال معى بالموضوع ذاته.
الشيخ أحمد حسن العدوى، شيخى الذى أقرأنى القرآن وأجازنى فى إقرائه، وهو باحث فى العقيدة والفلسفة وله اهتمام كبير بتحقيق المخطوطات، وفى تلك الفترة كان قد انتهى لتوه من تحقيق مخطوطة كتاب الحيدة والاعتذار لعبدالعزيز بن يحيى الكنانى. حمدت الله عندما أخبرنى الدكتور إبراهيم أنَّ الصحف المكتشفة تحتاج إلى محقق فذ للتعامل معها، فقد كنت أؤمن أنَّ هذا الفذ هو شيخى، وليست هذه النظرة هى نظرة الطالب لشيخه فقط، بل كان الشيخ أحمد يستحق هذا الإيمان، فلم أرَ فى حياتى شيخًا يعمل فى الأوقاف المصرية يشبهه، فهو رجلٌ له نهم فى طلب العلم، وله قراءات فى فلسفة العلوم والعقائد، وكان يُعد لمناقشة رسالة الماجستير فى كلية دار العلوم فى تلك الفترة، ومع هذا كله لم يقصر فى وظيفته، فهو قائم بمسجده، قد ملأه علمًا ونورًا. ولو أنَّه فرّغ نفسه لتحقيق المخطوطات لصار علمًا من أعلام هذا الفن، لكنه آثر عليه ميادين أخرى، ولم يكن التحقيق عنده إلا هواية تنسيه الحاضر وتجعل له يدًا على الماضى وأهله.
لما استيقظتُ ووجدت الصور المرسلة من الدكتور إبراهيم، اتصلت بشيخى واقتنصتُ منه موعدًا بعد عشاء الليلة ذاتها.
فى غرفة شيخى البسيطة فى مؤخرة المسجد، جلستُ إليه بعدما انتهت الصلاة وانفضّ الناس، وقلتُ له فى مكر وأنا أدفع إليه الصور: هذه صور للصحف المكتشفة مؤخرًا فى الطائف، والتى تروى حكاية على لسان أُمية بن أبى الصلت نفسه.. وقد صارت متاحة للدراسة والتحقيق...
سمعنى وهو يفحص الصور بعينين متلهفتين، ومع نهاية جملتى لمعت عيناه لمعة أعرفها!
سبق للشيخ أحمد أن تواصل مع دور الوثائق فى الرياض وبرلين والقاهرة فى أثناء تحقيقه لكتاب الحَيْدَة، وهذه الخبرة ستجعل مهمتى أقل صعوبة ولا يبقى لى إلَّا الجزء الفنى ومدى إتقان شيخى له. وافقنى الشيخ على مساعدتى فى تحقيق الصحف حتى أضعها فى كتاب ينشر فى مصر. وقد كانت هذه أمنيتى مذ علمت بأمرها، ففى النهاية هذه المخطوطة تضم سطور أول سيرة ذاتية عربية!
فلم يكن العرب فى ذلك الزمان يستهدفون تدوين سيرتهم كاملة إلا ما كان يُؤثر عنهم من القصص والحكايات والنوادر. لكن صاحب مخطوطتنا هذه كانت له دوافعه الخاصة.
بعد ثلاثة أعوام تقريبًا، وفى خريف ٢٠٢٤، كنتُ قد انتهيتُ من العمل على تحقيق مخطوطة الصحف، وقد كان عنوانها الأصلى «النبى»، لكن يبدو أن أحدًا أضاف كلمة «الكافر» بخط أحدث وبحجم أصغر، لتصلنا المخطوطة معنونة بـ«النبى الكافر»!.
ولفظاظة هذا العنوان الذى قد يُساء فهمه، استبدلت به العنوان الذى قرأته لتوك على الغلاف.
أما عن عملى فى المخطوطة؛ فبعد تحقيق النص الأصلى كله، أضفت هوامش توضيحية حتى يلائم المنتج النهائى ذائقة القراء وثقافتهم على تنوعها، وتشمل تلك الهوامش الكلمات غير الواضحة التى لم نستطع الوقوف عليها ففقدناها كلها، فوضعت مكانها [...] وبينتُ فى الهامش ما يغلب على ظننا من بقايا الكلمة وفقًا للسياق، وكذلك ذكرتُ فى الهوامش بعض المراجع التى وجدتُ فيها أحداثًا حكى عنها صاحب المخطوطة للائتناس والزيادة. فقد ذكر أهل الأخبار والسير عددًا من الحكايات التى وردت فى المخطوطة من غير طريق أُمية وبقليل من الاختلافات وطبعًاذكرتُ مرادفات الكلمات والتعبيرات الصعبة. فالمخطوطة تتكلم بلسان أُمية بن أبى الصلت وهو رجلٌ من أفصح العرب فى عصرهم الذهبى فى الفصاحة والبيان، ولغته قديمة بالضرورة. وأمَّا خارج الهوامش وفى المتن نفسه فقد تدخلت أحيانًا حتى أُفَصِّل مُجملًا أو أشرح مبهمًا، أو أتمم ناقصًا، وحتى لا يختلط النص الأصلى بتدخلى فقد جعلت كلامى فى فقرات مستقلة بين هلالين. إضافة لهذا كله فقد قدَّمتُ وأخرت وأعدتُ ترتيب الحكايات الواردة فى المخطوطة بالشكل الذى يجعل منها سياقًا مريحًا للقارئ، وكانت هذه أصعب مهمة، فلا أصعب من أن تهذب حكايا رجل أدلى بها محتضرًا.
قسمت متن المخطوطة إلى كُتب حتى تسهل على القارئ. وجاء تقسيمى على كتب خمسة، أولها «كتاب الدلائل» وفيه حكايات ذكرها أمية بطولها حتى يستدل بها فى سياق تالٍ على نبوته. وثانيها «كتاب الشام» وفيه حكايات خروجه من الطائف إلى الشام وما وقع فيها أو ترتب عليها وثالثها كتاب «النبوة» وفيه ذِكْرُ أُمية لنبوته. ورابعها كتابُ «النَّبيَّيْن» وفيه نبوة محمد بن عبدالله صلوات ربى عليه ومواجهة أُمية له فى مكة وما ترتب عليها. وخامسها كتاب «النهاية». كتبت المخطوطة بالخط الحجازى، فرغم انتشار الخط الكوفى فى القرن الثانى للهجرة فإنَّه وحتى منتصف القرن كان أهل الحجاز الذين ينتمى إليهم كاتبنا يرونه نوعًا من الزخرفة والفنون أكثر من كونه خطًا للكتابة السهلة، وهذا يضاف إلى أدلة كتابة المخطوطة فى النصف الأول من القرن الثانى. ويُعد الخط الحجازى مميزًا جدًا بحروفه المائلة إلى اليمين وكذلك ببساطته وعدم انتظامه أحيانًا وطبعًا قلة الزخرفة. أما الكوفى فهو فن تفرع منه عدد من الخطوط التى ما زالت تُبهر العالم إلى اليوم. وقد أرفقت صورًا للخطين فى ملحق الصور.
ولقد حاول عدد من الباحثين والمتخصصين فى الأدب الجاهلى جمع ديوان لأُمية بن أبى الصلت، فجاءت المحاولة الأولى للأديب الأب لويس شيخو فى كتابه «شعراء النصرانية» الذى نُشر عام ١٨٩٠م وقد جمع فيه ٢٥٦ بيتًا شعريًا لأمية، ثم تبعه فى مسعاه المستشرق فرديناند شولتز، وأخرج ديوانًا لأمية عام ١٩١١ جمع فيه ٥٣٠ بيتًا. وفى العام ١٩٣٤م نشر بشير يموت ديوانًا جديدًا فيه ٧٤٩ بيتًا، كل هذه المحاولات كانت تعج بالأخطاء المنهجية سواء فى الجمع أو التخريج أو الشرح، وبعضها أهمل أصلًا هذه المنهجية، بل إن منهم من استهدف بجمعه لديوان أُمية إثبات أنَّ القرآن كله كان مقتبسًا منه، وهذا الشطط هو نتيجة لجهل المستشرق بكلام العرب ولسانهم من ناحية وجهله بالقرآن نفسه من ناحية أخرى، فالقرآن إنما نزل بلسان العرب ومقالهم، فيه ألفاظهم ومعانيهم، ولهذا لم يستعجم عليهم. وهو مع هذا قد كسر قناتهم وارتقى فى البلاغة حتى أعجزهم، فليس من الغريب أن ترى فى كلام رجل من فصحاء العرب كأمية كلامًا استعمله القرآن. فهذا لا يُريبُ إِلَّا جَاهلًا.
ثم قام الدكتور عبدالحفيظ السطلى رحمه الله، بتصنيف ديوان لأمية بن أبى الصلت وحقق فيه ٧٥٣ بيتًا ثم زاد فى الطبعة الثانية ١١٦ بيتًا. وكان هذا العمل هو بابًا للعمل الأفضل على الإطلاق فى رأينا والمتمثل فى الرسالة الجامعية التى نشرتها وزارة الثقافة العراقية عام ١٩٩١م بعنوان «أُمية بن أبى الصلت حياته وشعره» للدكتور بهجة عبدالغفور الحديثى، وفيه ٨٥٧ بيتًا بجانب بحث مهم فى حياة أمية وبيئته وقطوف من الحياة الأدبية الجاهلية. وقبيل نهاية القرن العشرين نشر الدكتور سجيع الجبيلى ديوانًا جديدًا لأمية بن أبى الصلت زاد فيه على الدكتور الحديثى ٧٤ بيتًا.
فى هذه الأعمال كلها التى اهتمت بجمع شعر أُمية من كتب الدنيا المتفرقة، لم يُشر أحدٌ إلى أنه وقع على دليل يخص هذه الصحف المكتشفة مؤخرًا والتى ستقرأها بنفسك الآن. لكن الدكتور الحديثى ذكر شيئًا مهمًا، إذ قال: لم نستطع حتى الآن العثور على ديوان مخطوط لأمية بن أبى الصلت يجمع أشعاره، على أن هناك إشارات فى نصوص متفرقة تدل على أن لأمية ديوانًا مخطوطًا... وأملنا فى العثور عليه كبير لأن صاحب الخزانة يقول إنه رآه، وهو متوفّى فى العام ١٠٩٣ من الهجرة.
وصاحب الخزانة الذى يقصده الدكتور الحديثى هو عبدالقادر البغدادى صاحب كتاب «خِزَانةُ الأدب ولُبُّ لُبَابِ لِسَانِ العَرَب». بجانب ما قاله البغدادى فإنَّ الدكتور الحديثى ذكر رواية أخرى مهمة جدًا فى الكتاب ذاته تقضى بأن الأصمعى «٢١٦هـ» كان قد سأل وهب بن جرير «٢٠٦هـ» عن روايته لشعر أُمية؛ فأخبره وهب بأنَّه كان يملك صُحُفًا بها شعر أُمية، لكنَّ أحدًا استعارها منه وذهب بها!
وبالجمع بين الروايتين وبين ما ستستنتجه بنفسك من متن المخطوطة، فيبدو أن هذه المخطوطة كانت تضم سيرة أُمية التى أملاها بنفسه، إضافة إلى شعره، وأنّها اكتشفت فى المئة الثانية من الهجرة، أى فى القرن نفسه الذى كُتبت فيه، ثم اطلع عليها بعض الناس مثل وهب بن جرير، ولأنَّ سيرة أمية لم تكن ذات أهمية وقتها، فقد اهتم من وجد المخطوطة بجزئها الشعرى فقط، وربما فصل المخطوطة إلى جزأين، لأن المخطوطة تثبت أن أُمية أملى سيرته أولًا، ثم أمر بإلحاقها بأبياته المحفوظة كلها. ثم إنها أُخِذَت من وهب بن جرير وأُخفيت كما ذكر. ثم اكتشف الجزء الذى يضم الشعر مرة أخرى فى المئة الحادية عشرة واطلع عليه بعض مثل البغدادى، ثم أُخفيت الصحف مرة أخرى، ويعضد هذا الاستنتاج إضافة كلمة «الكافر» فى عنوان المخطوطة، والتى لوحظ بسهولة أنها كُتبت متأخرة عن أصل العنوان الذى كان «النبى». فكأنَّها عندما اكتشفت فى ذلك الزمان أثارت سخط من اكتشفها حتى وإن اهتم بما فيها من أبيات، فأضاف إلى العنوان كلمة «الكافر».
كتب المخطوطة عروة بن عامر بن عقيل بن ياسر الحرّ مولى أُمية بن أبى الصلت، وقد بيّن فى صدر المخطوطة أنَّه كتبها فى الشهور الأخيرة لعهد الدولة الأموية والتى انتهت فى العام ١٣٢ للهجرة.
كما سيتضح لك، أملَى أُمية هذا الكتاب فى ساعات عمره الأخيرة، ولذلك اقتصد وأوجز فى الحكايات التى تبعد عنه زمنًا ووقعت فى نصف عمره الأول، وأسهب فى الحكايات التى وقعت فى نصف عمره الثانى. واعلم أنَّ العرب أهل قصص، وهى سمةُ كلِّ مَن عاشَ فى بيئة كجزيرة العرب، فلا تعجب من ذكر أمية لقصص كثيرة - قد اختصرتها - لا يحتاج إليها السياق بمقاييسنا اليوم، فما يحتكم إليه الراوى اليوم، لم يحكم أمية وزمانه.
أفردتُ لك فصلًا بعد نهاية المتن بعنوان معجم الشخصيات، وقد ذكرتُ فيه تعريفًا ببعض الأسماء التى ذكرها أُمية فى حكايته بإيجاز ولهم أهمية فى ذلك التاريخ، ولم أبخل عليك بما يروى فضولك، فذكرت لك موقفهم من الإسلام إن وجدته.
أخيرًا:
اعلم أنَّ العرب فى جزيرتهم ينحدرون من أصلين لا ثالث لهما، الأصل الأول والأقدم هو اليمن وهم العرب القحطانية ويقال يمانية، ومنهم الأوس والخزرج والغساسنة ودوس وخثعم. والأصل الثانى هو إسماعيل عليه السلام، وهم العرب العدنانية نسبةً لولده عدنان، وقد انتشروا وكثروا فى جزيرة العرب، وغالبهم ينحدر من رأسين هما مُضَر وربيعة. وقبائل مُضَر هم الأكثر عددًا. بين العرب وكانوا يسكنون وسط الجزيرة وغربها، وبينهم تدور جُل الأحداث التى تقرأ عنها فى كتب السيرة وفى هذه المخطوطة، وتتفرع قبائل مُضَر من كنانة وقيس، فمن كنانة قبيلة قريش، ومن قيس هوازن بقبائلها: ثقيف وبنى عامر بن صعصعة وبنى سعد بن بكر وبنى جُشم بن بكر وبنى سُلَيم وبنى نصر بن معاوية. ومن قيس أيضًا غطفان بقبائلها: عبس وذبيان وفزارة وأشجع. وأما قبائل ربيعة فكان غالبها يسكن النصف الشمالى والشرقى للجزيرة، ومن ربيعة: تغلب بن وائل وبكر بن وائل وشيبان وحنيفة.
وأُمية بن أبى الصلت رجلٌ ثقفى قَيْسِيٌّ مُضَرِىٌ عدنانى.







