2067.. سعد القرش يفتح بوابة المستقبل على شجن الماضى

- الرواية تصف فى إطارها المستقبلى واقعًا متخبطًا فى مفاسد اجتماعية ودينية
- التكنولوجيا المتقدمة تتعانق مع مظاهر الحياة اليومية لترسم مستقبلًا ديستوبيًا يتخلله الأمل
يُمكن لروايات كُتبت فى فورة الثورات العربية والسنوات التى تلتها أن تظل فريسة لسخط على ما آلت إليه الأمور، وألم على تقزم أحلام كبرى تبيّن عامًا تلو الآخر أنها كانت أصعب من أن تصير واقعًا، ولكن بعد مرور سنوات، تبيت الخيبات ذكرى أليمة مُحرّضة على أمل فى ألا يكون المستقبل قاتمًا وأن تنبعث العنقاء مرة أخرى من رمادها. من عالم مستقبلى متخيل، يؤسس الكاتب والروائى سعد القرش فى روايته «2067»، الصادرة عن «المؤسسة العربية للدراسات والنشر» التى وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفانى، لثنائيات الألم والأمل، الانكسار والمقاومة، المستقبل والماضى، ليفتح نافذة الحُلم مرة أخرى بعد أن أوصدتها سنوات الانطفاء.

تدور أحداث الرواية فى المستقبل، وتحديدًا فى العام 2051، بعد مرور أربعين عامًا على ثورة المصريين فى 25 يناير. تتحرك الشخصيات فى المستقبل لكن أفئدتها معلقة بماض شهد انكسار حلم آبائهم الأكبر فى حياة كريمة تكللها الحرية والعدالة الاجتماعية؛ الشعارات الكبرى التى منها انطلقت ثورة أفسدتها أطراف شتى. ورث الأبناء الخيبة وشهدت طفولتهم على مرارة الهزيمة ولكنهم بعد أربعة عقود يجتمعون على أمل فى ألا يصير الحلم الكبير محض تاريخ أليم يطمسه البعض ويتناساه البعض الآخر، ويقررون أن يجمدوا اللحظة الماضية فى متحف يستعيد الماضى وحلمه الموءود.
الشخصيتان الرئيسيتان فى الرواية هما رشيد وسونهام اللذان يجتمعان مصادفة ويجمع بينهما قصة حب تعترضها العواقب تمامًا، مثل الحلم الكسير الذى ورثوه عن آبائهم المهزومين. ينتصر الوضع المؤسسى القائم رغم الفرح المؤقت بعشق انبثق من رماد واقع مأزوم. ومع ذلك، يتمسك الحبيبان بتخليد ذكرى الماضى فى متحف يُجمّد لحظة ولّدت فيهم وفى آبائهم انتشاء لا يريدون الاستكانة لفكرة اندثارها الكامل.
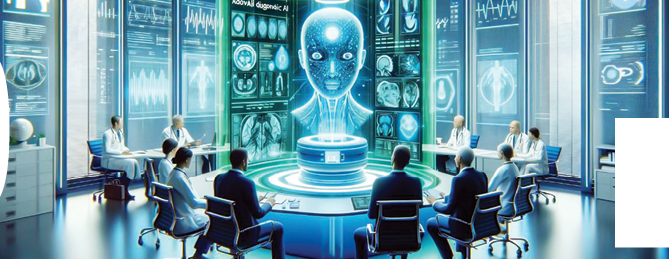
بين الماضى والمستقبل
لا يمثل الماضى فى هذه الرواية المستقبلية محض طيف ذكرى يراود الشخصيات من آن لآخر، وإنما يسير الماضى والمستقبل معًا فى خطين متوازيين فى السرد الذى يأتى عبر الراوى كلى العلم الذى يروى الأحداث وخلفياتها التاريخية وجذورها الأسطورية أحيانًا، كما يغوص فى مشاعر الشخصيات وهواجسهم وأفكارهم ويحللها، وربما يمارس التداعى الحر عوضًا عن الشخصية ذاتها.
وعلى الرغم من أن الثورة المصرية وما ارتبط بها من أيام مفصلية هى متكأ هذا الماضى وأساسه، فإن الكاتب، صاحب «الثورة الآن.. يوميات من ميدان التحرير»، ينطلق نحو محطات أخرى تالية وسابقة. إذ يستدعى عبر حياة والد سونهام ذكرى أحداث جمعة الغضب وما شهدته من أرواح مهدورة، وبالحديث عن والد رشيد ذكرى حكم جماعة الإخوان الذى كان يرى استحالة زحزحة الحاكمين باسم الله لو تمكنوا، والذى كان يؤمن بأنهم لن يخرجوا إلا بثمن باهظ «تكلفة دماء يحسبونها فى سبيل الله.. لو خالفتهم فأنت عدو الله. وباسم الله يحشدون الناس للفتك بك»، ثم إلى سنوات فيروس كورونا الذى حصد الأرواح وكان والد رشيد واحدًا من ضحايا فتكه.
ولا يكتفى الراوى العليم بسيرة الآباء وإنما يعود إلى الأجداد ليستذكر محطات تاريخية أبعد؛ ثورة ١٩٥٢، والحرب الأمريكية على العراق، وقصف بيروت والتدمير الإسرائيلى لجنوب لبنان، وإلى أشكال من الاستغلال الاستعمارى للشعوب المستضعفة، إلى حد يجعله يستذكر عمران؛ جد رشيد الذى كان أحد الناجين من فرقة العمال المصرية التى هلك معظمها والتى استخدمها الجيش البريطانى فى الحرب العظمى.
تمثل هذه الإطلالة التاريخية الموسعة فرصة للتأمل فى مصير شعوب أنهكها الاستغلال الاستعمارى والفساد بمختلف أشكاله لعقود إلى حد باتت معه أبسط أمنياتها مستحيلة وصار مستقبلها المنتظر قاتمًا لا سيما مع تقدم وسائل إحكام الهيمنة والقهر، وهذا هو الخط الثانى الذى يطرحه المتخيل الروائى ليمد خيوط الماضى القريب والبعيد.
فى هذا الزمن المستقبلى، تتعانق التكنولوجيا المتقدمة مع مظاهر الحياة اليومية. فى هيمنة مُحكمة، يبرز بوضوح زمن ديستوبى يتربع فيه «ذباب الكام العشوائى» باعتباره حارسًا شخصيًا للسلطة المطلقة، يستنبت فى معامل البيولوجيا كفاحًا للقبضة الأمنية. ترصد إدارة الكنترول أدق التفاصيل، حيث تشتغل هواتف المشاة والسيارات برنينٍ موحد يخترق الآذان، وحيث تتشدد الأعين فى مراقبة المنخرطين فى فعاليات الحياة اليومية. يصير الانزلاق نحو الأمنيات الفاضلة عابرًا لحدود المسموح، فالرنين «الهاتفى الأفندينى» لا يسمح بانفلات المعارضين والمتمردين، أولئك الذين يحملون أملًا فى كسر الجدران الخانقة.
فى هذا النطاق المظلم، تصطف الشوارع بلا أسماء، يُكتفى بالإشارة إلى «أفندينا» الذى يعادل فى الرواية «الأخ الأكبر» فى رواية «١٩٨٤» لجورج أورويل، فهو الذى يوجه دفة المستقبل بما يراه مناسبًا. ومن بين الشوارع الخاوية والمقاهى التى تقدم الأكسجين بالدقائق، تتقلص آمال المارة فى المساحات المفتوحة، فتتحول المدينة إلى فضاء ضائع.
الجميع فى هذا الزمن المستقبلى واقع تحت قبضة سيطرة محكمة ونافذة لا تسمح بالانفلات، لا سيما وأن جميع الأجهزة الإلكترونية خاضعة للتتبع، فلا يُسمح ببيع أى أجهزة إلا بإضافة بيانات المشترى إلى شريحة التتبع، التى «بها يقيم الكنترول فى مخ الجهاز، راصدًا ومرسلًا ومحتفظًا بما يمكن استدعاؤه فى أى وقت». ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يصل الأمر إلى استخلاص البيانات والأسرار من وحدات تخزين معلومات وشرائح تليفون استغنى عنها أصحابها.
ويستغل التقدم التقنى فى استنبات آليين من أعضاء بشرية تُخزّن فى بنوك وتعتمد على خلايا حية أو أعضاء كاملة تنتزع من ضحايا حوادث الطرق وأطفال الشوارع. كما يستخدم فى إيواء علماء أجانب فى معامل سرية لتطوير نوع من القماش يمنع الرؤية يُلف به الشخص فيحتجب ويصير شبحًا، ويصير الآليون والأشباح وسائل مستحدثة فى محاربة الخارجين على قانون «الأخ الأكبر».
وفى هذه الأجواء الخانقة التى يعززها وصول التلوث والمشكلات البيئية إلى حد غير محتمل، يصير تنفس الأكسجين محسوبًا بالوقت ومحددًا بأماكن هى «بارات الأكسجين» التى يصفها الراوى بحس ساخر بأنها «تتيح أماكن للراغبين فى الاسترخاء بإغفاءة لا يقل حدها الأدنى عن ساعة، وما دونها يحتسب ساعة كاملة».
وما بين الماضى والمستقبل، تحضر الذكرى للأسف على ما آلت إليه الأمور، وتصير الأشياء البسيطة مرتكزات دلالية فى الثيمة العامة للرواية، فذكرى شجرة اجتثت من ميدان التحرير ولم يعد لها وجود تحيل إلى الحلم الموءود، وتصير الشجرة «ضحية ثورة مغدورة، انصرف صانعوها حسنو النية من الميدان قبل أن يتأكد لهم نجاحها»، وعلامة على أن الأفعال العظيمة قد تتلاشى فى غفلة من الزمن، تاركةً وراءها ذكريات مغدورة.
غير أن الشخصية الأكثر تعبيرًا عن ثمرة هذا الواقع هى الطفل هادى؛ ثمرة علاقة الزواج المضطربة بين رشيد وسهير، إذ يعانى الطفل من التأخر فى الكلام فلا ينطق سوى بكلمات معدودة. يحلم هادى بأن يصير على هيئة الفارس فى لعبة الفارس والحصان التى جلبها له والده غير أن حلمه ومحاولاته لا تؤول إلا لتهشيم اللعبة، التى تنتقل إلى جوار دراجة صغيرة معطلة، أضاع هادى منها صامولة ولم يعثر على مثلها رشيد. ومع ذلك، لا يستسلم رشيد ويسعى جاهدًا لإصلاح العجلة ولاستنطاق ابنه، وتبيت محاولاته مع الطفل المتلعثم تعبيرًا عن التشبث بأمل الفارس المنطلق رغم كل الحواجز ووسط أى حطام.

الفساد الاجتماعى والدينى
تستعرض الرواية بعمق وألم واقعًا متخبطًا فى مفاسد اجتماعية وأخلاقية تزايدت فى العقود الأخيرة، فيتيح استدعاء الماضى وتأمل حيوات الشخصيات فرصة للكشف عن العديد من الجوانب المظلمة التى تسللت إلى نسيج المجتمع. يتناول الراوى العليم بألم مهنة المحاماة، التى لم تعد تشكل درعًا لحماية العدالة، بل تحولت إلى منصة لبعض الأفراد الذين صاروا ليس فقط حماة الشياطين، بل الشياطين أنفسهم، يسعون وراء المكاسب الشخصية على حساب المبادئ. وهذا الفساد ينسحب على مجالات أخرى، متمثلًا فى التشدد الدينى الذى تصاعد منذ سبعينيات القرن الماضى، ما أدى إلى منع الموديل العارى فى كليات الفنون، ليحرم الإبداع من التفتح ويعكس قمعًا لحرية التعبير.
تتأمل الرواية فى شخوص يهجرون المنحى الإنسانى للدين، مثل العم الذى يستند إلى مبررات ضعيفة ليستولى على ميراث طفلة يتيمة، ممعنًا فى الاستغلال ومستهترًا بجوهر الدين الذى يحث على الإنصاف والرحمة، والشيوخ الذين قد يتحرشون بالصغيرات بينما هم مستترون خلف قناع التدين الشكلى.
وأما عن مؤسسة الزواج، فتُصورها الرواية محملة بالقيود والأمراض النفسية والاجتماعية التى لا تُحصى. تصف عبارة «لعنة المؤسسة» كيف أن الزواج بات مهنة ثقيلة، تجر خلفها عواقب مؤلمة. تتداخل الأسئلة عن القيم والمبادئ لتسلط الضوء على ضرورة التغيير فى مجتمع يعانى أعباء الماضى وثقافة الفساد.

مستقبل آخر
على الرغم من أن عنوان الرواية يحمل تاريخ «٢٠٦٧»، فإن هذا التاريخ لا يرد فى متن الرواية سوى مرتين لا باعتباره مسرحًا للأحداث وإنما بوصفه نبوءة ربما أو أملًا على الأقل يحمله بطل الرواية رشيد إزاء المستقبل، فالبطل الذى ورث خيبة الماضى وعاين ديستوبيا زمنه المستقبلى يتشبث بحلم انبعاث طائر العنقاء من رماده، أن تنفجر ثورة أخرى فى هذا الزمان الذى حدده بعد ١٦ عامًا من زمنه المستقبلى؛ ثورة يكون بمقدورها تجنب أخطاء الماضى.
يؤمن رشيد بأن هذا العام، الذى رغم ارتباطه بالذكرى المائة لنكسة يونيو التى مثّلت انكسارًا للحلم العربى، قد يحمل فى طياته إمكانات جديدة للانبعاث والتغيير. انطلاقًا من أن رغبة الإنسانية فى التحرر والانعتاق، وفى الإقدام على تغيير حقيقى، قد تكون هى الشرارة التى تشعل الأمل فى هذا المستقبل. ومن ثم، فإن التشبث بهذا التاريخ يعكس تلك الرغبة العميقة لدى الكاتب فى السير نحو الأمل والتفاؤل، رغم كل التحديات والصعوبات التى تكتنف الواقع. فهو يحاول، من خلال شخصية رشيد، أن يبرز أهمية الإيمان بمستقبل أفضل، يمكن فيه للشعوب أن تتجاوز مآسى الماضى وتطلق طاقات جديدة لصنع غدٍ مملوء بالتغييرات الإيجابية.

يجد هذا الأمل فى نهاية الرواية ما يبرره من بذور تنمو مع تطورات الأحداث، فعلى الرغم من أن علاقة الحب بين رشيد وسونهام لم تكتمل، فحلمهما المشترك بإقامة متحف افتراضى يخلد آثار الحلم يصبح حقيقة. يصير هذا المتحف وجهة جديدة تتضمن «غنائم جمعة الغضب»، توثق أيام الثورة الشعبية. يستجيب الكثيرون للإعلان، ويعبرون عن تأييدهم واحتفائهم بالمبادرة. تختتم الرواية بافتتاح «أنتيكا»، الذى يتلاقى فيه الناس بحماس ليروا ذكرياتهم، ويتشارك الجميع آمالهم فى أن تكون هذه اللحظات بمثابة انطلاقة جديدة، متفائلين بأن إعادة المحاولة ممكنة، وأن التجربة القادمة بمقدروها الاستفادة من أخطاء الماضى وإنضاج شروط النجاح.
تُصر الرواية على البحث عن نور فى عتمة مستحكمة وتصل إلى المستقبل متشبثة بهذا الأمل. وهذا ما عبّر عنه الكاتب فى مقال سابق له حينما قال إنه لم يكتب الرواية إبراء للذمة، وإنما وفاء للمعنى وفرح بلحظة انتصار نادرة لحلمٍ مشروع بالحرية. يقول القرش: حملتها فى صدرى، ولم تكن عبئًا أتخلص منه بالكتابة. استمتعت بالاستعادة، وقررت أن أتركها وثيقة تتوسل بالفن، عبر قصة حب لا تكتمل أيضًا. آمل أن تجيب الرواية عن سؤال قارئ سوف يصادفها عام ٢٠٦٧: ألا يستحق المهزوم الأسير بعضًا من الشفقة؟ ألا تجدر الرحمة بالعزيز المنكسر؟ انتهيت من الكتابة، ولم أنشغل بسؤال: من سيقرأ رواية عن انتكاسته؟ من يحتمل فتح جرح الْتأم على غير تطهير؟ وجدت نفسى بعد قفزة زمنية، على مسافة أربعين عامًا من الثورة، بصحبة محبين لم يشاركوا فى صنع الحلم، ولا تطاردهم مشاعر جلد الذات. اكتشف أبناء الثائرين أنهم يحملون ميراث الآباء، ويحلمون بفرصة أخرى.






