عبدالوهاب الحمادى: الجوائز مصدر سرور للكاتب مهما ادعى غير ذلك للاستهلاك الإعلامى

- روايتى «لا تقصص رؤياك» لا تزال ممنوعة.. و«الحذر الاجتماعى» وراء ذلك
- «ولا غالب» تصلح أن تكون مثالًا للخيبة العربية والإسلامية فى فهم التاريخ
- غرقت فى كتابة رواية لم تنته منذ 2018.. وأعمل على «سنة القطط السمان»
عبدالوهاب الحمادى روائى كويتى شاب، وصلت روايته «لا تقصص رؤياك» إلى القائمة الطويلة لجائزة الرواية العربية «البوكر» لعام 2015، ومع ذلك لا تزال ممنوعة فى بلده الكويت.
وفى روايته اللاحقة «ولا غالب»، سبح «الحمادى» ضد التيار، عبر تفكيك أساطير مؤسسة للتاريخ العربى الإسلامى، وتعتبره المطلق فى الكمال والمثالية، مقدمًا إجابتين شافيتين عن سؤالين: كيف كنا؟، وكيف أصبحنا؟
حول هاتين الروايتين، ورأيه حول راهن ومستقبل الرواية العربية، وتأثير الجوائز الأدبية والرقابة وقوائم «الأكثر مبيعًا» عليها، وأسباب تعلقه الشديد بمصر ومبدعيها وأهلها ونيلها، كان لـ«حرف» الحوار التالى مع «الحمادى».
■ رغم مرور ١٠ أعوام على صدور روايتك «لا تقصص رؤياك»، ما زالت ممنوعة فى بلدك الكويت.. ما سبب هذا المنع؟
- للأسف لا تزال الرواية ممنوعة، رغم بعض التفاؤل فى تغيير يعبر الأجواء العامة فى الكويت. المنع جاء مُسببًا عبر الصحف آنذاك بالسبب التالى: «إساءة للأوضاع السياسية والاجتماعية فى الكويت، وللمعارضة والشيعة وأبناء القبائل»، وهى تهمة بالطبع غير صحيحة، لأننى أحترم كل أطياف المجتمع التى تشكل فسيفساء وطنى.
كل ما فعلته أننى فى سياق القصة وضعت أحاديث المتطرفين من كل فئة على لسان شخصية من الشخصيات، وهى نفس الأحاديث التى تنقلها القنوات التليفزيونية والصحف ووسائل التواصل الاجتماعى، وشكلت منها رواية لكى أرفع شارة التحذير لما قد يؤدى له هذا التفتت والتصدع، لعل أحدًا يلتفت لهذا المنزلق.
حتى إن نهاية تبرير الرقابة استخدمت كطرفة، عندما قيل إن الرقابة الرسمية فى الكويت تدافع عن المعارضة، ناهيك عن نشر الفصل الأول فى صحيفة يومية مقروءة، دون أن تحدث أى مشكلة.

■ هل للحضور القوى لـ«الإسلاميين» من إخوان وسلفية فى الكويت علاقة بمنع الرواية؟
- لا أنكر تأثير التيارات الدينية. لكن ما منع الرواية هو خليط من الأسباب، أستطيع أن أسميه «الحذر الاجتماعى»، الذى جعل مهمة الرقيب صعبة للغاية، وسط المحاذير التى ابتكرها المجتمع.
هم الرقيب أصبح منع أى ثغرة قد تجلب محاسبة ومعاقبة له كموظف، فى ظل أن أى مار فى أى معرض كتاب أو مكتبة يستطيع تصوير مقطع من منشور ما، ويرفعه على وسائل التواصل، ثم ينادى على الطريقة المشهورة: «اللى يحب النبى يضرب!»، ثم يتولى المسألة أحد أقطاب البرلمان وتبدأ «حفلة مزايدات» تصل إلى استجواب الوزير المعنى.
وكل طقوس «حفلات الزار الديمقراطية» هذه تنتقص من رصيد الكويت الثقافى، الذى عرفت به منذ القديم، مرورًا بتأسيس إصدارات ثقافية ترعرعت عليها أجيال من الخليج إلى المحيط. لكن، لنتفاءل قليلًا، قد يحدث تغيير إيجابى ما.
■ هل توجد مقومات معينة للرواية الناجحة؟ وهل التطرق إلى ثالوث «السياسة والدين والجنس» ضرورى لهذا النجاح؟
- ليتنى أعرفها، لو كانت ثمة خلطة سرية لكنت أول من يجربها، وبالطبع لن أخبر أحدًا. لكن يجب علينا أولًا تعريف النجاح، هل هو حصد الجوائز وتصدر لوائح «الكتب الأكثر مبيعًا»؟ لا أظن ذلك إلا فى شطر صغير من موضوع النجاح. لذا أعتقد أن الصدق والموضوع، والمعالجة الفنية من أدوات سردية ولغة، كلها قد تحقق رواية قيمة وتستحق وقت القارئ.
وبالنسبة للثالوث المحرم، لا أظن أن الحرية المطلقة فى الكتابة هى أساس، بل حرية التفكير هى الأساس، ثم يأتى الإبداع واللعب بالأفكار، ليستطيع الكاتب تمرير ما يوده من أفكار، دون اللجوء إلى المحرمات بشكلها الفج الرخيص.
■ فى سياق الحديث عن أثر الرواية فى تشكيل الوعى المجتمعى، وخشية الرقيب من «لا تقصص رؤياك» ومنعها.. هل ما زال هذا الأثر ساريًا؟ وهل لمسته بنفسك بين من قرأوا روايتك ولو سرًا؟
- «لا تقصص رؤياك» كانت من أكثر رواياتى مقروئية، ولفتت أنظار القراء من مختلف الدول العربية، ولم يكن ذلك بسبب المنع، ولله الحمد، بل بسبب وصولها إلى اللائحة الطويلة فى الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر».
ولا تزال حتى اليوم تأتيتى قراءات عبر عدة مواقع من بينها «goodreads»، وهى آراء متفاوتة تغلب عليها الإيجابية. ومن أطرف الآراء التى وصلتنى رأى يقول: «منذ زمن وأنا أسمع عن مشاكل الكويت والاحتقان السياسى فيها، لكن بدأت أفهمه لأول مرة بسبب هذه الرواية».
■ تذهب بعض الآراء مؤخرًا إلى أن الرواية لم تعد «ديوان العرب المعاصر»، وأن مكانتها تراجعت أمام وسائط الاتصال الحديثة.. كيف ترى الأمر؟
- الآراء مجانية، و«الحكى ما عليه جمرك» كما يقول اللبنانيون، وهناك لا شك فئات تحب أن تكون موجودة على الدوام على سطح الأدب، وليس لها من سبيل لذلك سوى تداول مثل هذه التصريحات.
الرواية تعيش عصرًا عربيًا ذهبيًا لأسباب عديدة منها الجوائز. لكن السبب الأوضح بكل تأكيد هو قدرتها الفنية على أخذ القارئ إلى قضايا مختلفة، وانتزاعه من عالمه اليومى إلى عالم مختلف، وإعطاؤه نظارات جديدة يرى العالم منها.
■ وماذا عن تأثير «الذكاء الاصطناعى» على الرواية، بعدما غزا العديد من مجالات الإبداع البشرى مثل الفنون البصرية والموسيقية وغيرها؟
- جربت مرة التعامل مع هذه البرامج وكانت مسلية وطريفة. لكن أستبعد أن تحل محل البشر فى الفنون. قد تساعد بمواضيع تقنية. مثلًا، أخبرنى صديق عن قدرة هذه البرامج على تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية فى النص المقدم. لكننى أستبعد أن تحل محل البشر فى المنتج الإبداعى الذى يرتكز أولًا وأخيرًا على الخيال.
■ فى روايتك «ولا غالب» لم تنحز للبكائية العربية/ الإسلامية عن الأندلس وأمجادها، بل غردت خارج السرب.. متى وكيف بدأت نواة كتابة هذه الرواية، وهل كان لكتابك السابق عليها «دروب أندلسية» دافع لكتابتها؟
- مع الوقت بدأت أكتشف أن لدىّ أمورًا أساسية لا أمل الحديث عنها، ومنها استخدام التاريخ للعب على الجماهير، خاصة فى منطقتنا، لذا كتبت «دروب أندلسية»، رغم أنه كتاب أدب رحلات.
وفى عام ٢٠١٨ غرقت فى كتابة رواية طالت وتحتاج لاشتغال طويل، ولم تنته حتى اليوم، وفجأة انبثقت الفكرة، وكانت فكرة مبسطة، وهى ٣ سياح كويتيين يحاولون استرجاع الأندلس، عندما يعبرون أحد أبواب «قصر الحمراء». لاحقًا نمت الفكرة، ولقيت أنها صالحة لأن تكون مثالًا للخيبة العربية/ الإسلامية فى فهم التاريخ، عبر أشهر مثال محبوب لهم وهو الأندلس.
■ خاتمة «ولا غالب» هدمت الصورة الذهنية المتخيلة لدى العرب المسلمين عن ماضيهم وأمجادهم، من خلال السؤال الافتراضى: «ماذا لو ظلت الأندلس عربية إسلامية حتى اليوم؟»، ألم تخش من غضب القارئ؟
- كان يمكن أن أنهيها بأكثر من طريقة. فى الحقيقة أثناء الكتابة كانت هناك ٣ نهايات، أردت أن تكون موجودة ويختار القارئ ما يناسبه منها. ثم ارتأيت أن أجعلها نهاية واحدة، علها تصيب القارئ بصدمة، تدفعه للتفكير وتداول الأمر بينه وبين نفسه على الأقل، والتأمل فى مصائرنا.
■ فى رأيك لماذا لم يتوقف أحد أمام هذه الصورة المثالية المليئة بالفخر المقترن بالشجن على ضياع الأندلس، ليسأل نفسه أو التاريخ: «وماذا عمن كانوا هنا على هذه الأرض وسكنوها قبل أن تأتيهم الفتوحات، بنفس منطق الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين؟»
- هناك مشكلة فى هذا الفهم، لأن إسبانيا عبر تاريخها المديد هى أرض تعاقب عليها الحكام، منذ الفينيق والواندال والرومان والقوط، ثم جاء العرب. بل إن حكامها حاليًا من سلالة فرنسية. لذا أظن أن الربط بينها وبين فلسطين لا أساس متين له، رغم استخدامه، للأسف، عبر المخيال الدينى الخطابى خلال العقود الأخيرة، لبيع السلع المزيفة على عقول الناس، وتم لهم ذلك عبر المنابر.

■ بم تفسر ظاهرة انتشار «الرواية التاريخية»؟ وهل بمقدور الروائى أن يكون مؤرخًا؟
- الرواية التاريخية موجودة منذ بداية الرواية العربية، ومن يردد أنها زادت لانتشار الجوائز لم يكلف نفسه غالبًا البحث فى هذا الموضوع، ولا ألومه. الرواية التاريخية العربية ازدهرت لأن التاريخ العربى ممتد وملىء، ولا تزال موضوعاته مغرية وتستحق أن تنعكس عبر الكتابة الإبداعية، وذلك لأسباب كثيرة، أبرزها أن التاريخ فاعل جدًا فى حياتنا اليومية، على عكس أمم أخرى.
وفى النهاية يمكن أن يكون الروائى مؤرخًا، من حيث لا يقصد التأريخ المباشر الأكاديمى، عبر نقله لحياة الناس وهمومهم فى أى حقبة يبحث عنها، بل إنه أحيانًا يتحول إلى باحث غارق فى القراءة عن زمن ما ليصنع عالمًا يكتب عنه.
■ تحمل مشاعر فياضة نحو مصر وأهلها ومثقفيها وفنانيها، متى بدأت علاقتك بمصر؟ وكيف تراها؟ ومَن من كتابها أثر فيك؟
- فى الحقيقة نحن فى الكويت تأثرنا بالثقافة المصرية قديم، وله جذور يمكننا تتبعها عبر المجلات والصحف القديمة وصولًا إلى أساطين الأكاديميات المصرية الذين عملوا فى الكويت، ناهيك عن الفن المصرى وتأثيره على الفن الكويتى.
مثلًا كنت أقرأ فى مذكرات الناقد الصديق، محمود عبدالشكور، وذاكرته عن السبعينيات والثمانينيات، ولفتت نظرى الذاكرة المشتركة، ذاكرتنا القرائية والفنية من أفلام ومسلسلات وأغانٍ. لذا التأثير المصرى كبير جدًا على الكويت، وعلىّ شخصيًا، وأستطيع كتابة أسماء لا حصر لها، لكننى سأكتفى باسمين: فؤاد زكريا ونجيب محفوظ.
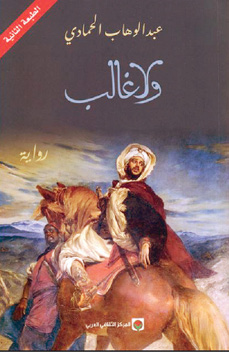
■ بين دعوات التجديد الشكلى والتجريب فى الفن الروائى، والمتمسكين بشكلها التقليدى، كيف ترى مستقبل الرواية العربية؟
- مستقبلها مشرق بالطبع، لأن هناك من الأجيال الجديدة من يعتنى بالرواية وكتابتها بشغف بالغ. يقرأ ويتعلم ويركز ويحاول التجديد. لذا رغم كل السيل الروائى الغث بسبب سهولة النشر، هناك مسيرة روائية عربية جديرة بالمتابعة.
لكن الميل للتجريب الزائد على حساب الموضوع مبالغة لا أميل لها، إذ أحبذ أن يكون الشكل لاحقًا ويسبقه الموضوع. لكن فى النهاية كل شىء جميل، سواء جاء عبر التجريب أو التقليدية، فالمهم الاشتغال الحقيقى.
■ إلى أى مدى أثرت ظواهر مثل «بيست سيلر» والجوائز الأدبية فى التكريس لاتجاهات بعينها فى الكتابة الروائية؟
- أثرت بالإيجاب أكثر من السلب، ولم تكرس لاتجاه إلا عند من يريد إقناع نفسه بذلك. نجد مثلًا من يقول إن جوائز معينة تريد أن تنحى الروايات التى تتناول فلسطين، ثم يفوز فلسطينى بنفس الجائزة. وحوارات المثقفين العرب معتادة عن التنظير للجوائز وغيرها، خاصة ممن يعرف خفايا المتاجرات الثقافية، وطبعًا لن أقول بنزاهة الجوائز وعصمتها، لكننى لن أعمى عن أهميتها فى رواج الرواية.

■ وصلت «لا تقصص رؤياك» إلى القائمة الطويلة لجائزة «البوكر» العربية ٢٠١٥. كما حصلت رواية «ولا غالب» على الجائزة التشجيعية فى الكويت ٢٠٢١... ما الذى تعنيه لك الجوائز الأدبية؟
- للجوائز قيمة فى أعين القراء، وهى مصدر سرور للكاتب، مهما ادعى غير ذلك للاستهلاك الإعلامى، وتبيان همومه الثقيلة، والظهور بمظهر المتواضع الزاهد. وهى تروج للأعمال بشكل جيد، لكنها بالطبع ليست دليلًا على الجودة الأدبية أبدًا، بل فى أحيان كثيرة دليلًا على الحظ فقط.
■ أخيرًا.. ما جديد عبدالوهاب الحمادى؟
- قريبًا تصدر لى رواية بعنوان «سنة القطط السمان»، عن دار «الشروق». وهى رواية تبدأ من قصة صغيرة حدثت فى الكويت عام ١٩٣٧، ثم يبدأ الخيال الروائى بالاشتباك بالتاريخ الحقيقى.
أرجو أن يجد فيها القارئ الكويتى ما يهمه ويمتعه، وأن يجد القارئ العربى، رغم محليتها، ما يدخله إلى عالم لم يعتد عليه. وحسبى أن يقول قارئ ما إن الاشتغال عليها فاق ما أصدرته من قبل، وأن يرصد تطورًا فى تقنيات الكتابة.




