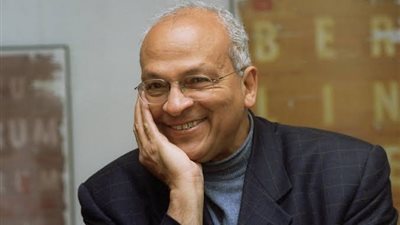امتياز المثقفين فى قدرتهم على الحوار
المبدعون وجوائز الأدب.. كلام مستقل فى جدل تغلبه الانحيازات

- للجائزة ما تبحث عنه وللكاتب ما يبقى ملتصقًا باسمه.. والتاريخ لا يعترف بحسابات الأيام والاحتياجات الصغيرة
- لم يحصل تولستوى على «نوبل» لكن اسمه استقر فوق قمة الأدب العالمى متجاوزًا كل من فازوا بها حتى الآن
- لم يفكر نجيب محفوظ فى «نوبل» فجاءته لأنه كتب وفق تصوراته والمناخ الذى يعيش فيه ولأنه بالفعل كاتب عظيم
فى روايته البديعة «أولاد حارتنا» صك أديبنا الكبير نجيب محفوظ عبارته الكاشفة «آفة حارتنا النسيان»، وهى فى ظنى الوصف الأدق لما يحدث فى المشهد الثقافى العربى خلال السنوات الأخيرة من القرن الحادى والعشرين، غير أنها، فى ظنى، بحاجة إلى استكمال يتوافق معها، ومع ما نعيشه من جدل تغلب عليه الانحيازات، وتسيطر عليه النعرات القومية والشيفونية، وعلى الرغم من أن غالبية الآراء تبدو متماسكة إلى حدٍ ما، ولو ظاهريًا، وتدعم مواقفها بما خبرته وعاينته من شواهد ومواقف أو أحداث تدعم انحيازها فى مواجهة انحيازات أخرى مضادة، فإننى أظن أن مناقشة تلك الشواهد والأحداث، والعمل على تفاديها هو الأقرب للصواب، ولو كان مستحيلًا.. وأنه فيما يتعلق بجوائز الأدب والإبداع الفنى، لا جدوى من الانحيازات الضيقة، ولا معنى للشيفونية، والانتفاضات العرقية، فكلها ليست فى صالح أحد، إن لم تكن فى غير صالح الجميع، وإن لم تضر بالمشهد الثقافى العربى كله، وتدفع بنا جميعًا إلى طريق التجاهل والغياب فى ركن منسى ومظلم من تاريخ الأدب العالمى.. امتياز المثقفين والمبدعين عن بقية خلق الله هو القدرة على الجدل والحوار، على تفنيد الآراء، ومحاكمة التصورات وفق قوانين القيمة الفكرية والجمالية وحرية الإبداع، والانتصار للإنسانية، والجمال، هو جدل الرفض والقبول، وتبادل الآراء والحجج وصولًا إلى برٍ للتعايش، أو مساحة للاتفاق.. وأغلب ظنى أنه لا يجوز للفئة المثقفة القارئة لتاريخ الفلسفة والفنون، ولتفاصيل رحلة الإنسان على وجه الأرض، أن تنزلق إلى تلك المساحات التى تجاوزها العالم منذ عقود طويلة، حتى أصبحت واحدة من بديهيات العمل الثقافى والفنى عالميًا، هى افتراض انحياز الكاتب والمبدع للإنسانية فى عمومها، وللجمال على إطلاقه، ولقيم العدل والمساواة على شمولها.. لا لعرق أو لون أو جنسية، ولا حتى لديانة أو معتقد..

هل تنكر أن الجوائز الأدبية موجهة فى عمومها؟
هى كذلك بالفعل.. من جائزة «نوبل» وحتى جائزة «القلم الذهبى للرواية» التى تم الكشف عنها منذ أيام، فلا يُلقى بأمواله فى سلة المهملات سوى سفيه أو مجنون.. وكل الجهات المانحة للجوائز الأدبية، وغير الأدبية، فى أى مكان فى العالم، خاصة أم حكومية أم تدّعى الاستقلال، لا بد أن تكون لديها توجهاتها المشروعة أو غير المشروعة، وإن أعلنت غير ذلك.. لديها ذائقتها ومعاييرها وأهدافها، وإن لم تعلن عنها أو تلوح بها.. لديها معطياتها ودوافعها وما تنتظره من نتائج، وإن لم يرضَ عنها الجميع.. تتفق معها أو تختلف حولها، لا مانع، فامتياز المثقفين، والنخبة المفكرة على مدار التاريخ هو القدرة على الجدل والحوار والمناقشة والتحليل، منطلقة من أن قماشة الإبداع متسعة جدًا، وكبيرة جدًا، ولن أكون مغاليًا إذا ذهبت إلى أنها بلا حدود.. ولك مطلق الحرية فى التقدم لهذه الجائزة أو تلك، ولك أيضًا مطلق الحرية فى اعتبارها جميعًا كأن لم تكن، كما أن لك مطلق الحرية، ثالثًا، فى الصياح والبكاء والجلوس على أطلال التاريخ، دون خطوة واحدة للأمام.. ولكن قبل ذلك كله، لك أن تعرف أنه منذ اللحظة الأولى للإعلان عن جائزة «نوبل للأدب» فى دورتها الأولى عام ١٩٠١ وهى تعانى من الاتهامات، والمعارضة، والرفض بسبب ما كان يراه كثيرون سوء اختيارٍ للفائز بها، ورفض الكثير من الكتّاب السويديين لمن وقع عليه اختيار أعضاء الأكاديمية.. حملة عنيفة قادها اثنان وأربعون كاتبًا من أهم الكتّاب السويديين، وانضم إليهم فيما بعد كتّاب من جميع أنحاء القارة الأوروبية، وجميعهم أعلنوا عن رفضهم ما شاب الجائزة من فساد يخص تجاهل قامة أدبية عالمية مثل الروسى ليف تولستوى، أو تجاهل لأيقونة القصة القصيرة على مر العصور أنطون تشيكوف، أو الروائى الفرنسى الكبير إميل زولا، وذهابها إلى شاعر فرنسى متوسط القيمة، متعدد العلاقات، ويبدو أنه كان نافذًا فى الأوساط العليا فى وقته، وسرعان ما انضم إليها كتّاب ومبدعون من دول أخرى، وحاولت لجنة الجائزة الأشهر عالميًا تدارك الأمر فيما بعد، ولكن دون جدوى.. حتى إن الكاتب الصحفى محمد عبدالسلام يبدأ كتابه «١١٤ نوبل.. شىء من العنصرية»، والصادر فى بدايات ٢٠١٦، بفصل يحمل عنوان «العظماء الذين لم يكونوا كذلك قط»، يقول فيه إنه «طوال ١١٤ عامًا مضت وجميع ترشيحات الأكاديمية السويدية مكمن جدل وشكوك نتيجة العشرات من التساؤلات التى يطرحها البعض عقب إعلان الفائز»، وينقل عن الأديب الأيرلندى الساخر برنارد شو أنه عندما علم بفوزه بالجائزة عام ١٩٢٥، قال ما نصه: «إننى أغفر لنوبل اختراع الديناميت، ولكننى لن أغفر له إنشاء جائزة نوبل.. إنها تشبه طوق النجاة الذى يتم إلقاؤه لأحد الأشخاص بعد أن يكون وصل إلى الشاطئ».

وفى حوار صحفى قال جير لوند شتاد، الأمين العام لجائزة نوبل للسلام، ما نصه: «نعلم تمامًا أن أعضاء لجنة الجائزة أخطأوا أخطاء فادحة عن غير عمد فى حق شخصيات عالمية كانت تستحق التكريم، لكنهم لم يحصلوا عليها، ولكننا فى النهاية نؤكد أننا لم نخضع بأى شكل من الأشكال للضغوط السياسية»، والطريف فى الأمر أنه كان يقول ذلك فى سياق تبرير منح الجائزة لليمنية توكل كرمان، وهى من هى، ولا حاجة بى للحديث عنها، ولكننى أرى أن هذا الكلام هو اعتراف صريح جدًا بحدوث الضغوط السياسية، هو فقط ينفى «الخضوع لها»، فلم يقل مثلًا «لم نتعرض»، بل «لم نخضع»، ووفقًا لطبائع الأمور فليس من المتوقع من أمين عام الجائزة أن يكمل اعترافه بالكلام عن الاستسلام لتلك الضغوط، الساذج فقط من يفكر فى التعامل مع جزئية النفى باعتبارها حقيقة ما حدث خلف الأبواب المغلقة، هى زاوية رؤية خاضعة للاحتمالات، ولأن القائل بها فى موضع الاتهام، فإن الاحتمال الأقرب هو احتمال «تبرئة النفس» فقط لا غير.. بينما المؤكد من هذا الاعتراف هو وجود الضغوط السياسية، والأخطاء الفادحة فى حق شخصيات عالمية.
المدهش أن الجائزة التى تصارع لجانها اتهامات الفساد حتى لحظتنا الراهنة، ما زالت بعد كل تلك السنوات والاتهامات والشد والجذب هى الجائزة الأشهر عالميًا، تطور من أدواتها عامًا بعد عام، وتعدل من قواعد منحها، وتوجهاتها، وما زالت تصاحبها الاحتفالات هنا وهناك، فما زالت دول العالم غير الأوروبية أسيرة أى اعتراف يأتيها من القارة العجوز، ولو فى صورة جائزة تحيط بها الشبهات وعلامات الاستفهام، ولكنها تراها وتتعامل معها وكأنها بمثابة «إعلانَ وجودٍ لعدم»، وكأنها بلاد بلا قيمة ولا وجود إن لم تعترف بها أى جهة أوروبية، ولو كانت مجرد مؤسسة «خيرية» تخصص جزءًا من أرباحها لجائزة «غسيل سمعة»، أدبية أو فنية أو علمية، أو أيًا كان نوعها.. دول كبرى وأدباء ومبدعون وعلماء ينيرون الأرض بإبداعاتهم وبأفكارهم وعقولهم، ولا يراهم مواطنوهم إن لم تأتهم الإشارة من الغرب الاستعمارى، سواء كان اسم تلك الإشارة «نوبل» أو «أوسكار» أو «السعفة الذهبية لكان»!!

هل تظن أن الجوائز تدعم الإبداع الحقيقى؟
هى بالفعل أيضًا كذلك.. من جائزة «نوبل» حتى أحدث جائزة تم الكشف عنها منذ أيام، بل وأغلب الظن أنه لا غنى عنها، خصوصًا فى بلاد مثل بلادنا، تعانى من شحٍ فى القراءة وفى نشر وتوزيع الكتب، ويعيش الغالبية العظمى من أدبائها ومبدعيها على حد الكفاف، إن لم يكونوا يدفعون مقابل نشر إبداعاتهم بالخصم من قوت أبنائهم، فهذه الجوائز، إلى جانب قيمتها المالية المهمة للفائز بها ولناشره، تفتح بابًا لترجمة الأعمال الفائزة بها وتمولها، وفى هذا تعريف بالأدب العربى فى جميع أنحاء العالم، إذا ما تم البناء عليه بصورة جيدة، هو مكسب كبير لكثير من المبدعين العرب، خصوصًا أنه ليس الرافد الوحيد للترجمة إلى اللغات الأخرى، فكثير من دور النشر والكتّاب يجيدون الترويج لأعمالهم بين المترجمين، وبالتالى، فإن إضافة رافد جديد، لا يخضع لما يريده القادم الغربى، وما يضعه من شروط للترجمة، هو فعل أظن أننا بحاجة ماسة إليه، خصوصًا مع ما نعرفه جميعًا من استهداف دور النشر الغربية لنوعيات محددة من الكتابات، سواء من حيث الترويج للمثلية الجنسية، أو المظلوميات السياسية، أو ما شابه من كتابات الانتقام السياسى والاجتماعى.. حتى وإن كانت تلك الجوائز تنطلق من ذائقة مختلفة، ومرجعيات مخالفة، وتوجهاتها معاكسة، فالأفكار تتحاور، تتجاذب وتتصارع، وفى رواج المخالف من آراء قوة دافعة وحافز لنقيضها لاستكمال أدواته، ودعمها.. ربما يرى البعض أن فوز شكل ما من الكتابة بجائزة كبرى «ماليًا» يؤدى إلى حالة إقبال على تلك النوعية رغم رداءتها، وهو كذلك بالفعل، فالمؤكد أن ذلك سوف يحدث، وستغرق أسواق الكتب بروايات تاريخية تافهة، وأخرى منقولة من أفلام ومسلسلات أجنبية، لكن الأدب والفن موضوع آخر، وحسابات أخرى.. فى الأدب والفن، للجائزة ما تريد وما تبحث عنه، وللكاتب والفنان والمبدع ما يبقى له أو عنه، فالتاريخ لا يرحم، ولا يعترف بحسابات الأيام الصعبة والاحتياجات الصغيرة.. فربما لم يحصل تولستوى على جائزة «نوبل للأدب»، ولكن اسمه وإبداعه استقر فوق قمة الأدب العالمى، متجاوزًا كل من فازوا بها حتى لحظتنا الراهنة.. فالثابت أن قيمة المنتج الأدبى أو الفنى تبقى لصيقة بالكاتب والفنان حتى بعد رحيله، تبقى لصيقة باسمه، وتاريخه، وهى التى تحدد كيف يذكره التاريخ.. لم يكن نجيب محفوظ يفكر فى «نوبل»، وإن تمناها أو جرت على لسانه.. لكنه كتب وفق تصوراته وقناعاته والمناخ الذى يعيش فيه، لا وفق ما تبحث عنه لجان الجائزة، وإن لم يسلم من الغمز فى وقتها.. فماذا حدث؟! عاش اسم نجيب محفوظ، وبقيت «أولاد حارتنا» و«الحرافيش» و«الطريق» و«ثرثرة فوق النيل»، فيما ووريت كل الأكاذيب الثرى.. كان يوسف إدريس يريدها، ويحلم بها، ويتواصل مع الجهات المانحة لها، حتى أنه هو من أطلق حكاية اتصالهم به ورفضه لاشتراط تقاسمها مع كاتب إسرائيلى، ولكنه لم يفز بها، وظل اسمه مقرونًا بأعماله الإبداعية كقاص لا يبارى، وقيمة أدبية مصرية وعربية كبيرة.. ومثله كثيرون لا يتسع المجال للحديث عنهم وعن إبداعاتهم ومكانتهم التى ستظل فى ذاكرة تاريخ الأدب والإبداع المصرى والعربى والعالمى.

ماذا عن فساد لجان التحكيم؟
وهى كذلك بالفعل.. من جائزة «نوبل» حتى أحدث جائزة تم الكشف عنها منذ أيام، بل ولا أنكر أنها فى الغالب تعمل وفق ما تمليه عليها أو تطلبه منها الجهات المانحة، فلم يحدث فى تاريخ الأدب العالمى أن تم الإعلان عن جائزة ثقافية، ومرت دون تساؤلات وشكوك واعتراضات وإلقاء «كرسى فى الكلوب»، ولعلك تذكر معى ما كتبه الشاعر الكبير أحمد سويلم على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» قبل أيام معدودة، ووضع له عنوانًا دالًا «حكاية عصرية مؤسفة»، وكتب تحته ما نصه: «هذه حكاية حبستها داخلى كثيرًا.. حتى كادت أن تحرقنى، فقررت أن أخرجها لأستريح.. كنت قد تقدمت بعمل مسرحى شعرى لإحدى الجوائز العربية، ولم أوفق للفوز.. وتلقيت فى العام التالى اتصالًا من المسئول عن الجائزة يبلغنى أن مسرحيتى موضع تقدير من الجميع هذا العام.. فلا داعى لإرسالها مرة أخرى، وبلغنى أن لجنة التحكيم قد اجتمعت وكادت توافق.. لولا وجود أحد المحكّمين، وكان مصريًا للأسف، وبالتأكيد يعرف أقدار مبدعى بلده، فأقنع اللجنة بذهاب الجائزة إلى شاعرة مصرية لم تكتب فى حياتها سوى مسرحية واحدة.. وقد كان.. وبغض النظر عن أسباب تحمس المحكّم المصرى وقدرته على إقناع اللجنة بوجهة نظره.. فقد قررت ألا أعاود التقدم إلى أى جائزة عربية.. ويكفينى زهوى وفخرى بجوائز دولتى الحبيبة: الجائزة التشجيعية عام ١٩٨٩، جائزة الدولة للتفوق فى الآداب ٢٠٠٦، جائزة الدولة التقديرية فى الآداب ٢٠١٥. وأولًا وأخيرًا ما أتلقاه من قرائى الأعزاء من تقدير يفوق كل الجوائز.. والله الموفق والمستعان».
وفى التعليقات كتب الشاعر حسين القباحى، مدير بيت الشعر بالأقصر: «حدث ذلك من كثيرين لصالح النساء أو الجنسيات العربية الأخرى وأعرف أسماء ومواقف بعضهم»، وكتب الدكتور أيمن تعيلب، أستاذ النقد الأدبى الحديث، ما نصه: «للأسف أصبحت سيرة المصريين وحدهم فى الجوائز مخجلة للغاية، وأنا شاهد على هذا عندما حكمت فى إحدى الجوائز الكبرى، وكان هناك أكاديمى مصرى له اسم كبير فى مصر، لكن كان موقفه مخزيًا»، مضيفًا فى الرد على تساؤل «يعنى الحكاية مكررة» بما نصه: «إلى الدرجة التى جعلتنى أفر من أى جائزة فيها مصرى، طبعًا مع خالص احترامى للشرفاء منهم، وهم أندر من الكبريت الأحمر»..
ولعله من المناسب هنا أن أذكر ما كتبه الناقد والمفكر نبيل عبدالفتاح على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» قبل أشهر قليلة، وتحديدًا فى بدايات شهر أبريل الماضى، وأذكر أننى توقفت وقتها عنده طويلًا، إذ كتب ما نصه: «من الملاحظ فى الجوائز النفطية الأدبية، أن بعض المرشحين من كبار الموهوبين والمبدعين الكبار ذوى الإنتاج الروائى المرموق، لا يحصلون عليها رغم أن أعمالهم متميزة ووراءها خبرات تقنية وتخييلات سردية استثنائية!!»، وقبلها بساعات كتب ما نصه: «جوائز الدول النفطية الأدبية كل عام، غالب من حصلوا عليها لا أحد يتذكرهم، بينما المواهب المتميزة يتذكرهم بعض القراء ذوى الثقافة والحساسية والتمثل الخلاق! جوائز ساهمت فى فيضان من السرد الردئ سنويًا، وبعضه يحصل على جوائز تليق به ويليق بها! كارثة عرب النفط البائدة»..
والحقيقة أننى كنت أود التعليق على هذين المنشورين فى وقته، لكننى قررت الاحتفاظ بتعليقى إلى وقتٍ آخر أكثر ملاءمة، خصوصًا أن بعض ما كنت أود كتابته يتعلق بدور كاتب المنشور نفسه فى عدد من الجوائز التى لعبت ذات الدور الذى ينتقده ويعلق عليه، فواقع الأمر أننى أرى ما كتبه الدكتور نبيل عبدالفتاح يسير فى اتجاه تساؤل أظن أنه هو شخصيًا واحد من المعنيين الرئيسيين بالإجابة عنه، وهو ما يتعلق بمعايير اختيار لجان تحكيم تلك الجوائز وغيرها، نفطية أم غير نفطية، ومبلغ علمى أنه كان يشغل موقع الأمين العام لجوائز مؤسسة ساويرس حتى دورتين سابقتين فقط، فهل اختلفت أسماء لجان التحكيم التى رشحها وقام باختيارها هو شخصيًا لجوائز الرواية والشعر والقصة القصيرة وغيرها عن تلك الأسماء التى نراها منذ سنوات طويلة فى لجان تحكيم «دائرة السياحة والثقافة فى أبوظبى» والمعروفة باسم «جائزة الرواية العربية» أو «البوكر» العربية، وجائزة «الحى الثقافى القطرى» المعروفة باسم «كتارا»، و«ملتقى القصة» الكويتية لصاحبها ومؤسسها الدكتور طالب الرفاعى، أو غيرها من جوائز أخرى أقل فى القيمة المالية أو أكثر؟!..
ولأننى خلال سنوات عمل كل تلك الجوائز تابعت فعالياتها، وطالعت ما تم نشره من أسماء الفائزين بها، ولجان تحكيمها، فلن أنتظر منه إجابة، لأننى باختصار أعرف أنهم «عصبة» لا تخرج عن عدد محدود للغاية من المحررين الثقافيين الذين ينطلقون من عدد محدود جدًا من الصحف المصرية والعربية، يضاف إليهم بعض من ممارسى كتابة الشعر والقصة والرواية إلى جانب عملهم الصحفى فى مطبوعات عربية تصدر من لندن أو قبرص أو باريس، وبعضٌ ممن يكتب عنهم هؤلاء الصحفيون أنهم نقاد، مصريون ومغاربة ولبنانيون، وهم يكتبون بالفعل ما يشبه «النقد الأدبى»، أو ما يظن البعض أنه كذلك، وهو أبعد ما يكون عن النقد وعن الأدب.. هؤلاء يتبادلون المقاعد، والاختيارات، وتجدهم حاضرين فى كل حفلات إعلان الجوائز، بلا استثناء، تجدهم هنا فائزين، وهناك أعضاء فى لجنة التحكيم، وهى حكاية ضمن حكايات كثيرة تخص «شلة» من المستأجرين المنتشرين فى الأوساط الثقافية المصرية والعربية، ربما تحصل على بعض الفتات الآن.. لكنها فى يقينى لن تستمر طويلًا، ولن تبقى.. وإن كانت آفة حارتنا النسيان، فإن امتياز المثقفين هو القدرة على الجدل والحوار، وامتياز الفن والإبداع فى قدرته على البقاء والعبور فوق الأجيال، والمنافع الضيقة.