الحنين إلى زمن أسامة أنور عكاشة.. رؤية أمريكية لـ«ليالى الحلمية» و«الرايا البيضا» و«مازال النيل يجرى»

- باحثة من جامعة شيكاغو تحلل أشهر المسسلات المصرية فى الثمانينيات والتسعينيات
- المؤلفة استغرقت 10 سنوات كاملة فى تأليف كتاب «دراما الأمة» عن الأعمال المصرية
- «الراية البيضا» سحر المشاهدين بأحداث رائعة عن الفارق بين الأصالة والابتذال
- ليلى أبولغد: من حيث الحجم والأقدمية والجودة مصر لا مثيل لها فى الدراما العربية
- من النص إلى الممثلين والموسيقى كل شىء فى «ليالى الحلمية» جذب المصريين
- فتحية العسال تنصر المرأة فى «أمهات فى بيت الحب» و«هى والمستحيل»
يعد كتاب «Dramas of Nationhood: The Politics of Television in Egypt» أو «دراما الأمة: سياسات التليفزيون فى مصر» من أهم الكتب الأمريكية التى تحدثت عن الدراما التليفزيونية المصرية، الذى صدر فى أغسطس 2004، عن مطبعة «جامعة شيكاغو»، من تأليف الباحثة الأمريكية ليلى أبولغد، أستاذة «الأنثروبولوجيا» ودراسات المرأة.
وقدمت «أبولُغد» أول ورقة بحثية لها عن المسلسلات المصرية التى عُرضت خلال فترتى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، فى اجتماعات «الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية» عام 1990، تلتها عدة أوراق بحثية عن هذه الأعمال من منظور «أنثروبولوجى» ثقافى واجتماعى.
ويتمحور كتاب «دراما الأمة» حول فكرة أساسية، هى أن التليفزيون المصرى فى فترتى الثمانينيات والتسعينيات لعب دورًا مهمًا فى «التربية الوطنية»، التى من خلالها يضع المواطنون أنفسهم كجزء من الأمة، معتبرًا أن التليفزيون مؤسسة رئيسية لفهم الأمة، لأنه يربط بين المجالين العام والمحلى، والثقافى والاجتماعى، ويهتم بأصوات النساء، المُهملة فى الأغلب.
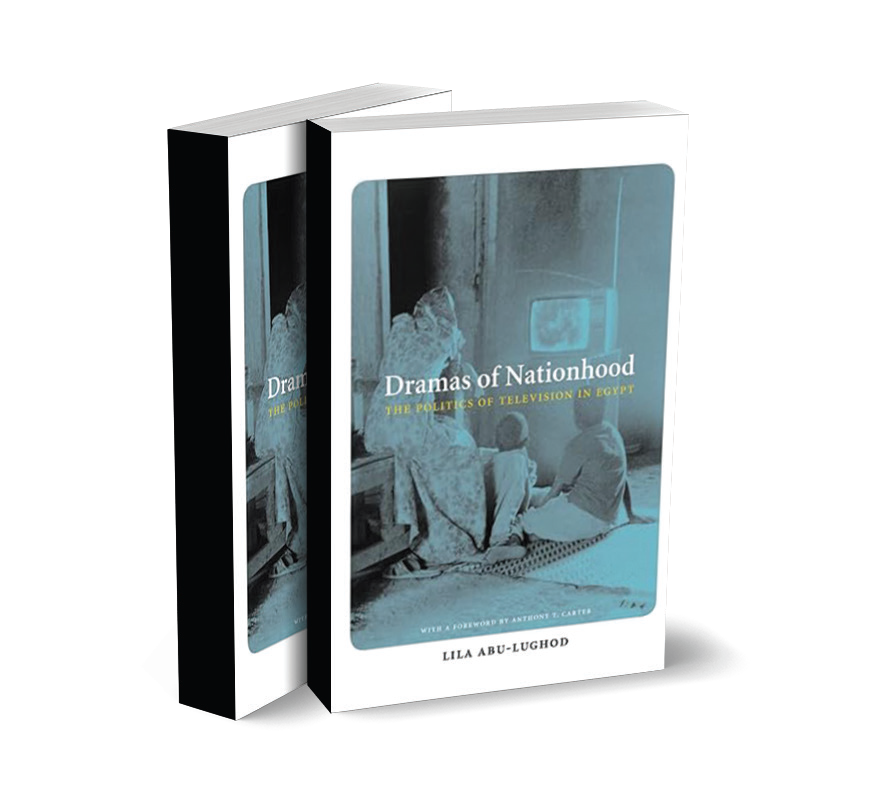
تركز الباحثة الأمريكية بشكل خاص، فى كتابها المكون من ٣٢٤ صفحة، على «الدراما المحلية»، التى كانت تُذاع على التليفزيون المصرى الوطنى، وهى مسلسلات تليفزيونية ميلودرامية تتناول هموم الناس العاديين، ومثلت أداة للتنمية الاجتماعية والتحديث، وتعزيز الوطنية.
وتعتبر أن «الدراما المصرية كانت تعد شكلًا ثقافيًا رائعًا يربط الأمة المصرية ببعضها البعض، وكانت أكثر ارتباطًا بالقضايا الثقافية والاجتماعية من نظيراتها الغربية، وذلك عبر تناول موضوعات مهمة، من بينها مكافحة التطرف الدينى، ومحو الأمية، وتنظيم النسل، والعلاقات بين الجنسين، والحياة اليومية، والتوعية الصحية.
ويُمثل كتاب «دراما الأمة» عقدًا من البحث، إذ استغرفت مؤلفة الكتاب أكثر من ١٠ سنوات لكتابته، وسافرت إلى مصر لإجراء مقابلات مكثفة مع عدد من كبار المؤلفين والمخرجين والممثلين والمنتجين المصريين لهذه الأعمال، مثل أسامة أنور عكاشة ومحمد فاضل وفتحية العسال وممدوح الليثى ومحفوظ عبدالرحمن ومصطفى محرم ونور الشريف، وغيرهم من أيقونات التأليف والإخراج والتمثيل فى ذلك الوقت، مختصة إياهم بالشكر فى مقدمة كتابها على منحها وقتهم الخاص، بل دعوتها لحضور بعض «البروفات» والكواليس فى مواقع تصوير بعض المسلسلات.
«حرف» تنشر فيما يلى أبرز ما جاء فى الكتاب عن المسلسلات الدرامية المصرية الشعبية، التى كانت تُبث على التليفزيون المصرى، خاصة خلال شهر رمضان، فى فترتى الثمانينيات والتسعينيات..فماذا قالت؟

المشاهدة للجميع
بدأتُ استكشاف عالم التليفزيون المصرى فى أواخر عام ١٩٨٩، وأودُّ أن أشكر جميع من أسهم فى إعداد هذا الكتاب، وإن كنتُ سأكتفى بذكر بعضهم. لولا أهل مصر الذين شاركونى حياتهم، وساعدونى فى فهم القليل مما يعنيه التليفزيون لهم، لما استطعتُ كتابة أى شىء.
قمت بـ٥ رحلات إلى مصر أثناء العمل على هذا الكتاب، أطولها كانت ٩ أشهر، وأقصرها ٣ أسابيع. فى جميعها، باستثناء المرة الأولى، أتيتُ مع أطفالى الصغار، وهو ما مثّل تحديًا خاصًا. لكنى تلقيت الكثير من الدعم اللوجستى وكرم الضيافة، بالإضافة إلى الرفقة الفكرية المتميزة، وشبكة المعارف والمصادر والمقتطفات والمراجع.
كنتُ محظوظة بوجود زميلى المشرف فاروق الرشيدى، من المعهد العالى للسينما فى القاهرة، الذى عرّفنى على العديد من زملائه، وفتح لى آفاقًا بحثية بين المتخصصين فى مجال التليفزيون. بسخاء لافت، تبرع العديد من هؤلاء المحترفين المشغولين بوقتهم. أنا ممتنة للغاية لكل من أسامة أنور عكاشة ومحمد فاضل وفتحية العسال.
كل هؤلاء منحونى مقابلات ودعونى لحضور «البروفات»، ومشاهدة التصوير فى مواقعه، ما أتاح لى الوصول ليس فقط إلى آراء محترفى التليفزيون الملتزمين والموهوبين، ولكن أيضًا إلى عوالم صناعة المسلسلات اليومية. كما تعلمت الكثير عن هذا العالم من ممدوح الليثى ومحفوظ عبدالرحمن ومصطفى محرم ونور الشريف ومنى زكى وآخرون.
لم يكن الجميع فى مصر يمتلك تليفزيونيًا عندما ظهر فى الستينيات، لكن بحلول منتصف التسعينيات، كان التليفزيون هو الشكل الإعلامى الأكثر شعبية، فالبيانات تظهر أن جميع الأسر المصرية تقريبًا وقتها أصبح لديها أجهزة تليفزيون. الغالبية العظمى من ٦٩ مليون مصرى، على اختلاف طبقاتهم، سواء من أباطرة الأعمال والمزارعين المستأجرين، البدو والأرستقراطيين الحضريين، والأمهات ونجمات السينما، الباعة الجائلين وأساتذة الجامعات، كانوا يميلون إلى مشاهدة نفس المسلسلات التليفزيونية تقريبًا كل مساء وبشكل خاص خلال شهر رمضان، عندما يشاهد الناس بشغف بعضًا من أكثر المسلسلات جاذبية التى تُبث كل عام.
ويعد التليفزيون مؤسسة رئيسية لإنتاج الثقافة الوطنية فى مصر، مؤسسة يسمح لنا استكشافها الدقيق بكتابة «إثنوغرافيا» للأمة المصرية. على أبسط مستوى، تبرز فى العمليات الوطنية بسبب المكانة الخاصة التى يبدو أنها تتمتع بها فى تعريف مصر كمركز ثقافى فريد مهيمن فى المنطقة العربية.
بصفتها المُنتِج الأول للسينما والتليفزيون فى العالم العربى، استضافت مصر فى عام ١٩٩٥ أول مهرجان عربى للتليفزيون، وفازت أفلامها ومسلسلاتها التليفزيونية بمعظم الجوائز. وقتها كان لبنان وسوريا والأردن وبعض دول الخليج العربى بدأت تنتج مسلسلات أيضًا. لكن من حيث الحجم والأقدمية، فإن مصر لا مثيل لها.
يعرف الناس فى مصر هذا، تمامًا كما يعرفون أن معظم النجوم الذين يملأون مجلات معجبيهم هم مصريون، وأن البرامج المصرية على شاشاتهم الخاصة تحظى أيضًا بمتابعة حماسية فى جميع أنحاء العالم العربى، وأن العديد من المطربين والممثلين من أماكن أخرى يأتون للعيش والعمل فى مصر.
بصفتى أجنبية وغريبة إلى حد ما عن التليفزيون المصرى، وانغمست فى مسلسلاته واستمتعت بها لمدة عقد أو نحو ذلك، يمكننى أن أؤكد أن هناك سببًا وجيهًا لهذا الفخر الوطنى. تُعدّ أفضل المسلسلات التليفزيونية عروضًا آسرة، تحمل فى طياتها حقائق أخلاقية تُدمع لها العيون، وأحداثًا مشوقة وحبكات تُثير اهتمام المشاهد، وشخصيات محببة تُضحكه، وحوارات رائعة تستحق التكرار، وموسيقى تُرسّخ المسلسلات فى الذاكرة، وشخصيات تُكوّن لدى المشاهدين روابط طويلة الأمد.
ورغم أن البعض يُبدى حماسًا أكبر تجاه مشاهد العنف والأغانى المُبالغ فيها، فى الأفلام الهندية التى تُبثّ كهدايا رمضانية خاصة، أو شغفًا بأنماط الحياة الرائعة والأخلاق الغريبة والشوارع النظيفة، فى المسلسلات والأفلام الأمريكية، ورغم أن البعض ما كان يعتبر نفسه حداثيًا كان ينتقد المنتجات المحلية المروية بمياه النيل لهوسها بالقضايا الاجتماعية والسياسية المحلية، ظل الانخراط فى تلك المناقشات حول المسلسلات كجزء لا يتجزأ من كون المصريين أمة تمتلك القدرة والموهبة لإنتاج دراما تليفزيونية عالية الجودة.
عندما كنت أشاهد التليفزيون مع عائلة قروية كبيرة فى صعيد مصر، كانوا يسترخون وأقدامهم مرفوعة، أو يجلسون على الأرض. وفى أحيان أخرى، عند استقبالهم ضيفًا، كانوا يجلسون باعتدال على المقاعد. فى مصر، يميلون إلى المشاهدة مع عائلاتهم فى المنزل. لكن هناك أيضًا العديد من الأماكن العامة التى تُشغل فيها أجهزة التليفزيون.
يشاهد البوابون فى المدن مع زملائهم من غرفهم فى الشوارع، ويشاهد أصحاب المتاجر مع زبائنهم. وغالبًا ما تُشغل المقاهى التليفزيون، ويجتمع الأصدقاء للمشاهدة فى منازل بعضهم البعض. وتميل مسلسلات رمضان الرئيسية إلى أن يكون لها متابعون واسعون ومختلطون.
حتى عام ١٩٨٦، كان حوالى ١٧٪ من البرامج الأسبوعية «تنموية»، إما تعليمية «محو الأمية والرياضيات والعلوم والثقافة»، أو معنية بالصحة والزراعة، أو الرعاية الاجتماعية التى تتعلق بالشباب والقانون والأسرة والسياحة أو المال.
وعلى الرغم من تسويق التليفزيون، استمرت الأيديولوجية التعليمية الرسمية فيه حتى التسعينيات، كما يصرح ممدوح الليثى، مدير قطاع الإنتاج السينمائى والمسلسلات فى الاتحاد المصرى للإذاعة والتليفزيون آنذاك. قال «الليثى» لى: «نحن كدولة مهتمون للغاية بالتعليم الثقافى لشعبنا. هدفنا الأهم فيما يتعلق بالمواطنين هو مساعدة الأفراد فى أن يصبحوا مثقفين. يجب أن نثقفهم ونعلمهم أساسيات الأخلاق والواجب الدينى. نحن بحاجة إلى غرس روح الوطنية والأخلاق والدين والشجاعة والمبادرة. لقد وجدنا أن أفضل وسيلة للوصول إلى الفرد هى الدراما لجعله جزءًا من الأمة».

ليالى الحلمية
ارتبطت بعض المسلسلات ارتباطًا وثيقًا بالنقاشات الدائرة فى المجتمع المصرى، كما تعلمتُ من المسلسل الرمضانى «ليالى الحلمية»، الذى جذب انتباه الجماهير وأثار نقاشًا وطنيًا، فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، من تأليف الكاتب أسامة أنور عكاشة، أشهر مؤلف تليفزيونى مصرى.
درس أسامة أنور عكاشة علم الاجتماع فى الجامعة، وكتب الأدب، ثم أدرك قدرته على الوصول إلى جمهور أوسع من خلال التليفزيون. تميّز مسلسله «ليالى الحليمة» بخصائص عديدة، منها كونه ملحمة تاريخية رائعة عن مصر الحديثة، بدأت فى أربعينيات القرن الماضى، وحملت المشاهدين إلى حاضرها، على مدار ٥ أجزاء سنوية ابتداءً من عام ١٩٨٧.
سرعان ما انشغل الجمهور بالنقاشات العامة حول هذا المسلسل، ونوقشت مزاياه فى الصحف والمجلات، وسط إشادة كبيرة بنصه الممتاز، ومخرجه الكفؤ، وممثليه الموهوبين والمتفانين، وجمهوره المُتفاعل. وحتى موسيقى «ليالى الحلمية» اجتذبت جميع أفراد الشعب المصرى كخلفية للأغنية الخالدة: «ومنين بيجى الشجن من اختلاف الزمن... ومنين بيجى الهوى من ائتلاف الهوى».

الراية البيضا
عُرض مسلسل «الراية البيضا» عام ١٩٨٨، وهو أيضًا من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد فاضل، وكما «ليالى الحليمة» نجح فى اجتذب الكثير من المشاهدين، خاصة مع قصته التى تسلط الضوء على الأصالة والابتذال، من خلال التناقض الشديد بين السفير «مفيد أبوالغار»، الشخصية التى جسدها النجم جميل راتب، و«فضة المعداوى»، الشخصية التى جسدتها النجمة سناء جميل، فى إطار عام يصور الصراع الثقافى الدائر بين الفن الراقى والهابط آنذاك.
ومازال النيل يجرى
من الأمثلة الرائعة أيضًا مسلسل «وما زال النيل يجرى»، الذى عُرض فى منتصف التسعينيات، من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد فاضل اللذين تعاونا فى العديد من المسلسلات الرائعة فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات.
لكن هذا المسلسل لم يحظَ بشعبية كبيرة، رغم حبكته المعقدة وتصويره السينمائى الرائع وأجوائه الريفية الواقعية. كان المسلسل استثنائيًا، إذ مُوِّل جزئيًا من قِبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأُنتج بالتعاون مع مركز المعلومات والتعليم والتواصل التابع لهيئة الدولة للإعلام.

قال أسامة أنور عكاشة لى عن هذا المسلسل: «كتبت عن تنظيم الأسرة لأننى أعتقد أن الزيادة السكانية مشكلة اقتصادية خطيرة، لذا فإن الكتابة عن هذه القضية واجب وطنى». كما قال عن هذا المشروع الدرامى، فى ندوة بعنوان: «كتابة السيناريو لأفلام التنمية» عام ١٩٩٧: «لا أعرف المقصود بمسلسلات التنمية، لأن كل فن جيد هو من أجل التنمية».
والعديد من الرسائل فى «وما زال النيل يجرى» جديرة بالاهتمام، وبعض القضايا التى يتناولها تتطلب شجاعة كبيرة. المسلسل ينتقد زواج القاصرات والاغتصاب الزوجى، ويُقدّم صورةً قاتمةً لاستغلال النساء، بالإضافة إلى عنف طبقة مُلّاك الأراضى، وهى مواضيع مألوفةٌ لدى المصريين من الأفلام والأدب. لكن هذا العمل يُصوّر مشكلة النساء الريفيات، التى تكمن فى استغلالهن من قِبل رجال ريفيين جهلاء، وليس فى أن جميعهن يعانين من ضائقة مالية.
البطلة الرئيسية لمسلسل «وما زال النيل يجرى» طبيبة، تُجسّد دورها الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد، زوجة المخرج محمد فاضل، التى تُساند النساء ضدّ رجالهن. فى الحلقة الافتتاحية، تظهر وهى تُولّد امرأة، وعندما تكتشف أن الطفل السابع فى العائلة، تتنهّد وتنظر إلى الفلاحات الفقيرات اللواتى يقفن خارج المنزل المتواضع بشفقةٍ وازدراء، ثم تتحدث عن امرأة شابة من القرية، باعتبارها «رمزًا لما تحلم به لكل امرأة وفتاة فى القرية»، لأنها «تعلّمت حتى المرحلة الإعدادية، ولديها الكثير من الوعى»، ثم تصف كيف أن هذه الشابة لديها طفل واحد فقط وزوج صالح... «عائلة تُسعد المرء».
أمهات فى بيت الحب
فى يناير ١٩٩٦، أثناء زيارة قصيرة لقرية فى صعيد مصر، شاهدتُ مع عدد من الأصدقاء بعض حلقات المسلسل التليفزيونى «أمهات فى بيت الحب»، الذى عُرض لأول مرة فى عام ١٩٩٣، وتدور أحداثه فى دار مسنين للنساء، ومحاولة صهر الأرملة عديم الضمير الذى يدير المكان الاستيلاء عليه، لتحقيق حلمه ببناء فندق من ٢٢ طابقًا.
مُسلَحات بهدف جديد، تتحد النساء الساكنات معًا للدفاع عن منازلهن المهددة. ينسين خلافاتهن حول البرامج التليفزيونية التى يشاهدنها، ويحشدن مواهبهن لجمع المال لشراء حصة هذا الرجل، ومواجهته بكل قوة، فى عمل من كتابة فتحية العسال، وهى كاتبة نابضة بالحياة وواثقة من نفسها، وواحدة من القلائل بين نساء جيلها اللواتى يكتبن الدراما التليفزيونية فى مصر.
عُرفت مسلسلات فتحية العسال باهتماماتها الاجتماعية، واعتبرت قضايا المرأة بالغة الأهمية. وفى مسلسلها هذا، أجرت بعض الدراسات «الإثنوغرافية» فى دار للمسنين لجعل نصها أكثر واقعية. قالت لى عن ذلك: «أردتُ خلق دور جديد للنساء المُسنات. فى دار المسنين نفسها، بدأن فصلًا دراسيًا لتعليم اللغة الإنجليزية، لأن إحدى النساء كانت أستاذة لغة إنجليزية، وأخرى كانت صائغة فضة، افتتحت ورشة صغيرة للفضة وعلمت النساء المهارات اللازمة لهذا العمل».
وأضافت: «فى الدار أيضًا شاركن فى محو الأمية، من خلال تعليم فتيات الحى القراءة والكتابة. كما قدمن دروسًا فى إدارة المنزل، وحتى الزراعة»، معقبة: «رسالتى هى أن المرأة لا تزال قادرة على التعلم فى هذا العمر، ولا يزال بإمكانها الاستفادة مما لديها لتُعلّمنا إياه».
وواصلت: «أتحدث هنا من واقع تجربتى الشخصية. أنا الآن فى الستين من عمرى. فى الماضى، عندما كانت المرأة فى الستين من عمرها، كان يُفترض بها أن تجلس فى المنزل تنتظر الموت، بعد أن تزوّج أطفالها. الآن لدى ٤ أطفال و٨ أحفاد، ولكن لأن لدىّ همومى وطموحاتى الخاصة ككاتبة، لا أشعر بأننى أتقدم فى السن. أردتُ إيصال هذه الرسالة فى مسلسل».
هى والمستحيل
من المسلسلات الأخرى التى تفتخر بها الكاتبة فتحية العسال: «هى والمستحيل»، الذى دار حول امرأة رفضها زوجها لعدم تعليمها، فخرجت وتلقت تعليمها. وعندما أراد زوجها العودة إليها، رفضت، رغم أن لديهما ابنًا. قالت «العسال» لى عن هذا المسلسل: «هدفى هو تأكيد قيمة البيت كمنزل زوجية. أنه لا ينبغى للرجل والمرأة أن يدخلا إلا بشرط أن يحبا بعضهما البعض. الزواج يجب أن يقوم فى المقام الأول على التفاهم والحب المتبادلين».
كانت مرجعيتها هى الطبقة الوسطى، وآراؤها تمثل الطرف الأكثر تقدمية وحداثة فى سلسلة متصلة. فى نظرى، كانت دعوات فتحية العسال إلى أدوار مفيدة اجتماعيًا للمرأة، ومهارات وأنشطة يمكن أن تُمكّنها من تجاوز مكانتها فى الأسرة والمنزل، والاستقلال الاقتصادى الذى من شأنه أن يُخفف من أسوأ آثار الهيمنة الذكورية، كلها دعوات مثيرة للإعجاب.
حصاد الحب
تطرقت الكاتبة فتحية العسال أيضًا إلى الاختلاف بين التجارب الحضرية والريفية، من خلال مسلسل «حصاد الحب»، الذى عُرض عام ١٩٩٢، عن ريف صعيد مصر. يُظهر المسلسل قسوة وسطوة كبار مُلاك الأراضى، وعجز الفلاحين الذين لا يسعون إلى قضية مشتركة.
كتبت «العسال» هذا المسلسل بدافع من قلق حقيقى، حتى أنها أمضت ٣ أشهر تعيش مع عائلة ريفية لإعداد نفسها لكتابة السيناريو، تمامًا كما درست دارًا للمسنين لكتابة «أمهات فى بيت الحب». كان تركيزها على الانتقام، والحل الذى قدمته أعاد إنتاج خطاب قديم وشائع جدًا للحداثة المستنيرة ضد العادات المتخلفة التى لا تزال تحقر رجال ونساء الصعيد.
بطل وبطلة مسلسل «حصاد الحب» هما زوجان شابان، «روميو» و«جولييت» معاصران، قادهما تعليمهما الحديث وأفكارهما المستنيرة إلى رفض الإقطاع، ومحاولة كسر قبضة الإقطاعيين وزوجاتهم، من خلال دعم جهود الفلاحين لإنشاء مصنع مملوك بشكل جماعى لهم.
وأفكار فتحية العسال التقدمية كانت جزءًا من خطاب وطنى عام قوى للإصلاح والارتقاء. هذا التوجه العام، المُعزَّز بـ«الإثنوغرافيا» والتعاطف الواسع مع قضية «العسال»، المتمثلة فى معرفة ما هو صالح للمجتمع، يُشكِّل أساس عمل العديد من كُتّاب المسلسلات التليفزيونية، تمامًا كما يُشكِّل مشاريع الإصلاح العديدة، من التعليم إلى خطط الصحة العامة.
حلم الجنوبى
فى عام ١٩٩٧، عُرض مسلسل درامى بعنوان «حلم الجنوبى»، لأول مرة على قناة «النيل»، القناة الفضائية الجديدة التى أُتيحت مجانًا فى المدن الكبرى، وقدّمت أفلامًا ومسلسلات مُترجَمة للسياح، وذلك بعد عدة أشهر من عرض العمل على «القناة الحكومية الرئيسية».
تُعيد الحلقات الافتتاحية، التى تدور أحداثها فى الأقصر وما حولها، تصوير صورة شائعة عن الصعايدة، أى «سكان الريف». فبعضهم يرفض دفع إيجار الأرض التى يزرعونها، والبعض الآخر تابعون مخلصون لرجال مهمين.
من بين هؤلاء، رجل صعيدى ثرى لكنه أمىّ، عمل فى السياحة، وحقق الثراء بالحفر تحت منزله واكتشاف الآثار الفرعونية. وهناك مرشد سياحى ضعيف المعرفة، لغته الإنجليزية ضعيفة، يُضلّل السياح بشأن النقوش القديمة، وشخصية أخرى- الشرير الحقيقى فى المسلسل- عادت لتوها من دول الخليج الغنية بالنفط، حاملةً هدايا لمدير المدرسة عديم المبادئ لاستعادة وظيفته كمدرس. حاول جميع الممثلين التحدث باللهجة الصعيدية، مستخدمين نطقًا وكلمات مميزة.
واجهت كل هذه الشخصيات النمطية شخصية فريدة، وهى شخصية «نصر وهدان القط»، وهز مُعلّم تاريخ مثقف يُحاضر طلابه فى المدرسة الثانوية عن تاريخ الحضارة العظيمة لمصر القديمة، على الرغم من أنه لم يكن مدرجًا فى المنهج الدراسى، ويقضى فترة ما بعد الظهيرة فى دراسة كتب الآثار من داخل معبد الكرنك، المعبد الفرعونى الرائع على الضفة الشرقية لنهر النيل فى الأقصر، ويدافع عن حق أبناء الفقراء فى التعليم.
وكما هو الحال فى أفضل المسلسلات التليفزيونية المصرية، كان لهذا المسلسل طابعٌ غير مألوف، من حيث التركيز على مجموعة مُعقّدة من المواضيع الاجتماعية، ولقطات شيّقة مُصوّرة فى الموقع، وشخصيات نابضة بالحياة، وتوتر درامى مُلفت.
وتباهى الكاتب محمد صفاء عامر بأنه يكتب عما يعرفه ويعايشه. فقد وُلد هو نفسه فى صعيد مصر، بالقرب من قنا، مع أنه قضى معظم حياته فى الإسكندرية، الموقع الآخر لـ«حلم الجنوبى». وقد استخدم الكاتب العديد من المواضيع التقليدية عن التخلف الريفى، والعنف فى صعيد مصر، المألوف فى التليفزيون والسينما والأدب.
ولا يقتصر الأمر على السكان المحليين الغاضبين فحسب، بل يشمل أيضًا موضوع السلطة الأبوية التعسفية. يتجلى غالبًا فى السيطرة على النساء، ومؤسسة الزواج القسرى المدبر، وكلاهما جزء من حبكة مسلسل «حلم الجنوبى»، الذى جاء استكمالًا لنجاح هذا الكاتب التليفزيونى السابق، المتمثل فى مسلسل «ذئاب الجبل».
وهناك موضوع أكثر شيوعًا فى «حلم الجنوبى»، وهو التوتر بين سارق القبور الأنانى الذى يريد بيع الآثار للأجانب، و«نصر وهدان القط» المثقف الذى يقدر الآثار كجزء من التراث الوطنى.
ومرة أخرى، أصر الكاتب على أن شخصية الرجل الذى يصبح ثريًا من خلال التنقيب عن الآثار تحت منزله، تستند إلى شخص حقيقى سمع عنه عندما كان صبيًا. وصور «حلم الجنوبى» الأشخاص المتورطين فى تدنيس المقابر الفرعونية، وبيع تراث مصر للأجانب، فى مواجهة المحدثين الوطنيين المتعلمين، سواءً من العاملين فى هيئة الآثار، أو المهندسين المشاركين فى بناء القرية الجديدة. يُمثّل هؤلاء الغرباء نماذج للأبطال المحليين الذين تحت وصايتهم، يكسرون فى نهاية المطاف التقاليد السلبية لأقاربهم.
يكمن الفرق فى مسلسلات التسعينيات التليفزيونية فى أن أحد أبناء الصعيد أصبح هو نفسه وطنيًا متعلمًا وحاميًا للأمة، فلا يوجد غرباء من شمال مصر الحضرى يشاركون فى الصراع المحلى، حتى لو تحالف «نصر» لاحقًا مع أستاذ آثار وابنته التى تدرس أيضًا علم الآثار، وهو دور لعبته بشكل غير متوقع مغنية البوب «سيمون»، فى الإسكندرية، وحصل على مساعدة منهما.
يُعيد المسلسل طرح موضوع جديد أصبح شائعًا فى أواخر التسعينيات، وهو «الإسلام السياسى» والتعصب الدينى، إذ يظنّون أن اهتمام صديق البطل بعلم المصريات «عبادة للأصنام»، فأضرموا النار فى منزله، مُحرقين مجموعته الثمينة من الكتب العلمية، وبالصدفة، وثيقة بردية تُمثّل مفتاح موقع مقبرة الإسكندر المفقودة. تُقدَّم هذا البردية على أنها كنز وطنى لا يُقدَّر بثمن، رفض بطلنا إعادتها إلى سارق المقابر الأنانى الذى عثر عليها. وبالطبع، شعر «نصر» بالرعب لأن هذا الرجل الجاهل أراد بيع هذه البردية للأجانب.
وعندما واجه منتجو «حلم الجنوبى» تحديًا بشأن دقة اختيار الأقصر كمكان لمثل هذه الجماعات المسلحة، دافع الكاتب عن نصه بأن جميع أنحاء تلك المدينة، من أرمنت إلى نجع حمادى، كانت حقول قصب السكر التى اختبأ فيها الإرهابيون. وقال صلاح السعدنى، الذى لعب الدور الرئيسى، إن الجغرافيا لم تكن هى القضية على أى حال، بل كان الخطر الذى تشكله هذه الجماعات، وهو ما أرادت الدراما نقله.
وكان العنصر الأساسى الوحيد الذى يبدو مفقودًا فى البداية، فى «حلم الجنوبى»، هو الثأر. ويُحسب للكاتب أن هذه الصورة تتم السخرية منها بوعى، عندما ترفض صاحبة عمارة سكنية فى الإسكندرية تأجيرها لبطلنا النبيل لأنه أعزب من الصعيد. تخشى أن يكون متورطًا فى ثأر ولا تريد المتاعب. تعتذر قائلةً: «أنت تعرف طبعكم أيها الصعايدة».
أخطر أعداء بطلنا هو زميله السابق من المدرسة، المهاجر العائد، الذى يتزوج ابنة أخت سارق القبور بسبب مالها، ليكتشف أنها مغرمة بالمعلم المثقف. بدافع من كبريائه المجروح، ينضم إلى أقاربه، عازمًا على الانتقام لخسارة البردية الثمينة. وهكذا، يتجلى الانتقام العنيف، لكنه يُقلل من قيمته لكونه لا ينبع من الحزن وحب العائلة الشديد، بل من التنافس والكبرياء والجشع.
وعلى عكس العديد من المسلسلات التليفزيونية، يوازن «حلم الجنوبى» بين هذه الشخصيات السلبية، والطيبين القادرين على توحيد قواهم مع سكان الإسكندرية الصادقين والوطنيين. هناك خادمان بسيطان لكنهما مخلصان وصادقان: أحدهما قروى ريفى، والآخر يتميز بنزاهته فى الصداقة. وهناك الفتاة الشابة- موضوع الحب- التى تسعى لتحدى العادات والتقاليد، فتُنقذ الموقف بشجاعة.








