العاشقة.. أوراق خاصة من قصة غرام عائشة عبدالرحمن وأمين الخولى

- بنت الشاطئ لم تكتب عن الرسول فى بيته بكل هذا التألق إلا لأنها كانت امرأة عاشقة
- عرضت عائشة عبدالرحمن لحياة النبى فى بيته ولم ترَ فيما عرضت شيئًا تتحرج منه قط
- «بنت الشاطئ»: لم يتخل عنى إيمانى بأنى ما سرت على دربى خطوة إلا لكى ألقاه
- ما يمكننا أن نأسف له أن أمين الخولى لم يتحدث عن غرامه بتلميذته
لا بد أن أعترف أمام الجميع بأننى كنت لا أميل إلى شخصية بنت الشاطئ الدكتورة عائشة عبدالرحمن، رغم ما تربطنى بها من صلة جغرافيا.. فأمها دمياطية كأمى تمامًا.
لكننى يجب أن أعترف فى الوقت نفسه بأننى كنت وما زلت معجبًا بما كتبته من تراجم لسيدات بيت النبوة، ولما أنتجته من دراسات قرآنية وهى كثيرة ومتعددة.
كان كتاب «نساء النبى» هو فاتحة الطريق بينى وبينها.
كنت وقتها فى الخامسة عشرة من عمرى، أدرس فى الصف الثالث الإعدادى، وما زلت أتذكر حالة السعادة التى سيطرت علىّ وأنا أقرأ ما كتبته عن حياة الرسول الزوجية بما فيها من عواطف ومشاعر وخصوصية بشرية.
كانت هذه أول مرة أرى النبى، صلى الله عليه وسلم، بهذه الصورة.
وبعد سنوات، أغسطس 2003، وعندما كنت أعد ملحقًا أسبوعيًا يصدر مع جريدة صوت الأمة، خصصت أحد الملاحق لنص «نساء النبى» كاملًا، ولم يكن لدينا فى العدد نفسه شىء له قيمة كبيرة.
بعد أقل من 24 ساعة وجدت رئيس مجلس الإدارة يسألنى: هو العدد ده فيه إيه؟
وقبل أن أجيبه، قال: أصل الجماعة بتوع التوزيع فى الأهرام بلغونى إن العدد خلص من عند البياعين وعاوزين نطبع تانى.
قلت له: تقريبًا عشان الملحق.. أصلنا نشرنا كتاب «نساء النبى» كاملًا، والكتاب ده تحديدًا فيه سر كبير.
هز رئيس مجلس الإدارة رأسه موافقًا لى معلقًا: تقريبا هو كده.
كنت أقصد تمامًا ما قلته، فالكتاب له سر.
حاولت أن أعرفه، كتبت فى تقديمه باحثًا عما يخفيه.
فلم تجلس عائشة عبدالرحمن إلى مكتبها لتخط كتابها الرائع «نساء النبى» إلا بعد أن قرأت كل ما فى المكتبة الإسلامية من مؤلفات تناولت حياة النبى الخاصة وحياة أزواجه أمهات المؤمنين.
بدأت بالقرآن الكريم ثم هبطت إلى كتب الحديث والسيرة النبوية والتفسير، ثم مرت بكتب التراجم والتاريخ، وضمت إلى ذلك كله ما وصل إلى يديها من كتب المستشرقين التى كتبوها عن محمد، صلى الله عليه وسلم، والإسلام.
وعندما بدأت الكتابة لم تتفلسف ولم ترتدِ درعًا واقية لتدافع عن النبى فيما قيل عن نزوعه إلى الزواج بالحق، وما زعموا أنه باطل، ولكنها دخلت إلى بيت النبى وهى تعلم أن زوجاته جميعًا ينزعن إلى حواء، جئن إلى بيت تلاقت فيه البشرية بالنبوة، واتصلت الأرض بالسماء وتزوجن من بشر يتلقى الوحى من أعلى ويبلغ رسالة الله، ولذلك أدركت أنها مهما أوتيت من حكمة فلن تستطيع أن تصور حياتهن كما ينبغى، فحياتهن تموج فيها أهواء البشرية فى فيض من النور وتتجاذب فيها الأنوثة التى نعرف رقتها وضعفها ورهافة وجدانها بتيارات بالغة القوة والعمق، يجذبها بعضها إلى الأرض، وتشدها أخرى إلى السماوات العلا، وتتعادل مع هذه البشرية السماوية.. سماوية إنسانية.
لم تجمع عائشة عبدالرحمن فى كتابها شتى الروايات عن نساء النبى، فهى لم ترغب فى جعل كتابها مجرد ترجمة لهن على النحو المألوف لكتب تراجم الشخصيات، ولكنها اهتمت بالعناية بحياة كل منهن فى البيت النبوى ومكانها فيه، وتصوير شخصيتها تصويرًا يجلوها زوجة وأنثى.
لقد رأت فى حياة زوجات النبى آية عظمة تمثلت فيه، فقد استطاع مع بشريته السوية أن يقوم بختام رسالات الدين، وأن ينقل بها الإنسانية إلى مرحلة الرشد ويحررها من ضلال الوثنية وشوائب الشرك ويقودها على مراقى طموحها إلى مثلها العليا وتحقيق وجودها الكريم.
وترى عائشة عبدالرحمن أن آية البطولة فى النبى، صلى الله عليه وسلم، أنه استطاع وهو بشر مثلنا أن يدخل التاريخ كما لم يدخله سواه، وأن يوجه سيره منذ بعث بدين الإسلام.

عرضت عائشة عبدالرحمن لحياة النبى فى بيته، ولم ترَ فيما عرضت شيئًا تتحرج منه قط، فقد تعاملت مع الرسول كزوج، ومع نسائه كزوجات، لهن مشاكل إنسانية عادية للغاية، كانت تدب بينهن الغيرة فيشتعل البيت النبوى نارًا، ولم تسلم الحياة الزوجية للرسول من بعض دسائس زوجاته، فكل منهن كانت تريده لها وحدها، كن مقتنعات بأهمية دوره وعظمة رسالته، لكن عندما يأتى دور الزوج لم تكن كل منهن ترى سوى نفسها، وهو ما دفع السماء أكثر من مرة إلى أن تتدخل لتفصل بين النبى وزوجاته.
كانت عائشة عبدالرحمن صادقة للغاية وهى تكتب عن نساء النبى، وقعت فى هواهن، ففى سطورها حالة من الصداقة العميقة التى تربط بين الكاتبة وبطلاتها، ولذلك جاء الكتاب- رغم دقته العلمية- إنسانيًا يحمل دفقات من المشاعر لن تتحملها، وأنت تقرأ، مرة واحدة.
ولأن للأوراق أسرارها التى تخفيها دائمًا، فقد كنت على قناعة بأن ما قامت به عائشة عبدالرحمن من تصوير خرافى للحياة العاطفية الرسول مع زوجاته وراءه سر كبير.
توالت السنوات وتجمعت الأوراق، لتصبح قناعتى بأن بنت الشاطئ لم تكتب عن الرسول فى بيته بكل هذا التألق والبريق والإنسانية الصادقة والعاطفة المتأججة، إلا لأنها كانت امراة عاشقة.
وهنا يمكن أن نعيد ترتيب الأوراق من جديد.
فى أرشيفها عثرت على مقال مهم نشرته لها مجلة «الهلال» فى عدد يناير ١٩٥١، عنوانه «تزوجت فى الجامعة».
فى صدر الصفحة يتصدر العنوان صورتان، الأولى على اليمين لها، والثانية على اليسار لزوجها الأستاذ أمين الخولى.
فى هذا المقال إشارة إلى بداية علاقة عائشة بالخولى، وهى العلاقة التى يمكن لكل من عرفوا بنت الشاطئ أن يرسموا لها صورة جديدة على هامشها وبدافع من تفاصيلها.
تبدأ عائشة مقالها: كنت حديثة العهد بالجامعة، الكلام هنا عن عام ١٩٣٥، حين سمعت زملائى الطلاب يفيضون فى الحديث عن صرامة أستاذ لهم، ويثنون من شدته فى أخذهم بما لا عهد لهم به من الدقة المنهجية، وهم مع ذلك لا يملكون إلا أن يحبوه ويؤمنوا به.

مضى عام كامل دون أن تجلس عائشة مجلس التلميذ من هذا الأستاذ الذى قيل عنه إنه يحطم رءوس الطلاب، ليعيد صنعها من جديد، وكان بحسبه أن يصنع رأسًا واحدًا، ثمنًا لجهده كله طيلة موسم دراسى بأكمله.
فلما كان العام الثانى، ١٩٣٦، سعت عائشة إلى درسه متحفزة، مصممة على أن تبهر بشجاعتها زملاءها الطلاب الخائفين، وأن تنتزع من هذا الأستاذ الصارم المخيف شهادة اعتراف بكفايتها ومقدرتها، فقد كانت فى هذه الأيام تكتب فى الصفحة الأولى من الأهرام، ولها فى مكتبة الجامعة كتاب مطبوع، وقد فازت بالجائزة الأولى فى المباراة الرسمية لحكومة رفعة على ماهر باشا.
كانت عائشة قد بدأت الكتابة فى الأهرام عام ١٩٣٣ بعد عامين من كتابتها فى مجلة «النهضة النسائية» التى كانت تملكها السيدة «لبيبة أحمد»، وعندما بدأت الكتابة فى الأهرام نشرت عدة مقالات عن حياة الفلاحين جمعتها بعد ذلك فى كتاب، هو كتابها الأول، وكان عنوانه «الريف المصرى»، وبنته على مقالها الأول فى الأهرام من هذه السلسلة وكان عنوانه «فلاحنا المسكين كم نظلمه».
نعود إلى مقال بنت الشاطئ، لنجدها تقول: بدأ الأستاذ محاضراته بأن حدثنا فى تواضعه، أو هكذا خُيل لى، عن التعاون المشترك بيننا، ثم بسط أمامنا دروس العام، وترك لكل منا أن يختار نصيبه منها بملء حريته، ليعده ويحاضرنا فيه، وأشفق الطلاب جميعًا من اختيار الدرس الأول، فأثارنى إشفاقهم وتقدمت فى حماس- وأكاد أقول فى استهانة- أعلن أنى سأعد الدرس الأول وألقيه عليهم بعد أسبوع واحد، ونظرت إلى الأستاذ فى تحدٍ، فلم يَبدُ عليه أنه اكترث لى، ثم نظرت إلى الطلاب فسرنى أنهم يشجعوننى.
وتضيف: كان موضوع الدرس هو «نزول القرآن»، وقد بدا لى سهلًا هينًا، لا يكلفنى سوى مراجعة بعض ما يملأ بيتنا من كتب التفسير وتاريخ القرآن، ثم أنسقه بقلمى، الذى كان يدبج المقالات الرنانة فى كبرى صحف الشرق، وحان موعد المحاضرة وسرت إلى المنصة بقدم ثابتة، ألفت أن تسير إلى مكان الخطابة فى قاعة «إيوارت» التذكارية.
بدأت عائشة فى إلقاء البحث، دون أن يدور بخلدها أنها مقدمة على أعسر امتحان تمر به، وخرجت تلهث إعياءً وتبكى غيظًا، لكنها آمنت فى أعماقها بالأستاذ والمنهج والجامعة، وأدركت مدى افتقارها إلى العلم، وقد كانت قبل ساعة واحدة تتحدى الأساتذة، وهنالك أسلمت رأسها للتحطيم كيما تصنع من جديد.
تقول: سبع سنوات من التلمذة المتصلة، صحبت فيها أستاذى أتلقى عنه وآنس إليه، وأغفر له ما ألقى من مشقة الدرس، سبع سنوات، لا أذكر أنى تخلفت فيها مرة واحدة عن حضور مجلسه العلمى، أو ترددت فى الإفضاء إليه بكل متاعبى، وسؤاله المشورة والرأى فى همومى، كنت أجد فيه الأستاذ والموجه والزميل والصديق، وأشعر نحوه بمثل ما يشعر به المريد نحو شيخه، فكانت تلمذة روحية عقلية عميقة قوية، تستجيب لما فى شخصيتى فى أثر النشأة الأولى فى صميم بيئة صوفية، وفى كنف أب شيخ له تلامذته ومريدوه.

وتضيف: كانت مثل هذه التلمذة، غريبة على بعض من ينتسبون إلى الجامعة لكنها كانت عندى الصورة المثالية لما بين الأستاذ والطالب، أو الطالبة، فى الجامعة، ولم يئن الأوان بعد لكى أروى قصة نضالى عن تلمذتى الصوفية، ويكفى أن أقول الآن: إننى لم أستطع بحال ما أن أجحد حقى فى أستاذى لمجرد كونى طالبة ولست طالبًا، بل مضيت أقرر هذا الحق وأباهى به، وأفرضه على من لا تسعفهم طاقتهم على تمثله وإدراكه.
وكنت أقول دائمًا: إن حاجتى إليه هى التى تقرر حقى فيه، مهما يجحد الجاحدون أو يرجف المبطلون، وحين عز علىّ أن أستغنى عن أستاذى تزوجته بعد تلك السنوات الطوال من التفاهم النفسى والتجاوب العقلى والانسجام الروحى، وما زلت حتى هذه اللحظة أبارك اليوم الذى لقيته فيه منذ اثنى عشر عامًا وبعض عام.
حسبى من زمانى أنى لقيته، واستشرفت إليه، وحسبى منه هو أنه حفظ على إيمانى وثقتى فيه، فى هذا الزمن الكافر الذى تتهاوى فيه المثل أمام أعيننا وتنهار، وما تكون الحياة بغير هذا الإيمان؟
كتبت عائشة عبدالرحمن هذه القصة باختيارها الحر عن زواجها بأمين الخولى، لكنها ألمحت بأكثر مما أفصحت، وأخفت بأكثر مما أظهرت.
لقد التحقت بالجامعة فى عام ١٩٣٥ وقابلت أمين الخولى فى العام الثانى وعندما رأته اشتعلت فى قلبها جذوة الحب التى لم تنطفئ أبدًا.
كان أمين الخولى فى هذا الوقت واحدًا من ألمع أساتذة الجامعة المصرية فى كلية الآداب قسم اللغة العربية، وكان تدريسه لعلوم القرآن مفارقًا للجميع، يصفه البعض بأنه أعظم عقلية لبست العمامة، وكان متزوجًا ولديه أولاده، لكن شيئًا من ذلك لم تره عائشة عبدالرحمن، رأت فيه الرجل الذى ترسخ فى يقينها أن الله لم يخلقها إلا من أجل أن تلتقى به.
وحتى تتأكد من ذلك، فيكفيك أن تعرف أنها وبعد حصولها على درجة الماجستير فى عام ١٩٤١ قررت أن تستقيل من الجامعة لتتفرغ له زوجًا وحبيبًا، وتتفرغ لبيتها وأولادها منه، وكانت صياغتها لاستقالتها من الجامعة دالة على ذلك.
فى خطاب الاستقالة قالت عائشة: إننى خرجت من البيت أطلب العلم ولم يكن الاحتراف غاية لى يومًا ما، وفى هذا العام أتممت دراساتى الجامعية العليا بإعداد رسالتى للماجستير فأصبحت أشعر بأن الاحتراف يؤذى فطرتى ويعطل مواهبى، وأريد أن أفرغ لإنتاج حر كريم فى ظل بيت كريم.

لم تفصح عائشة عن تفاصيل قصة حبها لأمين الخولى، لكن يمكننا أن نعرف مداها وملامحها من تصديرها لكتابها «على الجسر»، وهو التصدير الذى تقول فيه: تجلت فينا ولنا وبنا آية الله الكبرى الذى خلقنا من نفس واحدة، فكنا الواحد الذى لا يتعدد، والفرد الذى لا يتجزأ، وكانت قصتنا أسطورة الزمان، لم تسمع الدنيا بمثلها قبلنا، وهيهات أن تتكرر إلى آخر الدهر.
لكن ما حكاية كتابها «على الجسر»؟
يعتبر كثيرون أن هذا الكتاب هو سيرة عائشة عبدالرحمن الذاتية، والحقيقة أنه ليس كذلك، فهو توثيق لسيرة قصة حبها الذاتية، وقد بدأت كتابته فى مارس ١٩٦٦، بعد أيام قليلة من وفاة أمين الخولى، وهى الوفاة التى خلعتها من نفسها.
لم تتحدث عائشة عن ملامح قصة حبها، لكنها تدفقت واصفة مشاعرها تجاه زوجها الراحل بنص افتتاحى للكتاب، أعتقد أنه نص أسطورى يتناسب تمامًا مع القصة التى وصفتها بأنها أسطورية، وبأن الزمان لن يجد مثلها أبدًا.
يمكننا أن نلتقط أنفاسنا قليلًا قبل أن نقرأ هذا النص الذى تقول فيه:
«على الجسر ما بين الحياة والموت، أقف حائرة ضائعة فى أثر الذى رحل، أطل من ناحية فأجده ملء الحياة، وألمح طيفه الماثل فى كل من حولى وما حولى من معالم ودنا المشترك، وأتتبع آثار خطاه على دربنا الواحد، دفاقة الحيوية سخية العطاء، وأميز أنفاسه الطيبة الزكية فى كل ذرة من هواء أتنفسه، وأصغى إلى نجواه فى الصمت وفى الضجيج، فى سكون الخلوة وفى صخب الزحام، وأطوف بأرجاء عالمنا الرحب الذى ضمنا معًا، فلا أتصور أنه الراحل الذى لا يثوب».
«وعلى الجسر ألتفت إلى الناحية الأخرى حيث المصير المحتوم لكل حى، لا عاصم منه ولا مفر، فأدرك بملء وعيى أنه عبره قبلى، إلى نهاية الشوط وغاية المطاف، وأسترجع بيقظة مروعة ومرهفة خطوته الأخيرة على المعبر، إذ يستوعب الوجود كله فى نظرة ثاقبة، ويستجمع قواه ليجتاز المرحلة الباقية، فى بهاء فروسيته وعزة كبريائه وجلال إيمانه، مناضلًا حتى النفس الأخير عن الحق والخير، ومحتملًا حتى النفس الأخير أمانة الإنسان».
«وبملء وعيى كذلك، أستعيد المشهد الفاجع للزائر المرهوب، ألم يدارنا مقنعًا مستخفيًا، لا تراه عين ولا يدركه حس، فلم يتلبث غير لحظة خاطفة، أنجز فيها مهمته بأسرع من لمح البصر، ثم انطلق بعدها يتابع جولته المرسومة فى لوح القدر لحصاد الآجال، بعد أن ترك بصمته على ركن دارنا، وأسدل قناعه الحزين على الجسد الراقد، ملاءة رقيقة بيضاء، ما أهونها حاجزًا بين الموت والحياة، وإن لم يعرف الأحياء ما يدانيها كثافة وصلابة وغلظًا وثقلًا».

«وأتتبع المشهد حتى نهاية الرحلة بمقبرة القرية، فى الحفرة التى لبثت هناك مفتوحة تنتظر، ريثما واروا فيها جثمانه الدافئ، ثم سدوها بحفنة من طين وحصى ورمال، هى كل ما بينى وبينه حين ألم به زائرة، وهيهات هيهات المزار».
«أستعيد هذا كله، وأستحضره وأسترجعه بيقظة واعية، فأترنح على الجسر ضائعة الحيلة مبعثرة الخواطر ممزقة الرؤى، ويختلط فى سمعى صدى النعى المصمى بنجوى الطيف الماثل، وتمتزج فى صدرى ريح العدم، بعبير الأنفاس الطيبة للراحل المقيم، ويتصادم فى وجدانى نشيج الباكين وأنين المحزونين، وتأبين الراثين ودعاء المعزين، بإيقاع النغم الشجى الساحر للصوت الحبيب، وتتزاحم على الأفق من حولى مواكب المشيعين والمودعين، متداخلة فى مشاهد حركاته ولفتاته، وجولات نضاله ومواقف بطولته ومجالس أستاذيته وندوات مدرسته، وتتماحى الحدود والفواصل بين الحاضر المفجع، والماضى السعيد الحافل، والعد المحجب فى ضمير الغيب، المطوى فى غيابة المجهول، وتتداخل الأبعاد والآماد، حيث أقف على الجسر ما بين الحياة والموت».
«وما باختيارى أن تبطئ خطواتى عليه، ولا بإرادتى تخلفت عمن عبر، ولا علم لى بموضع قدمى فى الخطوة التالية، قصارى ما أعلمه هو أن {كل نفس ذائقة الموت}، {وما تدرى نفس ماذا تكسب غدًا وما تدرى نفس بأى أرض تموت}...».
«وإلى أن يحين الأجل، سأظل معلقة بين الحياة والموت، لا أدرى إلى أيهما أنتمى، وعلى أيهما أحسب؟ وملء مسمعى صدى النعى مختلط بنجوى الطيف الماثل، وعلى دربنا المتألق بنور حبه وكرم سجاياه، تلوح بصمة الزائر الرهيب الذى تسلل إلى دارنا خفية فى وضح النهار، فلم يتلبث غير لحظة خاطفة، ثم مضى عنا إلى حين، وفى أرجاء دنيانا التى تزدهى بملامحه وتزهو بآثاره وتتشبث بذكراه، تبدو معالم الجسر المارد العجيب الممتد بين الوجود والعدم، يتحدى أعتى القوى وأمنع الحصون، وتتطاول أبعاد فتطوى الآفاق من بر وبحر وهواء وفضاء، وإن بدا للغافلين من تهاويل الأحلام وأفانين الوهم والخيال».
«إلى أن يحين الأجل سأبقى محكومًا علىّ بهذه الوقفة الحائرة على المعبر، ضائعة بين حياة وموت، أنتظر دورى فى اجتياز الشوط الباقى، وأردد فى أثر الراحل المقيم: عليك سلام الله إن تكن عبرت إلى الأخرى، فنحن على الجسر».
قسمت عائشة عبدالرحمن كتابها طبقًا لحياتها على خريطة أمين الخولى، فلم يكن ما عاشته قبل أن تلتقى به، كان عمرها وقتها ٢٣ عامًا، من مواليد ٦ نوفمبر ١٩١٣، إلا تمهيدًا لأن تلتقى به وحده.
فى عام ١٩٦٦ عندما كتبت بنت الشاطئ قصتها مع أمين الخولى، أفاضت فى التفاصيل، ورغم ذلك لم تقل كل شىء.
ما رأيكم أن نمضى معها فى رحلتهما معًا مرة أخرى، ونتركها تتحدث دون تدخل منا إلا فيما ندر وكلما تيسر.
تحكى عائشة من جديد.
فريق من زملائى تحدونى أن أستغنى عن كلمة واحدة من دروس الأستاذ الخولى فى البلاغة والتفسير، على مدى السنوات الأربع، فكنت أدارى شعورى بالرثاء لضعفهم، وأقابل تحديهم بنوع من الاستخفاف، وكنا فى السنة الأولى، نحضر مجتمعين فى المدرج الكبير، كل المحاضرات المقررة علينا فيما عدا اللغة العربية واللغات الإنجليزية والفرنسية واللاتينية، التى توزعنا فيها أقسامًا فى محاضرات خاصة.

ولم يكن من حظى أن أتتلمذ على الأستاذ الخولى فى السنة الجامعية الأولى، لكن زملائى الذين درسوا عليه، ومعهم كل طلاب قسم اللغة العربية، لم يكونوا يملون الحديث عنه، والشكوى من صرامة منهجه وجبروت شخصيته، وقسوة مؤاخذاته على أى خلل فى المنطق أو خطأ فى التفكير أو قصور فى التعبير، فأتمنى لو أن ظروفى أسعفتنى على حضور دروسه، كى أبهر هؤلاء الطلاب بما تصورت، لفرط سذاجتى وغرورى، أننى بلغته من علم أستاذهم الكبير.
لقد حضرت عددًا من المحاضرات الجامعية فى النحو والعروض والأدب والتاريخ الإسلامى، فما وجدت قط جديدًا لم أكن قد تعلمته فى مدرستى الأولى بالبيت، وتفضل الأستاذ الجليل مصطفى السقا فأعفانى من حضور درسه فى النحو والصرف، لما رأى من تفاوت مستواى عن بقية المجموعة التى كان يدرس لها، كما رحب الدكتور حسن إبراهيم حسن بعذرى فى التخلف عن محاضراته بسبب ظروفى القاسية، بعد أن حضرت له درسين جرؤت فيهما على تصحيح آيات من القرآن الكريم كانت تتلى من كتاب السيرة على غير وجهها الصحيح فى التلاوة، معتذرة بحرمة كلمات الله، عن جرأتى فى رد أى خطأ فى قراءتها.
فماذا عسى الأستاذ الخولى أن يقدمه لى فى البلاغة والتفسير، وقد تلقيتهما على شيوخ كبار من علماء هذه البضاعة، وقيل لى: إنه صاحب منهج.
هززت رأسى فى غير مبالاة، وكلمة المنهج لا تعدو عندى أن تكون تسمية محدثة لما درجنا على تسميته بالمذهب أو الطريقة، ومبلغ علمى أن كل شيخ له طريقة، وإنما يتفنن غيرى من الطلاب بكلمة المنهج الرنانة الفخمة، لأنهم لم يقرأوا شيئًا لشيوخ البلاغة وأعلام المفسرين الذين طالت صحبتى لهم فى كتبهم التى يعيى طلاب الجامعة أن ينظروا فيها.
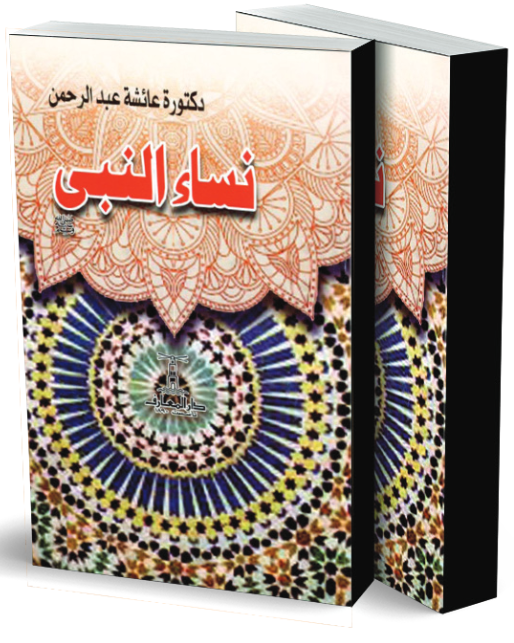
وكنت فى المرات القليلة التى ترددت فيها على الكلية خلال العام الأول، ألمح الأستاذ الخولى من بعيد بين حين وآخر، فى ردهات الكلية وأبهائها، بزيه اللافت وسمته المهيب وملامحه المتفردة، يحف به دائمًا عدد من تلاميذه شبه مسحورين، وقد أخذوا معه فى حوار متصل، فلا أتصور بحال أن هذا الأستاذ غريب عنى، وأظل أفكر طويلًا: أين ومتى يا ترى لقيته من قبل؟
ثم لا أجد تعليلًا لهذا الشعور الواثق من سبق معرفتى به، إلا أن أفترض أنه ينتمى إلى بيئة كتلك التى أنتمى إليها، وقد وصل مثلى إلى الجامعة، عن غير طريقها المباشر، ويقينى بأن علمه الذى بهر الطلاب فى الجامعة، مستمد من نفس النبع السخى الذى طالما نهلت منه حتى خيل إلى أنى ارتويت.
وأملى لى الزمن عامًا بأكمله، سادرة فى أوهام غرورى بما عندى من بضاعة القوم، مباهية بقديمى الأصيل الذى ما تصورت أن الأستاذ الخولى يمكن أن يضيف إليه جديدًا من عنده، ماضية فى طريقى إليه، وما أرتاب فى أنى عرفته من قبل أن ألقاه.
لا أزال أكتب من بعيد، مطلة من وقفتى على الجسر، على أثار خطاى قبل أن ألقاه، إذ أغذ السير فوق دربى، عبر المفاوز الحرجة والمنحنيات الخطرة، فى طريق تائه المعالم خابى المنارات، بغير زاد إلا الهواجس والمخاوف والظنون.
وبغير دليل إلا اليقين بأنى أسير موجهة بمشيئة عليا، اصطفتنى لتجربة صعبة تمتحن بها طاقتى على الصمود والاحتمال، وتبلور مدى استعدادى لاجتلاء السر المحجب المضنون به على غير أهله.
ولم أستبعد بعد عامى الأول فى الجامعة، أن تكون تلك التجربة هى أن أتعرض لما يخشاه قومى من فتنة الجامعة وغوايتها، ابتلاء لجلاء بصيرتى وقدرتها على التمييز بين الجوهر والعرض، لأعود فأسلك طريق الحق، أرهف حسًا وأصفى وجدانًا، وأقدر على احتمال ما يكابده أهل الطريق من مشاق الرياضة وتكاليف المجاهدة، وكنت حتى تلك المرحلة، أتعامل مع الدنيا بمنطق بيئتى المتصوفة وأتلقى العلم بعقليتها، وأمارس الحياة بذوقها ومزاجها، وأفسر الوجود بمنهجها الإشراقى المهم.
قررت أن أكشف ما عند الأستاذ أمين الخولى من علم يتحدانى طلاب قسم اللغة العربية أن أستغنى عن كلمة واحدة منه، وأن أفرغ من هذه الشخصية الأسطورية التى أخذتهم أخذ السحر وتسلطت عليهم بجبروتها الآسر.
انتظرت موعدى معه لألقاه فى درسه الأول بالسنة الثانية، وهاجس خفى يلقى فى يقينى أنه اللقاء الحاسم الذى تتم به التجربة، ويبدأ منه انطلاق خطواتى على معارج الطريق الواصل إلى الحق، بعد أن تنجاب عن الأفق سحب الوهم وتتكشف الظلال.
فى انتظار الموعد المرتقب، عكفت طوال أشهر الصيف على مراجعة ما فى خزانة بيتنا من كتب علوم القرآن والبلاغة استعدادًا للقائه، وقد زين لى الغرور أننى باستيعاب تلك الكنوز، أكون ندًا لهذا الأستاذ الذى حسبته بهر تلاميذه بما نهل من نبعنا الذى حجبوا عنه.
حاولت ألا أشغل نفسى بالذى سمعته من اتصال الأستاذ الخولى بالثقافة الحديثة، فى رحلته الطويلة إلى بلاد الإفرنجة.
لمحت الأستاذ الخولى يتحدث إلى عدد من تلاميذه تحلقوا حوله يصغون، فدنوت منه أسمع ما يقول، وكانت دهشتى بالغة حين ميزت فى صوته العميق نبرة مألوفة، جعلتنى أفكر متسائلة: أين ومتى يا ترى سمعت هذا الصوت؟
نفس السؤال الذى طالما رددته فى خاطرى كلما لمحت هذا الأستاذ من بعد، فلم أشعر أنه غريب عنى، وانثنيت أفكر، أين ومتى يا ترى لقيته من قبل؟
وشدتنى كلماته النافذة المنطلقة، قريبًا من منطقة الضوء، وكان الطلاب الذين تحلقوا حوله يحاورونه فيما يقول، لكنى لا أذكر أنى وعيت كلمة مما قالوا، بل كان همى أن أصغى إلى صوته القوى المسيطر وهو ينفذ إلى أعماق وجدانى وضميرى، فيكشف عن بصيرتى عطاء الغفلة والوهم والغرور.
وحين همّ الأستاذ بالانصراف، سأله سائل من طلاب فرقتى عن موعد درسه الأول لنا، فكان جوابه: ليكن الموعد فى مثل يومنا هذا من الأسبوع المقبل، ثم استطرد موضحًا: أحسبه السادس من نوفمبر، وأذهلتنى المفاجأة، فما تمالكت أن رددت بصوت خلته مسموعًا: السادس من نوفمبر؟ واعجبا، إنه يوم مولدى.
لكن الجمع قد انفض، فانصرفت لحالى، وأنا لا أكف عن التفكير فى ذلك الموعد العجيب الذى اختاره القدر للقائنا، دون بقية أيام السنة وعددها ثلاثمائة وستة وستون يومًا، وأعيانى أن أريح نفسى بافتراض أن الأمر لا يعدو أن يكون محض مصادفة، فما كان منطق بيئتى المتصوفة ليسمح لى بهذا الافتراض، وهو منطق يرفض القول بالمصادفة رفضًا حاسمًا، ويرد الأمر فيها إلى مشئية عليا تحكم ما يبدو للخلق، من قبيل المصادفات العشواء.
أخذت مكانى فى قاعة الدرس بالجامعة، متحفزة للجولة، ومستجمعة كل رصيدى المتضخم من زهو الطموح وإرادة التفوق، ومتأهبة لعرض بضاعتى التى تزودت بها من مدرستى الأولى فى تحد واثق من النصر.
دخل الأستاذ الخولى بسمته المهيب المتفرد، فألقى علينا التحية، واقترح لكى نتعارف أن يعرض علينا مباحث المادة المقرر علينا درسها من علم القرآن، ولكل طالب بأن يختار مبحثًا منها، ويعرضه للمناقشة فى الوقت الذى يحدده.
وبادرت فأعلنت اختيارى للمبحث الأول فى «نزول القرآن»، وعندئذ سرت فى القاعة همهمة ساخرة من هذه المبادرة الحمقاء، فتوقعت أن يحسمها الأستاذ بالمشهور من جده وصرامته، لكنه لم يلق لها بالًا، واستطرد يعرض بقية المباحث، وأنا أتشاغل عن غيظى المكتوم، بالتفرج على عدد من الزملاء، فى صراعهم المكشوف على المباحث الأخيرة إرجاء للموقف الصعب.
وعاد الأستاذ يسأل كل طالب منا، عن الوقت الذى يحتاج إليه فى إعداد بحثه، فأجبت فى عناد وشموخ: يكفينى يوم أو بعض يوم.
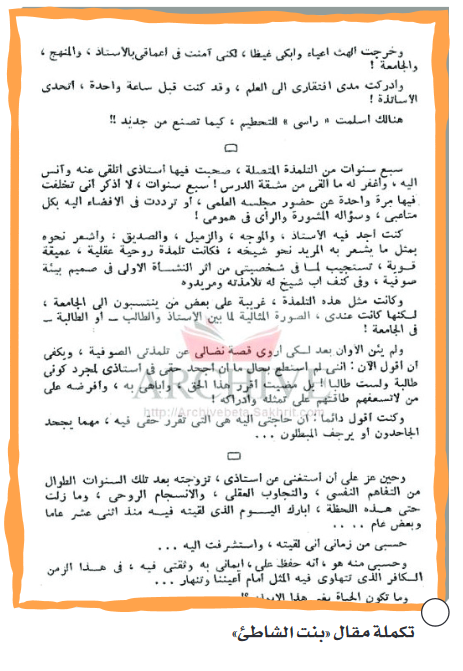
قال فى نبرة إشفاق وتحذير: كذا.. فكرى مليًا، فربما بدا لك أنك فى حاجة إلى مزيد من الوقت.
وأبيت أن أتراجع.. ولماذا أتراجع؟ ومبلغ علمى أن المادة مبذولة جاهزة، ومصادرها الأصيلة فى متناول يدى، فلن يحتاج الأمر معى إلى أكثر من بضع ساعات للمراجعة، وبضع ساعات أخرى للتنسيق والكتابة، ولم يفتنى أن الأستاذ يرانى تورطت فى هذا التعجل، فكأنى خشيت أن يأخذ عنى فكرة خاطئة، فقلت أسأله مدلة بما أملك من ذخائر علمه: هل يمكن أن أراجع فى موضوعى بكتاب «البرهان» للبدر الزركشى، وكتابى «الإتقان واللباب» لجلال السيوطى، مع الاستئناس بالسيرة الهاشمية، وطبقات ابن سعد، وتفسير ابن جرير الطبرى؟
أجاب: كتاب واحد يكفى الآن.. لو أنك عرفت حقًا كيف تقرئين.
كان هذا آخر ما توقعت أن أسمع منه ما قاله، ألمثلى يقال ذلك؟ وما من كتاب من أصول العربية والإسلام يعيبنى أن أقرأه، وكبحت غضبى وأنا ألتمس للأستاذ العذر، فلعله يتصور أننى كغيرى من الطلاب، وفيهم حقًا من لا يعرف كيف يقرأ، فما قلت هذه الكتب إلا لأننى قرأتها واستوعبت ما فيها، وإنما كان سؤالى عن مصادر أجنبية، ظننت أن الأستاذ قد يضيفها إلى مراجعى.
فما زاد على أن قال: لو أدركت الفرق بين المصادر والمراجع، لما تورطت فى مثل هذا السؤال المنكر.
وتحيرت لا أملك سؤالًا ولا ردًا، فما كنت حتى تلك اللحظة قد فكرت فى التمييز بين المصدر والمرجع، وتابعت الإصغاء إلى الأستاذ، وهو يلقى علينا مبادئ منهجه، حريصة على ألا تفوتنى كلمة واحدة مما يقول، وبجهد مرهق تشاغلت عن عالمى النفسى المائج بشتى الخواطر لأعى ما أسمع، ولا شىء يزعجنى غير دقات ساعة الجامعة، معلنة عن سير الزمن.
من ذلك اللقاء الأول ارتبطت به نفسيًا وعقليًا، وكأنى قطعت العمر كله أبحث عنه فى متاهة الدنيا وخضم المجهول، ثم بمجرد أن لقيته لم أشغل بالى بظروف وعوائق، قد تحول دون قربى منه، فما كان يعنينى قط، سوى أنى لقيته، وما عدا ذلك ليس بذى بال، وقد انصرفت من درسه الأول فى اليوم السادس من نوفمبر عام ١٩٣٦ وأنا أحس أنى ولدت من جديد.
حين وقفت بعد أسبوع أؤدى أمامه امتحانى الأول، لم أصمد سوى دقائق معدودات، أقررت بعدها أن حصيلتى من كنز الثقافة الإسلامية الذى حسبت أنى ملكته لا تعدو القشور والأصداف، وأن بينى وبين ذخائره المكنونة حجبًا وأرصادًا تحول دون النفاذ إلى الجوهر واللباب.
انتهت المرحلة الجامعية الأولى، ولم يبق لى من زهو الطموح إلا إدراكى لحاجتى إلى أن أتعلم، وتطلعى إلى أن أظل ما عشت تلميذة لهذا الأستاذ الذى علمنى كيف أقرأ، ولم يبق لى ما أعتد به فى مجال التنافس العلمى مع زملائى الطلاب، إلا أن أباهى بما أعلم من قصورى عن بلوغ مدى الأستاذ الخولى، حين يظن ظانون منهم أن التلمذة عليه بضع سنوات، قد تعطيهم مفاتيح علمه، وتبيح لهم أسرار درايته.
لقد ظننت حينًا أننى ما أكاد أصل إلى مرحلة الدراسة العليا حتى يهون الأمر على، إذ يصير لى حق اختيار المجال الذى أتخصص فيه وأفرغ له، غير أنى ما لبثت أن أدركت أن تلمذتى للأستاذ الخولى جعلت مما فات من مصاعب الطريق، أهون من أن تقاس بما أستقبله منها.
كنت أشعر بالأستاذ الخولى معى، فى كل ما أقرأ وما أكتب، فأخضع بهذا الشعور لرقابة عسيرة من صرامة منهجه وجبروت منطقه، فأطيل الوقوف عند كل كلمة، حتى ألمح سرها، وعجبت حين سمعته يؤكد لى أننى سأظل مرجوة طالما بقى لى شعورى بالقصور وإدراكى لمشاق الطريق، وأحسبه ذكر لى فى تلك المناسبة ما وعى الإمام مالك بن أنس من وصية شيخه هرمز: ينبغى أن يورث العالم جلساءه قول: لا أدرى.. فإن العالم إذا أخطأ أصيبت مقاتله.
وحين أفضيت إليه بأننى فى ريب من إمكان الوصول ببحثى إلى غايته، كان جوابه الذى ظل ملء مسمعى على طول المدى: ومن قال إن الطالب يستطيع أن يصل بالبحث إلى غايته؟ إننا نعيش العمر كله طلاب علم، كادحين إلى ما نستشرف له فى كل خطوة من جديد الآفاق والغايات، وما من بحث يمكن أن يقول الكلمة الأخيرة فى موضوعه، وجهد الطالب لا يقاس بمدى ما قطع من أشواط، وإنما يقاس بسلامة اتجاهه، ولو لم يقطع سوى خطوة واحدة على الطريق الطويل الممتد إلى غير نهاية ولا مدى.
وهكذا كنت أجد لديه لكل معضلة حلًا ولكل سؤال جوابًا، فأشعر بالرضا عن نفسى إذا لم يخنها صدق الإلهام وسلامة الفطرة، فاتجهت إلى من أحس كلما لقيته أننى أولد من جديد، وأحس كلما جلست إليه وحضرت درسه أن عالمى يرحب حتى لتضيق الدنيا عن أن تتسع له.
وكان من الغريب حقًا أننى حين فتحت قلبى وعقلى للجامعة، عن يقين واثق بأن لديها ما تقدمه من جوهر العلم ومنهج المعرفة، واجهتنى أزمة من عجز البيئة الجامعية عن فهم معنى التلمذة العلمية، بحيث اضطرتنى إلى أن أخوض معها معركة عنيفة، لكى أفرض عليها تلمذتى للأستاذ الخولى دون أن تكون مستعدة لقبولها.
كانت البيئة الجامعية تنظر إلى هذه القضية، من حيث هى علاقة شخصية أو ظاهرة عارضة مألوفة، على حين كنت أنظر إليها من حيث هى قضية مبادئ خلقية وقيم علمية، وكرامة عقلية، فكان صراعًا طويلًا مجهدًا، احتسبت كل أذى فيه امتحانًا لأهليتى لما تعلقت به وطمحت إليه، وجهادًا فى سبيل ما آمنت أنه حق وواجب.
وآن لى بعد تلك الرحلة الشاقة أن أعرف جواب ما طالما سألت عنه: أين ومتى يا ترى لقيته، وسمعت صوته من قبل؟
فمنذ قابلته تجلى لى السر المحجب الذى حيرنى أمدًا طويلًا، وكانت مجاهدتى الصعبة سعيًا دائبًا لكى أصل إلى مرتبة الكشف التى يفنى أهل الحقيقة أعمارهم فى سبيل الوصول إليها.
فقد آمنت منذ اللحظة الأولى للقائنا، بأنه اللقاء الذى تقرر فى ضمير الغيب منذ خلقنا الله من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وإن عدتنا الدنيا اثنين فى الحساب الرقمى والواقع العددى اثنين لكل منهما اسمه ونسبه ولقبه وصفته وصورته وعمله وشخصيته، وبهذه الثنائية العددية يتعاملان مع الدنيا والناس، ولكنهما فى جوهر حقيقتهما واحد لا يتعدد، لا كما تخيلت الأساطير عن النفس والقرينة، ولا كما تغنى الشعراء بالروح الواحدة فى جسدين، ولا كما تمثل الصوفية رؤية الفنان فى ذات الحبيب، ولا كما تأمل الفلاسفة فى وحدة الوجود، ولا كما تحدث العلماء عن الخلية الواحدة قبل أن تنقسم، وإنما هو سر وراء ذلك كله، تجلت فيه آية الله الذى خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها.
وكنا أحيانًا نفترق، يذهب كل منا إلى عمله أو يسافر فى بعض شأنه، وقد يمضى أحدنا إلى أقصى المشرق والآخر إلى أقصى المغرب، لأن الدنيا لا تعرف إلا أننا اثنان، والحياة تفرض علينا أن نعاينها بهذه الثنائية العددية ورغم هذا، كنا النفس الواحدة، وذلك ما أعيا الدنيا ويعيبها أن تفهمه أو تتصوره وتتمثله، إلا أن تحسبه من رؤى الشعراء الحالمين أو مواجد الصوفية العاشقين، ويعيى منطقها أن يفسره، إلا أن يقول إنه من تآلف القلوب واندماج النفوس وتعانق الأرواح وراء عالم الواقع ومقاييس المادة ومنطق الحس وأبعاد المنظور.
وكنا أحيانًا نتخاصم، وربما مرت علينا فترات مغاضبة يحسبها أهلونا وأصدقاؤنا من لهفة الحب ودلال العاشقين، ويلمح فيها أرهفهم حسًا وهج الضرام المتوهج فى أعماقنا يتلمس متنفسًا، دون أن يتصور أحدهم أن المخاصمة أو المغاضبة، ليست إلا صراعًا حتميًا بين جوهرنا الواحد، وبين الثنائية المزدوجة التى يفرضها علينا واقع الحياة وأوضاع الدنيا.
ومضى العمر كله وما كففت عن التساؤل: أكان يمكن أن أضل طريقى إليه، فأعبر رحلة الحياة دون أن ألقاه؟
وحتى آخر العمر لم يتخل عنى إيمانى بأنى ما سرت على دربى خطوة إلا لكى ألقاه، وما كان يمكن أن أحيد عن الطريق إليه، وقد عرفته فى عالم المثل ومجال الرؤى وفلك الأرواح، من قبل أن أبدأ رحلة الحياة.
هل من سبيل إلى أن أستبقى تلك الرؤى الباهرة لمسعاى إليه ولقائى به، لتؤنس وحشة الفراق إلى أن يحين الأجل فألحق به ويلتئم الشمل مرة أخرى فى عالم الروح، أسفًا.. كل ما مضى انتقل إلى منطقة الأحلام، فلا سبيل إلى استرجاعه إلا فى غفوة مختلسة لا تلبث أن تبدد بيقظة مروعة تسلمنى إلى قبضة الواقع، حيث المشهد الفاجع فى قصتنا التى كانت أسطورة الزمان.
لقد مضى وبقيت.
حاولت أكثر من مرة أن أتداخل مع رواية عائشة عبدالرحمن شبه الكاملة عن حبها وارتباطها بأمين الخولى، لكننى فى كل مرة كنت أتردد من باب الحياء، فكيف لمثل هذه القصة الرائقة أن يعترض طريق تدفقها أحد.
لكن ولأنها قالت ما لديها، فإننا يمكن الآن أن نتداخل معها عبر عدة هوامش.
الهامش الأول يخص المواجهة الأولى بين عائشة عبدالرحمن وأمين الخولى، فما لم تقله لنا إنها عندما بدأت عرضها لبحثها عن نزول القرآن قالت: أنا أرى، فاستوقفها الخولى، وقال لها: هل فى العلم مجال للرأى؟
وجدت عائشة نفسها فى حرج بالغ، فحاولت أن تخفف من وطأة ملاحظته، فقال: هذا مجرد مدخل للكلام.
لم يتركها الخولى وشأنها، ولكن زاد على إحراجه لها بقوله: من غير «كوريدور».. ادخلى فى الموضوع مباشرة.
كانت هذه نقطة مهمة فى العلاقة التى ربطت بين عائشة وأمين، جعلتها تدرك صورته باكتمال مطلق، ورغم حرج الموقف البالغ، فإنها تمسكت بها، وقررت أن تصل إلى أبعد ما يتخيل أستاذها وزملاؤها من الطلبة.. وهى أن تكون زوجة له.
أما الهامش الثانى فنجده فيما كتبه رجاء النقاش.
بعد وفاته– فبراير ٢٠٠٨- صدر لرجاء النقاش أكثر من كتاب، كان قد أعدها وجاهزة للنشر، من بينها كتابه «أجمل قصص الحب فى الشرق والغرب» الذى صدر عن سلسلة كتاب اليوم.
فى هذا الكتاب فك النقاش لغز ما قالته بنت الشاطئ مضمرًا ومخفيًا، فقد أشارت إلى أن البيئة الجامعية لم تقبل بسهولة قصة حبها لأمين الخولى الذى كان يكبرها بـ١٨ عامًا– مواليد ١٨٩٥– وأنها جاهدت لتتجاوز عوائق وعقبات هذه البيئة حتى تفوز بمن تحب.
يقول النقاش: أحبت بنت الشاطئ أستاذها فى الجامعة أمين الخولى الذى التف حوله كثير من التلاميذ والمريدين، وكان أستاذًا فى كلية الآداب بجامعة القاهرة، وهو إحدى قمم الفكر والثقافة فى مصر حينئذ، وصاحب الصالون الأدبى والفكرى الشهير بـ«مدرسة الأمناء»، وهذا الحب كان سببًا للثورة على بنت الشاطئ، ومن أجله تحملت الكثير من النقد القاسى والمقاطعة التى أصر عليها بعض المقربين منها.
ويشرح النقاش ما جرى: تعرضت عائشة لضغوط كثيرة للتخلى عن حبها، ولكنها تمسكت بهذا الحب، خاصة بعد أن بادلها أستاذها حبًا بحب، وقد انتهت قصة الحب بالزواج، وكان الخولى متزوجًا، فرضيت أن تكون زوجة ثانية، مع حرصهما أن تكون الزوجة الأولى فى أكرم وضع، وأن تحتفظ بكل حقوقها.
ويؤكد النقاش: لم تمر قصة الحب بينهما بسلام، فقد كانت موضوعًا للشائعات الكثيرة التى أراد بها بعض المنتقدين أن يسيئوا إلى بنت الشاطئ وزوجها، فقد ظنوا أنهم وجدوا فرصة نادرة للتشهير به والإساءة إليه من خلال قصة حبه بتلميذته، فقد ظنوا فى أول الأمر أن الشيخ يلهو بتلميذته ويستغل إعجابها الشديد به، ولكن المعركة انتهت بعد أن تزوجا.
ما يمكننا أن نأسف له أن أمين الخولى لم يتحدث عن غرامه بتلميذته، وأن عائشة عبدالرحمن اختارت أن تتحدث بالتلميح لا بالتصريح، فقد تحملت ما قيل عنها، وما تعرضت له من ضغوط، واكتفت بأن تغزلت فى زوجها هذا الغزل العفيف الذى يترجم ما ذهبت إليه من أن قصتها مع الخولى كانت أسطورية لن يجود بها الدهر مرة أخرى.
أما الهامش الثالث والأخير، فأعود بكم من خلاله إلى كتابها «نساء النبى».
فقد أهدت الكتاب إلى أمين الخولى بقولها: إلى رائدنا مجدد الفكر الإسلامى الأستاذ أمين الخولى فى قلوبنا وضمائرنا وعقولنا.
وقبل أن تتحدث عن زوجات الرسول تحدثت عن النبى الزوج، قالت: الفصل بين شخصيته زوجًا رجلًا، وشخصيته نبيًا رسولًا جد عسير، فلم تنزع الرسالة من قلبه عواطف البشر، ولا جردته من وجدانهم، ولا عصمته مما يجوز عليهم فيما عدا ما يتصل بالنبوة، فهو كما قال جل جلاله «قل إنما أنا بشر مثلكم» يسكن إلى زوجه، ويشغل بالأبناء، ويعانى مثل الذى يعانيه بنو آدم من حب وكره، ورغبة وزهد، وخوف وأمل، وحنين واشتياق، ويجرى عليه ما جرى على سائر البشر من تعب ويتم وثكل ومرض وموت.
لا أستطيع أن أفصل ما قالته عاشة عبدالرحمن عن الرسول الزوج عما وجدته عند زوجها أمين الخولى، فهى لم تكتب عن النبى مع زوجاته بكل هذا الحب إلا لأنها عاشت فى كنف زوج عاشق لها.. كما كانت هى له عاشقة.









