مـاذا يقرأ الفرنسيون الآن؟
أرض الله المفضلة.. لماذا يعيش الفرنسيون شغفًا لا ينتهى بـ«أم الدنيا»؟

فى مذكراته الأخيرة، اعترف نابليون بونابرت بأن أجمل أيام حياته قضاها فى مصر، رغم أن فترة إقامته لم تتجاوز عامًا وأربعة أشهر. وفى الجزء المعنون بـ«Mémoires: La Campagne d’Égypte 1798- 1799» أو «مذكرات الحملة إلى المصرية 1798- 1799»، قال القائد الفرنسى إنه كان يردد دومًا أثناء حملته: «أنا فى حماية النبى»، فى تعبير صريح عن ارتباط وجدانى عميق تشكّل بينه وبين هذه الأرض.
وربما لم يكن «نابليون» استثناءً، فذلك الشعور الذى اختبره ما زال يتجدد لدى الفرنسيين جيلًا بعد جيل، كما بدا جليًا فى جولة الرئيس إيمانويل ماكرون بين أزقة خان الخليلى والجمالية، حيث تماهى المشهد بين زحام الأمكنة وروحانيتها، بالقرب من مقام الإمام الحسين ومقامات آل البيت.
وقبل عام، تساءلت قناة «France Info»، فى تقرير مصوّر، عن سر هذا الشغف، قبل أن تجيب أن العلاقة تبدأ مبكرًا داخل الصفوف الدراسية من خلال دروس التاريخ، مشددة على أن الانبهار الفرنسى بمصر ليس لحظة عابرة، بل افتتان متجذر يصعب أن يخبو.
بعد أيام من زيارة «ماكرون» التى استأثرت باهتمام عالمى كبير، تفتح جريدة «حرف»، عبر زاوية «ماذا يقرأ العالم الآن؟»، نافذة على أبرز الإصدارات الفرنسية الحديثة التى تناولت مصر خلال الثلث الأول من العام الجارى، وهى: «مصر حبيبتى» من تأليف كريستيان جاك، الروائى وعالم المصريات الشهير، و«أم كلثوم» للصحفيتين والكاتبتين آن جوف وجيسى ماجانا، و«العلم والملفات الغامضة لمصر القديمة» لفرانك مونيه، المتخصص فى مجال البناء والهندسة المعمارية فى مصر القديمة، وأخيرًا «الأدب المصرى القديم» من تأليف برنارد ماثيو، أستاذ علم «المصريات» فى جامعة «بول فاليرى».
كريستيان جاك: مصر ليست مجرد دولة بل حالة وجودية لا مثيل لها

صدر كتاب «Égypte mon amour, le voyage d’une vie» أو «مصر حبيبتى: رحلة العمر»، فى ١٣ مارس الماضى، عن دار النشر الفرنسية المرموقة «XO Éditions»، التى تُعرف بسيطرتها على قوائم الكتب الأكثر مبيعًا فى فرنسا، وشكّلت إصداراتها نحو ٧٥٪ من تلك القوائم، وهى الدار نفسها التى نشرت كتاب «Révolution» أو «الثورة» للرئيس الفرنسى الحالى إيمانويل ماكرون.
الكتاب الجديد من تأليف كريستيان جاك، الروائى وعالم المصريات الشهير، أحد أكثر المؤلفين الفرنسيين قراءة على مستوى العالم، ولطالما شكّلت مصر محورًا أساسيًا فى جميع أعماله، التى أصبحت فى معظمها من الكتب الأكثر مبيعًا.
فى كتابه الجديد، يبوح «جاك» برغبة دفينة فى مشاركة القراء بدايات وأسرار حبه لمصر، ذلك الشغف الذى يعتبره رحلة العمر بحق، كما يشير العنوان الفرعى للكتاب. وفى ٢٠١ صفحة، يشرح المؤلف لماذا وصف إقامته فى مصر بأنها رحلة العمر، مُستشهدًا بالمحبة العميقة التى لمسها فى قلوب أهلها، والمغامرات التى لا تُنسى، والروحانية الغامضة التى تتغلغل فى أركانها، واصفًا إياها بأنها «أرض الآلهة المحبوبة»، مضيفًا: «يأتى هذا الكتاب تكريمًا لتلك القوى الخفية التى أشعر بأنها ما زالت حاضرة، وأريد أن آخذ القراء معى فى هذه التجربة الخاصة».
«جاك» الذى عُرف بأنه أهم الخبراء الفرنسيين فى حضارة مصر القديمة، يُمكّن قراءه من استكشاف التاريخ والبطولات والروح الكامنة وراء عجائب تلك الحضارة من خلال رواياته وقصصه.
ويُبرز فى الكتاب كيف أن المصريين القدماء كانوا يعتبرون الحب طاقة تُبنى حولها الأهرامات، ليُصبح بذلك مفهومًا روحيًا متكاملًا، مشيرًا إلى أن مصر القديمة لم تكن مجرد دولة، بل حالة وجودية فريدة.
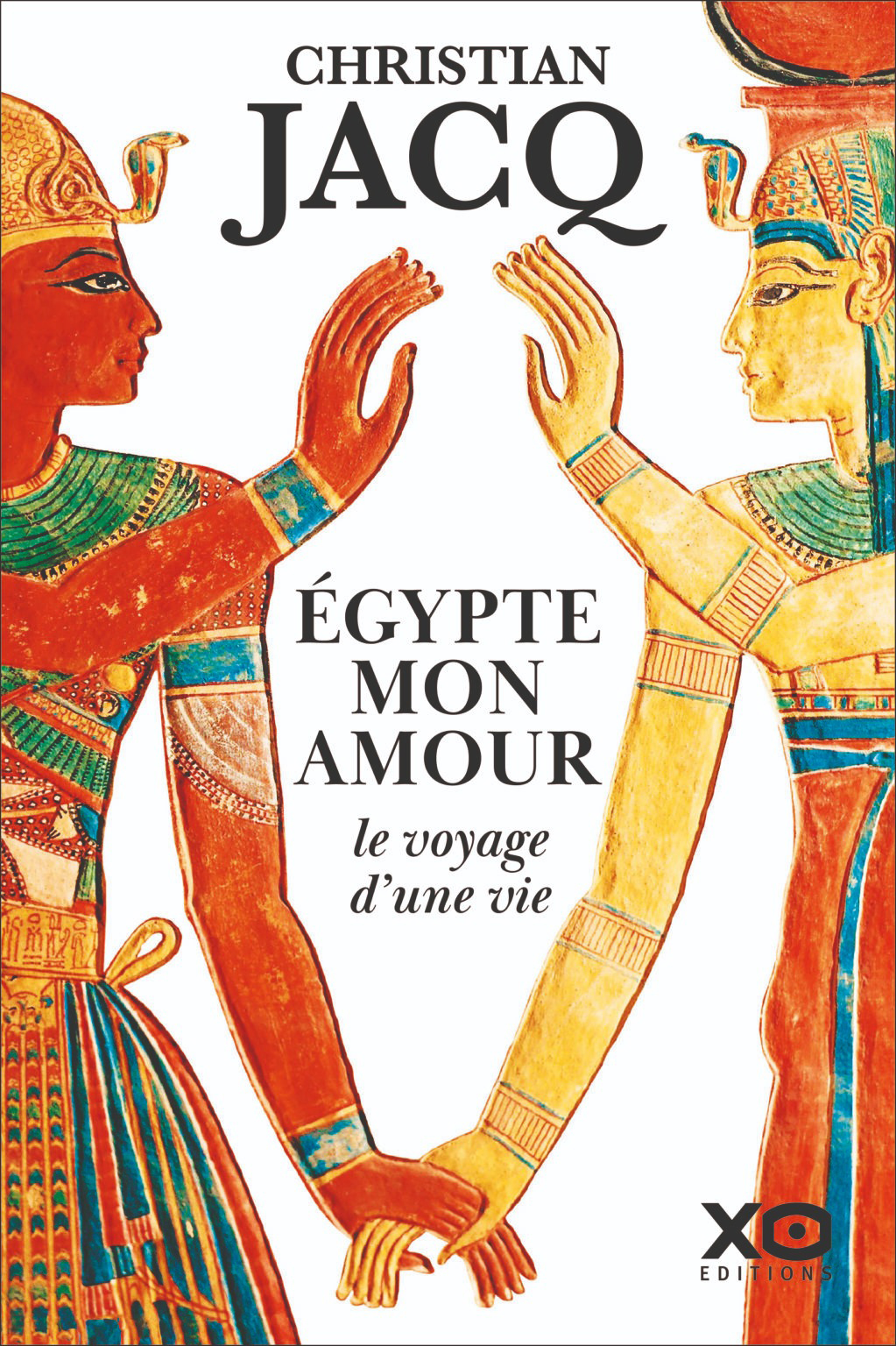
ويسترجع المؤلف تفاصيل علاقته الأولى بمصر، حين كان فى الثالثة عشرة من عمره عام ١٩٦١، ووقع بين يديه بالمصادفة كتاب عن حضارة مصر القديمة للمؤلف البلجيكى جاك بيرين، لتكون تلك اللحظة نقطة تحوّل فى حياته، وفى تلك السن المبكرة، بدأ كتابة الشعر والروايات، وتمكن من تأليف ٨ روايات فى ٥ سنوات، إلى جانب نص أوبرالى.
وعندما بلغ السابعة عشرة، تزوج وسافر مع زوجته الشابة فى رحلة «شهر عسل» إلى مصر، فى مغامرة كانت حلم حياته. كانت محطته الأولى فى «ممفيس»، حيث التقى بتمثال ضخم مستلقٍ للملك رمسيس الثانى، فى لحظة وصفها بأنها كانت اللقاء الأول الحقيقى مع مصر.
وفى الحادية والعشرين، أصدر كتابه الأول حول الروابط بين مصر القديمة والعصور الوسطى، ثم غيّر مساره الأكاديمى من الفلسفة إلى علم المصريات، ليتخرج من جامعة «السوربون» بدرجات علمية متقدمة، وصولًا إلى الدكتوراه، التى خصص أطروحتها لموضوع «رحلة إلى العالم الآخر وفقًا لمصر القديمة»، نُشرت فى عام ١٩٨٦.
ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف عن البحث والنشر، فكان كتابه «مصر الفرعونية العظيمة: التاريخ والأسطورة»، الصادر عام ١٩٨١، علامة فارقة فى مسيرته، وفاز بجائزة الأكاديمية الفرنسية لاحقًا، وأصبح منتجًا فى إذاعة «فرانس كولتور». كما كان فيلم «شامبليون المصرى» بمثابة انفجار جماهيرى غيّر مجرى حياته تمامًا، وجعله يعيش حلم الطفولة.
واختار «جاك» أن يكرّس حياته لهذا الشغف، فدخل مكتبة ضخمة تحتوى على أكثر من ١٠ آلاف مرجع، ومئات المجلات والصور العلمية. وكانت مصر، كما يقول، ليست مجرد موضوع دراسى، بل أصبحت «حياته كلها»، ودافعًا للعمل اليومى لساعات طويلة تراوحت بين ١٢ و١٤ ساعة يوميًا لكتابة الروايات والمقالات وإصدار الألبومات المصورة. وبرزت ثلاثيته: «قاضى مصر»، الصادرة بين عامى ١٩٩٣ و١٩٩٤، كأحد أبرز نجاحاته، إذ بيع منها أكثر من ٣٠٠ ألف نسخة، وظلت على قائمة الأكثر مبيعًا لعام كامل، ثم توالت مشاريعه الأدبية والعلمية، وتولى إدارة «معهد رمسيس» الذى يهتم بوصف فوتوغرافى شامل لمصر، إلى جانب نشر النصوص الهيروغليفية، علاوة على انضمامه لعدد من جمعيات علم المصريات، ما عمّق ارتباطه الدائم بمصر.
وفى عام ١٩٩٥، بدأ مشروعه الملحمى عن حياة رمسيس الثانى فى خمسة مجلدات، وتبعه كتاب «حجر النور» بأربعة مجلدات عام ٢٠٠٠، ثم «ملكة الحرية» بثلاثة مجلدات عام ٢٠٠٢، ليصل مجموع مبيعات هذه السلاسل إلى أكثر من ٢٣ مليون نسخة فى أنحاء العالم، وتُرجمت أعماله إلى أكثر من ثلاثين لغة.
وفى الأعوام التالية، كتب عن أسرار أوزوريس، ثم اتجه إلى أسلوب مختلف تمامًا عام ٢٠٠٥، من خلال مجموعته «ما أجمل الحياة فى ظلال أشجار النخيل»، ثم قرر فى ٢٠٠٦ أن يغوص فى عالم «موزارت»، ووجد روابط خفية بين الموسيقار العبقرى ومصر، من خلال أوبراته الشهيرة.
وبينما لا يزال غارقًا فى موسيقى «موزارت»، لم يفقد «جاك» أبدًا شغفه بمصر، الذى ظل يوجهه فى كل أعماله، حتى حين كان يستعد لحفل استقبال أُقيم على شرفه على ضفاف النيل، وفكر بطريقة المصريين القدماء وكان مقتنعًا بأن الرياح قد تفسد الحفل، إلا أن نصيحة ناشره، برنارد فيكسوت، بـ«الصلاة لإله الريح، آمون»، جعلت الحفل يمر بسلام.
هكذا، يظل كريستيان جاك، الكاتب الذى جعل العالم يقرأ عن مصر بشغف لا ينطفئ، وأحد أبرز سفرائها الثقافيين فى العصر الحديث، وكتابه الأخير ليس مجرد مذكرات شخصية، بل مرآة لعلاقة حب أبدية بين رجل وحضارة.
آن جوف وجيسى ماجانا: أى يوم يمر دون أم كلثوم... ضائع!

فى خطوة لافتة تؤكد استمرار الحضور العالمى لـ«كوكب الشرق» أم كلثوم، أصدرت دار النشر الفرنسية العريقة «غاليمار» أو «Éditions Gallimard»، فى ٢٣ يناير ٢٠٢٥، كتابًا مصورًا جديدًا مخصصًا للأطفال، يسرد سيرة الفنانة المصرية الأسطورية أم كلثوم، ضمن سلسلة «حيوات عظيمة» «Les Grandes Vies»، التى تحتفى بالشخصيات البارزة فى الفن والثقافة والسياسة.
الكتاب، الذى أعدته الصحفيتان والكاتبتان آن جوف وجيسى ماجانا، ويستهدف الأطفال بين سن ٩ و١٣ عامًا، يأتى فى إطار الاحتفاء بمرور خمسين عامًا على رحيل «كوكب الشرق» أم كلثوم، فى فبراير ١٩٧٥. وتقول دار النشر إن هدفه هو تعريف الجيل الجديد من الأطفال الفرنسيين بشخصية فنية تركت أثرًا عالميًا، وشكلت أيقونة ثقافية وسياسية فى زمن المدّ القومى العربى.
ويروى الكتاب، فى ٦٤ صفحة مُدعّمة بالرسوم من تنفيذ الفنانة هيلويز هاينزر، كيف تحولت فتاة ريفية من دلتا النيل، كانت تتنكر بزى صبى لتغنى فى الأعراس، إلى واحدة من أعظم الأصوات فى تاريخ الموسيقى العربية. ويسرد الكتاب محطات صعود أم كلثوم من قريتها الصغيرة، مرورًا باكتشافها فى القاهرة، ثم حفلاتها الجماهيرية التى امتدت إلى ساعات، وجعلت منها صوتًا لا يُضاهى داخل وخارج العالم العربى.
وبأسلوب مبسط وشيّق، يشرح الكتاب للأطفال كيف ارتبطت «أم كلثوم» سياسيًا بحركة التحرير المصرية، وعلاقتها بالرئيس جمال عبدالناصر، ودورها الوطنى من خلال أغنياتها التى كان نصفها تقريبًا يحمل طابعًا سياسيًا. كما يشير إلى موقعها كرمز للتحرر، رغم أنها لم تكن تُعرّف نفسها كنسوية، لكنها تولت رئاسة نقابة الموسيقيين فى بيئة يسيطر عليها الرجال، وكانت مصدر إلهام للنساء العربيات.
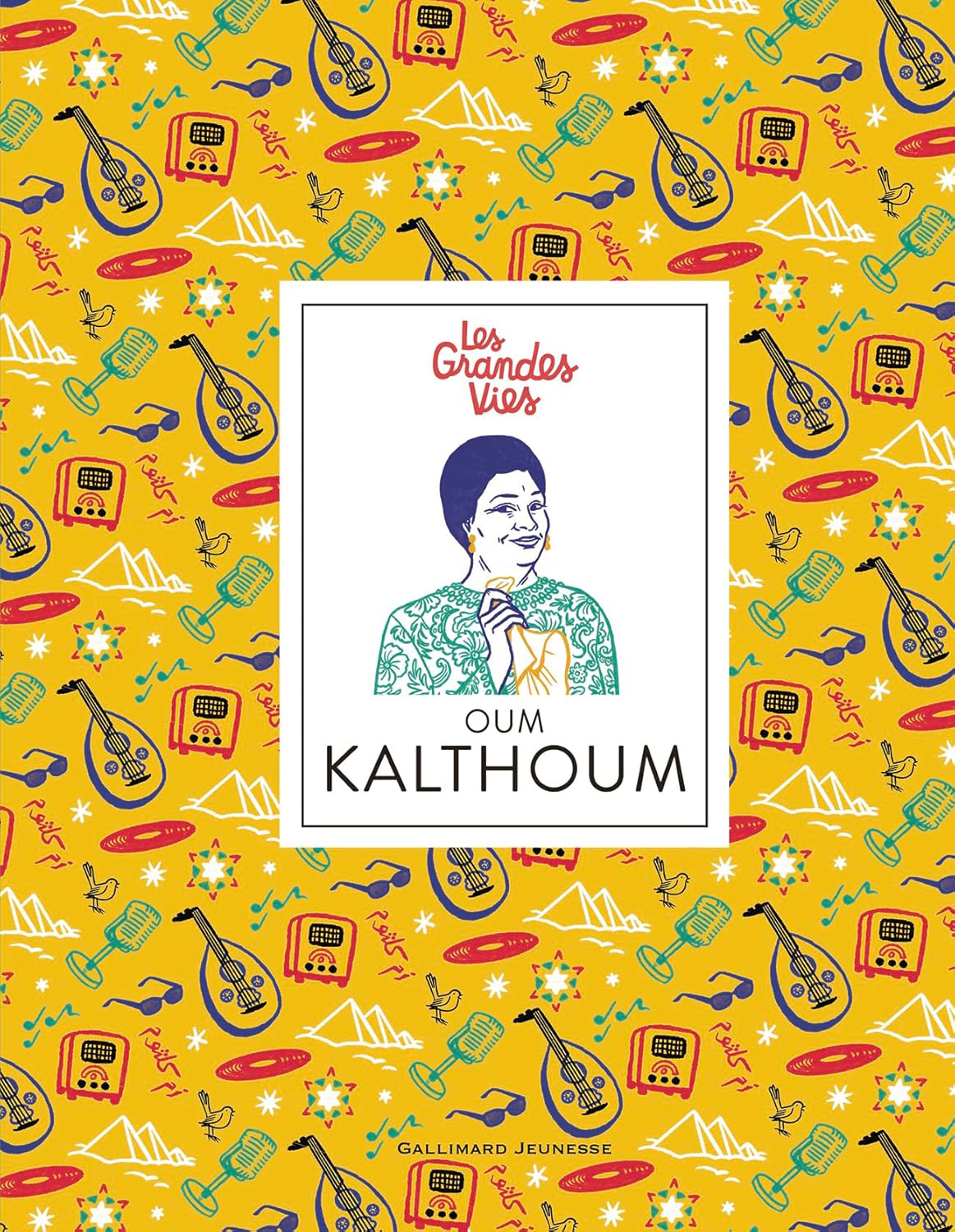
ويُشبّه الكتاب مكانة أم كلثوم لدى المصريين بمكانة إديث بياف لدى الفرنسيين، مشيرًا إلى أن حضورها لا يزال حيًا فى القاهرة، حيث يقول البعض إن «اليوم الذى يمر من دون سماع صوتها، هو يوم ضائع». كما يُبرز التأثير العابر للأجيال لأم كلثوم فى فرنسا، لافتًا إلى أن أطفالًا ومراهقين من أصول مهاجرة يستمعون إلى أغانيها مع أجدادهم حتى اليوم.
ويتوقف الكتاب عند لحظة مفصلية فى مسيرة «ثومة»، حين غنّت عام ١٩٦٧ على مسرح «الأوليمبيا» فى باريس، فى حفلة أسطورية امتدت لـ٦ ساعات، وشهدت تفاعلًا نادرًا من جمهور غربى مع فنانة عربية، وهو ما عُد حينها اختراقًا فنيًا وثقافيًا استثنائيًا.
ويخلص الكتاب إلى تقديم صورة شاملة لحياة أم كلثوم كرمز فنى تحوّل إلى أسطورة، جمعت فى صوتها بين التقاليد والحداثة، وغنّت لكبار الشعراء، وتجاوزت بطموحها وحدود طبقتها الاجتماعية، لتصبح «صوت العالم العربى»، وجسرًا ثقافيًا بين الشرق والغرب.
واختتم الكتاب بالحديث عن جنازة أم كلثوم، فى ٣ فبراير ١٩٧٥، واصفًا إياها بأنها واحدة من أكبر الجنازات فى العالم العربى، بعدما شيّع جثمانها مئات الآلاف فى شوارع القاهرة، فى وداع نادر لفنانة تركت إرثًا لا يُنسى.
فرانك مونيه: الفراعنة عباقرة هندسة.. وعجائبهم «من صنع أيديهم»
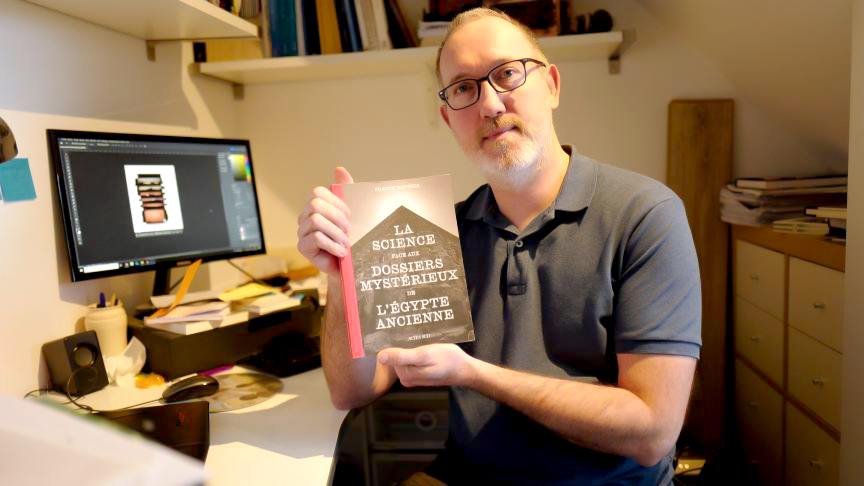
فى ٥ مارس الماضى، صدر كتاب «La science face aux dossiers mystérieux de l’Égypte ancienne»، أو «العلم والملفات الغامضة لمصر القديمة»، عن دار النشر «آكت سود»، التى شغلت صاحبتها فرانسواز نيسين منصب وزيرة الثقافة فى فرنسا، فى بداية الولاية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون.
الكتاب تأليف المهندس الفرنسى فرانك مونيه، المتخصص فى مجال البناء والهندسة المعمارية فى مصر القديمة، والذى يؤكد أن «البراعة المعمارية للمصريين القدماء مثيرة للإعجاب، لدرجة أن بعض الناس يجدون صعوبة فى إدراكها دون استخدام التكنولوجيا المتقدمة».
ويسخر المؤلف من النظريات المزعجة حول إبداعات المصريين القدماء، ومن بينها أن «فضائيين أو قوى من خارج كوكب الأرض» هم من يقفون وراء هذه الإنجازات، معتبرًا أن «من يروّج لهذه النظريات لا يستطيع استيعاب أن هناك حضارة وبشرًا صمموا تلك القطع الأثرية الغامضة بأنفسهم، لأنهم عندما يقارنون تلك الآثار العظيمة بالبيانات والعلوم يشعرون بالجنون، ويبدأون فى التساؤل حول الحضارة الرائعة التى تقف وراء تلك الإبداعات».
ويضيف «مونيه»، فى كتابه: «الأبواب السرية والأنفاق والآليات التى تخفيها الأهرامات العظيمة، هى حصيلة الهندسة المعمارية فى مصر القديمة. كانوا بالفعل مبدعين ومتقنين وخبراء فى الهندسة والحساب والفلك، وغيرها من العلوم، لذا تثير الحضارة المصرية فى العصر الفرعونى الكثير من الخيالات، وتتحدث العديد من الكتب عن أسرارها، خاصة فى الأمور العلمية».
ويخصص المؤلف كتابه بشكل جدى وموثق جيدًا لمحاولة لفهم عقلية المهندسين المصريين القدماء، وكيف صنعوا وشيدوا آثارهم العظيمة، والأهم من ذلك، لماذا تستمر تلك الآثار فى الازدهار وتُكشَف المزيد من أسرارها على مدى ٧ آلاف عام، مرجعًا إصراره على إصدار كتابه الجديد عن هذا الموضوع، لأنه ببساطة عندما كان مراهقًا، بدأ يشعر بالشغف بعلم المصريات، ووجد نفسه سريعًا أمام هذه الكتب التى تدافع عن نظريات أكثر هامشية، وبعضها أذهله.
ويتناول المؤلف العديد من الأساطير عن الحضارة المصرية القديمة، قائلًا إن «آثار مصر المهيبة تلهم بانتظام أكثر النظريات غرابة، ولعل أحدثها هى الفكرة التى أثارها مغنى راب شهير، وتقول إن الأهرامات تخفى جهازًا قادرًا على إنتاج الكهرباء، وأخرى عن وجود متاهات تحت الأهرامات»، مشيرًا إلى أن كتبًا قديمة جاء فيها أن «هناك تجاويف سرية مملوءة بالذهب تحت الأهرامات»، مع توجيه نصائح لـ«العثور على هذه الكنوز».
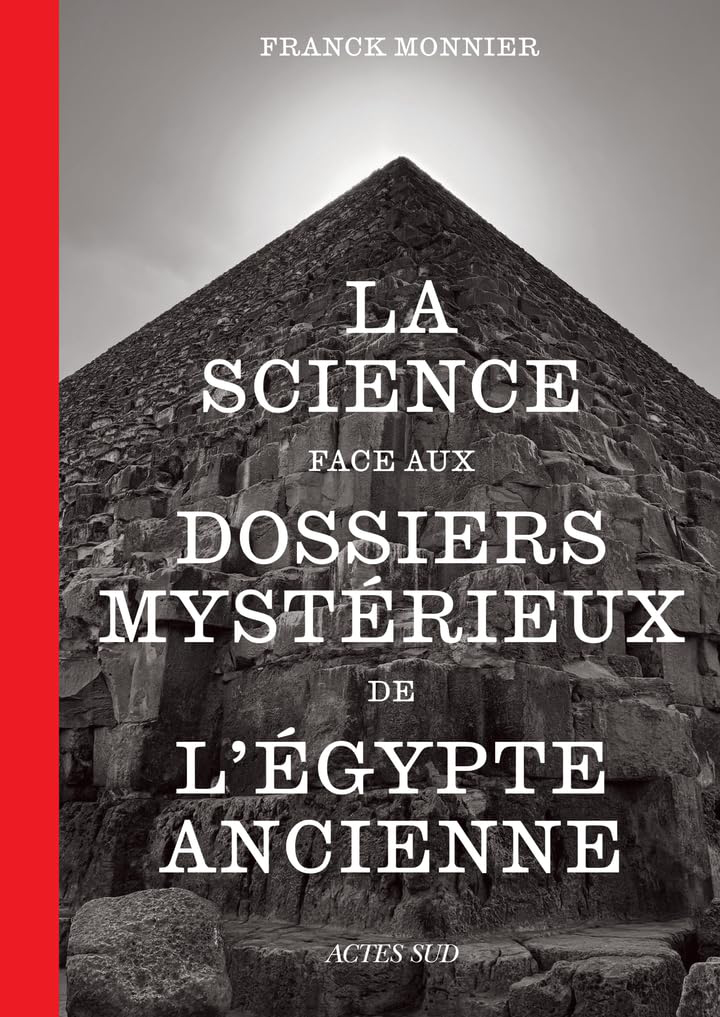
وزعمت هذه الكتب أن هناك أبوابًا تفضى إلى مساحات مفتوحة داخل «أبوالهول» نفسه، مع وجود العديد من التجاويف فى هذا التمثال المهيب، يقع أحدها فى رأسه، ومغلق بواسطة باب معدنى يقع فى الجزء العلوى من الجمجمة، وهى المعلومة التى كان أول من ذكرها هو توماس شو وريتشارد بوكوك فى عامى ١٧٢١ و١٧٤٣.
ويتم الترويج كذلك إلى وجود باب سرى ثانٍ فى الجزء الخلفى من «أبوالهول»، يُفتح على بئر حجرية، وفق المؤلف، مضيفًا: «لكن لا يعتقد أن تلك الأبواب تؤدى إلى غرف سرية. كما لا يوجد ممر سرى يربط أبوالهول بالأهرامات المجاورة، وإذا حفر أحد سيجد المياه الجوفية، كما هو موضح فى بئر أوزوريس، التى يغمرها الماء دائمًا».
ويؤكد المؤلف أن هناك غرفًا سرية داخل الأهرامات، وهى غرف الدفن التى ظلت بعيدة عن متناول الأيدى لفترة طويلة جدًا، مضيفًا: «الأهرامات هى فى الأصل مقابر، وتم استكشاف غرف الدفن بها فى وقت مبكر جدًا، استنادًا إلى الممرات التى تم حفرها فى القرن التاسع، فى عهد الخليفة المأمون، وفى عام ١٨٣٧، تم اكتشاف مساحات بارزة فوق غرفة الملك فى الهرم الأكبر».
ويضيف: «منذ عام ٢٠١٦، اكتشف فريق من العلماء بقيادة مهدى طيوبى، رئيس معهد الحفاظ على التراث والابتكار، وكونى هيرو موريشيما، الفيزيائى والأستاذ فى جامعة ناجويا، تجويفًا غير معروف، باستخدام تقنية التصوير الميوغرافى، وهى تقنية تستخدم الأشعة الكونية لاستكشاف الأحجام الصلبة الموجودة على سطح الأرض، ومن المحتمل أن يكون هذا التجويف المغطى بقبو متعرج عبارة عن مساحة بارزة، أى جهاز يخفف الضغط الذى يمارسه الهرم على الممر أسفله»
برنارد ماثيو: الأدب الفرعونى يحتاج مجلدات ضخمة مثل الكنوز الأثرية

رغم أن الأدب الفرنسى يعد من أغنى آداب العالم وأكثرها تأثيرًا، لتضمنه أعمالًا ثرية فى الشعر والقصة والرواية والمسرح، يظل الفرنسيون مهتمين بشدة بالأدب المصرى. ومع وجود كتب فرنسية شهيرة تتحدث عن أدب نجيب محفوظ وغيره من الأدباء المصريين، يبرز كتاب فرنسى يغرد فى منطقة أخرى، وهى الأدب الذى شهدته مصر القديمة.
الكتاب يحمل اسم «La littérature de l’Egypte ancienne» أو «الأدب المصرى القديم»، ويصدر بعد غدٍ الجمعة الموافق ١٨ أبريل الجارى، عن دار النشر الفرنسية «لى بيل ليتر»، التى تأسست عام ١٩١٩، المتخصصة فى نشر النصوص القديمة وتطوير الثقافة الكلاسيكية، من تأليف برنارد ماثيو، أستاذ علم «المصريات» فى جامعة «بول فاليرى».
ويؤكد «ماثيو»، فى كتابه، أن مصر الفرعونية ليست مجرد أهرامات ضخمة أو معابد مهيبة أو مقابر لم يمسسها أحد، بل تمتلك أيضًا أدبًا هائلًا، مشددًا على أن «أعمال الأدب المصرى القديم تستحق أن تُفرد لها مجلدات ضخمة، مثل كنوزها الأثرية الفريدة».
ويقدم الكتاب مختارات من الأدب المصرى، فى واحدة من أشهر فترات مصر القديمة هى الأسرة الثامنة عشرة «حوالى١٥٤٠- ١٢٩٢ ق. م»، وهى مختارات تتنوع بين: أغانى الحداد، والترانيم، بما فى ذلك «ترنيمة أتون العظمى»، وفصول من «كتاب الموتى»، ومؤلفات جنائزية عظيمة، إلى جانب سير ذاتية لعظماء هذا العصر مثل سننموت، صديق الملكة حتشبسوت، وأمنحتب ابن حابو، الصديق المقرب لـ«ملك الشمس» أمنحتب الثالث.
ويفصل المؤلف، فى كتابه المكون من ٤٦٤ صفحة، الأدب المصرى فى فترة الأسرة الثامنة عشرة إلى عدة أشكال، الأول هو الأغانى «المهنية» والطقسية، التى تتضمن أغانى المزارعين، وأغنيتى «عازف القيثارة» من مقبرتى نفر حتب وجحوتيمس، وأغانى الحداد.
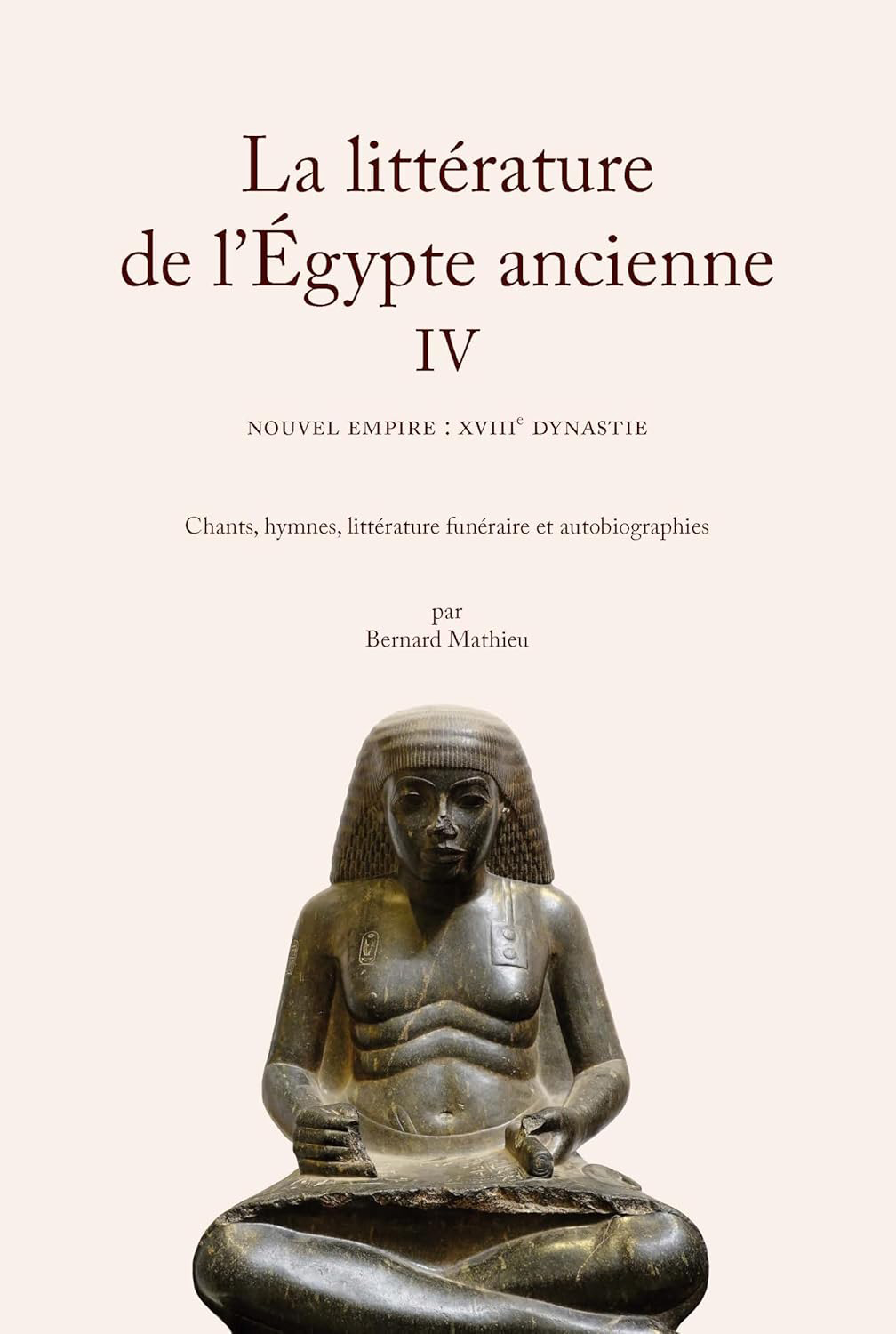
وفى فصل خاص بالأناشيد أو الترانيم، يُلقى الكتاب الضوء على «ترنيمة أتون العظمى» و«ترنيمة أمون العظمى» و«ترنيمة النيل العظمى»، إلى جانب ترانيم لكل من أوزوريس ورع وتحوت وماعت، فضلًا عن السيرة الذاتية للقائد العسكرى حور محب.
ويُلقى فصل «كتاب الموتى» الضوء على الصيغة الأدبية المستخدمة عند إنزال المومياء إلى مكان الدفن، مثل «أوشابتى»، وصيغ أخرى لطرد غضب الإله، أو المساعدة فى الانتقال إلى الحياة الأبدية، إلى جانب حوار أدبى بين المتوفى والخالق، ومؤلفات جنائزية أخرى منها «ترنيمة رع».
ويقول مؤلف الكتاب، الذى يعد أول تحليل شامل باللغة الفرنسية للأدب المصرى القديم: «مصر قدمت أدبًا يتمتع بثراء وتنوع استثنائيين، والهدف من الكتاب هو تعريف عامة الناس بالكتابات الرئيسية لهذا الإنتاج الفكرى الضخم». ويسمح الكتاب للقارئ الفرنسى بالانغماس فى عالم رائع، غريب فى بعض الأحيان ومألوف بشكل مدهش، للأعمال الأدبية العظيمة لمصر الفرعونية، وثقافتها وفكرها، عبر التطرق إلى «الكلاسيكيات» سالفة الذكر مع تفسيرات جديدة، بالإضافة إلى بعض الأعمال غير المعروفة التى لم تكن متاحة للناطقين بالفرنسية. وهذه المختارات مُخصصة لفترات رئيسية مختلفة من التاريخ الفرعونى، من عصر الدولة القديمة إلى نهاية عصر الدولة الحديثة «حوالى ٢٧٠٠-١١٠٠ ق. م».
ويضيف المؤلف أنه «قد يتبادر إلى الذهن، عند مقارنتها بحضارات قديمة أخرى، وجود كمّ هائل من النصوص التى تعود إلى ٣ آلاف عام من التاريخ الفرعونى، محفورة على الحجر، أو مكتوبة بالحبر على ورق البردى أو الألواح الخشبية، أو لفائف الجلد أو شظايا الفخار. هذا الانطباع الأول يطابق الواقع، لكن الأدب الذى يمكن أن نسميه (الآداب الجميلة) أو (الخطابات الجميلة)، على حدّ التعبير المصرى، لا يشغل سوى جزء ضئيل».
ويواصل: «كان لا بد من توثيق الثراء الشديد والتنوع والجودة فى الأدب الفرعونى، وتوضيح أصالته العميقة أيضًا، وتماسكه الذى يميزه عن الثقافات الأخرى، لأنه أدب يستحق بالتأكيد أن يكون معروفًا بشكل أفضل للمجتمع الفرنسى على اختلاف طبقاته، مع الكنوز التى يحتويها، ولا تقل إثارة للإعجاب عن أهرامات الجيزة، أو المسلات فى معبد الكرنك، أو المقابر المكتشفة أو المدفونة حتى الآن فى وادى الملوك».
ويُكمل: «بلا شك أن الأدب المصرى غنى ومتنوع، وليس من الصعب تحديد العديد من الأنواع التى تشبه إلى حد كبير تلك التى نتعرف عليها فى الثقافة الغربية، مثل: النصوص الجنائزية والطقوس، والرسائل الدينية والسياسية، والترانيم والصلوات، والمديح والسرد الملكى، والسير الذاتية، والتعاليم، والإرشادات والمجموعات التعليمية، وقصائد الحب وأغانى الحداد، والقطع السردية والحكايات الأسطورية، والرسائل الخيالية، والأعمال الساخرة، وأدب الأفكار، والخطابات البلاغية، وما إلى ذلك».








