مصطفى عبيد: كُتبى إعادة تفكير فى «ما وجدنا عليه آباءنا»

التاريخ لا يحتمل الرواية الواحدة ومصطفى كامل لم يكن زعيمًا وطنيًا
«يوليو» من أسباب انتشار «الإخوان» وخلقت مجتمعًا «شبه متأخون بالكامل» فى الثمانينيات
أتمنى أن يكون «أبناء محيى الدين» بداية لقراءات مختلفة لتاريخنا الاجتماعى
يعمل الكاتب الصحفى والباحث مصطفى عبيد على مشروع كبير لتحفيز العقل العربى، واستفزازه للتفكير بشكل مختلف، وتفكيك ما يسمى بـ«المُسلَّمات» أو «الثوابت»، ويؤمن بأنه لا ثابت سوى الله، وأن كل شىء قابل للبحث والتفكيك والمراجعة.
لذا كان من الطبيعى أن تلقى كُتبه وترجماته ورواياته، مثل «أبناء محيى الدين» و«ضد التاريخ» و«سبع خواجات» و«جاسوس فى الكعبة»، أحجارًا فى المياه الراكدة، أن تكسر النمطية والثبات والجمود، وتطرح أفكارًا غير معتادة، وتحاول نقد الشائع، بالشكل الذى توصل إلى أن «مصطفى كامل ليس زعيمًا وطنيًا»، على سبيل المثال.
عن هذا المشروع الفكرى المهم، وتفاصيل كل كتاب فى إطاره، يدور حوار «حرف» التالى مع الكاتب الصحفى والباحث مصطفى عبيد.
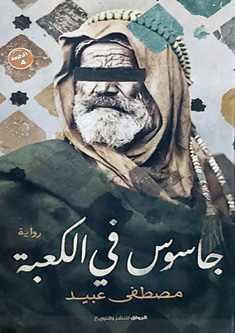
■ لديك اتجاهات خاصة فى العمل على كتبك، فكل منها يبدو كمشروع مستقل، لكنها فى مجملها تظهر كمشروع واحد كبير.. كيف ترى هذا؟
- بالفعل أنا لدىّ مشروع كبير هو تحفيز العقل العربى، واستفزازه للتفكير بشكل مختلف، وتفكيك ما يسمى بالمُسلَّمات أو الثوابت، إيمانًا بأنه لا ثوابت سوى الله، وأن كل شىء قابل للبحث والتفكيك والمراجعة، وذلك لأننى أتصور أن الإصلاح والتحديث يستلزمان خروجًا عن الأساليب التقليدية فى التفكير والتدبر.
من هنا يتصور أى متابع لما أكتبه، أن كل كتاب بمثابة مشروع فى حد ذاته، غير أن هناك مشروعًا كبيرًا أعم وأشمل، هو كسر النمطية، والابتعاد عن التقليد والتكرار. وأنا سواء فى بحوث التاريخ والسير والسرد، أميل إلى التجريب وطرح الأفكار غير المعتادة، ومحاولة نقد الشائع، سعيًا للوصول إلى معان وطرق جديدة.
■ من الفكرة إلى الكتابة.. كيف تنتقى ما تكتب عنه؟ وهل هناك رؤى بعينها تحرص عليها فى كل كتاب؟
- نعم، هناك هامش محدد أحاول تتبعه، وهو أن يكون الكتاب الجديد يضيف جديدًا، فالكاتب لا ينبغى أن يكرر ما سبق قوله، هذا ليس عملًا، والعمل المفيد هو الذى يقدم جديدًا، كشفًا ما، إنصاف شخصية مظلومة، دحض أكذوبة خاطئة، أو غير ذلك.
من هنا أفكر دائمًا فى المناطق المعتمة فى التاريخ أو الفكر وأسعى إلى إضاءتها. أتصور أننا فى حاجة لتنوير ما هو مظلم، تعريف الناس بشىء لم يُعرَف من قبل. أؤمن بأننا ميتون وأعمارنا قصيرة، وعلينا أن نقدم دومًا ما يبقى للناس. من هنا فإن أهم ما فى الفكرة هو تقديم شىء جديد.
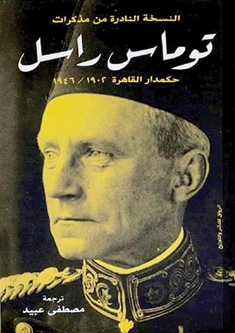
■ السير الذاتية التى ترجمتها لها علاقة وطيدة بالمجتمع المصرى، ومنها كتب سيدنى سميث وتوماس راسل.. ما الدافع وراء اختيار هذه الأعمال؟
- قطعًا أعمالى فى ملف الترجمة لم تكن انطلاقًا من الترجمة نفسها، وإنما خضعت إلى الفكرة ذاتها، وهى تقديم جانب معرفى جديد. مثلًا عندما قرأت مذكرات حكمدار القاهرة توماس راسل، ومذكرات سيدنى سميث، شعرت بأنها تقدم شهادة مهمة وجديدة وغائبة عن مصر المجتمع والناس والعامة لا الساسة، لذا كان يجب طرحها كقيمة معرفية جديدة للباحثين وجمهور القراءة. أنا مهتم بشكل خاص بشهادات الغير عنا، لأنها دومًا كانت مستبعدة، تحت تصور التشكك فى الآخر، أو من كان يومًا عدوًا، فآفتنا هى تعميم الأحكام وإطلاقها كحقائق راسخة.
■ الكثير من العائلات المصرية لها سير تاريخية محترمة.. لماذا اخترت عائلة «محيى الدين» لتكون موضوعًا لكتابك الأخير؟
- «أبناء محيى الدين» هو أحدث كتاب لى، وهو يتناول تاريخ عائلة «محيى الدين»، منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى وقتنا الحاضر. وقد اخترت هذه العائلة للكتابة عنها لعدة أسباب يمكن إجمالها فى التالى:
أولًا: هى العائلة الوحيدة فى مصر التى خرج منها رئيسا وزراء، هما زكريا محيى الدين وفؤاد محيى الدين، وهى العائلة الوحيدة التى أخرجت وزراء للداخلية والصحة والحكم المحلى والاستثمار والتعليم العالى والبحث العلمى، كما أخرجت عُمدًا ونوابًا فى البرلمان ومفكرين اقتصاديين وغير ذلك، رغم أنها ليست عائلة ثرية.
ثانيًا: صعود العائلة اجتماعيًا وسياسيًا ارتبط بصعود طبقة جديدة من المصريين، فى نهايات القرن التاسع عشر الميلادى، لا تنتمى إلى رجال السلطة، وذلك بفضل مهارة بعض الأفراد، مثل الرجل المؤسس محيى الدين فؤاد، الذى كان تاجرًا بسيطًا، لكنه استفاد من تجارة القطن وبرع فيها، وصعد مع ميلاد سمعة القطن المصرى عالميًا، وأسس عائلة ضخمة، وعلم أبناءه فى الخارج، ليتمكن من تبديل حاله الاجتماعى فى زمن شديد الصعوبة.
ثالثًا: هذه العائلة ارتبطت ارتباطًا غريبًا بتحول هام ودرامى فى تاريخ مصر الحديث، هو ما حدث فى ثورة يوليو ١٩٥٢، ذلك أن اثنين من أعضاء مجلس قيادة الثورة أو الحركة الجديدة ينتميان إلى العائلة، ورغم ذلك فإنهما كانا من المتحفظين والناقدين لكثير مما شهده التحول من سقطات.
وفى المجمل أتمنى أن تكون هذه الدراسة بداية لقراءات متنوعة لتاريخنا الاجتماعى وفق قوالب جديدة.
■ «سبع خواجات- سير رواد الصناعة الأجانب فى مصر».. الكتاب يبدو وكأنه محاولة لإنصاف الرأسماليين الأجانب فى مصر، والرد على ما يقال بأن كلهم كانوا فسدة.. هل هذا صحيح؟
- «سبع خواجات» يقوم على فكرة رئيسية، هى عدم التسليم لكل ما تربينا عليه باعتباره حقائق ثابتة، فالفكرة السائدة هى أن كل الأجانب لصوص وفاسدون، لكن عند إخضاع هذه الفكرة إلى تقييم حقيقى بعيدًا عن «الشوفينية» والتعصب، وجدت أن هناك نماذج عديدة نافعة وجيدة ومهمة، وتركت لنا آثارًا تستحق أن تُشكر.

■ رغم أن البحث يستهويك لكنك لا تنفك عن العودة إلى الرواية فكتبت «جاسوس فى الكعبة».. هل يمكن ضمها إلى مشروعك الأكبر، خاصة فى ظل بُعدها التاريخى؟
- بالنسبة لرواية «جاسوس فى الكعبة»، أنا أحب السرد الروائى، وأتصور أن التاريخ مجموعة من الحكايات، وكانت الفكرة الرئيسية للرواية هى محاولة استقراء الصدام والاحتكاك المبكر بين الشرق والغرب.
الرواية تتناول حكاية شخص سويسرى طموح من أسرة عريقة تؤمن بالعلم، انتقلت من لوزان إلى بازل، وتعرضت إلى مشكلات اقتصادية بسبب الغزو الفرنسى، فى نهايات القرن الثامن عشر. هذا الشخص اسمه «لويس»، والذى تعلم جيدًا لإيمانه بإمكانية استعادة مجد عائلته، عائلة «بركهارت»، من خلال العلم، فانتقل إلى ألمانيا بسبب كراهيته الاحتلال الفرنسى لبلاده، وكراهيته لنابليون بونابرت.
اهتم «لويس بركهارت» فى ألمانيا بدراسة الشرق والتعرف على الإسلام، وخاض فى علوم الاستشراق، ثم سافر إلى إنجلترا طلبًا لوظيفة جيدة تكافئ ما حصله من علوم، وهناك اتفقت معه الجمعية الجغرافية البريطانية على العمل لحسابها، والمشاركة فى اكتشاف مناجم الذهب فى النيجر.
كان الكثير من الرحالة البريطانيين قد قتلوا فى رحلتهم لاكتشاف الذهب فى النيجر، لسفرهم عبر البحر، ومرورهم من الجزائر، وكانت الخطة البديلة أن يسافر «لويس» عبر الطريق البرى من مصر، مع قوافل الحجاج الأفارقة العائدين إلى النيجر، لذا فقد قرر تعلم اللغة العربية، وارتدى أزياء العرب، وانخرط وسطهم كتاجر ثرى.
بدأت مهمة «لويس بركهارت»، الذى صار اسمه «الشيخ إبراهيم المهدى» فى الشام بمدينة حلب، ومنها غيّر مسار مهمته للبحث عن مدينة «الأنباط» المفقودة، التى كتب عنها الأوروبيون المصاحبون للحملات الصليبية، لكن أحدًا لم يصل إليها. وبالفعل يخوض «لويس» عدة مغامرات ليصل فى النهاية إلى «البتراء»، ويكتشفها فى أغسطس ١٨١٢.
بعدها يجد نفسه فريسة لعيون جواسيس محمد على باشا المنتشرين فى الشام، ويسافر إلى مصر استعدادًا للحاق بقافلة النيجر، لكنه يتعرض لمغامرات أخرى فى القاهرة، ويغير مهمته ليعمل كعين راصدة لنجم باشا مصر الصاعد، محمد على، ويتابع أخباره، ويصبح لافتًا للباشا، الذى يعتقد أنه جاسوس للمماليك أو السلطان العثمانى أو غيرهما، ويتربص هو الآخر به.
- يُجرى «لويس» استكشافات فى صعيد مصر، ويستكشف بالفعل بعض المعابد المصرية القديمة، ويقوم برحلة إلى النوبة والسودان، ويتزوج بإحدى أرامل المماليك، ليصبح محل شك دائم لمحمد على ورجاله، قبل أن تُقرر بريطانيا تغيير مهمته وإرساله إلى الحجاز، لمتابعة ورصد ظهور وتوسع الحركة الوهابية، وزيارة الكعبة وقبر الرسول واستكشاف كل شىء عنهم.
وبالفعل يُصبح لويس «إبراهيم المهدى» شاهدًا على حروب محمد على وابنه «طوسون» مع «الوهابيين»، ويتابع أحداثها وحكاياتها، ويتم وضعه تحت المجهر تمامًا، ليصدر قرارًا سريًا بتصفيته، لكن بطريقة هادئة وبموت بطىء حتى لا يلفت الأنظار.
يكتب الرحالة كل شىء عن مصر ومحمد على ورجاله و«الوهابيين» والعرب والإسلام، ويصحح مفاهيم مغلوطة لدى الأوروبيين عن الإسلام، الذى يعتبره دينًا إصلاحيًا.. وقطعًا فإن قالب الرواية جيد ومناسب للتفكير فى التاريخ بشكل جيد.
■ كيف جاءت فكرة كتاب «ضد التاريخ»؟
- الدافع الأول لهذا الكتاب هو إرساء التعددية وكسر الأحادية الحاكمة للفكر العربى فى شتى المناحى، سواء الفكر الدينى أو السياسى أو التاريخى، لأن الشيوع والتمدد الواسع للتيار الدينى فى المجتمعات العربية يرجع إلى أحادية الفكر، وتنشئة أجيال من البشر، عبر ٧ عقود، على فكر واحد ورأى واحد وصوت واحد وحزب واحد.
ليس أدل على ذلك فى مصر من أن جماعة «الإخوان المسلمين»، بعد تأسيسها فى ١٩٢٨، قضت أكثر من ٢٠ عامًا لا تجد قدرة على التمدد والتأثير فى الشارع، لأن خطابها كان أحاديًا، بينما كانت النخبة مشبعة بالتعددية. لكن بعد يوليو ١٩٥٢ تحولت مصر إلى فكرة «الكل فى واحد»، وصار الحزب والطرح والفكر واحدًا، وهو ما يعبر عن السلطة، ومن ثم صارت الأحادية الحاكمة للمجتمع مناخًا ملائمًا للجماعة كى تتمدد وتنتشر وتهيمن على مصر، على الرغم من الضربات الأمنية التى تلقتها، لنصل إلى مجتمع «شبه متأخون بالكامل» فى الثمانينيات.
أنا ابن هذه المرحلة، شببت لأجد الخطاب الدينى زاعقًا ومهيمنًا على كل شىء. رأيت الناس إما مع أو ضد، وكان تقديرهم للشخصيات التاريخية إما أبيض أو أسود، وهذا ما جعلنى أبحث عن الآخر وأستقرئه، وأعيد قراءة ما طرحه ورفضه السابقون.
لقد كنت مدفوعًا بتأكيد أن الأحادية هى سبب تخلفنا، وأننا مدعوون جميعًا- نُخبة وكتابًا- إلى التفكير فيما وجدنا عليه آباءنا. إن القرآن الكريم أنكر على الأمم الضالة قولهم، إن دُعوا إلى دين جديد، إنهم يسيرون على ما سار عليه آباءهم دون تفكير أو تمحيص، ونحن للأسف الشديد وصلنا بفضل أحادية الفكر إلى قطيع يرفض كل طرح جديد، ويستعذب تكرار السائد دون تشغيل للعقل.
كانت فلسفتى القائمة هى أن التاريخ تحديدًا علم نسبى، لا يحتمل الرواية الواحدة، وحاولت تقديم أمثلة عديدة لروايات تبدو غير مألوفة لدى الناس ومخالفة لما هو سائد، انطلاقًا من قراءة جديدة تضع فى خلفيتها المنطق والعلم والأخلاق كمعيار لإعادة تقييم الأفعال. وهنا فقد كانت إشارتى مثلًا إلى أن مصطفى كامل ليس زعيمًا وطنيًا.
قراءة أى حدث مضى أمر فى غاية السهولة بسبب تعدد الروايات ووفرتها وإتاحتها عبر وسائل كثيرة. وكل حدث رواه صانعوه وضحاياه، لكن الأعظم هو ما رواه المشاهدون والمتابعون، والمهم هو وضع مقياس ما لتقييم الأحداث، وأول شىء هو استخدام فكرة تحليل المضمون استنادًا للمنطقية، يليها محاكمة الفعل أخلاقيًا، هل ما حدث يتسق مع الأخلاق أم لا؟ وأتصور أن القضية ليست فى انتقاء المراجع، فهى جميعًا متاحة، لكن القضية فى الفلسفة القائمة لقراءة الأحداث.
■ما هو الكتاب الذى يعمل عليه مصطفى عبيد الآن؟
- أعمل الآن على رواية جديدة تحاول إعادة استكشاف شخصية حقيقية لعبت دورًا هامًا فى فترة تحول عظيمة، ومارست تأملًا حيويًا ومهمًا تم إغفاله فيما بعد. والفكرة قائمة على طرح سؤال مهم هو: أى مدى أخلاقى يفترض تجاوزه عند خدمة الأوطان؟!






