تونى موريسون.. الأم الروحية لأدب الأمريكان السود

- قاست فى طفولتها أحقر تجليات العنصرية الأمريكية ضد السود.. وكان والدها يكره البيض ولا يسمح بدخولهم المنزل
- فى أولى سنوات تحققها نشرت أعمال سوينكا ومذكرات محمد على كلاى.. وقصائد شاعر مغمور أسود قتله شرطى فى المترو
تونى موريسون من الروائيات القلائل اللواتى ترجمت جميع أعمالهن الأدبية إلى اللغة العربية، وأغلب الظن أن الحس المأساوى «الميلودرامى» العنيف الذى طبع رواياتها الإحدى عشرة، وميزها عن غيرها، واحتشاد نصوصها بالشحنات العاطفية، والمآسى المتلاحقة، لعب دورًا كبيرًا فى تلك الحالة الفريدة التى تستهوى المترجم والناشر العربى، وأدت إلى رواج كتاباتها بين القراء والنقاد على حدٍ سواء.. وربما لعبت استضافتها فى برنامج المذيعة التليفزيونية الأمريكية أوبرا وينفرى مرات عديدة طوال سنوات متتالية، وتمثيلها دور البطولة فى الفيلم المأخوذ عن روايتها الأشهر «محبوبة» دورًا آخر فى نجوميتها حول العالم، رغم أن الفيلم لم يصمد طويلًا فى دور العرض السينمائى فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا فى أى دار عرض سينمائية حول العالم، وقيل إن السبب الرئيسى فى ذلك أنه لا أحد يمكنه الاستمرار فى التعرض لتلك الحالة التراجيدية المغرقة فى الدموع فترة طويلة كتلك التى يستغرقها زمن الفيلم، الذى يقترب من ثلاث ساعات كاملة.. العرب والهنود وحدهم تستهويهم تلك الحالة، وسبق أن توحدوا مع كثير من الأفلام الهندية المأساوية من نوعية «سانجام»، و«من أجل أبنائى» وغيرهما من الميلودراميات المطولة المشحونة بالمآسى والدموع والهزائم والانكسارات.. ولولا أنه من المعلوم أن تونى موريسون من مواليد ولاية أوهايو الأمريكية فى 18 فبراير 1931، لظن قراء أعمالها أنها من أصول هندية أو عربية، بسبب تلك الجرعات المكثفة من المآسى التى تلاحق أبطال وبطلات رواياتها، ولا تحتفى بها الثقافة الأوروبية والأمريكية إلا فى حالات نادرة ومحدودة، ولروايات معدودة، ربما كان أشهرها روايتى «البؤساء» و«أحدب نوتردام» للفرنسى فيكتور هوجو، ورواية «العطر» للألمانى باتريك زوسكيند، وهو ما يدفعنى شخصيًا إلى الظن بأن فوزها بجائزة نوبل 1993 «التى لا أحسن الظن بها»، وكانت أول إفريقية أمريكية تنال هذه الجائزة فى تاريخها، جاء بدفع من حالة الرغبة الأمريكية فى غسيل سمعتها من جرائم الآباء المؤسسين العنصرية ضد السود والأفارقة، وهى الحالة التى ظهرت بكثافة فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين، وتمثلت فى منح العديد من الجوائز الكبرى عالميًا لأمريكيين من أصول إفريقية، بدأت بفوز النجم دينزل واشنطن فى 1990 بجائزة أوسكار أحسن ممثل دور ثانٍ عن دوره فى فيلم «جلورى»، وبعدها بأوسكار أحسن ممثل عام 2002 عن دوره فى فيلم «تريننج داى»، وهى الجائزة التى لم يسبقه إليها زنجى سوى سيدنى بواتيه عندما فاز بجائزة أحسن ممثل عامى 1959، و1964، ولم يكن من المقبول تجاهل براعته التمثيلية وقتها.
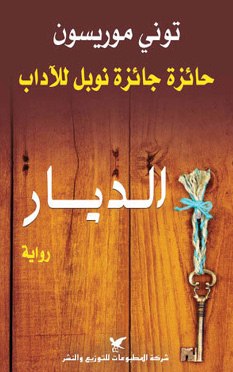
وقاحة ضخمة وشرور شاذة
على أى حال، فإن تلك السيدة السمراء الأمريكية ذات الجذور الإفريقية، التى تتمتع بطلة مليحة ملحوظة، وخفة ظل فائقة، مثلت حالة فريدة فى الثقافة الأمريكية منذ بداياتها الأولى، فاحتلت منذ مطلع سبعينيات القرن الماضى صدارة المشهد الأدبى الأمريكى عبر مواهبها المتعددة كروائية وكاتبة مقالات ومسرحيات وأغانٍ، وعرفت برواياتها التى تناولت العبودية، والتمييز العنصرى عبر مراحل التاريخ الاجتماعى للأفارقة الأمريكيين، وامتازت كتاباتها بأسلوب عاطفى، ولغة أدبية محملة بشحنات كثيفة من الشجن والغنائية التى تقربها من لغة الشعر، حتى أن لجنة الأكاديمية السويدية تحدثت فى قرار اختيارها للفوز بجائزة نوبل حول طريقة استخدامها اللغة فقالت إنها «لغة تريد تحريرها من قيود العرق».. وهى الكتابات التى تركزت حول تجارب النساء فى مجتمعات السود فى الجنوب الأمريكى، وما تعرضن له من محن قاسية، والتى توجتها بالكثير من الجوائز المحلية والعالمية، بداية من جائزتى «بوليتزر»، و«جمعية نقاد الكتاب الوطنى» الأمريكية، وصولًا إلى جائزة نوبل للآداب عام ١٩٩٣، كما حظيت بإعجاب ومتابعة عدد كبير من الشخصيات العامة العالمية، ومن مختلف الأوساط والفئات، من سياسيين ونجوم ورجال أعمال، ومن أشهر المعجبين بكتاباتها إلى جانب الأمريكية الأشهر أوبرا وينفرى، هناك وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق هيلارى كلينتون، والنجم مارلون براندو، والروائية الكندية مارجريت أتوود، والشاعرة والروائية البريطانية أنتونيا سوزان بيات.
بدأت رحلة موريسون مع أحقر درجات العنصرية و«الميلودراما» العنيفة مبكرًا جدًا، وربما فيما قبل ولادتها، إذ ولدت لعائلة من الطبقة العاملة فى لورين بولاية أوهايو، بعد قرار والديها مغادرة الجنوب الأمريكى هربًا من التمييز العنصرى، وكانت هى الطفلة الثانية من بين أربعة أطفال، وكان اسمها عند الولادة هو كلوى أرديليا ووفورد، وقيل إن والدتها «نيى ويليس» ولدت فى جرينفيل بولاية ألاباما، وهى ربة منزل كلاسيكية، بينما نشأ والدها «جورج ووفورد» فى كارترسفيل، جورجيا، وتحكى أنه عندما كان فى الخامسة عشرة من عمره، قامت مجموعة من البيض بشنق رجلى أعمال أمريكيين من أصل إفريقى كانا يعيشان فى نفس الشارع الذى كان يعيش به، وقالت: «لم يخبرنا أبدًا أنه رأى جثثًا، لكنه رآهما، وأعتقد أن هذا كان صادمًا للغاية بالنسبة له»، ولهذا فبعدها بفترة قليلة انتقل بأسرته إلى بلدة لورين، أوهايو، الخالية من التمييز العرقى، على أمل الهروب من العنصرية، وتأمين عمل مربح، فعمل فى وظائف غريبة وكثيرة إلى جانب عمله الأساسى كعامل لحام فى شركة «يو إس ستيل»، وفى مقابلة أُجريت معها عام ٢٠١٥، قالت موريسون إن والدها «كان يكره البيض كثيرًا، لدرجة أنه لم يكن يسمح لهم بدخول المنزل».

وعندما كانت موريسون فى السنة الثانية من عمرها، حدث أن والديها لم يستطيعا دفع إيجار المنزل الذى كانوا يعيشون به، أشعل مالكه النار فيه أثناء وجودهم بداخله، إلا أن رد فعل عائلتها على ما فعله مالك البيت الأبيض كان هو الضحك على ما أسمته «شكلًا غريبًا وشاذًا من الشر»، وقالت إن رد فعل عائلتها أظهر كيفية الحفاظ على نزاهتك وحياتك فى مواجهة «الوقاحة الضخمة»، كبديل عن الوقوع فى اليأس.
غرس والدا موريسون فيها شعورًا بالتراث واللغة من خلال سرد الحكايات الشعبية الأمريكية الإفريقية التقليدية وقصص الأشباح والدراما الغنائية، وإلى جانب ذلك كانت هى تقرأ كثيرًا عندما كانت طفلة، ومن بين مؤلفيها المفضلين جين أوستن وليو تولستوى.
أصبحت موريسون كاثوليكية فى سن الثانية عشرة، واتخذت اسم المعمودية أنتونى «على اسم القديس أنتونى بادوا»، وهو الاسم الذى اختصره أصدقاؤها فى جامعة واشنطن لاحقًا إلى تونى، وكان قرارها بدراسة الأدب الإنجليزى خيارًا طبيعيًا لرحلتها فى المدرسة الثانوية، حيث كانت عضوًا فى فريق المناقشة، وطاقم الكتاب السنوى، وفى نادى الدراما، لكن تجربتها الجامعية الأولى وضعتها فى مواجهة العنصرية والفصل العنصرى مرة أخرى، وعلى الرغم من أن جامعة «هاوارد» التى درست فيها بواشنطن العاصمة، كانت لعموم السود، فإن الطلبة فيها كانوا يُوزعون فى مجموعات تبعًا لدرجة سواد بشرتهم، كما واجهت المطاعم والحافلات المنفصلة عنصريًا لأول مرة فى حياتها.
فى البداية كانت طالبة فى برنامج الدراما، ودرست المسرح مع مدرسى الدراما المشهورين وقتها آن كوك ريد وأوين دودسون، وتخرجت عام ١٩٥٣ بدرجة البكالوريوس فى اللغة الإنجليزية، ثم حصلت على درجة الماجستير فى الآداب من جامعة كورنيل فى إيثاكا، نيويورك، وكانت أطروحة الماجستير الخاصة بها بعنوان «معالجة فرجينيا وولف وويليام فوكنر للمنبوذين»، بعدها بدأت العمل بالتدريس فدرست اللغة الإنجليزية أولًا فى جامعة تكساس الجنوبية فى هيوستن لمدة عامين، ثم فى جامعة هاوارد لمدة سبع سنوات تالية، وأثناء التدريس فى جامعة هاوارد التقت بهارولد موريسون، المهندس المعمارى الجامايكى، وتزوجته عام ١٩٥٨، حيث ولد ابنهما الأول عام ١٩٦١ وكانت حاملًا فى ابنهما الثانى عندما انفصلا عام ١٩٦٤، وبعد طلاقها وولادة ابنها سليد، بدأت العمل محررة فى قسم الكتب المدرسية فى دار نشر «راندوم هاوس» فى «سيراكيوز»، ولكنها بعد عامين انتقلت إلى العمل بالمقر الرئيسى للدار فى مدينة نيويورك، حيث أصبحت أول محررة كبيرة سوداء فى قسم الروايات الخيالية، وهى الدار التى ارتبطت معها لنحو ١٨ عامًا.. وبصفتها هذه لعبت موريسون دورًا حيويًا فى وضع الأدب الأسود ضمن الاتجاه الرئيسى للدار، وكان أحد أول الكتب التى عملت عليها هو «الأدب الإفريقى المعاصر»، وهى مجموعة تضمنت أعمال الكتاب النيجيريين وول سوينكا، وتشينوا أتشيبى، والكاتب المسرحى الجنوب إفريقى أثول فوجارد، ورعت جيلًا جديدًا من الكتاب الأمريكيين من أصل إفريقى، بما فى ذلك الشاعرة والروائية تونى كيد بامبارا، والناشطة الراديكالية أنجيلا ديفيس، والروائية جايل جونز، كما جلبت للدار السيرة الذاتية لبطل الملاكمة الأشهر محمد على كلاى «الأعظم: قصتى الخاصة»، التى نُشرت عام ١٩٧٥، بالإضافة إلى ذلك روجت لعمل هنرى دوماس، وهو روائى وشاعر أسود غير معروف قُتل بالرصاص عام ١٩٦٨ على يد ضابط فى مترو أنفاق مدينة نيويورك، وكانت دار النشر غير متأكدة من المشروع، لكن نشره قوبل باستقبال جيد، وربما يفسر ذلك ما قالته فى مقابلة مع صحيفة «أوبزرفر» البريطانية عن بداياتها: «كان هناك شىء واحد فقط أردت الكتابة عنه، التأثير المدمر للعنصرية على المرأة السوداء والطفل، وهما أكثر وحدات المجتمعات التى لا حول لها ولا قوة وتفتقد الحصانة والحماية».
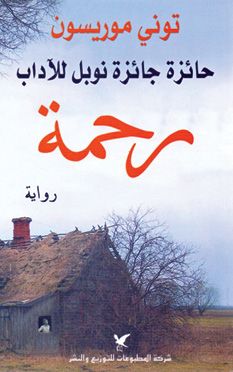
تاريخ وعلم اجتماع وفلكور وكابوس وموسيقى
بدأت موريسون رحلتها مع الكتابة خلال وجودها ضمن مجموعة غير رسمية من الشعراء والكتاب فى جامعة «هاوارد»، وكانوا يجتمعون لمناقشة أعمالهم، وفى إحدى المرات قرأت عليهم قصتها الأولى عن شابة سوداء تصلى يوميًا من أجل أن يمنحها الرب عينين أكثر زرقة، لأنها تعتقد أن عالم القهر الذى تعيشه سيتغير عند النظر عبرهما، وهى القصة التى بنتها على تجربة شعورية حقيقية لإحدى صديقاتها، وهى القصة التى طورتها فيما بعد، وحولتها إلى رواية «العيون الأكثر زرقة»، فكانت تستيقظ كل صباح فى الساعة ٤ صباحًا لكتابتها فيما تقضى بقية اليوم فى عملها ورعاية طفليها اللذين ربتهما بمفردها، وهى الرواية التى صدرت عام ١٩٧٠، عن دار «هولت وراينهارت ووينستون».. لم تحصل الرواية على مبيعات جيدة فى البداية، بالرغم من حصولها على تقييم جيد من قبل النقاد، إذ كتب عنها جون ليونارد فى مقال بصحيفة «نيويورك تايمز»: «إنه نثر دقيق للغاية، ومخلص للغاية، محمل بالألم والدهشة، لدرجة أن الرواية أصبحت شعرًا.. إنها ليست رواية فحسب، هى أيضًا تاريخ، وعلم اجتماع، وفلكلور، وكابوس، وموسيقى».. بعدها وضعت جامعة نيويورك الرواية على قائمة القراءة الخاصة بقسم الدراسات السوداء الجديد، وهو ما فعلته كليات وجامعات أخرى، ما أدى إلى زيادة المبيعات، كما لفتت الرواية انتباه روبرت جوتليب، المحرر الأدبى الشهير بإحدى الدور التابعة لراندوم هاوس، الذى أصبح فيما بعد المحرر الأدبى لجميع روايات موريسون.

بعدها بثلاث سنوات نشرت روايتها الثانية «صولا» التى رشحت لجائزة الكتاب الوطنية، غير أن روايتها الملحمية «نشيد سليمان» التى نُشرت فى ١٩٧٧، كانت مفتتح سلسلة من الروايات التاريخية عن تجربة الأمريكيين السود، وهى التى لفتت الانتباه إلى موهبة موريسون وتوجت بجائزة «نقاد الكتاب الوطنى» الأمريكية.
كتبت موريسون أيضًا عددًا من كتب الأطفال بالتعاون مع ابنها الأصغر سليد، وهو رسام وموسيقى، توفى بسبب إصابته بسرطان البنكرياس عام ٢٠١٠ بعمر ٤٥ عامًا، وكانت حينها تعمل فى روايتها «وطن» فتوقفت عن الكتابة، لكنها كشفت لاحقًا عن أن محاولات أصدقائها مواساتها لم تفلح فى إخراجها من حزنها وانقطاعها عن الكتابة، وقالت لصحيفة «جارديان»: «ماذا تقول؟ ليس ثمة كلمات تعبر عن ذلك. حقًا لا توجد كلمات».. «حاول البعض أن يقولوا لى نحن آسفون، آسفون جدًا، يقول الناس ذلك لى، ليس ثمة لغة مناسبة للتعبير عن ذلك.. آسف لا تنفع هنا. أعتقد أنك ينبغى أن تحضن الناس فقط»، لكنها تمكنت أخيرًا من العودة إلى الكتابة وإكمال روايتها قائلة: «لأن ذلك ما كان يرغب به سليد»، وقالت فى محاضرة تكريمها بجائزة نوبل إن السرد لم يكن مجرد ترفيه، بل هو فى اعتقادى إحدى الطرق الرئيسية التى نستوعب بها المعرفة»، وقالت: «أنا لا أكتب انتقامًا من العنصرية بل لتغيير اللغة إلى لغة لا تنتقص من الناس».

أثر محبوبة وتأثير أوبرا وينفرى
على الرغم من غزارة كتابات موريسون، التى تمتعت بالاحتفاء والشهرة، فإن روايتها «محبوبة» ظلت أكثر رواياتها شهرة، وهى الرواية التى تحولت إلى عمل سينمائى عام ١٩٩٨، بطولة أوبرا وينفرى ودانى جلوفر، ١٩٨٧، وهى أيضًا الرواية التى شكلت نقطة حرجة فى تاريخ نجاحها عندما فشلت فى الفوز بجائزة الكتاب الوطنية، وجائزة النقاد، ما دفع ثمانية وأربعين ناقدًا وكاتبًا أسود إلى الاحتجاج ضد إغفالها، وكتبت ميتشيكو كاكوتانى، مراجعة الكتب فى صحيفة «نيويورك تايمز»: «إن مشهد الأم وهى تقتل طفلها «وحشى ومزعج للغاية، لدرجة أنه يبدو وكأنه يحرف الوقت قبل وبعد ذلك إلى خط واحد ثابت من القدر»، فيما كتبت الكاتبة الكندية مارجريت أتوود: «يبدو أن تنوع السيدة موريسون ونطاقها الفنى والعاطفى لا يعرف حدودًا. إذا كانت هناك أى شكوك حول مكانتها كروائية أمريكية بارزة، من جيلها أو من أى جيل آخر، فإن (محبوبة) ستضع حدًا لهذا».
الرواية استوحتها موريسون من قصة حقيقية لأمريكية مستعبدة من أصل إفريقى، هى مارجريت جارنر، هربت من العبودية، لكن صائدى العبيد طاردوها، وفى مواجهة العودة إلى العبودية، قتلت ابنتها البالغة من العمر عامين حتى لا تراها تُؤسر وتُستعبد من جديد، لكن تم القبض عليها قبل أن تتمكن من قتل نفسها، وتتخيل رواية موريسون عودة الطفلة الميتة كشبح، المحبوبة، لتطارد والدتها وعائلتها.

فشل الفيلم فى شباك التذاكر، وقالت مجلة «إيكونوميست»: «معظم الجماهير غير راغب فى تحمل ما يقرب من ثلاث ساعات من فيلم عقلى بقصة أصلية تتميز بموضوعات خارقة للطبيعة والقتل والاغتصاب والعبودية»، ووصفت الناقدة السينمائية جانيت ماسلين، فى مراجعة بعنوان «لا سلام من إرث وحشى»، الفيلم بأنه «تكيف مذهل وعميق الشعور لرواية تونى موريسون، بالطبع محوره الرئيسى هو أوبرا وينفرى، التى كانت تتمتع بالقوة والبصيرة لإحضاره إلى الشاشة ولديها الحضور الدرامى لربطها معًا»، وفى عام ١٩٩٦ اختارت وينفرى «نشيد سليمان» لنادى الكتاب الذى أطلقته، الذى أصبح ميزة شائعة فى برنامجها، وشاهد نحو ١٣ مليون مشاهد فقرات النادى، ونتيجة لذلك، عندما اختارت وينفرى أقدم رواية لموريسون «العيون الأكثر زرقة» للنادى عام ٢٠٠٠، باعت نحو ٨٠٠ ألف نسخة إضافية، وكتب جون يونج أن مسيرة موريسون شهدت دفعة جديدة بتأثير أوبرا التى اختارت أربع روايات لـ«موريسون» على مدار ست سنوات، كما ظهرت الروائية أيضًا ثلاث مرات فى عرض وينفرى، حتى اندهش البعض من ذلك، وقالت وينفرى: «بالنسبة لجميع أولئك الذين طرحوا السؤال: تونى موريسون مرة أخرى؟، أقول بكل تأكيد إنه لم يكن هناك نادى أوبرا للكتاب لو لم تختر هذه المرأة مشاركة حبها للكلمات مع العالم».
كانت موريسون هى أول امرأة سوداء من أى جنسية تفوز بجائزة نوبل للأدب، وقالت فى خطاب قبولها: «نحن نموت، قد يكون هذا معنى الحياة، لكننا نمتلك اللغة، قد يكون هذا مقياس حياتنا»، كما تحدثت عن قوة سرد القصص، ولإثبات وجهة نظرها روت قصة تتحدث عن امرأة سوداء، عمياء، عجوز، اقتربت منها مجموعة من الشباب، وسألوها: «ألا يوجد سياق لحياتنا؟ لا أغنية، لا أدب، لا قصيدة مليئة بالفيتامينات، لا تاريخ مرتبط بالخبرة يمكنك تمريره لمساعدتنا على البدء بقوة؟!» وقالوا لها: «فكرى فى حياتك، وفى حياتنا، وأخبرينا بعالمك الخاص، اخترعى قصة».










