لويس عوض.. المُفترَى عليه من الجميع

- خصومات لويس عوض لم تقتصر على المعروفين بسلفيتهم فقط بل امتدت إلى آخرين
مقدمة لا بد منها:
من الضرورى والمهم أن نعترف بأن هناك فجوة حضارية مريعة بين العالم الواقعى والمادى على الأرض فى مصر والعالم العربى، أو ما يسمى بتعبير أشمل العالم الإسلامى، وبين منهجية وطريقة التفكير المتبعة فى التعليم والسياسة والسلوك الاجتماعى، وكلما حاول نفر من الباحثين والمفكرين والإصلاحيين أن يضبطوا المسافة بينهما، انقلبت الدنيا كلها، ولدينا أمثلة لا تخفى عن أى قارئ أو متابع أو باحث، بداية من «قاسم أمين» فى أواخر القرن التاسع عشر عندما أصدر كتابه «تحرير المرأة»، الذى ووجه بعاصفة من الاحتجاجات والردود الغاضبة، وكتب فى تلك الردود شخصيات فكرية وموقرة آنذاك، باحثون وكتاب ومفكرون بارزون، على رأسهم الأستاذ محمد فريد وجدى، والرائد الاقتصادى محمد طلعت حرب، وحدث أن لحق الرجل بعض أذى من الهيئة الاجتماعية بعدما أصبح منبوذًا عند المشايخ، وبعض رجال الأزهر الذين شنوا هجومًا على الرجل جعله حديث المنابر فى ذلك الوقت، حتى الزعيم مصطفى كامل صديقه، كتب مقالًا فى جريدته «اللواء» ينقد الكتاب بشدة.

نستثنى فى تلك المرحلة ذلك الحوار الفكرى الممتع والديمقراطى الذى دار بين الشيخ محمد عبده، والكاتب والأديب والمسرحى فرح أنطون الذى أتى من الشام هو ورتل من المثقفين العتاة، أبرزهم: يعقوب صروف وفارس نمر وخليل مطران وجُرجى زيدان ونقولا حداد وغيرهم، عندما ضاق مناخ الحرية هناك، واستطاعوا أن يحدثوا طفرة فى الوعى النخبوى والجمعى فى مصر، وأصدروا مجلات وكتبًا، وأقاموا مسارح شعبية، وبرز من كل هؤلاء مفكرون وفنانون وأدباء كثيرون، منهم: فرح أنطون الذى أنهى دراسته فى مدرسة أرثوذكسية فى طرابلس، وجاء إلى مصر فى عام ١٨٩٧، ويغيب بعض الوقت فى أمريكا، ويعود ليستقر فى القاهرة، وينطلق فى عمل صحفى وثقافى عام، عبر حوارات وسجالات ذات أهمية خاصة، وكان أهم تلك المساجلات ما دار بينه والشيخ محمد عبده ورشيد رضا، وأنجز مجموعة من الترجمات مثل كتاب «حياة يسوع» لرينان، و«مناقشات نيتشه وتولستوى»، وكان من بين أبرز إبداعاته روايته «أورشليم الجديدة» عام ١٩٠٤، ثم بحثه الكبير «ابن رشد وفلسفته» الذى نشره مجتزئًا أولًا فى مجلته الجامعة، ثم ضم إليها كل الردود التى كتبها محمد عبده على آرائه حول «ابن رشد وفلسفته»، وكذلك ردوده هو على تلك، وكان صدور الكتاب لأول مرة عام ١٩٠٣ فى الإسكندرية، أى فى وقت كان التراكم الثقافى العربى التنويرى قد حقق أصداءً ملحوظة فى الحياة الثقافية- كما يكتب طيب تيزينى فى تحقيقه للكتاب- ولا نريد أن نسترسل فى عرض وتحليل الكتاب، فقط أردت أن أشير إلى حوار كان مثمرًا فى بداية القرن العشرين، قبل أن تستفحل الظواهر السلفية الرجعية، وتصنع لها مؤسسات ومراكز وصحفًا كثيرة ومدعومة من جهات عديدة، ويظل الحوار بين فرح والشيخ محمد عبده من أعمق ما جاء فى تلك الفترة.
بعد ذلك كان صدام الشاعر بيرم التونسى مع الشيخ قبيل ثورة ١٩١٩، ومهاجمة الشيخ لكل من يحتج أو يعترض، فكتب التونسى قصيدته الشهيرة التى بدأها بـ:
«أول مانبدى القول
يلعن أبوك يابخيت».
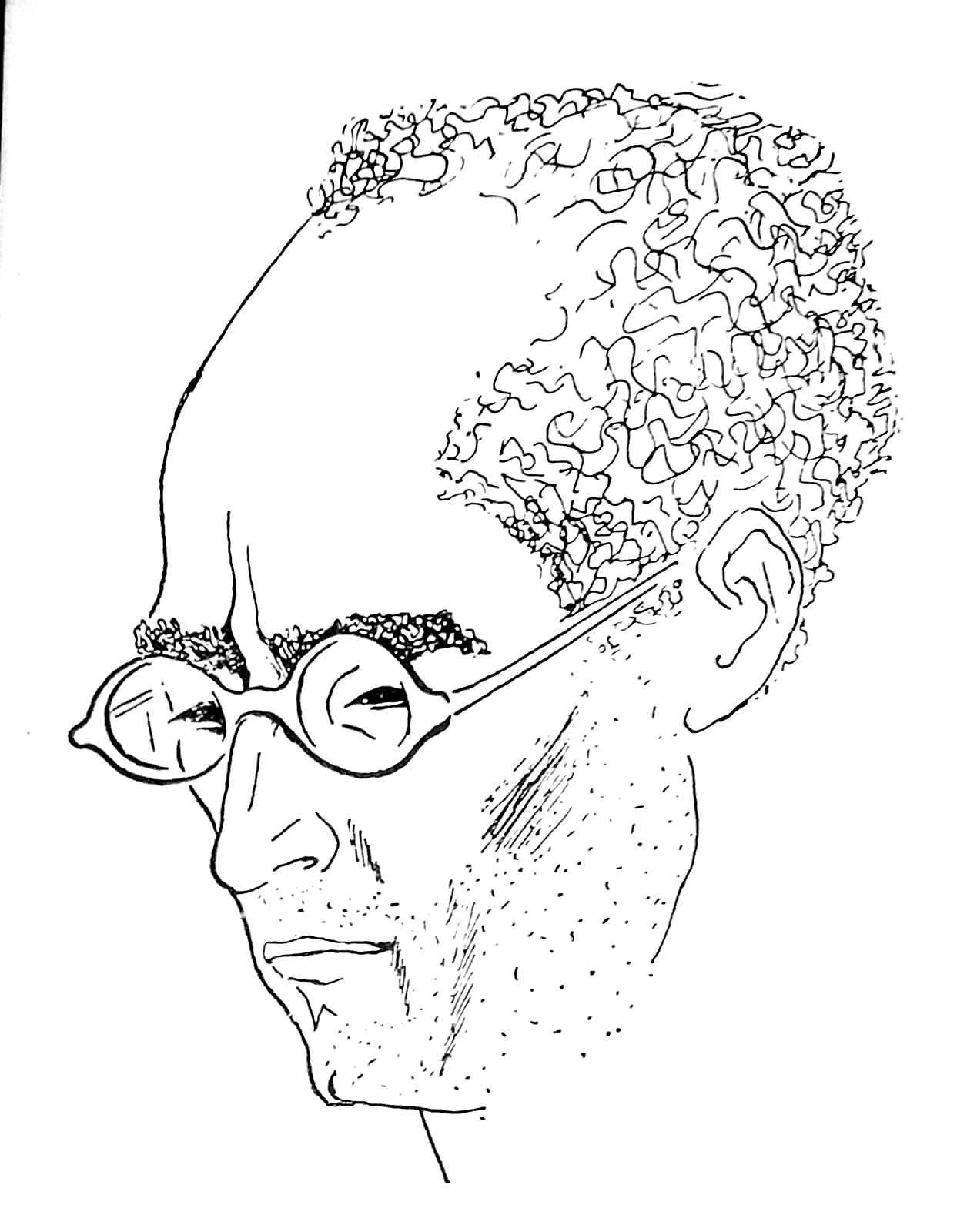
رسمه على قهوة ماتياس عام ١٩٤٦
ثم جاءت ثورة ١٩١٩ وجاء معها زخم تنويرى كتتويج لكثير مما سبق من كفاح لكتاب وساسة وإصلاحيين، وحدثت طفرة طليعية للأمام، وتكون حزب شيوعى جاء على رأسه الكاتب المفكر سلامة موسى، ومحمد عبدالله عنان، ومحمود حسنى العرابى، وشعبان حافظ وآخرون، ولكن تمت تصفيته سريعًا، حيث إن العناصر الرجعية انتبهت لدوره الذى بدأ ينمو ويتزايد، وربما لم يكن الظرف مواتيًا لاستيعاب ذلك الحزب بكل أفكاره، ونشأت فى تلك الفترة مجموعة صحف ومجلات حزبية، مثل صحيفة «البلاغ» جريدة حزب الوفد، التى كتب فيها عباس محمود العقاد سلسلة مقالات مهمة تحت عنوان «ساعات بين الكتب»، وعباس حافظ الذى ترجم عيون الأدب من الشرق والغرب، وزكى مبارك الذى انفتح على الأدب العربى فى عصور محورية من تاريخه، وكانت جريدة «السياسة» على الطرف الآخر الصادرة عن حزب الأحرار الدستوريين، تنشر لأكثر الكتاب ليبرالية، رغم أنه حزب كبار الملاك، فكان يكتب فيها الأخوان المستنيران على ومصطفى عبدالرازق، وعبدالعزيز البشرى، ومى زيادة، ومحمد حسين هيكل مؤلف رواية زينب، وكان رئيس تحريرها، وعزيز ميرهم، ومحمد عبدالله عنان، وهكذا، وحدثت طفرة صحفية وثقافية كامتداد لأفكار وتوجهات الثورات.
فى ظل ذلك، وفى ٣ مارس عام ١٩٢٤، سقطت الخلافة العثمانية فى تركيا، وكان قائدها كمال أتاتورك، وتم إلغاء منصب الخلافة إلى الأبد، هنا بدأت مطامع الملك فؤاد، ملك مصر، تنشط لتولى تلك الخلافة، وحتى لا تكون هناك شبهة ما، استقر الرأى- كما يكتب محمود عوض فى كتابه «أفكار ضد الرصاص»- على أن يقوم الأزهر بالدعوة إلى مؤتمر إسلامى فى القاهرة، الهدف الظاهرى بحث موضوع الخلافة بعد سقوطها فى تركيا، والهدف الحقيقى لإقناع ممثلى الأقطار الإسلامية بمبايعة الملك خليفة للمسلمين، لذلك هرول بعض المشايخ من أجل إقامة ذلك المؤتمر، لكى ينتهى بتتويج الملك فؤاد خليفة للمسلمين، وتم تكليف شيخ شاب من المنصورة اسمه على عبدالرازق بالاشتراك فى ذلك المؤتمر، ولم يكن معنى ذلك الاختيار إلا لسمعة عائلة عبدالرازق التى تضم فى إهابها كثيرًا من العلماء والباحثين، وكانت المفاجأة مدوية، وهى عبارة عن كتابه «الإسلام وأصول الحكم»، الكتاب الذى أثبت أن موضوع الخلافة لم تكن له أى استنادات فقهية، وبالتالى ضرب فكرة الخلافة فى مقتل، ومن هنا بدأت الحملة على الشيخ الشاب بضراوة لم تنقطع على مدى عقود عديدة تالية، وتم فصل الرجل من تلك الهيئة التى تسمى هيئة علماء الأزهر، وكان ذلك فى عام ١٩٢٥، والقضية مشروحة ومعروضة بكل تفاصيلها فى كثير من الكتب.
ثم جاءت قضية كتاب «فى الشعر الجاهلى» للدكتور طه حسين فى عام ١٩٢٦، لتشهد الساحة الفكرية والسياسية والثقافية لغطًا أكثر مما حدث فى موضوع الخلافة الإسلامية فى كتاب الشيخ على عبدالرازق، وتم التربص بطه حسين فى كل العقود التى جاءت بعد ذلك، وظلت عقدتا كتابى «الإسلام وأصول الحكم، وفى الشعر الجاهلى»، تطلان على كل حدث تنويرى يأتى لوأده، وتأسست جماعة الإخوان المسلمين فى عام ١٩٢٨، كمؤسسة شعبية إسلامية، وتكون دون رابط أو ضابط، وتكمل ما لم تستطع مؤسسة الأزهر الرسمية أن تقوم به، فرسخت للعنف، ولأسلمة كل شىء فى الثقافة والمجتمع، وهناك شبهة قوية جدًا فى اغتيال الكاتب والمفكر الشاب إسماعيل أحمد أدهم، الذى كتب مقالات تحت عنوان «لماذا أنا ملحد؟»، بعدها تم إلقاؤه فى البحر المتوسط، ليقال بأنه انتحر، ثم سلسلة الاغتيالات الأخرى، ومحاولة شق صف الأمة المصرية، ووضع عناصر وبذور الكراهية بين المسلمين والمسيحيين، ومن هنا بدأت تلك الكراهية تعمل فى كل المجالات، وعلى رأسها المجالان الفكرى والثقافى.
هذا هو المناخ الذى بدأ فيه الدكتور لويس عوض، مسيحى الديانة، أستاذ الأدب الإنجليزى، العائد من الغرب، والمتأثر بثقافته وعلومه، القارئ النهم للتراث العربى، والمنفتح على كل الثقافات، والذى كان مبعوثًا بتوصية من الدكتور طه حسين.
كان أول إصدارات لويس عوض عبارة عن طفرات فكرية متتالية، وهو ترجمة كتاب «فن الشعر» لهوراس، كتبه فى كامبريدج عام ١٩٣٨، ولكنه نشر فى عام ١٩٤٥، ثم كتاب «برومثيوس طليقا»، ونشره عام ١٩٤٦، بعد ذلك ترجم «صورة دوريان جراى» لأوسكار وايلد، وصدرت عن دار الكاتب المصرى عام ١٩٤٦، وفى العام نفسه ترجم لوايلد أيضًا روايته «شبح كانترفيل»، ونشرها له أيضًا الدكتور طه حسين فى دار الكاتب المصرى التى كان يديرها.
أما قنبلته الكبرى فكانت ديوانه الشعرى «بلوتولاند»، ذلك الديوان الذى لاقى صخبًا منذ صدوره، وتربص به كثيرون، رغم أن ذلك الديوان كان فى مقدمة حركة الشعر الحديث كلها، وحاول لويس عوض فى مقدمة الديوان أن يضع أسسًا لكل ما جاء به من تجديد وأفكار ثورية، ونشر الديوان عام ١٩٤٧ فى طبعته الأولى.
يبدأ لويس عوض مقدمته بمقولته المدوية التى تحمل عنوانًا ثوريًا وهو «حطموا عمود الشعر»، ثم تقول المقدمة: «لقد مات الشعر (العربى).. متى مات؟.. عام ١٩٣٢، مات بموت أحمد شوقى، مات ميتة الأبد، فمن كان يشك فى موته، فليقرأ جبران ومدرسته وناجى ومدرسته، أما شعائر الدفن فقد قام بها أبوالقاسم الشابى وإيليا أبوماضى وطه المهندس ومحمود حسن إسماعيل وعبدالرحمن الخميسى وعلى أحمد باكثير وصالح جودت وصاحب هذا الكتاب».
تكفى هذه المقدمة الأولى لكى تثير عليه كثيرًا من النقمة، وتأويل كل ما فى المقدمة إلى مهمة تخريب الشعر العربى، وإفراغه من مضمونه، وإفساد الذائقة العربية، أى أن الذائقة العربية كانت تنتظر لويس عوض لكى يفسدها.
ولا يتوقف عوض عن إرسال أفكاره، ويكمل بعد استطرادات أخرى فيقول: «فالشعر لم يمت، وإنما مات الشعر العربى، وحقيقة الحال أن عمود الشعر العربى لم ينكسر فى جيلنا، وإنما انكسر فى القرن العاشر الميلادى، كسره الأندلسيون، وحقيقة الحال أن الشعر العربى لم يمت فى جيلنا وإنما مات فى القرن السابع الميلادى، قتله المصريون وأصدق من هذا أن يقال إن الشعر العربى فى مصر لم يمت، لأنه لم يولد قط بها».
لا بد أن نذكر أن لويس عوض كتب على غلاف ديوانه «بلوتولاند، وقصائد من شعر الخاصة»، ولذلك اهتم كثيرون بتلك المقدمة التى طالت، والتى أصبحت من كلاسيكيات الحداثة الشعرية فى مصر والعالم العربى، ولكن المتابعين من مهاجمين ومن مؤيدين، لم يلتفتوا إلى الشعر نفسه الذى كتبه عوض فى ذلك الديوان، ومن وجهة نظرى أنه كان مقدمة لأشعار كثيرة أتت بعد ذلك من شعراء كبار، وأول هؤلاء الشاعر صلاح جاهين فى رباعياته، ففى «بلوتولاند» يقول عوض فى مقطوعة عنوانها «عذاب الصوفى»:
«لغز الحيا ده سكرة،
الله نفخ من روحه،
فى طينة لسه بكرة،
الله محبة، قالوا:
إزاى باحب وأكره؟
هو النبيت مش صافى،
ولا القزازة عكرة».
ثم يقول فى مقطوعة أخرى عنوانها «الأجل»:
«أوتار الفن طقت،
واللحن لسه فكرة،
حرام ياموت تاخدنى،
قبل ما أغنى بكرة».
ثم فى مقطوعة ثالثة عنوانها «تابلو» يقول:
«جنية ليها ريش،
اتمددت عريانة،
تتشمس ع الحشيش
وطبقت خجلانة،
ستاير الرموش،
حر الجنوب لفحها،
قالت تعالى حوش»
هذه المقطوعات كانت مقدمة ثورية وجذرية للغاية فى النظرة الجديدة لشعر العامية المصرية، وأعتقد أنه كان حافزًا ومحرضًا على التجديد الجذرى الذى حدث على أيدى فؤاد حداد وصلاح جاهين، أمير شعراء العامية، كما قال عنه عوض نفسه فى سلسلة دراسات سنتعرض لها فى الحلقات القادمة إن شاء الله، وكان تجديد وسطوع شخصية عوض الشعرية فى صوره المذهلة، «ستاير الرموش»، ومفردات مثل «اتمددت، لفحتها»، وهكذا مما يحتاج إلى دراسة كاملة لوضع أيدينا على العناصر التخييلية التى أتى بها عوض فى تلك المرحلة المبكرة من ثورة الشعر الحديث، كما أن ما أتى به فى الفصحى كان مذهلًا أيضًا.
وبالطبع لم يستسغ النقاد فى تلك الفترة ذلك الديوان، ولا دعوته، ولا قصائده، وظل الديوان يعانى من أشكال الهجوم مرة، ومن أشكال التجاهل مرة ثانية، ومن أشكال إزاحته من الحالة الثورية التى تجعله من أوائل الدواوين التى رسخت ثورة الشعر الحديث على أيدى شعراء كبار مثل بدر شاكر السياب ونازك الملائكة فى العراق.
ولا أريد أن أقول إن لويس عوض كان أسبقهم فى النشر، ولكنه كان أسبقهم فى الكتابة، حيث إن قصيدة الكوليرا لنازك الملائكة، كتبت ونشرت فى عام ١٩٤٧، وقصيدة «هل كان حبًا؟» لبدر شاكر السياب جاءت فى تلك الفترة، ولكن من كتبوا التاريخ، قالوا إن السياب كان أسبق فى الكتابة، ولكنه لم يكن أسبق فى الشعر، وقالوا إن السياب كتب قصيدته قبل قصيدة نازك بشهرين، أما لويس عوض فقد سبق الاثنين بستة أعوام، أى كتب قصائده فى كامبريدج عام ١٩٤٠، لكن لم يتطوع باحث لرصد تلك التفاصيل حتى تظل الريادة لنازك والسياب مكتوبة لهما بشكل أبدى.
وهذا الأمر الذى استبعد لويس عوض كان لسببين، السبب الأول يتلخص فى أن الذائقة فى ذلك الوقت لم تكن مهيأة إطلاقًا لتقبل دعوات لويس عوض الثورية، إذ كانت قصيدتا السياب ونازك تلقيان هجومًا كبيرًا، القصيدتان اللتان كانتا تلتزمان بالتفعيلة، ولكنهما لم يحطما الإيقاع، فما بالنا بشاعر يدعو لتحطيم الشعر العربى، أما السبب الثانى، فهو أن لويس عوض كان دخيلًا على الشعر كما قال كثيرون من خصومه فى ذلك الوقت، فلم يعبأ أحد بفحص ذلك الأمر، حتى جاء المحقق «محمود محمد شاكر»، لكى يكيل له اتهامات كثيرة، ويربط بينه وبين سلامة موسى، وغالى شكرى، فقط لأن الثلاثة، مسيحيون، ولم يكتف بذلك فحسب، ولكن اتهمه بالجاسوسية، مما سنفصله لاحقًا.
وكنت أعتقد أن الهجوم على عوض سوف يقتصر على باحثين وكتاب ومفكرين يعتنقون التوجه السلفى أو الأصولى فى الثقافة العربية، ولكننى لاحظت أن الخصومة والعداء يمتدان إلى باحثين ونقاد بعيدين تمامًا عن أن يكونوا كذلك، على سبيل المثال: فاروق عبدالقادر، ورجاء النقاش، وسوف أشير هنا إلى ما كتبه فاروق عبدالقادر فى كتابه «أوراق أخرى من الرماد والورد»، الصادر عن مؤسسة العروبة عام ١٩٩٠، والمقال عنوانه «بلوتولاند، تلك النكتة السخيفة القديمة»، ولا بد أن أشير هنا إلى أن الناقد فاروق عبدالقادر نادرًا ما كان يتعرض لنقد الشعر، لأنه كان مهتمًا بشكل أساسى بنقد الرواية، والمسرح، والقصص القصيرة، ثم بعض قضايا الثقافة العامة، وجاء مقاله فى أعقاب نشر طبعة ثانية من الديوان عام ١٩٨٩ فى الهيئة العامة المصرية للكتاب، وجاء فى مستهل مقاله: «لا أعرف ما أصاب لويس عوض وناشره- وهو ناشر الدولة- فجعلهما يطلقان علينا تلك النكتة السخيفة القديمة التى اسمها بلوتولاند وقصائد أخرى»، ولا بد أن نلمس هنا نبرة التحريض فى التنويه إلى أن الناشر هنا، هو ناشر الدولة، وكأنه يستكثر على لويس عوض أن يستمتع بما تمنحه الدولة لكل الكتاب، أو لا يحق له ذلك، فيسترسل قائلًا: «نعم، كنا نعرف هذه النكتة من قبل، ونتندر بها فى مجالسنا، وبعضنا يحفظ للويس عوض كلمات مأثورة لمثل هذا التندر، منها لقد مات الشعر العربى.. مات مات..»، ويسترسل عبدالقادر فى تسخيفه وتحقيره لذلك الديوان الرائد، لكى ندرك أن خصومات لويس عوض لم تقتصر على المعروفين بسلفيتهم فقط، بل امتدت إلى آخرين كما سنوضح لاحقًا إن شاء الله، لكى ندرك أن الأفكار السلفية كانت، وما زالت قائمة وفاعلة فى العقل النقدى العربى كله.









