شعراء وأجراء.. من الأبنودى ونجم إلى هشام الجخ.. عندما تصبح القصيدة مجرد «لقمة عيش»

- من حق الكاتب أن يبحث عن مصادر لزيادة دخله.. ولكن ليس بتحويل الشعر إلى «نمرة» فى فرح
- عندما اهتم الشعراء بإثارة الضحك والتصفيق تحولت القصيدة إلى مجرد فقرة ترفيهية لا علاقة لها بالأدب
- فعلها الأبنودى ونجم قبل الجميع.. لكن يشفع لهما ما أنتجاه من أعمال مؤثرة ومحفورة فى الوجدان
لست ممن يطلبون من الشعراء أن يعيشوا مرارة الفقر والحاجة، أو حتى العيش على حد الكفاف.. لم أحب يومًا أن يتحول الكتاب والمبدعون إلى نموذج شاعر البؤس الأشهر عبدالحميد الديب، الذى وصف حاله فى كثير من القصائد المتداولة، مثل قوله «تحملت صبر أيوب من الضنا، وذقت من هزال الجوع ما يفوق غاندى»، وقوله الأشهر «هام بى الأسى والفقر حتى.. كأنى عبلة والبؤس عنتر، كأنى حائط كتبوا عليه: هنا أيها المزنوق...»، والحقيقة أننى لا أريد المزايدة على أحد بادعاءات الترفع والسمو فوق حاجات الدنيا، واحتياجات الأفراد البسيطة والمشروعة، ولا القول بأن «كل الأمور تمام» ولا يوجد ما يدعو الأديب والكاتب إلى البحث عن زيادة مصادر دخله، أو الطموح فى سعة الرزق كطريق لحياة أفضل.. لكننى أيضًا لا أستطيع القبول أو الموافقة على تحولهم إلى مستأجرين و«أرزقية» ومهرجين فى حفلات الترفيه عن بعض الميسورين، أو من يملكون براحًا من الوقت يبحثون عن ملئه بالفرجة والاستماع إلى بعض النكات والقفشات الموزونة والمقفاة.. لا أتخيل أن صفوة عقول الأمة، أى أمة، يمكن أن تتحول إلى مجرد أراجوزات يتم استخدامها للترفيه عمن يقدرون على الدفع، أو لغسيل سمعة من يملكون السلطة والمال، ولو عن طريق مؤسسات خيرية تمنح ما يتبقى لديها من فتات فى صورة جوائز أو منح وعطايا وهبات.. وأغلب ظنى أن هناك دائمًا مساحة للتوازن والبحث عن حياة لائقة، فلا يمكن أن يكون الاستئجار لمن يدفع أكثر هو البديل عن الفقر والاحتياج.. لا نموذج المتنبى فى علاقته بكافور الإخشيدى، وتحوله من مدحه بأروع الصفات، إلى سبه بأبشع العبارات لمجرد أنه لم يعطه ما كان يطلبه، هو النموذج المطلوب أو الأمثل، ولا بؤس عبدالحميد الديب هو المثال للرد على ما أريد الذهاب إليه والحديث عنه.

بين الشاعر والمتربح من الكتابة
فى ذاكرتى واقعتان ليستا على درجة كبيرة من الأهمية فى غير بدايات تعرفى على شعر العامية كمصدر للرزق، لكنهما توضحان الفارق بين الشاعر وبين المتربح من كتابته، سواء اتفقنا على وضعها فى خانة الشعر أم «العرض الترفيهى»، وذلك بخلاف ما نعرفه جميعًا من قصص تخص شعراء العربية الأوائل.
تفاصيل الواقعة الأولى تعود إلى نهايات عام ٢٠٠٣، وكنت وقتها المسئول عن صفحة الثقافة بإحدى الصحف الأسبوعية التى تعتمد فى صدورها على ما تحصل عليه من إعلانات، وتصدر بأعداد قليلة خارج مصر، وقتها حدثنى مالك الصحيفة عن رغبته فى استكتاب الشاعر أحمد فؤاد نجم مقابل أى مبلغ يطلبه، وكنت من زواره فى «مجلس قيادة السطوح» بالمقطم، ومقر دار «ميريت» الأول بجوار مسرح وسينما قصر النيل، فكان أن حدثت نجم عن تلك الرغبة، ولأنه لم يكن يهتم كثيرًا بغير شرط المحبة، ابتسم وسألنى «إنت إيه رأيك؟!»، فشرحت له تصورى للأمر، ثم وافق عندما ذكرت له أنه ليس مضطرًا للذهاب إلى مقر الجريدة، وأننى سوف أتولى كل التفاصيل بما فيها تسلم وتوصيل مكافأة النشر التى لم يناقشنى فيها.. والطريف أننا اتفقنا فيما بعد على أنه ليس مضطرًا لكتابة مقالات جديدة لصحيفة لا يقرأها أحد، وأننى سوف أقوم بإعادة نشر مقالاته القديمة التى كنت أحتفظ بها، ومراجعتها معه قبل إعادة النشر.. ثم لم يسألنى بعدها عن أى شىء، رغم أن هذه القصة استمرت حتى مغادرتى الصحيفة لتغير رئيس التحرير، وأذكر أن رئيس التحرير الجديد هاتفه يطلب المقال الجديد، لكنه اعتذر طالبًا منه التواصل معى، وهو ما لم يكن ليفعله، فلم يكن بيننا أى شكل من أشكال العمار.

الواقعة الثانية حدثت بعدها بنحو عشر سنوات، وتحديدًا فى منتصف ٢٠١٣، وكنت مسئولًا عن التحرير المركزى بإحدى الصحف اليومية التى تجمعنى برئيس تحريرها صداقة قديمة، وقتها حدثنى رئيس التحرير غاضبًا عن تواصله مع هشام الجخ، وهو مقدم فقرات استعراضية قريبة من الشعر، وكان فى حالة دهشة واستغراب كبيرين، وقال لى إنه عندما طلب من الجخ كتابة مقال أسبوعى للجريدة، أبلغه بأن يتصل بمدير أعماله للاتفاق على التفاصيل، ثم أرسل إليه مدير أعماله المذكور بريدًا إلكترونيًا بطلباته واشتراطاته للكتابة، والتى تضمنت طلب مبلغ مالى مبالغ فيه جدًا، إلى جانب قائمة طويلة من المواصفات، كالإشارة إلى المقال فى الصفحة الأولى من العدد مع صورة يختارها بنفسه، وغيرها من المسائل التى انتابتنى حالة من الشك فى صحتها، ورغم أنه لم يكن يسألنى الرأى فى الأمر، قلت له إن ذلك الشخص لن يضيف شيئًا للجريدة، ولا حاجة بنا إلى ما يكتبه من تصورات أو حواديت أراها بلا قيمة، ولكنه احتج بأن لديه جمهورًا كبيرًا، ثم راح يحكى عما يعرفه من تفاصيل ما يحصل عليه من عائدات «حفلاته» العامة فى تونس، ومثيلاتها فى عدد من الدول العربية التى يتهافت أثرياؤها على طلبه لإحياء سهرات خاصة بمنازلهم، وهو ما أكده لى أحد المسئولين عن فعاليات ثقافية بدولة الإمارات، وهو يحكى لى عن طلب أحد النافذين استقدام الجخ لتقديم فقرة ضمن برنامج إحدى الحفلات، ولكنه عندما اطلع على قائمة طلباته له ولمرافقيه أو مساعديه، حسبما جاء فى البريد الإلكترونى، وأبدى تحفظه على مثل هذه الطلبات للشيخ المسئول عن الفعالية، كان رده «اعطه ما طلب»، قبلها كنت أسمع الكثير من الحكايات عن الأقراط والخواتم والمشغولات الذهبية التى كانت تلقى تحية للراحل عبدالرحمن الأبنودى فى الحفلات الخاصة بالكويت والسعودية وعدد من دول الخليج، ولم أكن أصدقها، وإن كنت أعرف عن الأبنودى أنه لم يكن يرفض هدية، وإن جاءته بصورة ربما لا يقبلها غيره، وهو ما كان يحدث أيضًا مع نجم والشيخ إمام، خصوصًا خلال سنوات حكم الرئيس السادات، فى دول ما كان يعرف وقتها بجبهة الصمود والتصدى، وتكرر فيما بعد مع كثير من شعراء العامية، ما انعكس على قصائدهم ومنتجهم الشعرى بالسلب، وليس عليك لمعرفة ذلك والتأكد من حدوثه سوى البحث عن كم القصائد غير المنشورة لنجم والأبنودى وغيرهما، وكلها قصائد كتبت بهدف مغازلة أو مجاملة صاحب الحفل وجمهوره أو ضيوفه، الذين نسميهم فى مصر «المعازيم».. على أن ذلك لا يقلل فى ظنى من قيمة ما أنتجاه كاثنين من كبار شعراء العامية المصرية، يشفع لهما ما أنتجاه من أعمال كثيرة ومهمة ومؤثرة ومحفورة فى الوجدان المصرى والعربى، لكننى لا أجد ما يشفع للأجيال الجديدة من مقدمى فقرات ما يسمى شعر العامية، من أمثال الجخ وعمرو حسن وشاعر الفلاحين الذى لا أعرف اسمه، لكننى شاهدت له فقرة تليفزيونية «يرط» فيها أزجالًا رديئة، ومليئة بالأفكار المتخلفة، والقفشات التى تهلل لها مذيعة لا أذكرها، وترتفع معها ضحكات الجمهور، ويعلو تصفيقهم «على الفارغة والمليانة»، فلا خيال، ولا مشاعر ولا لغة، ولا شىء سوى بعض العبارات المرصوصة فيما يشبه الزجل، لتسول الضحكات، والتصفيق، و«تحليل لقمة العيش».

شهادة من داخل البيت
ما لفت نظرى إلى هذه المسألة، ودفعنى للتوقف أمامها، وتأملها والبحث فيها، هو ما كتبه الشاعر الكبير إبراهيم عبدالفتاح فى العدد الأخير من «حرف»، فى إطار حديثه عن الأسباب التى أدت إلى انتكاسة قصيدة العامية المصرية، وتراجعها عما كان متوقعًا لها منذ بدايات الألفية الجديدة، وبعد انطلاقة قوية بدأها شعراء الثمانينيات والتسعينيات، تحولت معها إلى مجرد باب للرزق والترفيه، لا علاقة له بالأدب والفن.
يقول إبراهيم عبدالفتاح فى مقاله الذى أراه بمثابة شهادة شديدة الأهمية من داخل البيت، ما نصه: «فى مطلع الألفينات، بدأ نمط جديد يفرض نفسه على المشهد الشعرى العامّى، حفلات الشعر. وهى لقاءات تُنظم فى المقاهى أو المراكز الثقافية أو حتى قاعات الحفلات، لقاء تذكرة يتقاسم عائدها كل من الشاعر وصاحب القاعة، حفلات يُلقى فيها الشعراء قصائدهم وسط تصفيق وهتافات الجمهور، أحيانًا على وقع الموسيقى، وأحيانًا بطريقة أقرب إلى الـ«ستاند أب»، ويضيف عبدالفتاح: «ورغم أن هذه الحفلات أسهمت فى إعادة الجماهير إلى الشعر، إلا أن لها جانبًا آخر أقل بريقًا، إذ دُفعت القصيدة أحيانًا إلى التخلى عن تعقيدها وجمالياتها الجديدة لصالح الإفيه، والإثارة السريعة، واللعب على ذائقة اللحظة. صار بعض الشعراء يكتبون لا لتأمل العالم، بل لإثارة الضحك أو الصدمة أو التصفيق، ما سطّح القصيدة وحوّلها إلى منتج ترفيهى أكثر منه عملًا أدبيًا».
مقال إبراهيم عبدالفتاح فتح فى قلبى جراحًا قديمة، وأعادنى إلى أيام كنت أنظر فيها بغضب إلى ما كنت أسمع عنه من حكايات، وما يحدث قدام عينى من ممارسات متدنية باسم الشعر، وباسم قصيدة العامية المصرية على وجه التخصيص.. والتخصيص هنا مصدره أنه بخلاف قصيدة الفصحى، التى قلما تجد من يتحمس لتلحينها وغنائها، مع تراجعها فى مواجهة غزو اللغات الأجنبية المدارس والجامعات فى كثير من مجتمعاتنا العربية، فإن شاعر العامية بمقدوره كتابة الأغنية التى يمكن اعتبارها مصدرًا جيدًا للدخل، سواء من حيث حقوق الأداء العلنى فيما بعد الإصدار، أو بالتعاقد المباشر مع منتجى الغناء، شركات كانت أم أفرادًا، لكن حتى هذه لم تفلت من فخ الجماهيرية الخادعة، ومن الهبوط الحاد فى الذائقة، وبدلًا من إثارة الخيال، وإيقاظ المشاعر الدفينة، والتعبير عن الكامن من عواطف وتطلعات، انحدرت الأغنية إلى هاوية القفشات و«الإفيهات» لإثارة الضحكات، وتحريك العضلات المتيبسة، فحطت كلمات من نوعية «ماهى كده كده بايظة»، إلى جوار «المشربيات عيونك بتحكى على خلق ولت.. سهرت وصلت وعلت، فى الصخر شقت ما خلت» رائعة عبدالرحيم منصور، التى غناها محمد منير، وبدلًا من التحليق مع عصام عبدالله وهو يقول «فى قلب الليل، وعزف الصمت متهادى كموج النيل»، أو جمال بخيت فى رائعته «أنا كنت عيدك، تنقص نجوم السما أزيدك»، لعلى الحجار، تراقصت على إيقاعات «كاتش كادر فى الألولو»، وهبطت إلى هاوية «كل مرة أشوفك فيها يبقى نفسى آآ».. هكذا انتقلت الأغنية إلى جوار ربها لا حول لها ولا قوة، ولم يبق منها سوى بعض المهرجانات، والإيقاعات الصاخبة، والكلمات المحرضة على العنف والانتقام والسباب و«المعايرة»، وكلها يكتبها شعراء للإيجار، مجرد مستأجرين جاهزين للكتابة ورص الكلمات حسب نغمات أو ألحان مسروقة أو منقولة من الشرق والغرب بقليل من التصرف، وبدون تصرف فى كثير من الأحيان.
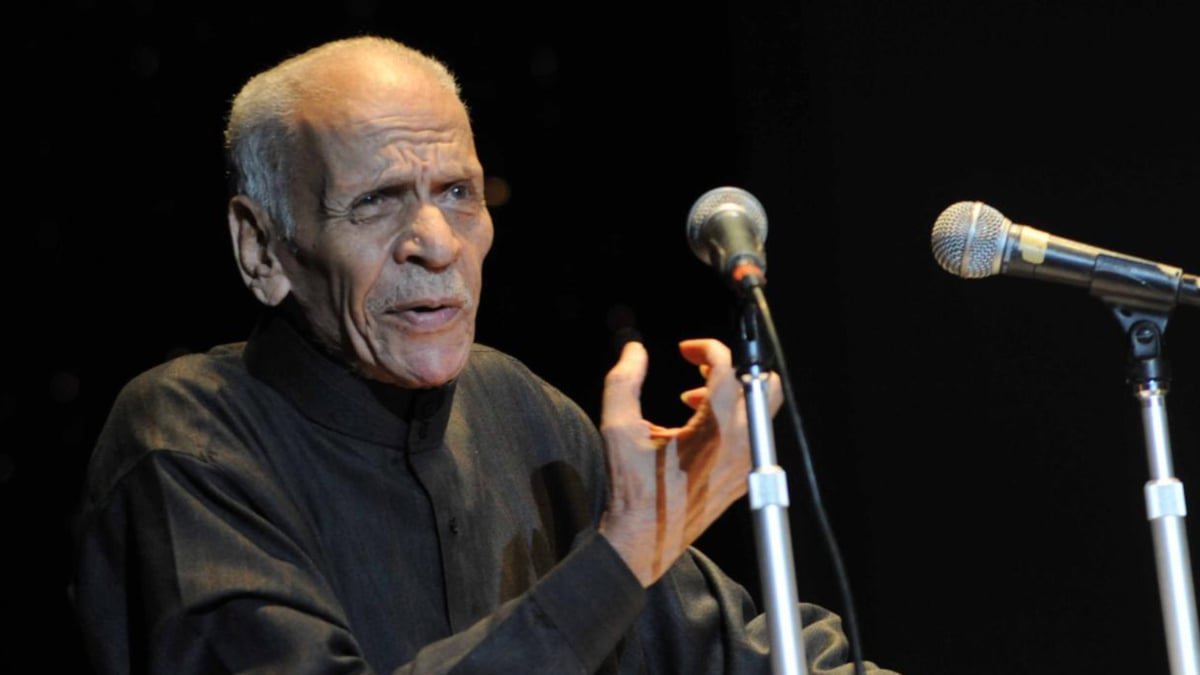
وللنشر حكاية أخرى
ربما يتحجج البعض بما يحدث فى سوق نشر الأدب بصورة عامة، وبما يفعله بعض الناشرين من طلب مشاركة الشعراء فى تمويل نشر كتبهم، ودفع تكاليفها، ثم مشاركتهم فيما يجنون من أرباح تالية، سواء فى صورة جوائز أو غيرها من عائدات، وهو رأى صحيح إلى حد كبير، لا يمكننى مخالفته، خصوصًا مع تحول كثير من الناشرين إلى مجرد تجار للورق، لا ينظرون إلا إلى حسابات الربح والخسارة، فيقبلون بنشر أى كلام طالما سيدفع المؤلف تكاليف طباعته.. لكننى أظن أن الكاتب هو أصل المشكلة، وهو وحده من يملك مفاتيح حلها، خصوصًا مع تعقيدات مسألة العلاقة بين الناشر والمؤلف وتشابكاتها الكثيرة، حتى إنها أصبحت واحدة من المشاكل المزمنة فى عالمنا العربى، ليس فى مصر وحدها، ولا فيما يتعلق بقصيدة العامية دون غيرها.. فهى الأزمة التى تطول الرواية والقصة والمسرح والفكر والأدب، وكل فروع المعرفة، وهى أزمة شديدة التعقيد، ومليئة بالتشابكات التى تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد، وإلى مساحات للحوار بين أطرافها كافة.
مرة أخرى، لست هنا لكى أدين من يطلب مقابل إبداعه، أو يبحث لنفسه ولأسرته عن مكان يليق بما يقدم من فن وإبداع، ولكن للبحث فى أسباب تحول الشاعر من وريث للنبى، ومن منادٍ بالحق، ومحرض على الخير والجمال، من باحث عن سر الإنسان، وكواليس رحلته مع الحياة، إلى مسخ مقلد يحيا على الفتات، يقف فى موقع المهرج، أو مضحك الملك، ولا أجدنى فى موقع المدافع عنه، ولا من يحسنون الظن بما فى النوايا، أو من يلتمسون لهم الأعذار.









