محمد طرزى: سعادتى مضاعفة لاقتران اسمى بـ«نجيب محفوظ».. والوضع فى لبنان دفعنى لكتابة «ميكروفون كاتم صوت»

- القائمون على النظام السياسى فى لبنان شوّهوا البلد.. وأزعم أننى إفريقى بقدر ما أنا لبنانى
- فضلت أن تكون الحوارات بالدارجة اللبنانية لأنها رواية اجتماعية تعكس حياة الناس وثقافتهم
- القاهرة قلب العالم.. وكل شىء فيها ملهم سواءً التاريخ والحاضر أو تطلّع ناسها إلى المستقبل
قبل نحو عقدين من الزمان، انتقل الكاتب اللبنانى محمد طرزى للإقامة فى دولة موزمبيق، التى صارت مستقرًا له، وهناك، قرب الساحل الشرقى من القارة الإفريقية، انبهر طرزى بالحضور العربى التاريخى فى شرق القارة، فنبش فى هذا المبحث، ومن ثم كتب رواياته التى تتناول هذا التاريخ وتلك الجغرافيا.
أصدر طرزى روايات: «جزر القرنفل.. حكاية الحلم الإفريقى» و«ماليندى» و«إفريقيا.. أناس ليسوا مثلنا»، و «رسالة النور.. رواية عن زمان ابن المقفع».
وقبل أيام أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ العريقة، وكان محمد طرزى واحدًا من بين 6 كتاب مصريين وعرب وجدوا بالقائمة، عن روايته الأحدث «ميكروفون كاتم صوت»، التى صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون.
فى «ميكروفون كاتم صوت» انتقل طرزى من لونه الروائى الأثير، أى الرواية التاريخية، إلى الرواية الاجتماعية، راسمًا صورة للبنان، فى ظل الظروف الاستثنائية التى يعيشها البلد الشامى صغير المساحة عريق الثقافة.
حول الرواية وألوانها المتنوعة، حول الكتابة والأدب، حول الوطن والغربة، حول نجيب محفوظ و«ميكروفون كاتم صوت» أجرينا هذا الحوار مع محمد طرزى.

■ فلنبدأ من الآخر، وصلت روايتك «ميكروفون كاتم صوت» إلى قائمة جائزة نجيب محفوظ، كيف تشعر مع اقتران اسمك بهذا الكاتب المصرى العالمى؟
- قبل الشروع فى كتابة «ميكروفون كاتم صوت»، كنت مترددًا فى الانتقال من الرواية التاريخية إلى الرواية الاجتماعية. استحضرتُ تجربة نجيب محفوظ، إذ بدأ مشروعة الأدبى بالرواية التاريخية، ثم حين تبنى النص الاجتماعى، ذهب عميقًا فى ما هو محلى، وقدمه للعالم نصًا وجدانيًا، يعكس بطريقة إنسانية رهيفة ثقافة الناس العاديين وطريقة عيشهم فى الحارات والأحياء البسيطة. هو الكاتب الذى علمنا أننا لا نحتاج إلى موضوع كبير، كى نكتب نصًا استثنائيًا؛ إذ يكفى أن نراقب الذين يعيشون حولنا، نتلمّس عواطفهم الدفينة، ونقاربها بحس إنسانى صادق. لذلك فإن سعادتى باقتران اسمى بالكاتب الكبير مضاعفة، لأن هذا الاقتران جاء بسبب الرواية التى اهتدت بتجربته.

■ هل يمكن القول إن «ميكروفون كاتم صوت» هى «مرثية روائية للبنان» الذى يمر بواحدة من أقسى الفترات فى تاريخه؟
- أخشى أن تكون كذلك، لكنّ القائمين على النظام السياسى ما فتئوا يفعلون كل شىء حتى يشوهوا صورة لبنان الذى أحبه العالم والعرب. ترد فى الرواية فقرة لعلها تجيب عن سؤالك. إذ بعد أن تُسأل إحدى الشخصيات عن مصير المدينة، تجيب الشخصية بأنها مدينة زائلة بمعنى أن «البحرُ والرملُ والسماء، كلّها أشياء ستبقى، لكن الروح بعد كل هزيمة هى التى تتبدل. وها هى ذى روحها تتبدل الآن أمام حصار الفاسدين وذوى الثقافات الغريبة؛ لم يتصد لهم الناس كما يجب، فلا ضيم أن يعاقبوا بخسارتها».
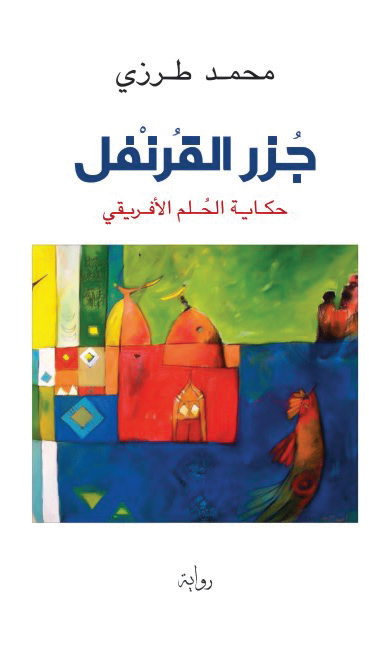
■ هناك قصة حب مستحيلة بين سلطان ووداد، وهناك المقبرة بمقابل البحر، والوطن مقابل الطائفة.. حدثنا عن لعبة «الأضداد» و«الإسقاطات» فى الرواية.
- لا أميل إلى اعتبار علاقة وداد بسلطان مستحيلة بقدر ما أعدها علاقة مشوهة، فرضتْ إيقاعَها المدينة المشوهة بالصور واللافتات والمكبرات. إنهما شخصيتان فى عمر الشباب، تحاصرهما التناقضات والأضداد؛ فكر أن اليد التى تقول له «ابقَ»، هى اليد نفسها التى تمدّه بالمال حتى يرحل. كل تلك التناقضات أثّرت على طبيعة العلاقة ونقاوتها، فاتخذا قرارات متسرّعة، بل وغير مفهومة، حتى انتهت الحكاية على النحو الدرامى الذى ورد فى النصّ.
تقوم الرواية على لعبة الأضداد، بدءًا من عنوانها، وصولًا إلى آخر تفصيل فيها؛ فسلطان لا يقيم فى قصر، بل فى بيت متواضع مطلّ على مقبرة، يحبّ الكتابة لكنه يدل زائرى الموتى على قبور ذويهم. المومسُ اسمها عفاف، وهى رسامة على طريقتها. أما حسن الآثم، فهو ضمير الرواية. إنها رواية عن الميكروفونات التى تكمم الأفواه، والبحر الذى يبتلع الحالمين بمكان أفضل من المقبرة.
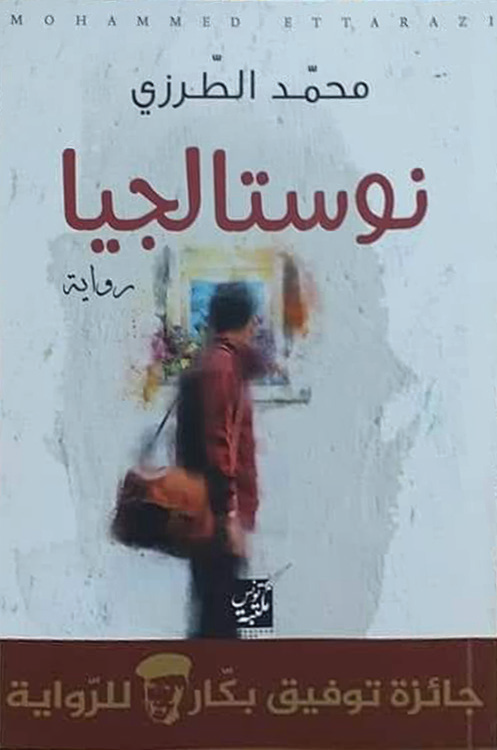
■ يظل الحوار فى الرواية العربية سؤالًا مفتوحًا.. اخترت أن تكون الحوارات بالدارجة اللبنانية. لماذا فضلت الدارجة على ألسنة الشخصيات؟
- هى رواية اجتماعية تعكس حياة الناس وثقافتهم، فمن الطبيعى أن أنقل لهجتهم أيضًا. فلا يمكن تصوّر حفار القبور الأمى يخاطب أصحابه أو أهالى الموتى بالفصحى. يبدو ذلك مجافيًا للحقيقة والواقع، وقد يجرد الرواية من روحها. لم أكتفِ بتفضيل اللهجة الدارجة فى الحوار، بل منحتُ لكل شخصية لهجتها المنسجمة مع الطبقة الاجتماعية التى تنتمى إليها. صحيح أن ذلك لا يبدو جليًا للقارئ العربى، لكن القارئ اللبنانى يلتفت إلى تلك الفوارق البسيطة. حتى إننى اعتمدتُ الحرف اللاتينى، خلال بعض محادثات «واتس آب» الواردة فى الرواية، على اعتبار أنها الطريقة التى يتواصل بها الشباب فى الحيز المكانى للنص. وإذ أخذتُ بعين الاعتبار غرابة بعض التعابير المحلية على القارئ العربى، عمدت إلى إيضاحها بصورة مواربة عبر السرد اللاحق، بحيث يتضح معناها بسهولة.
■ هل توافقنى على أن «ميكروفون كاتم صوت»، هى قطعة مغايرة عن أغلب رصيدك الروائى، حيث ركز الكثير من رواياتك السابقة على الحضور التاريخى للعرب فى بعض دول شرق إفريقيا كتنزانيا وكينيا؟
- هى كذلك بطبيعة الحال. فى البدء، أردتُ التخصّص فى الرواية التاريخية، لأننى أحبّ هذا النمط الأدبى. فانكببت منذ البدايات على مطالعة الروايات التاريخية، سواء تلك التى تقارب تاريخ المنطقة أو العالم. اطلعتُ على الأعمال التى تسرد التاريخ بأمانة، وتدرّجت مع تطوّر الأدب التاريخى، وصولًا إلى معالجة الحدث عبر منح الخيال حيزًا أوسع فى النصّ، بغية سدّ الفجوات التى يغفلها المؤرّخون. ما حصل فى لبنان بدءًا من عام ٢٠٢٠، وضعنى أمام حدث تاريخى راهن، فضلًا عن أنه بلدى، والمكان الذى أنتمى إليه ثقافيًا وعاطفيًا. إذ انفجرتْ فى ذلك البلد الجميل كلُّ الأزمات دفعة واحدة؛ تحلّل النظام السياسى، ووقع الإفلاس المالى والاقتصادى، صار الناس يموتون على أبواب المستشفيات، بعدما احتكرت فئة قليلة الدواء المدعوم، وعمدت إلى بيعه فى السوق السوداء؛ العصابات فى كل مكان، فى الكهرباء، فى الإنترنت، فى المقالع والكسارات، فى المصارف والأملاك البحرية. ثم تفشّى فيروس كورونا، وانفجر المرفأ فى الناس، مزيلًا الواجهة البحرية للعاصمة، فى ظل غياب مطلق لأى مساءلة قضائية أو سياسية. سُرقت ضرائب المواطنين، قبل أموالهم المودعة فى المصارف، فزاد الناس فقرًا، واغتنى الزعماء وحاشيتهم. أمام هذا المشهد الدرامى، لم يكن بوسعى إشاحة الوجه عن المأساة، وأواصل مشروعى الأدبى القائم على التاريخ، كأن شيئًا لم يحصل.
■ بالعودة إلى أعمالك السابقة، لماذا اخترت ملف «الحضور العربى فى إفريقيا» ليكون محل بحثك روائيًا؟
- وصلتُ إلى موزمبيق منذ ١٨ عامًا، لم يكن لدى أى فكرة عن عمق الحضور العربى التاريخى فى شرق إفريقيا. هناك تعرفت إلى مواطنين من أصول عربية؛ عمانية ويمنية تحديدًا. ما كانوا يتكلمون العربية، لكنهم على دراية وافية بتاريخ أجدادهم الذين عبروا من الجزيرة العربية إلى القارة السوداء. أثار التاريخُ العربىُ فى شرق إفريقيا فضولى، فانكببت على قراءة كل ما له علاقة بتلك المرحلة. ثم حصل أن اطلعتُ على روايات الكاتب الجنوب إفريقى ويلبور سميث، هى أعمال فى التخيّل التاريخى، عن شرق إفريقيا، ولكن من منظور عائلة أوروبية. هكذا ولدت فكرة الكتابة عن شرق إفريقيا، من منظور عربى. للمفارقة، بينما كان هناك عشرات الأعمال الأدبية عن الأندلس، لم يكن قد كتب حتى ذلك الوقت أىُّ رواية عن عرب الشرق الإفريقى. بدأتْ رحلتى مع جزر القرنفل، وهى عن زنجبار القرن الـ١٩، خلال حكم السلطان سعيد بن سلطان. فازت الرواية بجائزة غسان كنفانى، وحققت انتشارًا مقبولًا. ما شجعنى على مواصلة «حكاية الحلم الإفريقى»، فكانت ماليندى، وعروس القمر، بالإضافة إلى رواية إفريقيا.
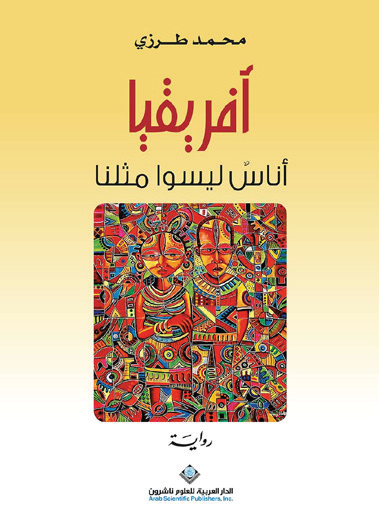
■ هل فكرت يومًا أن تكتب بالبرتغالية التى تتقنها بفضل سنوات طويلة قضيتها فى موزمبيق؟
- نكتب الأدب باللغة الأقرب إلينا، وهى عادة ما تكون اللغة الأم. حتى إنك تجد مترجمين يتقنون أكثر من لغة، ومع ذلك، حين يترجمون نصًا أدبيًا، يفضّلون الترجمة إلى اللغة الأمّ، وليس العكس. اللغة الأم تتماهى مع مشاعرنا الأولى، تُجبل بها، حتى يستحيل فصلها عن ذاتنا الحقيقية بعد ذلك. المفردات والتعابير، مهما كانت غنية لدى الكاتب تبقى جوفاء إن لم تشحن بمشاعره الأصلية. ثمّ إننى تعلمتُ البرتغالية فى الـ٢٣ من عمرى، وفى سياق العمل التجارى، لذلك أعرف اللغة ولكنى لا أملك مفاتيحها الفنية. درّستُ الاقتصادَ بالبرتغالية، ولكن أنّى عالم الأرقام من عالم الأدب.
■ كيف أثر وجودك فى البلدان الإفريقية على مسيرتك ككاتب؟
- أثّرت إفريقيا على مسيرتى ككاتب، عبر تأُثيرها علىّ كإنسان. إذ بعد أكثر من ١٨ سنة من الإقامة فى إفريقيا، تنقلتُ خلالها بين دول مختلفة، منخرطًا فى حياة الناس وتفاصيلهم اليومية، بإمكانى الزعم بأننى إفريقى بقدر ما أنا لبنانى. كلُّ ما كتبته فيه شىء من إفريقيا، حتى إنك تجد فى رواية محليّة «كميكروفون كاتم صوت»، ذكرًا لموزمبيق وللبنانيين هاجروا إلى تلك البلاد البعيدة.
■ بخلاف قائمة جائزة نجيب محفوظ، سبق لبعض رواياتك أن وجدت فى قوائم جوائز، مثل كتارا والشيخ زايد. فى ظنك كيف تضيف الجائزة إلى الكاتب؟ وهل يصح أن نعتبر الجائزة معيارًا دقيقًا على جودة العمل الأدبى؟
- تسلّط الجائزة الضوء على الكتاب، وهذا أمر يحتاجه الكاتب اليوم أكثر من أى وقت مضى، نظرًا لكثرة الإصدارات الأدبية. بهذا المعنى، تساعد الجائزة الكاتب للوصول إلى قراء قد يصعب الوصول إليهم من دون تسليط الضوء على عمله، عبر نيله جائزة مرموقة. كذلك، توفر بعض الجوائز مبالغ نقدية، قد يكون الكاتب فى أمس الحاجة إليها، كى يواصل مشروعه الأدبى.
لا شك أن الفوز بجائزة هو معيار من معايير جودة النص، خاصة إن كانت الجائزة عريقة، تضم لجنتها التحكيمية أعضاء من ذوى الكفاءات، لكنّ ذلك لا يعنى أن عدم الفوز أو حتى عدم الوصول إلى القوائم معيار على النقيض. هناك أعمال لم تصل إلى أى قائمة عربية، لكنها فازت بجوائز عالمية بعد ترجمتها، علمًا أننى لا أعلم إن رُشحت تلك الأعمال للجوائز العربية أم لا. فى السياق نفسه، أقرأ من وقت لآخر نصوصًا أدبية باهرة لا يأتى ذكرها فى القوائم.
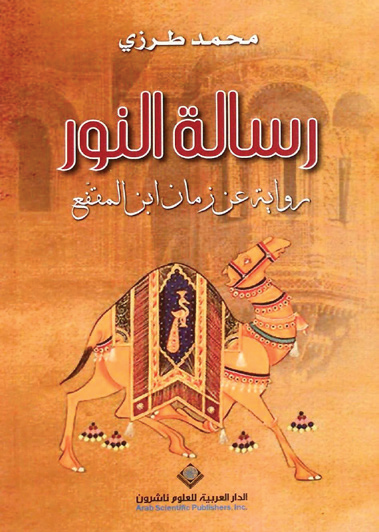
■ ستنتقل قريبًا إلى إيطاليا لخوض تجربة إقامة أدبية.. كيف تقيم فكرة «الإقامة الأدبية»؟ وما المستهدف منها وكيف تفيد الكاتب والكتابة؟
- أول تجربة لى فى هذا المجال كانت فى نيويورك، بإشراف مؤسسة آرت أوماى الأمريكية، وبمنحة كريمة من دار جامعة حمد بن خليفة القطرية. تعرّفت خلال تلك التجربة على كُتّاب ومترجمين من قارات أربع، بعضهم ذوو تجارب أدبية استثنائية، ما كان بالإمكان الاستفادة منها، من دون الإقامة بينهم، لمدة من الزمن. كذلك شملت أنشطة البرنامج تعريفَ الكُتّاب بدور نشر أمريكية، بغرض التعاون فى ترجمة الأعمال إلى الإنجليزية ونشرها، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها. أذكر أن مقر الإقامة كان فى ريف ولاية نيويورك، وسط طبيعة خلّابة، ما أتاح لى الكتابة فى هدوء وسكينة.
اليوم أستعدّ للسفر إلى إيطاليا، للمشاركة فى إقامة بُغلْيَاسكو فى جنوة. هذه الإقامة مختلفة بعض الشىء عن سابقتها، فالمشاركون الذين ينتمون لدول وثقافات مختلفة، ليسوا بالضرورة كُتّابًا أو مترجمين هذه المرة، وإنما موسيقيون، ورسامون ومسرحيون ومخرجى أفلام.
■ فى ظنك لماذا يحرص الكاتب العربى على إلقاء التحية على القاهرة والوجود فيها؟
- أحبّ مصر والمصريين. لى فيها أصدقاء كثر وذكريات طيبة. زرتها تلبية لأكثر من دعوة ثقافية، وشاركتُ فى معارضها. إن سألتنى عن الكُتّاب الذين ألهمونى، ستجدهم مصريين، وعن النقّاد الأساتذة الذين وجّهونى، تجدهم مصريين أيضًا. القاهرة قلب العالم، كل شىء فيها ملهم؛ التاريخ والحاضر وتطلّع ناسها إلى المستقبل، لذلك لا يبدو لى مستغربًا أن الكُتّاب المصريين ما فتئوا يتصدّرون المشهد الثقافى العربى، وأن العديد من الكُتّاب، من غير المصريين، كتبوا أجمل أعمالهم خلال إقامتهم فى مصر.





