فهم الرواية.. الناقد الأردنى حسين دعسة: نجيب محفوظ «بابا كل الأجيال»

- الرواية جيش مهزوم ولا زمن لها.. وما زالت تدور حول رموزها الكبار
- الرواية كنوع سردى أدبى ليس لها مكان ولادة أو شهادة ولادة
فى عالم النقد الأدبى يبرز اسم الناقد حسين دعسة كواحد من الأصوات التى تسعى إلى تفكيك النصوص الأدبية بعمق ووضوح، مقدّمًا للقارئ مفاتيح لفهم أوسع للأدب، خاصة الرواية.
وفى كتابه الجديد «فهم الرواية.. مقدِّمات فى غياب نقد النَّقد وإشكاليّات السرديّات المعاصرة»، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، يقدّم «دعسة» رحلة شائقة داخل عالم السرد الروائى، متناولًا تقنياته وأساليبه وتحولاته، ويعد الكتاب دراسة أكاديمية رصينة ومرشدًا للقارئ والمتخصص لكشف الطبقات الخفية للرواية وفهم أدواتها الفنية والجمالية.
عن كتابه الجديد ورؤيته لمستقبل الرواية، فى ظل التحولات الثقافية والتكنولوجية التى يشهدها العالم اليوم، أجرت «حرف» الحوار التالى مع حسين دعسة.
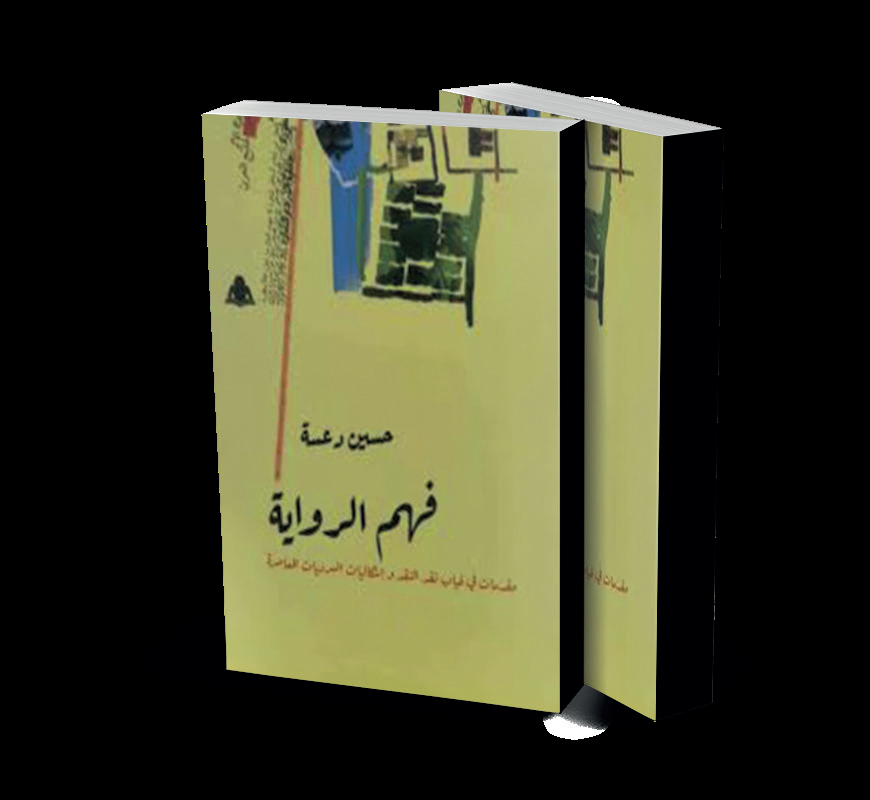
■ بداية.. عمَّ يدور كتابك «فهم الرواية»؟
- أفنيت سنوات من البحث فى وعى السرديات التى تحيط عالمنا الأدبى والأكاديمى والإعلامى، فكان كتابى «فهم الرواية» حصيلة فلسفة منطق السرديات فى العين النقدية.
إنَّ مصيرًا جدليًا أصاب فهمنا للرِّواية- حواريّة القارئ والناقد والمبدع والكاتب- وطبيعة دورها التثقيفىّ، وصولًا إلى أثرها فى الثقافة العربيّة المعاصرة، ذلك أنَّ السرديّات قد تحوَّلت ونقلت بتحوُّلاتها عديد الأفكار الجدليّة التى جعلت من الرِّواية مخيال الوعى الجمعى العظيم بعد المسرح، وبعد الشعر.
عربيًا، علينا أنْ نفهَمَ مُحاولات تنميط السرديّات عبر تنميط الرِّواية، وتسييدها على الفعل الثقافى فى مختلف مجالات السَّرد الموازى للحياة الثقافيّة المعاصرة المعاشة.
إنَّ فهم سرديّات الرِّواية العربيّة المعاصرة يجعلنا نواكب حركة الجمال فى الرُّؤى النَّقديّة- الجماليّة التى تتوالد من تواتر الأشكال السرديّة، عبر أوعية الثقافة والوسائط التقنيّة، وعبر الشبكة السيبرانيّة الرقميّة التى باتت تهدِّد حكايات الرُّواة، ما يحيط بنا، فلسفيًا، إلى تحرّى دوافع الخوف من التطبيقات التى تنافس المحكيّات الشفاهيّة ونتاج دور النشر من أمَّهات القصص والرِّوايات، المؤلَّفة منها أو المترجَمة، والخوف من تناثُر الوعى عند الجمهور فى وقت يتناثر فيه وعى النَّقد، ونقد النَّقد، لموروث يتجدَّد فى عالم الكتابة.

■ ماذا تقصد بـ«نقد النَّقد»؟
- إن الانطلاق لتحديد مفهوم «نقد النَّقد» سيواجهُ طرقًا شتّى للإحاطةِ بهِ، وعلى الرغم من تعدُّد الدِّراسات التى كُتبت حوله، إلا أنَّكَ لا تكاد تعثر على إطار مستقرّ يُحيط بهذا المفهوم إحاطة كاملة، حتى فى محاولة تحديد النشأة الحقيقيّة له، من الباحثين مَن سيحيلكَ إلى القرن الرابع قبل الميلاد حيث كتابات أفلاطون وأرسطو، قائلًا: إنَّ «نقد النَّقد» يرجع إلى بواكير التشكُّل الأولى للنَّقد نفسه.
أمّا حقيقة الأمر فى القول حول نشأة «نقد النَّقد» فيمكن أن تكون أقل تشدُّدًا فى الإحالة إلى زمنٍ أو أدب معيَّن، فالعلوم تتَّخذ تطوُّرها من خلال التَّراكم المعرفى، بغض النَّظر عن المنظومة المُنشِئة لها، وعلى الرّغم من هذا لا يمكننا التأصيل لنشأة هذا المفهوم إلا من حيث بدءِ الوعى له نقديًا.
يقول بعضهم إنَّ الموقف النَّقدى طردٌ للموقف الجمالى، من حيث عدم سهولة وجودهما معًا كطريقة للنَّظر إلى موضوعٍ واحدٍ، هذا بالنِّسبة للنَّقد، فكيف إذا كان الحديث عن «نقد النَّقد»، وهذا ما يدفعنا إلى التَّساؤل حول نوعيّة القراءة التى يمارسها المشتغِل بهذا المفهوم.
وقد يكون من الصَّواب القول إنَّ ممارسة هذه القراءة بحاجة إلى شجاعة كبيرة من قِبَل ممارسى نقد النَّقد، لا من حيث صعوبتها معرفيَّا فقط، ولكن من حيث إنَّها تضعكَ على خط قرائى معيَّن لا ينفع معه أن تكون حياديًا أو متطرِّفًا بإصدار الأحكام فى الوقت ذاته، حيث يمكن اعتبار هذه القراءة هيئة عُليا ذات فهم مُتجاوب، تجعل من ممارسيها «قرّاء متفوِّقين».
■ لماذا لا يوجد مفهوم وإطار واضح لفكرة «نقد النقد»؟
- عند تحديد المفهوم من صيغ ومسار فكرى وثقافى، القارئ المنصف سيجد أن مقدمات نقد النقد تعنى أن منطق فهم الرواية هو أن تكون مشروعًا ثقافيًا نقديًا، بالدرجة الأولى، وفصول الكتاب تتناوب على وضع محددات هذا المفهوم، بالرجوع إلى مفهوم عملية الفهم فلسفيًا وأدبيًا، وبالتالى نقديًا.
وكان على الرّاوى العربى، قبل الناقد، الخروج من «لذَّة النص» إلى مواكبة عمليّات فهم السَّرد، على الأقلّ لجعلنا نفهم إشكاليّة الرِّواية، ودخولها فى مفاصل الكتابة العربيّة مبكرًا؛ فهل كان ما كُتب خارج النص مرآةً تستنطق ما كان بداخله؟ وما الدَّرجة التى وصل إليها فعلًا فى استنطاقه، أى حالة النقد، ونقد النقد؟ وما مدى جدل الكاتب مع الناقد؟ وبالتالى، ما مدى الجدل الآخر حول ما بعد عمليّات تحليل «ما بعد النَّقد»؟، وما جدوى ذلك معرفيًا وثقافيًا؟
ولعلَّ الاستشهاد بنماذج روائيّة، كما أفردتها فى الكتاب، يُعينُ فى إعادة التَّعريف بقدرة الرِّواية على خلق الوعى، بعيدًا عن كلاسيكيّات أصبحت بؤرًا لعمليّات النَّقد الأكاديمى ومعها تراجَعَ النَّقد.
ومن بين هذه النَّماذج، العربيّة والمُترجمة، خيارات معرفية حضارية، أساسها الوعى بالتراث المحاكى وما واجهه فى ميزان النقد.
وأنا أطرح الكتاب، أخوض مواجهة فكرية ثقافية، لا أضع الرواية والنقد حولها ضمن دراسات أو نظريات التفكيكية أو غيرها من الأفكار التى يحملها مفهوم نقد النقد، هى عملية تزلزل لذة الرواية، وقد تؤدى إلى موت المؤلف.
■ هل كتابك يمكن أن يمتد ليناقش فهم القصة وفهم المسرح وغيرهما؟
- كتابى «فهم الرواية.. مقدمات فى غياب نقد النقد وإشكاليات السرديات المعاصرة»، هو معنىٌ بما يعرف أكاديميًا بالمشكلة، وفى المفهوم الفلسفى، هو دلالة المنطق فى شكل التأويل، لهذا سيكون هناك سلسلة من الأجزاء، وهى تحت العمل، تعالج ذات الحلول لذات المشكلة، وهى فهم السرديات، الناطق الخفى فى عالم القصة القصيرة والمسرح والحكايات الشفهية والحكايات الشعبية والدراما الفنية من حيث هى سيناريو، هنا تجد المشروع ينفتح على خصوصية كل مكون سردى، كما هو يبحث فى المكون النقدى.
■ أشرت إلى مفهوم «عصر الرواية».. كيف ترى تلك المقولة؟
- الرواية كنوع سردى أدبى ليس لها مكان ولادة أو شهادة ولادة، وإن كانت الكتابة كمخطوطات وثائق الأمم والشعوب والشرق الجميل، عربيًا وإسلاميًا منها، وثقت عصر الكتابة، ثم صنفت حراك الأدب، فيقال فى تاريخ الأدب إن الرواية قصة كبيرة، عرفت مجدها فى القرون ما قبل التاسع عشر، لكنها تبلورت سردية نتاج كتابة متباينة اكتملت أدواتها الفنية بذاتها عن أشكال الكتابة الأخرى، كأدب الرحلات والمقامات والنثر الأدبى والشعر والسرديات التاريخية، لكنها لم تنفصل عن أثر القصة أو الرواية المسرحية أو الشعرية.
وانتقلت عمليات النقد الموازى لاجتراح مسميات، فمن «عصر الأنوار»، إلى «عصر الرواية»، و«عصر الصورة».
والقول بعصر الرواية، عربيًا وعالميًا، فيه تباين واختلاف، فالرواية العربية ما زالت تدور حول رموزها الكبار، نجيب محفوظ، الطاهر وطار، علوية صبح، غالب هلسا، عبدالخالق الركابى، وما زالت أيضًا تعزف ذات المطبوعات وتسير وراء «أولاد حارتنا»، وتتخبط فى محركات، وقد ندرك أن عصر الرواية، وفق «فهم الرواية»، ليست له شرعية، فهو لم يتجاوز أى عصر سابق، ولم يؤسس لما بعده.
وبنية المجتمعات البشرية، الشرقية والغربية، العربية والأوروبية، هى نتاج الحكاية التى ليس لها صورها فى تراث البشرية.
والرواية العربية تتأرجح بين المخطوطات والشفافية، ونادرة هى الروايات التى يسمح لنا بأن نقول إنها مؤسسة لعصر مستقل من الكتابة.
والرواية جيش مهزوم النماذج، وقليلة هى الأعمال التى جرحت الواقع والحقيقة، وكانت أب عصرها، منها رواية «أولاد حارتنا»، أو «الحرافيش» لنجيب محفوظ أو رواية «موجيتوس» لمنير عتيبة، أو «سابع أيام الخلق» للعراقى عبدالخالق الركابى، أو رواية «ذات» لصنع الله إبراهيم، ولا أنسى رواية «حارسة الموتى» للروائية عزة دياب.
لا عصر حقيقيًا للرواية عربيًا، وربما حتى فى الآداب العالمية، سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ولغويًا، الكتابة باتت فنًا منافسًا، ليدخل عصر الصورة التى تجاوزت العقل.
والرواية كتابة قد تتحول إلى متفجرات، فكيف يكون لها عصرها والسلاح قاتل، قاتل للمؤلف، وللرواية، التى ما زالت تدافع عن مفاهيمها الجمالية والمنطقية، كتابة خارج التنمية، خارج فهارس الأدب الشكلانية، أو الأخلاقية.
وما أدركه فى «فهم الرواية» يتناقض مع أزمنة أو عصور إذا ما علمنا أن ما يقال إن تصنيف الكتابة يهدد تصنيف الناشر والقارئ والناقد.
والرجوع إلى خصوصية دعوة أو تأسيس أو مفتاح نقد الراحل جابر عصفور، الذى قال عن هذا التوصيف «عصر الرواية»: «إذا كانت هذه التحولات المركبة هى التى تؤكد (عصر الرواية) فإنها هى التى تبرر ما حدث من تغير لافت فى القراءة، واستقبال الأدب».
وحين استبدل جمهور القراء بالشعر «ديوان العرب»، الرواية، فإنها ملحمة العصر المتغير الإيقاع. وبقدر تقلص دائرة قراء الشعر انسربت صفة «الشعرية» من القصيدة إلى الرواية، لتؤكد إمكان ما تولده لغتها من ثراء فى الدلالة، وإسهام فى تجسيد خصوصية الفضاء الزمانى المكانى الذى تتحرك فيه الأحداث والشخصيات.
واقترن «عصر الرواية» بعصر الآلة، فى شبكة أكثر تعقيدًا من أدوات المعرفة وعلاقات الاتصال وتقنيات الإبداع التى ترصد لحظات التحول المتداخلة، الممتدة، الرمادية، وتصوغ دلالاتها المكثفة، فالرواية هى نغمة عصرنا المائزة وعلامته الإبداعية البارزة، هذا صحيح منطقيًا، لكنه فى دائرة النقد، العصر مشتت، الرواية والروائيون اكتشفوا أنهم فى حالة لهاث خلف عناوين وأغلفة ومحركات نشر، بينما القارئ المتلقى لا يدرك أى عصر يعيش، كذا الأمر مع النقاد والأكاديميين.
■ ما وضع نجيب محفوظ فى هذه المنظومة؟
- نجيب محفوظ حالة استثنائية فى الكتابة، هو مصرى أصيل، عربى الانتماء، لكنه كاتب عالمى، ليس بسب «نوبل»، فقد شغلنا وشغل كل العصور بتميز أعماله الروائية.
وقد خصص معرض أبوظبى للكتاب جلسة «حوارات وشهادات نقدية»، ضمن البرنامج الثقافى، وخصصت حوارًا عن «حرافيش نجيب محفوظ»، وأتيح لى فتح ذاكرة ٤٠ عامًا من الحراك الثقافى.
ففى أول زيارة إلى مصر، القاهرة والإسكندرية، كان الإنسان فيها، ذلك العظيم نجيب محفوظ، «بابا كل الأجيال»، والتقيته فى ذات العام، وهو ما كان أساس شهادتى فى معرض أبوظبى، وكان لقاء الشاب اليافعى مع المبدع الإنسان الإشكالية فى «الحرافيش» كما هو فى أمثولة «أولاد حارتنا» أو رواية «كفاح طيبة» أو «الثلاثية».
وقد دخلنا القاهرة مجموعة كتاب وفنانين رسامين نحمل لوحاتنا عن فلسطين ومعاناة الإنسان الفلسطينى تحت الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى، وكانت لدينا دعوة لإقامة معرض فى قاعة أخناتون، «قصر عائشة فهمى»، والتقينا نجيب محفوظ على مقهى الشارع، وتحدثنا: إننا لا نعرف غيرك يقدمنا للصحافة. وهذا ما حدث، ونقل محفوظ الخبر عن المعرض والأسماء المشاركة، ونشرها المرحوم كمال الملاخ فى «الأهرام»، فى الصفحة الأخيرة، كانت أسطرًا حولت المعرض إلى حدوته مصرية فاقت التوقعات.
هذا هو «بابا نجيب»، الذى كتبت عنه سرديات عشرات الكتب والدراسات، لكنها فى ميزان النقد تحتاج إلى إخضاعها لحكمة نقد النقد، لتقف على أين نحن من نجيب محفوظ.
وأعود لكتابى «فهم الرواية»، فهو قائم- فعلًا- ويتناوب على سؤال الكتابة، وسؤال ماذا يحدث بعد الكتابة، وبالتالى: كيف يكون لدينا قراءات نقدية جادة مختلفة جديدة بحيث نؤسس لمنهج فى نقد النقد ونستطيع تقييم الرواية، أو السرديات، وهذه مسئولية يشتغل عليها كثر فى الثقافة المصرية الراهنة، أبرزهم الدكتور يسرى عبدالله، والدكتور خيرى دومة، والدكتورة سحر الشريف.
وندرك أن المشهد النقدى والأكاديمى قد لا يكون بذات القدرة على مواكبة نشر الدراسات النقدية، ففى العالم العربى والمجتمع الأدبى الدولى كم كبير جدًا من الروايات والسرديات والكتابات فى حالة اعتيادية من سورة الناشر، وعتمة الجوائز التى دخلت نفق تدمير الكتابة.
وهنا، يؤسس كتابى بكل تواضع لحوار حول الحديث الكثير عن المقاربات النقدية التى تناولت مفهوم النقد، وتاليًا «نقد النقد»، وفهم طبيعة الإشكاليات فى هذا الواقع.
■ هل يمثل عبدالفتاح كيليطو حالة نقدية استثنائية؟
- لا يمكن وضع حالة استثنائية للكاتب والناقد الأكاديمى عبدالفتاح كيليطو، وهو ممن بدا أنه تأثر بعنف بالفكر الغربى، تحديدًا الثقافة الفرنسية، وهو عندما يتحدث عن أوروبا وكيف سببت الهوس للكتاب العرب، يستهجن التجربة الحضارية، هى غالبًا تجارب روائى أولى حياتية بحكم اختلاف حريات أوروبا عن البلاد العربية وتقاليدهم الإسلامية، وتابو الحياة، والعربى يسافر إلى أوروبا للعلم أو العمل أو الهجرة ويكتب.







