القاهرة عشقى.. الكاتب الإسبانى رافائيل باردو مورينو: نجيب محفوظ مصدر إلهامى الأهم

- سعيد بأن نبوءتى عن الإخوان فى روايتى تحققت
- التأثيرات المتراكمة من الحضارات القديمة جعلت المصريين يتعاملون مع الدين بانفتاح أكبر
- أردت أن أخبر القارئ العربى بأن الغرب رغم تقدمه المادى ليس الجنة الموعودة
من خلال شخصيات متعددة، وأحداث متشابكة، يُقدّم المؤلف الإسبانى رافائيل باردو مورينو فى روايته «القاهرة عشقى»، الصادرة حديثًا عن «دار صفصافة للنشر»، وجهات نظر عميقة حول مفاهيم متعددة، من بينها العلاقة بين الغرب والشرق، وتأثير الاستعمار على العقلية العربية، ومفهوم الهوية فى ظل النزاعات السياسية، وسمات الدين كما يظهر فى مصر.
تسرد الرواية قصة روبرتو، وهو شاب باريسى يقرر السفر إلى مصر فى السنوات الأخيرة من حكم مبارك، ويلتقى مصادفة أستاذًا مصريًا يؤمن بقيم التنوير الفرنسى، وبأن «الغرب» هو الجنة الموعودة، بينما يتمسك فى الوقت نفسه بتقاليد العالم العربى. تكشف الرواية عبر علاقة روبرتو العاطفية بامرأتين مختلفتين عن تأملات فى الحب، لكنها فى الآن ذاته تسلط الضوء على صراعات اجتماعية وثقافية لا تزال تمثل جوهر التحديات التى تواجه العالم العربى.
رافائيل باردو مورينو، الذى وُلِد فى مدريد عام 1945، عاش حياة مليئة بالتحديات السياسية دفعته إلى مغادرة وطنه فى مرحلة مبكرة من حياته. معارضته لفرانثيسكو فرانكو وحركاته السياسية أضافت عمقًا فكريًا لتوجهاته الأدبية، ليصبح لاحقًا أستاذًا للحضارة الإسبانية فى باريس. فى هذا الحوار، نلتقى مع المؤلف الإسبانى رافائيل باردو مورينو، الذى يزور القاهرة لإطلاق ومناقشة روايته «القاهرة عشقى»، وبمساعدة المترجمين المختصين فى اللغة الإسبانية سيد واصل وسعفان عامر، نناقش الكاتب فى أفكار روايته ورؤيته للعلاقة بين الشخصية والمكان، إذ يتحدث عن تأثير القاهرة فى تشكيل أحداث القصة، ورؤيته الخاصة فى كيفية تأثير الثقافة والتاريخ على مسار الأحداث وتطور الشخصيات داخل النص.

■ كيف بدأت علاقتك بالقاهرة.. ولماذا اخترتها فضاءً رئيسيًا لرواية «القاهرة عشقى»؟
- علاقتى بالقاهرة بدأت من خلال اهتمامى بالأدب الإسبانى والعربى، إلى جانب تأثرى بالوجود الإسلامى فى إسبانيا، وهو ما دفعنى للتفكير فى الكتابة عن هذه المدينة. بعد تقاعدى، بدأتُ أعمل على رواية تدور أحداثها فى القاهرة، مستعينًا بأحد الأصدقاء الذى يعشق المدينة، خاصة أن البعد الثقافى فيها أكثر حضورًا مقارنة بأى مكان آخر.
■ كيف نشأت فكرة الرواية.. وهل استلهمت أحداثها من وقائع حقيقية أم أنها محض خيال؟
- الرواية تمزج بين الواقع والخيال، إذ تنطلق فكرتها من لقاء عابر فى مقهى الفيشاوى بين شاب فرنسى يُدعى روبرتو، جاء إلى القاهرة بدافع عشقه للثقافة العربية، وبين البروفيسور سعيد، الذى يمثل الحضارة العربية لكنه عاشق للحياة الباريسية. من هنا، بدأت الفكرة الأساسية التى تقوم على التقابلية بين الثقافة العربية والثقافة الغربية. الرواية تسلط الضوء على المفارقة بين شخص غربى مفتون بالثقافة الشرقية، وآخر شرقى مغرم بالحضارة الغربية، من خلال الحوارات التى تدور بينهما، والتى تكشف عن اختلاف رؤاهما وفهم كل منهما للآخر.
■ هل تحمل الرواية أبعادًا درامية أخرى إلى جانب هذا الحوار الثقافى؟
- بالتأكيد، هناك بعد درامى يتمثل فى الصراع العاطفى الذى ينشأ عندما يقع روبرتو فى حب سليمة، وهى شابة مكلفة من الحكومة بمراقبته لمعرفة أسباب تردده المتكرر على القاهرة، فى الوقت نفسه تنشأ علاقة أخرى بينه وبين الراقصة فايقة، المنتمية إلى طبقة اجتماعية مختلفة. هذا المثلث العاطفى يخلق توترًا دراميًا يتقاطع مع البعد التاريخى فى الرواية، فيتم التلميح إلى شخصيات ورموز من التاريخ المصرى مثل إيزيس وأوزوريس، إضافة إلى استحضار محطات مهمة كحقبة الاحتلال الفرنسى والإنجليزى، وأحداث نكسة ١٩٦٧، التى تظهر فى سياق الحوارات بين الشخصيات.
هناك مشهد يجسد روح الرواية بشكل سينمائى، ففى مقهى الفيشاوى كان روبرتو يتفحص الكوب ليتأكد من نظافته، وبينما ينظر فى الماء داخله، يرى انعكاس عينين تراقبانه، ليلتفت فيجد سليمة التى كانت تتابعه منذ فترة. هذا المشهد يمثل لحظة محورية فى الرواية، حيث تبدأ خيوط القصة العاطفية والسياسية فى التشابك، ما يفتح الباب أمام الصراعات والتطورات اللاحقة.
■ تبدو القاهرة فى الرواية مسرحًا لصراع بين قوتين: الحداثة التى يمثلها الأستاذ القاهرى من جهة والتقاليد التى يتمسك بها المجتمع من جهة أخرى.. ما الذى اعتمدت عليه فى تكوين هذه الصورة.. وهل من قراءات محددة أفادت وعززت معايشتك للمصريين؟
- الرواية تجمع بين الخيال والواقع، فالمعلومات التاريخية التى أوردتها مستمدة من قراءاتى ومعارفى الأكاديمية، فأنا أستاذ حضارة وأدرّس تاريخ إسبانيا فى العصور الوسطى، وهى حقبة كانت فيها الحضارة عربية إسلامية. قراءتى فى هذا المجال ساعدتنى على تقديم خلفية تاريخية دقيقة للرواية، لكن الأحداث نفسها تحمل جانبًا تخيليًا يُثرى السرد ويجعله أكثر تشويقًا.
وبالطبع قرأت للعديد من الكتّاب، لكن أكثر من تأثرت به كان نجيب محفوظ، فأسلوبه فى تصوير القاهرة وأجوائها كان ملهمًا لى. وكذلك جمال الغيطانى الذى كان صديقًا شخصيًا لى، وتعرفت عليه فى باريس لكننى لم أتأثر بالغيطانى بنفس الدرجة، لأن أسلوبه أكثر تعقيدًا ويحمل أبعادًا روحانية أعمق، وهو ما لم يكن متناسبًا مع طبيعة السرد الذى اعتمدته فى الرواية.
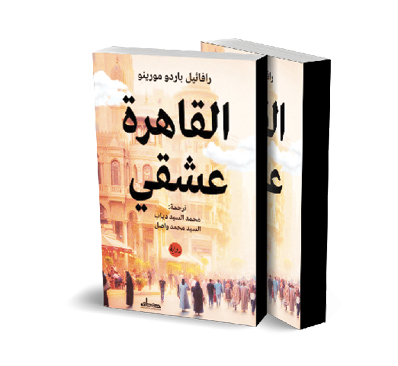
■ هل كان تصوير واقع مصر فى السنوات الأخيرة من حكم مبارك من أهدافك الرئيسية فى كتابة الرواية؟
- لم يكن هدفى الأساسى توثيق تلك المرحلة، لكننى سعيد لأننى استطعت التنبؤ بقوة الإخوان المسلمين كتيار سياسى منظم يتفوق على غيره. فى الرواية، أشرت إلى أنهم كانوا الفصيل الأكثر تماسكًا مقارنة ببقية التيارات التى، رغم وجودها، لم تكن تمتلك نفس الزخم أو التأثير. أرى الآن أن ما كتبته آنذاك تحقق لاحقًا على أرض الواقع، وهذا يمنحنى شعورًا بالرضا عن رؤيتى المبكرة للمشهد السياسى فى مصر.
■ ما الفارق الذى لاحظته فى تلقى الرواية بين بلدان مختلفة؟
- الرواية لاقت استقبالًا رائعًا فى فرنسا، فقد نفدت طبعاتها بسرعة، أما فى إسبانيا فالأمر ليس كذلك. الفارق بين السوقين يعود إلى الخلفية الثقافية؛ القارئ الفرنسى يجد فى الرواية شيئًا جديدًا ومثيرًا للاهتمام، بينما الإسبانى قد تكون لديه معرفة مسبقة بتاريخ الحضارة العربية الإسلامية بحكم تاريخه. أما فى العالم العربى، فلم تتبلور ردود الأفعال بشكل واسع بعد، لكن خلال مناقشة الرواية فى المقر الرئيسى لدار النشر، كانت هناك إشادة قوية بها، لدرجة أن بعض الحاضرين رأوا أنها كُتبت بروح كاتب عربى، وهو ما أعتبره مؤشرًا إيجابيًا.
■ إلى أى مدى تظن أنك قد نجحت فى التخلص من المنظور الاستشراقى فى كتابتك الرواية؟
- كونى أجنبيًا لم يكن عائقًا، بل ربما كان ميزة، لأننى عشت فى القاهرة واندمجت فى تفاصيلها، بالمقابل ثمة شرقيون يعيشون وفق نمط الحياة الغربية بكل عمق. من هنا، فإن وجهة نظرى فى الرواية لم تكن محكومة بمنظور استشراقى، بل كانت متوترة بين رؤيتين ثقافيتين متقاطعتين. هناك مستشرقون كتبوا عن العالم العربى بروح قريبة من أبنائه لأنهم عاشوا التجربة بعمق، وهذا ما حاولت فعله، خاصة أن كونى أجنبيًا دفعنى إلى شرح كثير من التفاصيل للقارئ الغربى، على عكس الكاتب العربى الذى قد يعتبر هذه الأمور مفهومة ضمنيًا ولا يحتاج إلى تفسيرها.
■ فى أكثر من موضع تتوقف الرواية عند تعاطى المصريين مع الدين.. ما أكثر ما لفت انتباهك فى هذا الجانب؟
- نعم، هذا واضح فى الرواية، ويمثل نقطة محورية فيها أشكرك على إثارتها. بالنسبة للشعوب الغربية هناك جهل عام بالإسلام وتعاليمه، إذ يعتمدون فى فهمهم على الصورة التى ينقلها الإعلام. فى نظرهم، العرب هم المغاربة والتوانسة والجزائريون، بينما الدين والتقاليد فى مصر مختلفة تمامًا. كل بلد اعتنق الإسلام لكنه ظل محتفظًا بجذوره الثقافية السابقة، ولذلك هناك فرق واضح بين المصرى والمغربى والخليجى.
الجذور الثقافية لمصر تمتد لآلاف السنين، والتأثيرات المتراكمة من الحضارات الفرعونية والقبطية واليونانية جعلت المصريين يتعاملون مع الدين بشكل مختلف وأكثر انفتاحًا. فى المقابل، المجتمعات المغاربية والخليجية لها سياقات ثقافية خاصة بها؛ فالمغاربة مثلًا ينحدرون من أصول بربرية، بينما فى الخليج لم تكن هناك حضارات سابقة على الإسلام، وهذا يجعل الفروقات كبيرة. فى الرواية حاولت إبراز هذا التمايز، والتأكيد على أن الإسلام المصرى مختلف عن الصورة التى يعرفها الغرب عبر الجاليات المغاربية فى فرنسا.
على سبيل المثال، فى أحد المشاهد، يجلس روبرتو فى مقهى الفيشاوى ويسأل سعيد: «كيف يمكن أن يكون هناك نساء محجبات وأخريات غير محجبات فى نفس المكان؟ كيف يحدث هذا التعدد؟» فيرد عليه سعيد قائلًا: كلنا أبناء إبراهيم، وهو رد يلخص طبيعة التنوع الدينى والاجتماعى فى مصر.
كان هدفى أن أقدم للقارئ الغربى، خاصة الفرنسى، صورة بديلة عن الإسلام المصرى، صورة أكثر انفتاحًا وتسامحًا، لمواجهة الصورة النمطية التى يروجها الإعلام عن العرب بصفتهم متشددين أو إرهابيين. الرواية كانت محاولة لكشف الحقيقة وكسر هذه النظرة السلبية.

■ فى الرواية، هناك حديث عن الاستعمار الإنجليزى والفرنسى لمصر.. وبدا وكأنك ترى أن تعثر مسار الحداثة العربية يرجع إلى إرث الاستعمار.. هل تؤمن بذلك؟
- الاستعمار بطبيعته يقوم على استغلال ثروات الشعوب، لكنه فى الوقت نفسه يحجب أو يخفى ما لا يناسب مصالحه. عندما خرج نابليون من مصر، تولى محمد على الحكم، وكان ديكتاتورًا مستنيرًا. نابليون لم يأتِ فقط بجيوشه، بل جلب معه حملة علمية من المتخصصين فى مختلف المجالات، وهذا خلق جوًا ثقافيًا استفاد منه محمد على، فأسس المدارس وأرسل البعثات ووضع أسس التعليم العام.
لذلك، رغم أن الاستعمار كانت له آثار سلبية، فإنه فى الوقت نفسه فتح الأبواب أمام مصر للتفاعل مع الغرب، وأخرجها من العزلة التى كانت تعيشها. لا يمكن إنكار أن الاحتكاك بالغرب، رغم كونه قسريًا، لعب دورًا فى تحديث بعض المؤسسات وإدخال أفكار جديدة.
■ تبدأ الرواية بما يمكن اعتباره نقدًا للحداثة الغربية.. إذ تسلط الضوء على الحسابات الاستراتيجية الباردة للقوى الغربية والنزعة الفردية والاستغلال قديمًا وحديثًا.. هل تتبنى شخصيًا هذا الرأى؟
- نعم، أردت أن أوصل هذه الرسالة من خلال الرواية، وأن ألفت نظر القارئ العربى إلى أن العالم الغربى، رغم تقدمه المادى، ليس الجنة الموعودة. صحيح أن الغرب متطور من الناحية العلمية والتكنولوجية، لكنه يفتقد إلى الروحانيات، وصلة الرحم، والمشاعر الدافئة التى لا تزال حاضرة فى المجتمعات الشرقية.
حين يفقد الإنسان الروحانيات يتحول إلى آلة، ويفقد آدميته. هذه هى الرسالة الأساسية فى الكتاب، وكما كنت معنيًا بتقديم صورة حقيقية عن الشرق للقارئ الغربى، كنت أيضًا أخاطب القارئ العربى، وأدعوه لإعادة النظر فى تصوره للحداثة الغربية.








