رفيق أهل العقل.. محمود الوروارى: الإعلام والكتابة «ضُرتان» تريدان سحبى 24 ساعة

- الكتابة أكثر تأثيرًا وبقاءً من الإعلام.. ووفقت بينهما فى مشوارى
- ضيوف «الآخر» تنبأوا بغزو العراق.. والبرنامج يُدرس فى جامعات أمريكا
- العالم فى انتظار «حدث جلل» عام 2031 كما حدث فى 91 و2011 و2021
- «السلفية» أقدم من «الإخوان» بـ100 عام.. ومن عباءتها خرجت «جماعة البنا»
- «الربيع العربى» حدث تاريخى مفصلى لا يقل عن الحربين العالميتين
- «الحدث المصرى» أول «توك شو» سياسى مصرى على قناة عربية كبيرة
- «الإخوان» جماعة مفضوحة.. ومن يحتاج لمشروع بحثى شامل هم السلفيون
تحتار بشدة فى وصفه، فحتى من يجمع بين أكثر من موهبة، تجد أن إحداها يغلب البقية فتصفه بها، لكن الحالة مختلفة عند الحديث عن الإعلامى محمود الوروارى، ذلك الوجه المعروف على القنوات المصرية والعربية.
فالرجل صاحب برامج «الآخر» و«أهل العقل» و«سلفيو مصر» و«الحدث المصرى»، تميز فى الإعلام للدرجة التى تجعلك تصفه بالإعلامى بضمير مرتاح، وفى نفس الوقت أبدع فى الكتابة بمختلف أنواعها، لتلحق به صفة الروائى والكاتب، فضلًا عن صناعة أفلام وثائقية أرّخت لفترة مهمة من تاريخ مصر.
عن هذا المشوار الطويل والمسيرة الحافلة، ورؤيته تجاه العديد من القضايا الفكرية فى عالمنا العربى وواقعنا المصرى على وجه التخصيص، يدور حوار «حرف» التالى مع الإعلامى محمود الوروارى.

■ جمعت بين الإعلام والكتابة وتميزت بشدة فى كليهما.. كيف فعلت ذلك؟ وهل أثر أى من المجالين على الآخر؟
- منذ دخولى مهنة الإعلام أو الكتابة، أؤمن تمامًا بأن الاشتغال على المشاريع الطويلة هو الذى يفيد، وأرى أن أى مشروع يحتاج من ٤ إلى ٥ سنوات عمل حتى يكون مؤثرًا، لكن الاشتغال من دون تركيز بأعمال متفرقة هنا وهناك، أعتقد أنه لا يمكن أن يفيد المتلقى بطبيعة الحال.
حاولت أن أوازن بين الكتابة والإعلام، باعتبارى إعلاميًا وفى نفس الوقت كاتب، فأنا أكتب الأدب من رواية وقصة ومسرح، وأكتب فى الفكر أيضًا، على ضوء اهتمامى بالتفكير والفلسفة وموضوع العقل الدينى.
بالتالى، يمكن القول إن لدى حقلين، الكتابة الأدبية فى الرواية والقصة والمسرح، والكتابة فى التفكير، خاصة ما يتعلق بالاشتغال على العقل الدينى فى الإسلام بشقيه السنى والشيعى، وكذلك المسيحى بكل تداخلاته.
تلاقى شغفى هذا بالكتابة مع عملى ومهنتى منذ ٣٠ عامًا كإعلامى، والإعلام والكتابة «ضُرتان»، كل واحدة منهما تريد أن تأخذك بالكلية، أن تسحبك لمدة ٢٤ ساعة فى اليوم. لكنى أعتقد أن الكتاب هو الأبقى، فصحيح أن الإعلام مؤثر، لكن الكتاب مؤثر على المدى البعيد.
ولذلك التحدى الرئيسى أمامى كان أن أصنع جسرًا تلتقى فيه الكتابة الإبداعية والفكرية مع العمل الإعلامى، خاصة نوعية الإعلام الذى أقدمه، وهو الإعلام الجاد، الإعلام الخبرى والسياسى الذى يقوم على فكرة الوعى.
هذا ما عملت عليه وبدأت التجريب فيه حتى استطعت الوصول إلى رؤية معينة، وهى أنه من الممكن أن يلتقى الأدب والفكر مع الإعلام، وهو ما فعلته فى عام ٢٠٠١، عندما كنت أعمل فى قناة «الشارقة».
كانت وقتها قناة مهمة جدًا، ومدعومة من «اليونسكو»، ومُصنفة بأنها ثقافية، بل تعد أول قناة ثقافية عربية، منذ انطلاقها بشكل رسمى فى عام ١٩٩٥، وهو ما استمر حتى ضرب برجى التجارة العالمية فى الولايات المتحدة، يوم ١١ سبتمبر ٢٠٠١، وهو الحدث الذى يمكن اعتباره المحطة الرئيسية فى تحولات سياسية كبرى لاحقة، يُمكن أن تُكتَب عنها كتب كثيرة.
■ ظهرت فى هذه الفترة ظاهرة «الإسلاموفوبيا» وتصاعدت بشدة فى العالم كله كيف تعاملت معها على ضوء عملك الإعلامى؟
- نعم، تصاعدت موجة «الإسلاموفوبيا» فى هذه الفترة، وظهر ما يسمى «أعداء الإسلام»، الذين يكرهون الإسلام بشدة ويصفونه بـ«دين الإرهاب»، ويتهمون المسلمين بأنهم «إرهابيون».
كانت تُعقد جلسات فى جامعة الدول العربية وقتها لمناقشة هذه الظاهرة، وكنت أُدعى لحضورها، وكانت الرغبة آنذاك هى وجود قنوات مؤثرة تُمنح مساحات للرد على الاتهامات الموجهة للإسلام والمسلمين، لكن كنت أرى عكس ذلك، فقد كانت لدى قناعة بأن الرد على الاتهامات هو تأكيد لها.
لذا رغم مطالبة البعض بتأجير مساحات على الهواء، فى قنوات عالمية مثل «سى إن إن» و«بى بى سى»، ومنحها للكتاب والمفكرين العرب للرد على الاتهامات الموجهة للعرب والمسلمين، رأيت أن أفعل عكس ذلك فى برنامج «الآخر»، من خلال استضافة مفكرين وكتاب وصحفيين غربيين.
لم يكن لدى ضيف عربى واحد فى هذا البرنامج، وإنما كبار المفكرين حول العالم، وعلى رأسهم روجيه جارودى ونعوم تشومسكى، وعدد كبير من الكُتاب فى فرنسا والسويد والولايات المتحدة، وتحدثت معهم عن العديد من القضايا المهمة، وكيف أن العالم مُمهد لتطبيق أفكار فوكو ياما فى «نهاية التاريخ»، وصامويل هانجتنتون فى «صدام الحضارات».
كان على رأس هذه الأفكار ما يُعرف بـ«تفكيك الكتلة الصلبة»، التى تقوم على فكرة أن أكبر كتلتين فى العالم هما المسلمون «١.٦ مليار نسمة»، والصينيون «١.٧ مليار نسمة»، باعتبارهما الكتلتين الصلبتين اللتين سيعوقان المشروع الليبرالى وقتها، ما يتطلب تفكيكهما.
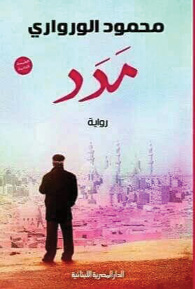
تُرجمت هذه الأفكار بشكل عملى فى الحرب التى أعلنت على الصين، وفى احتلال أفغانستان بعد حادث الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١ بشهر، بداعى إنهاء وجود «القاعدة» وقتل أسامة بن لادن، وبعدها بعامين احتلوا العراق.
كل هذا تحدث عنه المفكرون الذين استضفتهم فى البرنامج، وكل ما توقعوه حدث بالفعل بعد ذلك، قالوا سيتم احتلال العراق وتم احتلاله، وسيتم احتلال أفغانستان وتم احتلالها، بل أنهم تحدثوا بشكل دقيق عن طريقة احتلال العراق، من خلال حل الجيش وتفجير خلاف بين الشيعة والسُنة.
نجح البرنامج بصورة كبيرة، وكتبت عنه صحف ومجلات عالمية مهمة على رأسها «التايم»، ووصف بأنه خرق أو نافذة كبرى للإعلام الأجنبى فى الشرق الأوسط وليس العكس، لذا جرى تدريسه فى جامعة «إلينوى» بالولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره نموذجًا لانفتاح الإعلام على العقل، وتحوله من السطحية إلى العمق.
كان هذا عام ٢٠٠٣، وبعدها بعام واحد بدأت فى إعداد كتابى «الآخر»، الذى أعتبره وثيقة مهمة جدًا، ويمثل تجربتى الأول فى الجمع بين الإعلام والكتابة بمعناها الراصد العاقل وبشقيها السياسى والفكرى.
■ ما المحطة التالية المهمة فى حياة محمود الوروارى؟
- المحطة التالية المهمة بالنسبة لى كانت فى عام ٢٠١١، وأنا أعتقد أن العالم يتحرك فى «عشريات»، بمعنى أن هناك حدثًا ما ضخمًا للغاية يحدث ويؤثر فى العالم كله كل ١٠ سنوات، بداية من عام ١٩٩١، حين أعلن بوش الأب عن تدشين النظام العالمى الجديد، القائم على فكرة العولمة مقابل انهيار وتفكيك الاتحاد السوفيتى.
بعدها بـ١٠ سنوات فى ٢٠٠١ كانت أحداث الحادى عشر من سبتمبر، التى أدت إلى انقسام العالم بشكل رهيب، وبعدها بـ١٠ سنوات أخرى حدث ما سُمى بـ«الربيع العربى»، وصولًا إلى جائحة فيروس «كورونا» بعدها بـ١٠ سنوات أخرى، والتى غيّرت وجه الخارطة العالمية.

كل ١٠ سنوات سيكون هناك حدث جلل، لذا أتوقع أن يكون هناك حدث كبير جدًا فى ٢٠٣١، وأنا لست «مُنجِمًا»، لكنى أقول ذلك فى إطار حركة التاريخ، ومن يدرك حركة التاريخ يدرك أشياء كثيرة، كما قال «أوباما» عام ٢٠٠٩، حين تولى رئاسة الولايات المتحدة.
فى ٢٠١١ كان لدى يقين كبير بأننا أمام حدث فارق فى تاريخ الشرق الأوسط والعالم، وأن المنطقة ستتغير كما هى الآن، لذا أعتقد أن ٢٠١١ حدث مفصلى فى التاريخ لا يقل أهمية عن الأحداث التاريخية التى مر بها العالم، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية.
■ أين كان «الوروارى» فى ظل هذه الأحداث المفصلية؟
- فى هذا التوقيت قدمت برنامج «الحدث المصرى»، الذى استمر لمدة ٨ سنوات كاملة على قناة «العربية»، وكان تقديمى إياه فى القاهرة، بعدما تركت دبى، وهو عبارة عن «توك شو» سياسى لمدة ٣ ساعات.
وهذه المرة الأولى التى يكون لدينا «توك شو» سياسى مصرى على قناة كبيرة مثل «العربية»، وليست قناة محلية، وكان الهدف الرئيسى وراءه رصد مجريات ما حدث فى مصر بعد ٢٠١١، مع وجود متغير مهم للغاية، وهو «التنظيمات الإسلامية»، التى كانت تعمل فى الخفاء، ثم ظهرت إلى العلن حين شعرت بالأمان فى هذا الوقت.

تركيزنا كلنا كان على «الإخوان»، رغم أننا نعرف تاريخ الجماعة، وهناك العديد من الرسائل الجامعية التى تحدثت عنها، إلى جانب من انشقوا عنها وكشفوا أسرارها وكواليس عملها مثل ثروت الخرباوى، لذا «الإخوان» بالنسبة لى كانت حركة مفضوحة، فالمصريون يعرفون توجهاتها، ولا تحتاج إلى مجهود بحثى كبير.
لكن المشروع الذى كان يحتاج عقلًا راصدًا ومشروعًا بحثيًا شاملًا هو السلفيون، لأن التيار السلفى فى مصر هو ما خرجت منه تيارات سلفية فى العالم كله، ومن بينها جماعة «الإخوان» نفسها، فالحركة السلفية فى مصر أقدم بـ٨٠ أو ١٠٠ عام من جماعة «الإخوان»، التى تأسست عام ١٩٢٨.
■ لماذا ترى أننا فى حاجة إلى مشروع بحثى شامل عن السلفيين فى مصر؟
- الحركة السلفية بدأت من الشيخ السبكى عام ١٨٥٠، والجمعية الشرعية، قبل أن يأتى محمد حامد الفقى ويؤسس «جماعة أنصار السنة»، وكان أول ترخيص للجمعيات التابعة لها عام ١٩١٢، وجرى منحه إلى «الجمعية الشرعية».
بعد ٢٠١١ بدأت قيادات السلفية تتحدث، فعقدت جلسات عمل طويلة جدًا مع عدد منهم، مثل الشيخ أحمد فريد، وياسر برهامى، إلى جانب زيارة عدد من المؤسسات السلفية، مثل «الجمعية الشرعية» و«أنصار السنة المحمدية»، فضلًا عن المساجد الخاصة بها، ووقتها ساعدونى بشدة، لأنهم كانوا يشعرون آنذاك بالأمان، ويمثلون الكتلة الثانية فى برلمان ٢٠١٢.
كما أننى لم تكن لدى عقلية عدائية ضدهم، وكنت أريد معرفة الحركة السلفية من حيث التأسيس والمبادئ الفكرية، وكيف تطورت من سلفية الدعوة والدين إلى السلفية الجهادية والحركية والعلمية، وحتى سلفية الظواهرى وأسامة بن لادن، وسلفية ناجح إبراهيم وكبار قيادات الحركة.
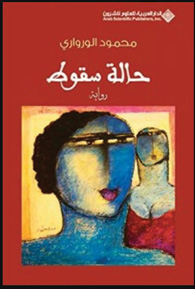
والحقيقة أنهم فتحوا لى مخزونًا أرشيفيًا ضخمًا فبدأت أقرأ، وأخذ منى هذا مجهودًا كبيرًا لا يقل عن عامين أو ثلاثة من العمل المتواصل، وكأننى أعد رسالة دكتوراه، ثم عادت إلىّ فكرة المشاريع المؤثرة، وضرورة اتباع كل الأساليب والوسائل التى يكن من خلالها إيصال مشروعك إلى الناس.
قلت إننى أجيد وسيلتين لتوصيل مشروعى إلى الناس، إما الكتابة أو الإعلام، فقررت تنفيذ ما يمكن اعتباره أكبر سلسلة وثائقية عن السلفيين فى العالم العربى، بواقع ٥ أفلام كاملة، كل فيلم منها ساعة كاملة، وهذا عمل ضخم جدًا يحتاج إلى كتيبة إعلامية تعمل عليه وليس شخصًا واحدًا.
الحقيقة أننى بدأت العمل على المشروع بالفعل، وطلبت من قيادات الحركة السلفية فى مصر أن نوثق هذا التاريخ، ولأنهم كانوا فى ارتياح ويشعرون بأنهم فى مرحلة انتصار، وافقوا على طلبى، لأبدأ العمل بالفعل عام ٢٠١٢.
بدأت أسجل مع القيادات الكبرى فى التيار السلفى، والحقيقة تكلموا بكل أريحية، بعد أن قسمت إياهم إلى تيارات سلفية مؤسساتية وحركية وعلمية، إلى جانب «سلفية الشيخ»، وبدأت أجعل الشيوخ يتحدثون عن سلفيتهم ومبادئهم وقواعدهم، وكيف اختلفت كل سلفية عن الأخرى، لأنتهى من عمل توثيقى عظيم استمر لمدة عامين.
وأثناء تسجيل هذا المشروع الوثائقى، كان فى ذهنى العمل على كتاب، ورأيت أنه لن يكون كتابًا مرجعيًا يبقى للزمن إلا إذا تضمن الجهد التوثيقى، وليس التأليف، وهناك فرق كبير جدًا بين أن تكون مؤلفًا وموثقًا، وأنا بطبعى أميل إلى التوثيق وليس التأليف.
يمكن مثلًا أن أكتب وأقول: «قال لى الشيخ أحمد فريد»، لكن حين يخرج أحمد فريد نفسه ويتحدث هو أمر مهم للغاية، لذا كانت هناك جمل عامية تركتها كما هى، لأنها تحتمل التأويل، فى هذه السلسلة الوثائقية المهمة.

أذاعت «العربية» الفيلم لمدة ٥ ساعات، وكان يحمل عنوان «سلفيو مصر»، وهو عمل تاريخى توثيقى مهم، وكان مرهقًا للغاية، حتى أننى مرضت بعد الانتهاء منه بشكل كامل، لأننى كنت وحدى فى الجانب البحثى، وهو مجهود مرهق جدًا.
حدثت ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ما أدى إلى حالة «الانكماش السلفى» التى نراها منذ ذلك التاريخ، وأصبح من الصعب جدًا أن تقابل أى قيادى منهم، بعد أن عادوا مرة أخرى إلى بيوتهم وبياتهم الشتوى والصيفى.
أصبح من الصعب أن تقوم بهذا العمل مرة أخرى، لأن الزمن لن يرجع، ولأن من تحدثوا لن يتحدثوا بتلك الطريقة من الأريحية والبساطة. هنا بدأت التفكير فى كتابة كتاب، لإعادة تقديم التوثيق المرئى فى توثيق مقروء، وكان ذلك أكثر إرهاقًا من العمل التوثيقى، حتى صدوره بعنوان «سلفيو مصر»، عن الدار المصرية اللبنانية.
■ كتابك «أهل العقل» الذى ناقشت فيه أزمة التخلف وقضايا الفكر الدينى والمذاهب المختلفة، كان فى الأصل برنامجًا مسموعًا على إذاعة «صوت العرب»، ومرئيًا على قناة «العربية».. ما الذى دعاك لتحويله لكتاب مقروء؟
- فى البداية سمعت حديثًا للرئيس عبدالفتاح السيسى يطالب فيه بتجديد الخطاب الدينى، وقبل ذلك كانت كل دعوات التجديد تخرج من الفقهاء والمشايخ وعلماء الأمة، ولم يكن مرحبًا بها من قِبل الساسة.
رأيت أن هناك دائمًا عقلًا دينيًا وعقلًا سياسيًا، وغالبًا هما ليسا متوافقين إلا فى فكرة الفقيه والسلطان، يعنى السلطان يريد فقيهًا يؤدى أغراضه، والفقيه يريد سلطانًا يعطيه القوة.
لكن فى حالة الرئيس عبدالفتاح السيسى وجدته يؤكد للتنويرى الكبير الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه يريد تجديد الخطاب الدينى، ومن هنا تكونت لدى الخلفية الكبيرة المتعلقة بطبيعة العقل الدينى ومحطات الانحراف فى التفكير، من الدعوة إلى الدولة، ومن التفكير إلى التفجير، وغيرها من الانحرافات التى حصلت فى مسار تاريخ الأمة وكانت تستوجب وقفة، ولكن لم يحدث.
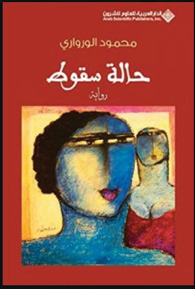
كل التيارات الدينية، من «الإخوان» حتى التيارات المتشددة التى جاءت بعدها، كانت تتم مواجهتها أمنيًا، وكان يوكل إلى وزارات الداخلية والأمن فى البلاد العربية مواجهة هذه التيارات، لكن لم تحدث مواجهتها بالفكر.
الأمن يواجه لكنه لا يغير فكرًا، وأنت تريد أن تكون مؤثرًا، فكان لا بد أن تغير الفكر، قبل أن تضطر إلى قطع يد «الداعشى» وهو يضع حزامًا ناسفًا فى وسطه، والذى من الممكن أن يفجر نفسه فيك، ويكون سعيدًا جدًا.
و«الداعشى»، أو غيره، كلها أسماء لا تختلف، لكن القواعد الفقهية التى استندوا عليها فى تنظيماتهم واحدة، لم يحدث أن فكر أحد فى تفكيكها، أو هناك قلة حاولت لكن الكتب وُضعت فى الأدراج، ولم تصل إلى الناس.
■ إذن كيف واصلت مشروعك «أهل العقل»؟
- كان علىّ أن أنفذ مشروعًا مهمًا يحتاج تنفيذه إلى دولة وليس فردًا، هذا المشروع استمر ٥ سنوات من البحث، وأعتقد أن وجهة نظرى كانت صحيحة فى طرحه. نحن لدينا مفكرون وتنويريون لكن لا يوجد عندنا تنوير، لدينا مفكرون لكن لا توجد حركة تفكير، هناك قطيعة ما بين الاثنين، ما بين التنويرى والتنوير، والمفكر والتفكير.
من هنا بدأت أبحث على مدار ٥ سنوات، كنت أسافر إلى دولتين كل شهر للقاء علماء الأمة فى كل المجالات فيهما، فى المسيحية، وفى المذهب الشيعى، وفى السنة، وفى التيار العلمانى، وفى التيار السلفى المتشدد، وغيرها من التيارات الأخرى.
بدأت مشروعًا جديدًا، بعدما قررت قناة «العربية» طرح برنامج اسمه «منارات» من تقديمى، هم قالوا لى «منارات»، لكن أنا أسميته «أهل العقل»، واحترامًا للقناة قدمناه باسم «منارات» على مدار ٥ سنوات وحتى ٢٠٢٠.
هذا البرنامج كان حواريًا عميقًا، بمعنى أنك لن تلتقى بشاعر أو كاتب، لكنك تلتقى بمفكرين إسلاميين، ومن العقل المسيحى والعقل الشيعى والعقل السنى والعلمانى والسلفى.
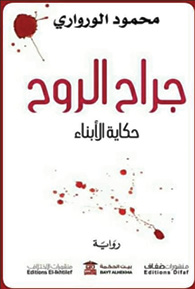
بدأت أطرح فكرة التجديد، ومعنى الفكرة ليس تجديد خطاب بقدر ما هو تجديد فكر وعقل، وبدأت هنا أستعيد فكرة الباحث الجزائرى محمد أركون فى نقد العقل الدينى، والمشاريع الكبرى مثل مشروع محمد عابد الجبرى فى «نقد العقل العربى»، وفى سلسلته «عن القرآن».
ذهبت إلى علماء الأمة مثل هشام جعيط وطه عبدالرحمن ومحمد سبيلة وحسن حنفى وجابر عصفور ومحمد الطالبى، وولد أباها وحمدا ولدتاه فى موريتانيا، وبدأت أطرق أبواب العلماء فى كل العالم الاسلامى والعربى.
لم أكن أذهب إليهم بأسئلة كثيرة، بالعكس هو سؤال واحد أو سؤالان أو ثلاثة لكل هؤلاء الناس، كنت أذهب لأتعلم. وليس لأحاور وأخرج بمعلومات، أنت أمام «جهابزة»، فيكفى أن تجلس أمامهم.
أريد أن أقول إن هذا كان صعبًا جدًا، لدرجة أن كثيرًا منهم أحب أولًا إجراء «إنترفيو» حتى يعرف هل سيكمل الموضوع أم لا، وأتصور أن الراحل العظيم المفكر المغاربى الكبير محمد سبيلة لم يكن يحب التليفزيون، لكنه أجرى هذا اللقاء، وكان أول وآخر لقاء له، وكذلك هشام جعيط، رحمه الله.
كل هؤلاء توفوا ولم يبق منهم إلا النذر البسيط، كلهم ماتوا، حسن حنفى، وسيد ياسين، وجابر عصفور، ومحمد الطالبى، وهشام جعيط، ومحمد سبيلة، كل الرواد رحلوا.
■ ما نوعية القضايا التى طرحتها فى هذا المشروع؟
- أكملت هذا المشروع فى نسختين، نسخة الأفراد ونسخة الموضوعات، وعملت على فكرة التوثيق، خاصة فى النسخة الثانية من البرنامج آخر عامين، وعملت على قضايا عكرت صفو العقل العربى، مثل «الصحوات» عام ١٩٧١، أو الأفكار التى انتشرت فى السعودية خلال الثمانينيات، وكذلك فكرة «ولاية الفقيه» فى العقل الشيعى، ورأيت إلى أى حد أسس العقل الأمريكى لفكرة الإرهاب.
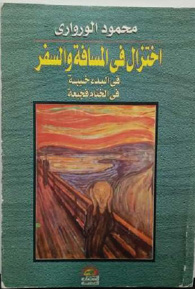
■ طرحت قضايا «مصرية ابن خلدون» وليس «مغاربية ابن خلدون»، وقضايا أخرى فى إطار التوثيق والسينما التاريخية، فى التاريخ مثلًا عملت على مدار عامين بطريقة تشبه عمل الأفلام الوثائقية، وأنا أجيد فكرة التوثيق. والحقيقة أنا درست صناعة هذه الأفلام دراسة جادة، فبعدما انتهيت من دراسة السياسة والاقتصاد درست فى أكاديمية الفنون، والمحصلة التى استخلصتها أننى وضعت يدى على العلة، لماذا تخلفنا؟ ولماذا تقدم الآخرون؟
- هذا نفس ما طرحه شكيب أرسلان، المفكر اللبنانى الكبير، الذى قدم كتاب «لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون»، عام ١٩١٤، وهو كتاب مهم جدًا، لكنه لم يقدم إجابة حقيقية لتساؤلاته، لكن بعد هذه الجولة الممتدة لـ٥ سنوات كاملة، تكونت لدىّ إجابات.
■ ما أبرز هذه الإجابات؟
- عرفت لماذا تأخرنا، عرفت العلة، عرفت فترة القطيعة ما بين التنوير والظلام الذى نعيشه حتى الآن فى فكرة العقل والفكر، وهذه الأمور كلها، والحقيقة أنه كان لا بد أن أكمل المشروع، فقدمته فى برنامج إذاعى فى «صوت العرب»، لاقى استحسانًا كبيرًا.
صورت ٣٠ حلقة للبحث عن إجابة سؤال واحد فقط «لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون؟»، وأخذت أعبر المحطات فى مقارنة «كيف انتقل العالم الأوروبى من الظلام إلى النور»، بدءًا بالعقل الدينى انتقالًا إلى العقل الفكرى التفكيرى ثم العقل السياسى ثم العقل العلمى، وانتقالًا بما حدث فى أوروبا كلها، وبدأت من سنة ١٥٥٢ من مارتن لوثر كينج، صاحب العقل الدينى التفكيرى التصحيحى فى الكنيسة، ثم بحركة المفكرين، ثم بعد ذلك مرورًا بالشاعر الإيطالى دانتى وكتابه «الكوميديا الإلهية»، ثم الانتقال إلى العقل العلمى، ثم الدخول إلى الآلة البخارية والسيارة، ثم الثورة البريطانية عام ١٦٠٠، والثورة الفرنسية ١٧٠٠، ثم انتقلت إلى عام ١٧٨٢ حيث تأسست أمريكا.
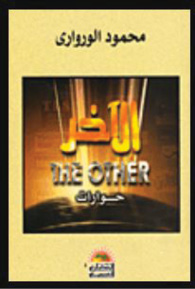
رأيت الإصلاح يبدأ من العقل الدينى ويحدث مع حركة التفكير، والفيسلسوف الألمانى هيجل والمفكرون الكبار بعد ذلك انتقلوا إلى العقل العلمى، وبعد العقل العلمى انتقلوا إلى العقل السياسى، ورأينا ذلك الحراك فى الثورة الأمريكية والفرنسية والبريطانية.
وبعد ذلك انطلقت فى طرح الموضوعات، وقارنت بين ما قدمته فى «صوت العرب» تحت عنوان «أهل العقل»، والجزء المرئى على قناة «العربية»، ورأيت أنه لا بد من جمع كل هذه المادة فى كتاب، فاتخذت الخطوة وسميت الكتاب «أهل العقل»، وأثنى على مقدمته كثير من مراكز الأبحاث الفكرية الفلسفية العميقة، مثل «مؤمنون بلا حدود» وغيرها من المراكز الكبرى.
وفى مقدمة الكتاب رصدت فكرة أننا أمة غير قابلة للتقدم والتفكير، ورصدت كيف تحدث المفكرون الكبار عن قضية الانغلاق، التى يستحيل معها أن يحدث تقدم. ولا بد أن أنوه إلى أن الكتاب صدر فى جزئه الأول عن الدار المصرية اللبنانية، تحت عنوان «أهل العقل»، وأنوى طرح جزء آخر منه.
■ ما كواليس كتابتك رواية «حالة سقوط»؟
- شهد عام ٢٠٠١ تدمير برجى مركز التجارة العالمى، وغزت أمريكا أفغانستان ثم العراق بعد ذلك، وقد سافرت كثيرًا لهذه المناطق، والمهم أننى سافرت كثيرًا لأفغانستان وأجريت الكثير من الوثائقيات، وكونت مصادر صحفية قوية وعلاقات بالذين يحكمون البلد فى هذا التوقيت.
«طالبان» كانت دولة تسيطر على أفغانستان وتحكمها منذ عام ١٩٩٦، وكان لها ممثل فى الأمم المتحدة، وكان على رأس حكومة «طالبان» الملا عمر، وكنت أعرف أصدقاءه جيدًا، وكانوا يسمحون للصحفيين بلقائهم.
وتحت ذريعة الأسلحة النووية بدأت الإرهاصات لغزو العراق، وذهب الدكتور هانز بليكس، مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية، والدكتور محمد البرادعى، المسئول الأممى حينها، إلى العراق، وبدأت قدماى تعرف طريقهما إلى العراق، وقابلت «بليكس»، وأجربت معه حوارًا كبيرًا نشر فى كتاب آخر لى.
وقتها قال لى صراحة إنه لا توجد أسلحة نووية فى العراق، ولا مشروع نووى عند الرئيس العراقى صدام حسين، وكان هذا الأمر فقط حجة لاحتلال البلاد، لتسقط بغداد فى أبريل من عام ٢٠٠٣، ولم أفارق بغداد لحظة منذ السقوط الكبير، كنت أسافر وأرجع، ورأيت الكثير ووصلت إلى الكثير من المعلومات، ورأيت الموت بعينى، ومن هنا جاءتنى فكرة المشروع الروائى، وكان لا بد أن أوثق ما رأيت فى عمل روائى، لتخرج «حالة سقوط» إلى النور عام ٢٠٠٥.

وتدور أحداث الرواية حول أسرة عراقية، وكيف انعكس السقوط السياسى للنظام على السقوط الإنسانى فيها، وكيف كانت التفاصيل من الداخل، وكل ما قلته فى الرواية تحقق، ولم يكن نبوءة، ولكن صدقنى للأسف الشديد، نحن لم نكن أمام سقوط فردى لصدام حسين، لكن أمام حالات من السقوطات ستتوالى.
قلت إن مسبحة الحكام العرب انفرطت وستعقبها سقوطات كثيرة جدًا، وقلت إن معاهدة «سايكوس بيكو» التى كانت على الحدود ستتشكل فى المرحلة المقبلة داخل العقول، أى سيتم تقسيم المقسم وتقطيع المقطع، وهذا حدث ما بين الشيعة والسنة، ثم بدأ سقوط الحكام العرب منذ ٢٠١١.
والرواية ترصد حركة مجموعة من الأبطال.. مصرى ولبنانى وسورى وعراقى، وصنفت باعتبارها الرواية الوحيدة التى حركت أبطالها كلهم فى الجغرافيا الإيرانية. والجغرافيا الأفغانية. وهذه الرواية حظيت باهتمام كبير وكتبت بلغة صوفية شبيهة بلغة مولانا جلال الدين الرومى وشمس التبريزى، كان فيها لغة عالية جدًا، ومع ذلك حظيت بانتقادات كثيرة.
■ ماذا عن مشروعك المسرحى؟
- بدأ معى منذ الثانوية العامة، وأخرجت مسرحيات وأنا فى الجامعة، ودرست المسرح فى أكاديمية الفنون، واستمريت فى ذلك نحو 4 سنوات، وقدمت أعمالًا كثيرة، مثل مسرحية اسمها «الخفافيش»، تقوم على فكرة «حينما يفقد الإنسان البصر والبصيرة»، وفكرة «البلد كلها عميان»، وفكرة «قيمة المقام والحراس»، وأولئك الذين يتخذون من الدين ستارًا للوصول إلى أغراضهم، سواء سياسية فى كرسى الحكم كما هم «الإخوان»، أو مادية بمعنى الاسترزاق كما هو حال الدعاة الجدد. ومسرحية «الخفافيش» صدرت عن الهيئة العامة للكتاب، وكتب عنها الدكتور حسن فتح الباب، رحمه الله.

■ أنت لديك مشروع درامى أيضًا.. ما تفاصيله؟
- مشروعى الدرامى بدأته منذ عام 1994، فكنت وبعض أبناء جيلى نذهب ليوسف شاهين فى مكتبه، والرجل كان له تأثير كبير فى جيلى، ومن هنا بدأت أكتب، وكان المخرج الكبير يعمل على فيلم «المهاجر» حينها، ونخبره بأفكارنا ونسلم عليه وندعوه لمشاهدة مسرحياتنا، وكان يحضر.
كتبت فيلمًا سميته «ورد وبارود»، وعرضته على أحد الأصدقاء المخرجين، لكن لم يكتب له أن يتجسد سينمائيًا. والحقيقة أننى كتبت العديد من الأعمال الدرامية وغيرها، لكن لم يتجسد أحدها إلى الآن، كتبتها من واقع الدراسة، وهناك عمل درامى ضخم من 30 حلقة لم يكتب له أن يرى النور أيضًا، وهناك فيلم كتبته باسم «مدد»، لكنى حولته إلى رواية بعد ذلك، ولدىّ عدد من المسلسلات والأفلام الكوميدية، وانشغالى بالإعلام أبعدنى عن العمل فى هذا المجال.








