أدهم العبودى: نمتُ فى «الجَبَّانة» وصاحبت «مجاذيب» لكتابة رواياتى

- الجنوب أضاف الكثير لكتابتى وكل صعيدى هو حكاية مستقلة
- هجرت الجنوب والأسطورة إلى الصوفية فى «حارس العشق الإلهى»
- كل تجاربى فى النشر مفيدة ولا يمكن أن أفضل إحداها على الأخرى
- ظللتُ أكتب الشعر لسنوات.. وأفكر فى معرض لموهبتى الأولى الرسم
واحد من أبناء الجنوب الذين تعاملوا مع طمى الأرض وملحها، عاش الكثير من الحيوات فى صورة حكايات سمعها من هنا وهناك، فالمجتمع الجنوبى حكاء بامتياز، ومن لا يحكى يستمع.
عاش فى مجتمع يعتبر الحكاية مثل الطعام والشراب، وحين كبر قرر أن تكون مهمته هذه الحكايات، سواء كما هى بكل ما فيها من ثراء ومعانٍ وواقع من شدة غرابته حسبته خيالًا، أو ممزوجة بالخيال وأفكار أخرى.
إنه الروائى الأقصرى أدهم العبودى، صاحب روايات «متاهة الأولياء» و«خطايا الآلهة» و«حارس العشق الآلهى» و«ما لم تروه ريحانة» و«الخاتن»، وغيرها الكثير، والذى تلتقيه «حرف» فى حوار خاص، للتعرف على أبرز ملامح تجربته الثرية.
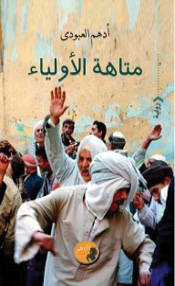
■ فى روايتك «متاهة الأولياء» كانت هناك لغة رهيفة تنبع من استنادك على المكان فى الجنوب، وفيما بعدها، حاولت أن تُلبس كلَّ رواية ثوبًا خاصًّا بها، على اعتبار أنَّ اللُّغة تنتمى للعمل وليس الكاتب.. كيف حققت ذلك؟
- الجنوب أضاف لى الكثير على مستوى الكتابة، يكفى تلك التفاصيل السحريَّة الموجودة فى شكل المعابد والمنقوشة على جدرانها، تفاصيل البشر بأشكالهم وطموحاتهم البسيطة ومعاناتهم الدَّائمة.
الجنوب ملىء بالتُّراث والحدُّوتة والأسطورة، مخزون ثقافى كبير وضخم يمدّنا بالحكاية بلا نهاية، كلّ إنسان فى الجنوب له حلمه المختلف، حلم كبير، لكنَّه مختلف، كل إنسان له قصة آسرة، كلّ إنسان فى حد ذاته حكاية مستقلة. فى «متاهة الأولياء» كانت اللغة محركًا جوهريًا لدوافع الشّخوص ومعبِّرًا عنها. أنت هنا تتحدَّث عن أكثر من سبع وثلاثين شخصية تتقاطع بينها المصائر، لها أحلامها، لها حكاياتها، لا تبدأ كما ستنتهى، لا تستطيع التعبير عن لحظات الانكسار والغضب والحزن والفرح، ولا يُمكنها وصف المتغيِّرات والتحولات إلا عبر الحوار فيما بينها.
«متاهة الأولياء» من أصعب الرّوايات التى كتبتها. مثلًا اضطررت أن أبيت فى الجبّانة لأيّام متتالية كى أكتب شخصية «إبراهيم الفحَّار». صاحبت مجذوبًا وكتبت طريقته فى الكلام، قرأت الأناجيل. رواية مرهقة على مستويات كثيرة أهمّها اللُّغة.
أمَّا أن تتوحَّد اللُّغة ما بين شخصية قادمة من جِباب التاريخ، وشخصية تعيش حولنا اليوم، شخصية لها أفكارها المتضادَّة مع شخصية أخرى، فهذا من وجهة نظرى عدم اعتناء بالشخصيات. ليس أدل على ذلك من امتزاج المفردات العاميَّة مع الفصحى فى «متاهة الأولياء». بينما رواية مثل «خطايا الآلهة» أو «حارس العشق الآلهى» كان يستحيل معهما استخدام نفس اللغة.
اللُّغة فى حدّ ذاتها بداية البنيان، الأساس الذى تقوم عليه إنشاءات لا بد أن تكتمل، مثل الحبكة وأسلوب السرد وتقنيات الكتابة على اختلافها من عمل لآخر. علينا أن نحتفى باللُّغة بما يليق بمكانتها، فضلًا عن اعتبارها مكونًا أوليًا من مكوّنات الضَّرورات الفنيَّة والسياقات الجماليَّة. اللُّغة أكبر أداة من أدوات التحرِّى عن الجمال.
■ تطرح نوعين من الأعمال أوَّلهما له جانب عقائدى نفسى مع الاتكاء على الأسطورة، والآخر يناقش قضايا عامة مثل روايتك «ما لم تروه ريحانة».. ما دافعك فى الاثنين؟
- إن الأسطورة لها انعكاسات على سلوك كلّ مجتمع بعينه يؤمن بهذه الأسطورة بل ويستعين بها، مهمًا بدا من تغيّراته وتطوّراته. أظنُّ أنَّ الأسطورة محرّك أساسى من محرّكات المجتمعات، خاصة تلك التى قصرت تقدُّمها على ملابسات الأسطورة وظلالها ودلالاتها. الأسطورة أيضًا تعد جزءًا أصيلًا وحتميًا من عقيدة كل مجتمع، فالعقيدة قائمة على الإيمان الحسّى لا البصرى، مثلها مثل الأسطورة، قائمة على التّواتر والحكايات المتواترة.
كان يُمكن أن تدور أجواء رواياتى داخل قوالب واقعيَّة أو تاريخية بحتة، دون الالتفات لسحرية «الفانتازيا» وما تصبغه على الحكاية من عُمق أسطورى، لولا أن سيقت قناعاتى- عن غير عمد- إلى أن أمارس الأشكال الجديدة التى ظلَّت تراودنى وتشاغبنى، فامتزجت الأجواء وتشابكت.
أمَّا القضايا المعاصرة، قضايا المرأة مثلًا، ففى مجتمعاتنا الشرقيَّة تتشابه قضايا مع أخرى. «ما لم تروه ريحانة» ليست قضية امرأة ظُلمت وأُعدمت دفاعًا عن شرفها، بل امرأة عرّت مجتمعًا بأكمله، وضعته نصب الأعين وتحت دائرة الضّوء، كشفت مساوئه للعالم كلّه. ريحانة جبّارى شغلتنى كثيرًا ودُفعت دفعًا لسرد سيرة مغايرة عنها، سيرة اختلط فيها الواقع بالخيال، سيرة لا يُمكن إلَّا أن تكون سيرة مجتمع بأسره، على علّاته وعوراته.

■ ناقشت جلال الدين الرُّومى والتَّصوف فى عملين كانا من أهم أعمالك مبيعًا.. ما الذى جعلك تهجر الجنوب والأسطورة لتكتب فى التصوف وغيره؟
- يُمكن أن نطلق عن هذا الهجر «تجريبًا»، فى النهاية هو هجر جميل، أن يتّسع لك القلم للكتابة عمّا هو مغاير. «حارس العشق الإلهى» لم تنح للصّوفية كما نحت لاستجلاب الحكاية من التّواريخ المنسيَّة، المؤلمة فى معظمها. مع ذلك أمامك خياران: إمَّا أن تسرد الوقائع المعروفة الآمنة، وإمَّا أن تفرش خيالك صانعًا وقائعك الخاصَّة بك. فى الجزء الأوَّل من «حارس العشق الإلهى» ظللت مشغولًا بنشأة تجربة صوفيَّة مختلفة وفريدة، لذلك لم يلتق «الرُّومى» و«التبريزى» إلَّا فى المشهد الأخير. فى الجزء الثَّانى كان لا بد من التعمُّق فى العلاقة الآسرة الأسطوريَّة ما بين كليهما، ما الذى حدا بالمريدين والأبناء أن يتدخَّلوا لبتر هذه العلاقة مثلًا؟ كيف عومل «التِّبريزى» وقد شوهد أكثر من مرَّة فى رحاب «الرُّومى»؟ كيف رآه الآخرون؟ لماذا نكَّلوا به ثمَّ قرَّروا أن يقضوا على حياته؟ إنَّها تساؤلات لها علاقة بمستويات بشريَّة معقَّدة ومتشابكة، ليست الغيرة وحدها ولا الظّنون، ربّما هناك طبقات من السّلوك البشرى لم تقصصها الحكايات.

■ وماذا عن رواية «الخاتن» التى ناقشت فيها مأساة الأكراد؟
- «الخاتن» رواية ذات طبيعة مأساوية، تذهب للقُتم حينًا وللأمل المبعوث جدلًا حينًا آخر، تمزج الواقع المرير بالخيال الصّادم، تدور بين الماضى والحاضر، بين الأزمنة، بين الاسترجاع والتخيّل، وتطرح تساؤلات عن كُنه أعماق النفس البشرية، وتحوّلاتها من سوادٍ إلى سواد أعظم.
تتساءل هل يُمكن أن تؤثّر العلاقات العابرة على أقدار الشّخوص؟ هل يُمكن أن تهجر الملائكة أرض البشر؟ هل يُمكن أن نكاشف الرّب عمّا تختزله أرواحنا من شكوى؟ كيف نتحوّل من لا شىء إلى عدم مطلق؟ وكيف تهون الأوطان على أنظمتها؟ كيف يُمكن أن يختِن النِّظام وطنًا بأكمله؟!
تمتدّ المأساة بديمومة الأسى نفسه، الأسى البشرى، لا يستطيع أن يستعيض الفرد بماضيه أى أمل، رحلة نحو العبث، نحو الخرافة، نحو أسطرة الواقع قسرًا جرّاء الحسرة، رحلة نحو كلّ ما يتفرّع إلى المأساة بأكثر من وجه وأكثر من التباس، رحلة فى عُمق الإنسان، خالصًا، الإنسان المفطور على الارتحال والتأمّل، والمجبور على مواجهة قدرَه، إمّا بالإيمان المُطلق أو بالجدل والتساؤل.
يرى البطل أنّ المشاهد التى تبقى من الوطن تفنى داخل حلقة من الغبار والدُخان والنّار، يرى أنّ العالم يستعذب الضَّلال، يبدّل ثوبه القديم، يستعذب بكلّ جوارحه بلا احتساب، شاحذًا بأسه وجبروته، إذ يصبح الدّم والموت والألم والدَّهشة والغباء والبلادة والقمع والعجز تسكن هذا العالم، والأرض تغرق بدمائهم، بهؤلاء المستهلكين سلفًا.

■ تعاقدت منذ فترة على صدور كل أعمالك عن دار «الرَّسم بالكلمات».. كيف تقيّم التجارب السابقة؟ وتجربتك الحالية مع الناشر محمد المصرى؟
- كلّ التّجارب التى خضتها عبر رحلاتى فى النشر كانت مفيدة وأضافت لى الكثير، ليس يُمكن فصل تجربة عن غيرها، ولا يجوز أن نفضّل إحداها على الأخرى، كلّها ساهمت فى أن يكون ثمّة بناء أمام الأبصار، بناء له ملامحه، لذا لو عاد بى الزمن لسلكت نفس السُّبل، لصدرت أول أعمالى فى دار «وعد»، ولكنت نشرت فى جميع الدّور التى تعاملت معها.
أنا نتاج تجاربى، مهما ساءت تجربة وكان تقييمى لها. إنَّنا أبناء أخطائنا فى نهاية الأمر، وسوء تقديرنا أحيانًا، ولولا الخطأ ما حدث الصّواب، خاصَّة أنِّى بدأت الكتابة مبكرًا، كنت أكتب القصص وأمزّقها، والتحقت بأحد نوادى الأدب، وهناك كتبت الشِّعر على استحياء، ظللت لسنوات أكتب الشعر، وفى مصادفة قدريّة تحوَّلت إلى السَّرد، ووجدتنى هناك، هل يُمكن اعتبار الشِّعر تجربة فاشلة؟ على العكس، الشِّعر كان طريقى للسَّرد، لذلك أعتبر كلّ تجاربى كانت سعيًا لما أنا عليه الآن.
بخصوص «الرَّسم بالكلمات»، أرى أن التَّجربة إلى الآن مرضية بالنسبة لى، الدَّليل أنِّى منذ تعاقدت معهم على نشر «معشر الجنِّ» أكملت معهم المشوار، من خلال إعادة نشر أكثر من ٨ أعمال.

■ أصدرت أيضًا أعمالًا لها علاقة بتخصُّصك فى المحاماة مثل «حكايات الرُّوب الأسود» و«المحكمة تستشعر الحرج».. كيف ترى هذين العملين وسط أعمالك الروائية؟
- قبل هذين العملين أصدرت كتبًا لها علاقة بالسّيرة الذاتية مثل «نوستالجيا ٨٠» و«سيرة المجاذيب». أنا أعتقد أنَّ السّيرة الذاتية جزء من مسار الكاتب الإبداعى، إنَّنا نكتب أنفسنا على كلّ حال، حياتنا تتسرَّب رغمًا عنَّا إلى كتابتنا، والكتابان عن المحاماة والمحكمة مجرَّد امتدادين لكتابة السّيرة الذاتية نفسها.
ظننت أنَّ عشرين عامًا كافية لأن أكتب عن تجربتى خلالها، ثمّة ما ظلّ يؤرّقنى، ثمّة حكايات وتصوّرات عن هذا العالم غير المعلن علىّ أن أتخلَّص منها. إنَّنا فى سراى المحكمة نقابل أنماطًا شديدة الواقعيَّة، لكنَّنا نقابلها فى أشدّ لحظاتها انكسارًا ومعاناة، نقابلها فى ضعفها وعجزها وقلّة حيلتها، وهذه أنماط ملهمة لأى كاتب، تخيَّل أن ترى البشر فى ظلّ كلّ ما يُمكن أن تباشره عليهم الحياة من قسوة ومرارة!

■ حزت بعض الجوائز مثل «الشَّارقة» و«إحسان عبدالقدوس» و«اتّحاد الكتّاب»، ودخلت قوائم قصيرة مثل «حمد بن راشد الشَّرقى»، وطويلة مثل «كتارا».. كيف ترى دور الجوائز فى عالم الكتابة؟
- الجوائز فى حدّ ذاتها إبقاء لك على طريق قرَّرت طواعية أن تسلكها، إنَّها الضّوء الذى يدفعك لأن تتبعه، هذا ليس معيارًا أكيدًا بالطَّبع، لكنَّنا بشر، فى لحظة انهيار يُمكن أن نترك كلّ شىء ونتقهقر، الجائزة تأتى أحيانًا كأنَّ الكون يصفِّق لك، ويقول لك أكمِل أنت على الطَّريق.
ماذا إذا أفنيت سنوات عمرك ولم تتحصَّل على النتائج التى تستحقها؟ مؤكَّد سيدخل إلى روحك اليأس ويدفعك دفعًا لهجر الطَّريق التى اتّخذتها، حينها قد نفقد مبدعًا عظيمًا. لسنا كلّنا نشبه بعضنا البعض، الحياة أقسى من أن يحتملها كلّ المبدعين.
ثمّة ركائز ينبغى أن تكون لكى نعلو ونتطوّر ونبدع، لا أقول إنَّ الجوائز مهمَّة للجميع، فقيمتها ماديًا ومعنويًا قد لا تعنى بعضًا منَّا. لكن أقول إنَّ دور هذه الجوائز مهمّ، وعلى إداراتها وحكَّامها أن يتوخّوا الحياديَّة والنزاهة بقدر الإمكان.
عليهم أن يلتفتوا أكثر للمبدعين الحقيقيين الذين هُمِّشوا كثيرًا، أولئك الذين لم يعد يشعر بهم أحد، وما أكثرهم، خاصة أن الإحباط فى هذه الحياة تفشَّى وترعرع، ونال من مبدعين كثيرين لا مجال لذكرهم هنا.

■ فى النِّهاية.. ما تفاصيل عملك المقبل؟
- عملى المقبل يطرح قضية مسكوتًا عنها ولا يرغب أحد فى طرحها، دعنا ننتظر التفاصيل قريبًا.

■ رسمت العديد من الشخصيات، منها بهاء طاهر ومحمد صلاح وغيرهما.. ألم تفكِّر فى معرض يجمع كلّ تلك «البورتريهات»؟
- موهبتى الأولى هى الرَّسم، وهى موهبة انتقلت لى من أبى توارثًا. قضيت حياتى إلى أواخر العشرينيات وفى ظنِّى أنَّ هذه الموهبة هى التى سأتقدَّم من خلالها لهذا العالم، لكنَّ الكتابة غلبت فى نهاية الأمر. أفكِّر بالفعل فى معرض لـ«البورتريهات»، لكن هذا قد يأخذ منِّى بعض الوقت.








