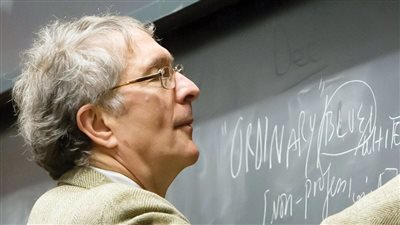إبراهيم الإعيسر: الفن «كومبارس» لا يمكنه أن يكون فلسفة

عبر رحلة نقدية غنية بالرؤى، قدم الكاتب والناقد السودانى إبراهيم أحمد الإعيسر نقدًا فلسفيًا عميقًا، تجاوز النصوص الأدبية إلى الفنون بمختلف أشكالها، حتى أصبح اسمًا ذا ثقل فى مجال النقد الفنى والأدبى على حد سواء.
فى حواره التالى مع «حرف»، يكشف «الإعيسر» كيف يمكن لأفكاره الفلسفية فى أعماله المختلفة أن تساعدنا فى استكشاف القضايا الوجودية والإنسانية، وكيف يدمج بين الفلسفة والفن فى تحليلاته النقدية، متطرقًا فى الوقت ذاته إلى رأيه فى العديد من القضايا الثقافية على الساحة.

■ البعض يقول إننا فى العالم الشرقى نعيش «عصر غثاء ثقافى».. هل تتفق مع ذلك؟
- ليس «غثاء ثقافيًا» فقط، نحن نعيش فى ظل غثاء فكرى واجتماعى وسياسى وحضارى. أما إذا تحدثنا عن الجانب الثقافى تحديدًا، يمكن أن نعرف الأزمة بأنها أزمة مؤسسة ثقافية وعلمية قبل أن تكون أزمة مثقف. فالمؤسسات الثقافية المبنية على معايير إبداعية ومعرفية أيديولوجية، والتى «سلعت الثقافة» عبر الرأسمالية المتوحشة، هى ما أنتج مثقفًا غير ناضج معرفيًا وإبداعيًا وأخلاقيًا، حتى وغير ملتزم كذلك. مثلًا إذا نظرنا لكثير من المؤسسات والمراكز الثقافية التى تدعم الجوائز الأدبية، نجد أنها تحت رعاية سلطوية حكومية، تفرض معاييرها الأيديولوجية والثقافية.
المؤسسات العلمية كذلك تفترض مناهج علمية ذات توجه أيديولوجى، يسهم فى «هندسة التجهيل»، عبر تزييف الحقائق التاريخية، واستخدام آلية التلقين فى التعليم. أى ببساطة «أدلجة» أو «تسييس» أو «تسليع» الثقافة والعلم، ما ينتج مجتمعات غير ناضجة الفكر، أو غير قادرة على تكوين تفكير نقدى.
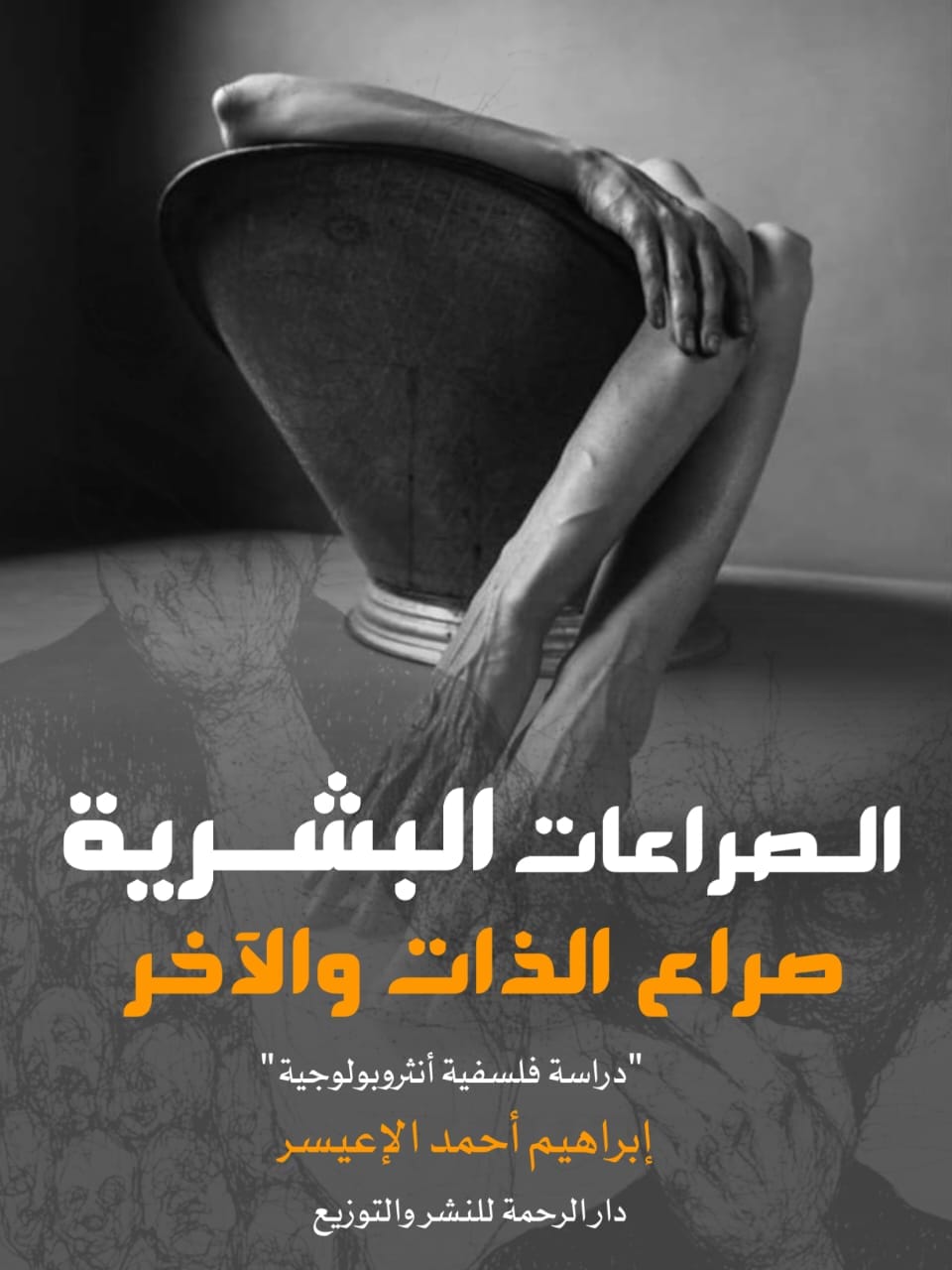
■ «إبستيمولوجيا الجنون والفنون» هو أحد أبرز أعمالك.. كيف تفسر العلاقة بين الجنون والإبداع؟
- العلاقة بين الجنون والإبداع علاقة «المختلف أو اللا مألوف»، فمن منطلق فلسفى، يمكن أن نعرف الجنون بأنه حالة وعى أو فكر متقدم أو نبوغ عالٍ، كما الإبداع، وهذا التقدم أو التعالى هو ما يعنى «اللا مألوف». الرواية مثلًا كمنتج حضارى غربى، ظهر فى أوائل القرن الـ١٨، بعد الفنون الأخرى مثل الشعر والمسرح، لكنها صُنفت كفن أدبى، لأنها قدمت نفسها كـ«مختلف». كما يمكن تعريف الجنون أيضًا بأنه «اللا متوقع»
■ هل هناك فترات فى حياتك شعرت فيها بأنك قريبًا من «الجنون» أثناء الكتابة؟
- تجربتى فى كتابة «الصراعات البشرية.. صراع الذات والآخر»، وهى دراسة فلسفية أنثروبولوجية، شعرت فيها بإحساس «الجنون» على المستوى الفكرى، بل أننى «شطحت» فى التفكير لدرجة أجبرتنى على حذف جزء كبير جدًا من الكتاب لأسباب فكرية دينية، وأسئلة لم أجد لها إجابات. هذا الكتاب بدأت «خميرته» الفكرية فى ظل الحياة المأساوية التى عشتها فى السودان، من فراغ وبطالة واكتئاب بسبب الأوضاع الاقتصادية الطاحنة، وفشل الثورة السودانية، علاوة على فشلى فى الهجرة إلى أوروبا.
■ فى أعمالك هناك ارتباط كبير بين الفلسفة والفن. ما الذى يجعل الفلسفة ضرورية لفهم الفن، والعكس؟
- تمثل الفلسفة بالنسبة لى أعلى درجات التفكير فى الحقول المعرفية، لذا أنا أوظف الفلسفة كمادة خام للفن، أو الفن بالنسبة لى هو ولادة فلسفية مشوهة من رحم الفلسفة. أهمية الفلسفة تكمن فى أنها تولد تفكيرًا نقديًا، يساعد فى البنية الفنية من حيث خطابها. أما الفن بالنسبة لأهميته إلى الفلسفة، فهو «كومبارس»، يستعرض الفلسفة فى قوالب فنية، ولا يمكن أن يكون بذاته فلسفة.
■ مَن أهم الفلاسفة الذين أثروا فى مسيرتك الفكرية؟ وكيف استطعت دمج أفكارهم مع رؤيتك للجنون والفنون؟
- يمكننى القول إن الانتقائية العالية حاضرة فى كل تفاصيل حياتى، ودائمًا ما تمثل نقيضًا لـ«الكلاسيكية» التى ترفضها الفلسفة نفسها، لذا أفضل أكثر الفلاسفة عمقًا وتمردًا على «مألوفية الفكر»، مثل الفيلسوف الأمريكى توم ريجان، الذى تخصص علميًا فى تخصص نادر، هو «حقوق الحيوان»، ويعارض من خلاله استخدام الحيوانات فى التجارب العلمية.
هناك أيضًا الموسوعى باروخ سبينوزا، الذى وصف العالم بأنه «عبارة عن فئة فرعية من الله»، إضافة إلى مارتن هايدجر، وفيلسوف التشاؤم أرتور شوبنهاور، والساخر فولتير، والمثقف البوهيمى ديفيد رجل الكهف.
■ ما المعوقات التى تواجه الكُتاب والمثقفين فى منطقتنا العربية؟
- يمكننى العودة إلى المؤسسات الثقافية التى «سلعت» و«أدلجت» الفن، فأصبح الفن للأغنياء، ولمن يتماشون مع المعايير التى تضعها هذه المؤسسات لتأطير الفكر والإبداع، بالإضافة إلى عدم الاستقرار المادى والنفسى، وما تعانيه الخارطة الإفريقية والعربية من مشاكل اقتصادية وسياسية وحروب أهلية، تمثل جميعها آليات متحدة لـ«قتل» الثقافة والمشاريع الثقافية، علاوة على عدم وجود قارئ بنسبة كبيرة، ما يخلق عاملًا محبطًا لدى الكاتب.
■ كيف ترى دور المثقف فى ظل جنون الحروب الطاحنة بالمنطقة؟
- الدور الحقيقى للمثقف هو الالتزام الأخلاقى، فالحرب نفسها كفكرة وصراع لتقسيم الموارد، هى من هندسة عقل مثقف غير ملتزم أخلاقيًا تجاه شعبه والشعوب الأخرى. المثقف من واجبه أن يكون صادقًا وأمينًا لوطنه وشعبه، وألا يُباع ويُشترى كسلعة رخيصة مقابل الخيانة لمصالح الآخر.
■ ماذا عن نظرتك للفنون والكتابة فى ظل التحولات السياسية والاجتماعية التى نعيشها فى عالمنا العربى اليوم؟
- بقدر ما تؤثر التحولات السياسية والاجتماعية على صناعة الفن، تشكل مادة خام للفن، فالفن يخرج من رحم المأساة، ويمكن الاستدلال على ذلك بالتجربة السورية، التى أنتجت منتوجًا فنيًا كبيرًا، فى دول الشتات التى هاجر إليها السوريون بعد ٢٠١١، إلى جانب تجارب المهاجرين الأفارقة فى فرنسا.
■ كيف ترى تأثير الثقافة السودانية والعربية بشكل عام على كتاباتك؟
- أولًا، اسمحى لى ألا أعرف نفسى بـ«عربى»، فأنا لم أعش فى ظل ثقافة عربية، ولا أنتمى إثنيًا وثقافيًا إلى العروبة، بخلاف ما أحمله من جذور عربية مغربية، وهذا محط جدل حول هوية المغاربة: عرب أم أمازيغ؟! أنا مغترب عن الثقافة العربية لتخلق فىَّ الأثر الذى يجعلنى أوظفها فى كتاباتى.
من ناحية أخرى، مشروعى قائم على الاهتمام بالفلسفة والنقد الفنى. لكن عمومًا إذا نظرنا إلى الثقافة السودانية، هى تمثل مجموعة ثقافات متنوعة ومتعددة وغنية وفريدة من نوعها. لكنها لم تجد حيزها الكافى من التعريف على المستوى العالمى. لذا، الفن يمثل أفضل وسيلة للتعريف بها، وزيادة انتشارها وتأثيرها.
■ هل يمكن أن تؤدى التطورات التكنولوجية المتسارعة إلى «جنون» جديد فى الأدب والفن؟
- التطورات التكنولوجية أسهمت فى إنتاج أسطورة زائفة، أو إنتاج أناس «تافهين»، كما وصفهم الفيلسوف الكندى آلان دونو، فى كتابه «نظام التفاهة». بسطت التفاهة سلطانها على أرجاء العالم كافة، و«التافهون» صار لهم القول الفصل والكلمة الأخيرة فى كل ما يتعلق بالخاص والعام، بداية ونهاية بالجامعات والكليات ومراكز الأبحاث. كما أسهمت التكنولوجيا فى رفع ثقافة المشاهدة على ثقافة القراءة، لذا بالتأكيد لها أثر كبير على تراجع نسبة المقروئية.