سيد ضيف الله: غالبية المُبدِعات تبرأن من «الكتابة النسوية» بسبب التشويه

- الانتقاص من إبداع المرأة يحتاج مقاومة وليس تبرؤًا من «النسوية»
- النقد الأدبى النسوى أكثر الاتجاهات النقدية العربية سوء حظ
- هذا النوع من الأدب تعرض إلى تشويه قوى على مدار عقود
فى كتابه النقدى الأحدث: «الرواية التاريخية النسوية- مقاربات لنماذج روائية»، الصادر عن «بيت الحكمة للثقافة»، يقترح الدكتور سيد ضيف الله، أستاذ النقد الأدبى المساعد فى «قسم النقد الأدبى» بمعهد النقد الفنى فى أكاديمية الفنون، تقديم إعادة قراءة لتاريخ الرواية التاريخية فى كل دولة عربية، على ضوء تقاطعات الهُوِيَّة الجندرية مع الطبقة الاجتماعية والهُوِيَّة الدينية والوطنية، بهدف كتابة تاريخ للرواية من منطلق تعدد التصورات الموجودة باستمرار حول الأمة التى ينتمى لها المبدعون والمبدعات.
بنى «ضيف الله» تفاوضه مع «النقد النسوى» على أساس الوعى بضرورة تجاوز مرحلة الاتهامات، والأهم ضرورة مواجهة الفزاعات التى تقف فى وجه الناقد، حين يحاول أن يمارس عقله النقدى من على أرضية هذا النوع من النقد، من أجل العثور على آلية تحليل للنصوص الأدبية تنسجم مع تقاطعات فعلية فى مجتمعاتنا العربية للهُوِيَّات الجندرية والاجتماعية والدينية والوطنية.
حول هذا الكتاب، ومصطلح «الرواية التاريخية النسوية»، و«الجندر» فى الكتابة بصفة عامة، وغيرها من التفاصيل الأخرى المهمة، يدور حوار «حرف» التالى مع الدكتور سيد ضيف الله.

■ لنبدأ بعنوان كتابك الأحدث.. ما تعريفك لـ«الرواية التاريخية النسوية»؟
- من الضرورى عند محاولة صك مصطلح جديد أن نتعرف على الخلفية المعرفية التى تنتجه. هذا التعرف لا غنى عنه لتحديد الموقف من هذا المصطلح الجديد، خاصة إذا كان فى منطقة بحث إشكالية.
أؤمن بضرورة الإقرار بوجود اختلاف بيولوجى «ذكر/ أنثى»، وأن هذه الطبيعة البيولوجية لا يمكنها أن تنجو من تشكيل ثقافى واجتماعى تبلور لكل طبيعة بيولوجية أيديولوجيًا، لنغدو أمام جندر «مُذكر» وجندر «مؤنث».
ومن ثَم، فالتعامل النقدى مع النصوص الأدبية لا يمكنه أن يتم- من وجهة نظرى- مع الأنثى والذكر مجردين من التشكيل الثقافى والاجتماعى لهما، ومن ثم يتعامل الناقد مع النصوص الأدبية بوصفها نصوصًا «مُجندَرة» أى نتاج مؤلف/ مؤلفة ذى/ ذات وعى مُذكر أو وعى مُؤنث، وبناءً عليه يكون نصًا بوعى ذكورى أو نسوى.
■ ما المقصود بـ«الجندر» من وجهة نظرك؟
- المقصود بـ«الجندر» هنا مجموعة من الخصائص التى تشكلت ثقافيًا، ويتم إضفاؤها على الإناث والذكور لتحديد أدوارهم الاجتماعية فى سياق تاريخى معين، وهو يشير إلى علاقات القوى بين الجنسين. وعلى هذا، حين ينطلق كاتب أو كاتبة من الوعى بوجود خلل فى منظومة علاقات القوى فى المجتمع ضد المرأة، ويسعى للكتابة الأدبية لمقاومة هذا الخلل من أجل «عدالة جندرية»، فإن النص المُنتَج، سواء كان لرجل أو لامرأة، هو نص ذو وعى نسوى.
■ هل نفهم من هذا أن العبرة فى التمييز بين النصوص الروائية ليست حسب جنس المؤلف، وإنما بنوع الوعى الذى تقدمه الرواية؟
- بالضبط. لأننا حين نقول إن الروايات «مُجندَرة»، فإننا لا نعنى أننا أمام صراع بين نصوص كل الرجال ونصوص كل النساء، وإنما يعنى أن نفهم «جندرة» الروايات على أساس أن الروايات بشكل عام، والرواية التاريخية خاصة، هى ساحة نزاع بين الساعين للمساواة من جانب، والحريصين على استمرار «الهيمنة الذكورية» من جانب آخر، وكل فريق منهما فيه رجال ونساء.

■ لماذا اخترت الرواية التاريخية تحديدًا لترصد فيها مظاهر هذا الصراع؟
- لجوء أى كاتب أو كاتبة إلى التاريخ لكتابة رواية له أهداف عديدة، تختلف باختلاف الروايات، إضافة إلى ذلك، لم يعد هدف الروائيين والروائيات الذين يكتبون الرواية التاريخية هو تعليم القارئ نصف المتعلم التاريخ، مثلما كان يقول جورجى زيدان، رائد الرواية التاريخية.
ومع ذلك، سواء كنا نتكلم عن روايات جورجى زيدان التاريخية ذات الطابع التعليمى، أو كنا نتكلم عن أحدث رواية تاريخية صدرت من مطابعنا اليوم، فلا يمكن أن ننكر أن الرواية التاريخية، سواء هدفها الظاهر تعليميًا أو سياسيًا.. إلخ، تقدم بوضوح تصور مؤلفها أو مؤلفتها للهوية، وتظهر بوضوح صورة الأمة التى يتخيلها المؤلف على أنها أمته وأمة قارئه الضمنى، والأخير هو قارئ مفترض فى ذهن المؤلف لحظة كتابة روايته، ويكاد يصاحبه ذهنيًا وهو يكتب كل سطر فيها، فيتسرب لها حتى لو لم يُشار إليه بشكل صريح.
■ وما العلاقة بين «الهوية» و«النسوية»؟
- الهوية «مُجندَرة» أى متأثرة بوعى الناس رجالًا ونساء، منحازين للمساواة والعدالة، أو ساعين للهيمنة على الآخرين، واستمرار سيطرة الثقافة الأبوية الذكورية على مفاصل الحياة. وبالتالى هناك نساء يدافعن عن السلطة الأبوية والثقافة الذكورية، مثلما هناك رجال يدافعون عن العدالة بين الرجال والنساء، وعدم التمييز على أساس الانتماء البيولوجى، ويقاومون التغطية الثقافية التى تضفى الشرعية على هذا النوع من التمييزات.
والناقد لا يعتنى بمعاينة علاقات القوى بين الرجال والنساء فى المجتمع وتمثيلاتها فى النصوص فحسب، وإنما يمتد عمله بالضرورة إلى معاينة علاقة القوى بين النساء والنساء فى المجتمع، وتمثيلاتها فى النصوص كذلك.
من هنا كان انحيازى فى هذا الكتاب إلى استخدام كلمة «النساء» وليس «المرأة»، لأننى لا أتعامل مع قضايا النساء باعتبارها قضايا «المرأة»، لما فى مفهوم «المرأة» من وضع كل النساء على تنوع خلفياتهن الطبقية والعرقية والثقافية والسياسية والتاريخية والجغرافية فى سلة واحدة، ومثلما يتجلى الاختلاف بين الجنسين فى علاقات القوى، ينعكس الاختلاف فيما بين النساء على طبيعة علاقات القوى بينهن.
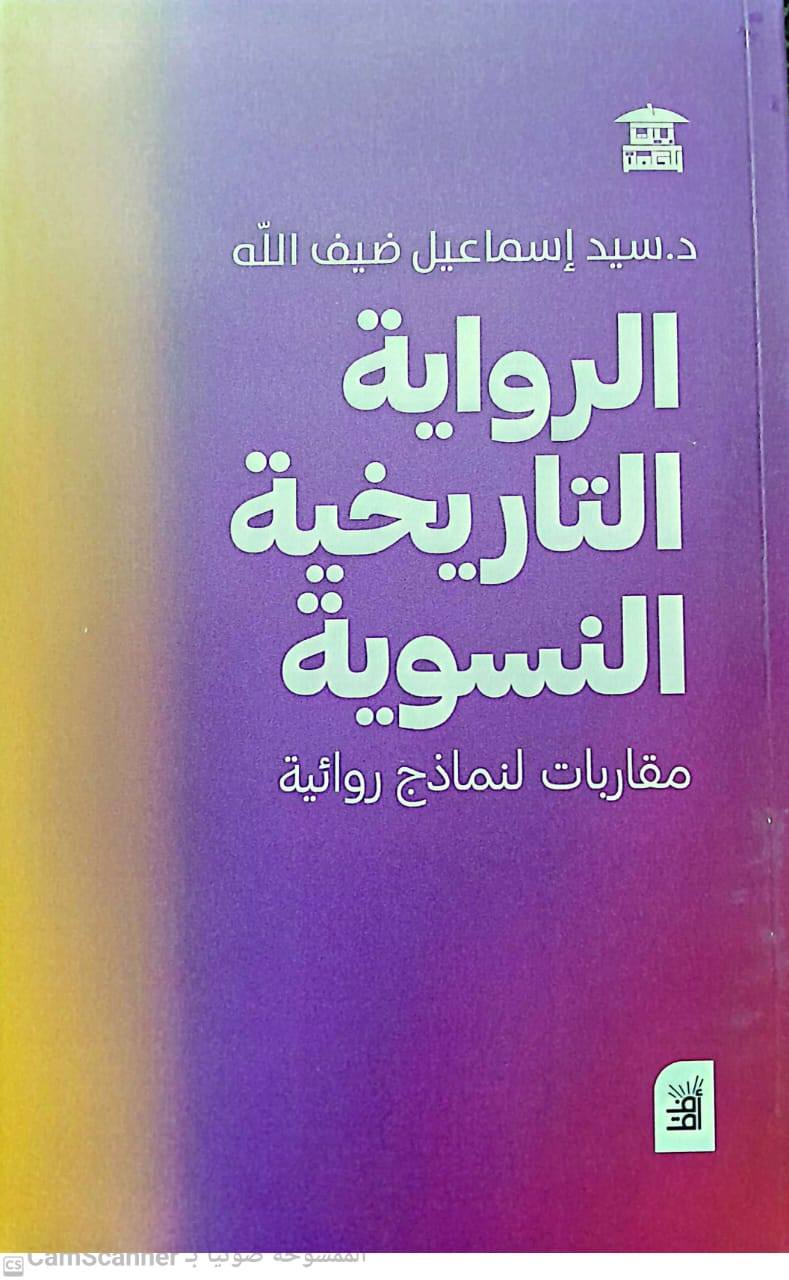
■ فى ضوء هذا التصور، ما أبرز ملامح الرواية التاريخية النسوية التى رصدتها؟
- ليس ثمة تعارض بين البحث عن جماليات للرواية التاريخية النسوية، والكشف عن مقاومة هذه الروايات للسلطة الأبوية بوصفها غاية نفعية تحفز الكاتبات على تخييل الواقع. ويمكن القول إن كل نص تاريخى نسوى له مُخطط سردى تتحقق به تلك الغاية، وإذا اتفقت الروايات النسوية من وجهة نظرى على غاية أساسية، وهى مقاومة السلطة الأبوية، فإن هذه الروايات بطبيعة الحال ذات مُخططات سردية مُختلفة، لكل مُخطط منها جماليته الخاصة.
إضافة إلى ذلك، الروايات التاريخية النسوية لديها غاية أبعد من مقاومة السلطة الأبوية، وهى بناء الأمة وفق عدالة «جندرية» تحول دونها هيمنة الذكورية والأبوية على الأمة المُتخيلة التى تجعلها تظهر بصورة متجانسة.
لذا ما أعنيه بمصطلح «الروايات التاريخية النسوية»، الذى أقترحه فى الكتاب، هى تلك التى تسعى للكشف عن عدم تجانس تصورات الأمة بتمثيلها لعلاقات القوى الاجتماعية والثقافية بين الشخوص فى سياقها التاريخى، خاصة بالاعتماد على مخططات سردية تتمكن بها الأصوات المهمشة، لتعود العدالة «الجندرية» بين الأصوات السردية فى المجالين الخاص والعام، بغض النظر عن النوع البيولوجى للمؤلف.
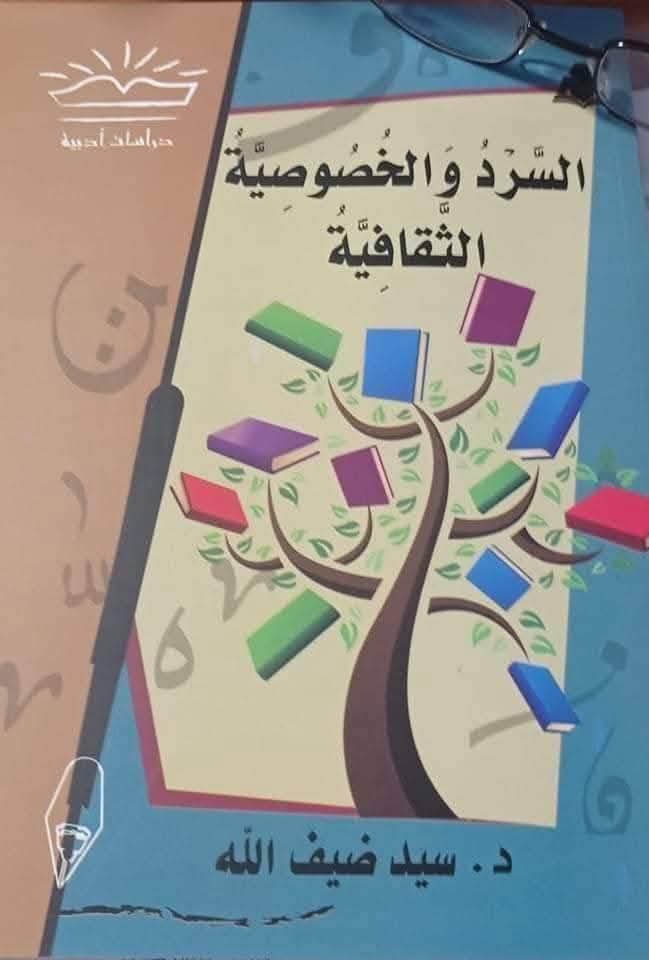
■ كيف طبقت ذلك على الروايات محل الدراسة؟
- اخترت ٣ روايات لهذه الدراسة، هى: «سيدات القمر» للعُمانية جوخة الحارثى، و«النبيذة» للعراقية أنعام كجه جى، و«غيوم فرنسية» للمصرية ضحى عاصى. لم أهدف من وراء اختيارى هذه الروايات الإيهام بتمثيل جغرافى عربى ما، ولا الإيهام بوجود اتفاق بين البلاد العربية فى تاريخ حركاتها النسائية، ولا فى نوعية مشكلات النساء فيها ومستواها، ولا فى تشابه الكتابة الأدبية النسوية فيها. فمن وجهة نظرى، فإن التباين العربى- العربى فى كل النقاط السابقة أكبر من أن ينفيه أى عدد من النصوص الروائية يمكن لناقد أن يعالجها للإيهام بالحديث عن ظاهرة أدبية مجتمعية ثقافية تتعلق بـ«أمة عربية»
اختيارى للنصوص الروائية كان غير منفصل عن آلية التحليل التى تبنيتها فى الدراسة، وهى «الجندر» وتقاطعاته مع العِرق والاستعمار والدين. بالتالى كان اختيارى النصوص يعتمد على اختيار الرواية المناسبة لمعالجة التقاطعات الثلاثة لـ«الهوية الجندرية» مع العِرق والاستعمار والدين، لتقديم تصور لكيفية تحليل الرواية التاريخية النسوية للكشف على اختلاف أشكال الصراع اليوم لبلورة هوية مُتخيلة للأمة.
كان من المفترض أن تشتمل الدراسة على رواية لمؤلف ذكر لنفى تصور أن الرواية التاريخية النسوية تكتبها النساء دون الرجال، وربما هذا ما يجعلنى أفكر فى جزء ثانٍ للكتاب، ليس لإثبات نسوية رواية تاريخية كتبها مؤلف رجل فحسب، وإنما للكشف أيضًا عن تجليات مختلفة للذكورية وللسلطة الأبوية فى روايات تاريخية كتبها رجال ونساء.
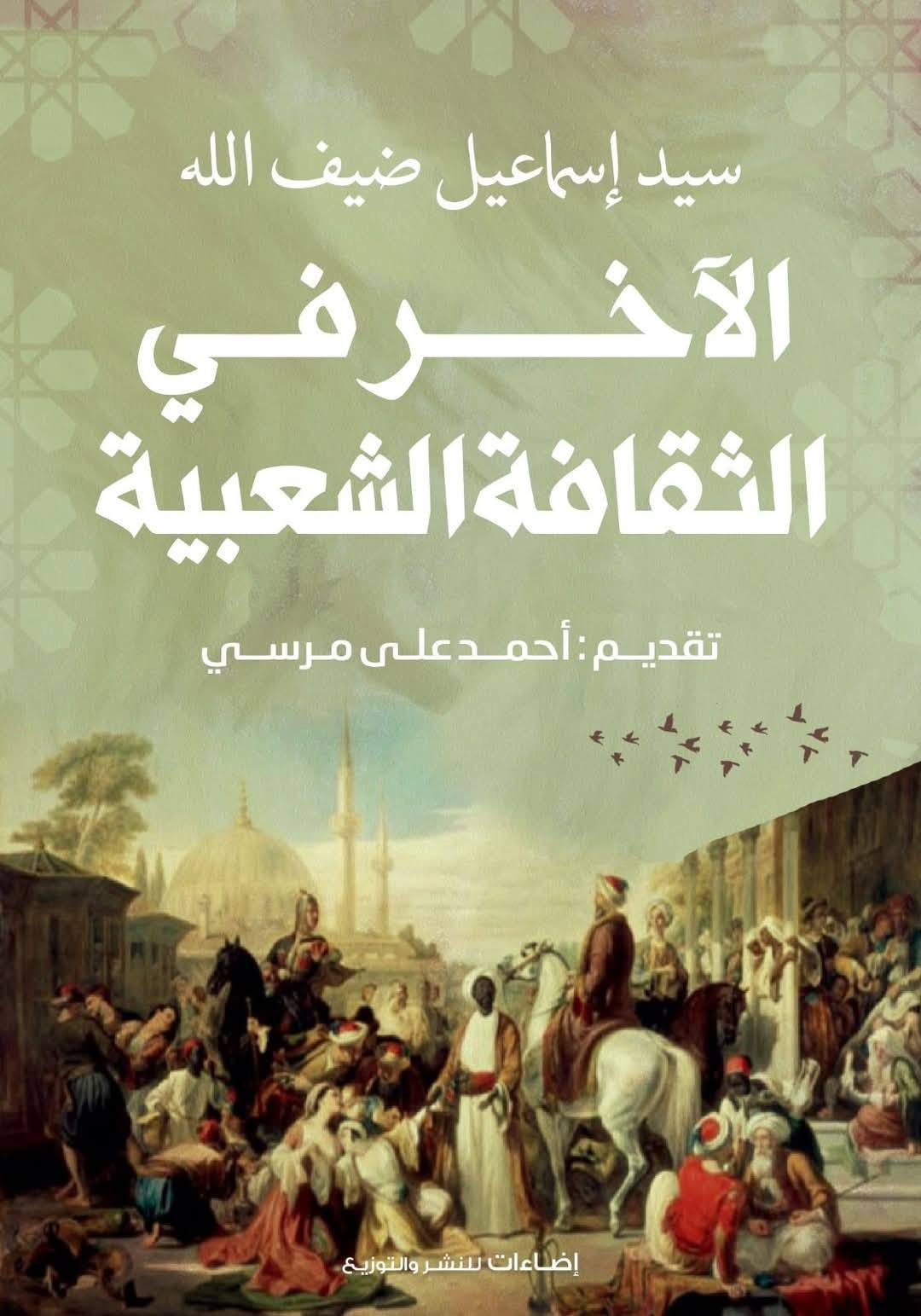
■ ما الإشكاليات التى تواجه الناقد عند تناوله «الكتابات النسوية»؟
- أظن أن النقد الأدبى النسوى كان أكثر الاتجاهات النقدية سوء حظ فى البيئة العربية، لارتباطه بفزاعتين أساسيتين، الأولى تشويهه بربطه بتبنى الخطاب الاستعمارى منذ بدايات القرن العشرين وحتى الآن لأجندة نسوية تدعى أنها عالمية، فبينما كان الاستعمار يرهب مستعمريه بخطاب دفاعى عن المرأة العربية، كانت الأجندة النسوية الغربية متواطئة مع النزوع الاستعمارى والإمبريالية الغربية، على مر القرن العشرين وحتى اليوم.
أما الفزاعة الثانية التى يواجهها الناقد فتتعلق بالأرض الرخوة التى تقف عليها التطورات النسوية وما بعد النسوية فى الغرب، فيما يتعلق بدراسات «الجندر» والأديان، بشكل لا يسمح للناقد أن يقف عليها، لأنها فى الغالب ليست الأسئلة التى تطرحها النصوص الأدبية والسياق الثقافى المنتج لها، والذى ينتج معرفة نقدية فى إطاره.
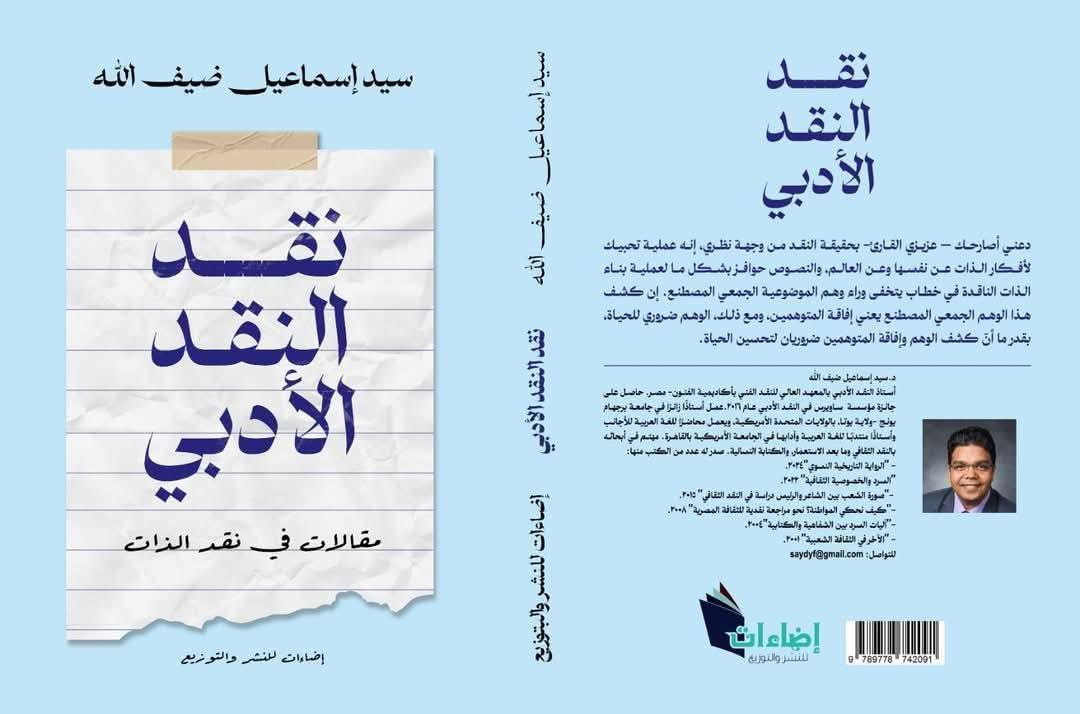
■ إلى أى مدى تمثل «الذكورية» فزاعة لسلطة «النقد/ الناقد»؟ وكيف يواجهها؟
- هناك صورة نمطية عن الناقد الأدبى بأنه مُنحاز إلى «الذكورية» والسلطة الأبوية، سواء من قبل نقاد عرب نسويين، أو ناقدات نسويات عربيات، أو بشكل عام حين تُوجه أصابع اتهام استشراقية للعالم العربى وتصفه بالذكورية والسلطة الأبوية.
ومع ذلك، أظن أن دافعى لهذه الدراسة لم يكن إحساسًا بتأنيب ضمير أو عقدة ذنب، إذ لم أكن مقتنعًا يومًا بمشروعية توجيه اتهام من طرف تجاه طرف، فضلًا عن تلك الاتهامات ذات التعميمات المفرطة فى مجال الجهود المعرفية، خاصة فى مجال العلوم الإنسانية، فليس من حق أحد أن ينصب نفسه معيارًا ويطالبنى بأن أقيس جهدى عليه، سواء كان جهدًا فرديًا، أو جهد جيل أو أمة ذات تاريخ ثقافى طويل.
وعلى هذا اخترت طريق التفاوض مع مقولات النقد النسوى لاستكشاف ملامح رواية تاريخية نسوية، وبنيت تفاوضى مع النقد النسوى على أساس الوعى بضرورة تجاوز مرحلة الاتهامات، والأهم ضرورة مواجهة الفزاعات التى تقف فى وجه الناقد حين يحاول أن يمارس عقله النقدى مع أى مقولات نظرية نقدية.
■ ما نتيجة هذا التفاوض؟
- أظن أن نتيجة تفاوضى مع هاتين الفزاعتين النجاح فى العثور على آلية تحليل للنصوص الأدبية، تنسجم مع تقاطعات فعلية فى مجتمعاتنا العربية للهُوِيَّات «الجندرية» والاجتماعية والدينية والوطنية، بما ينسجم مع غاية هذه الدراسة، وهى تمكين صوت النساء العربيات لكى يكون مسموعًا وهن يقدمن تصوراتهن عن الأمة، ربما يكون لهذه الأصوات صدى عند القارئ، فنخطو خطوات باتجاه مجتمعات عقلانية أكثر عدالة «جندرية».
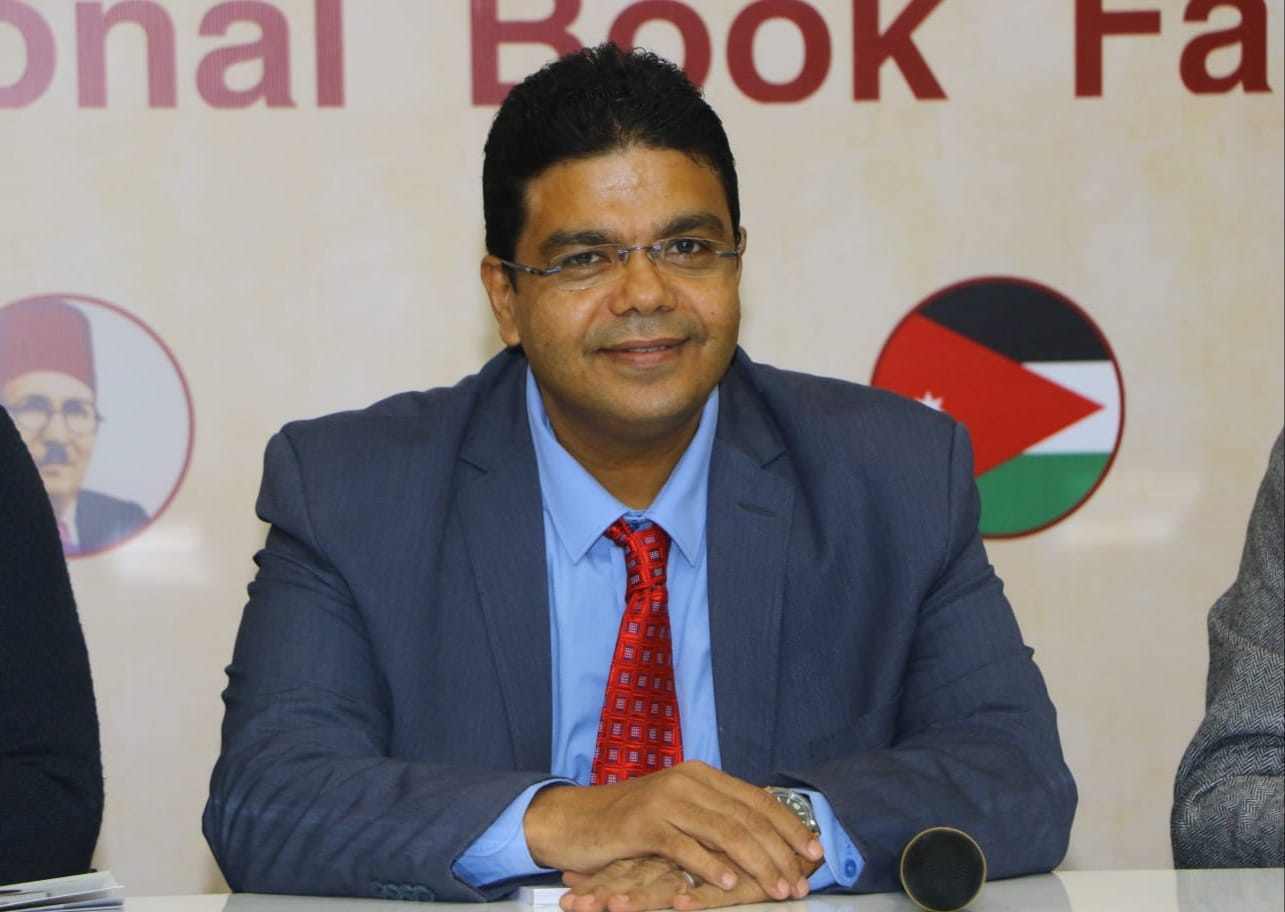
■ بمَ تصف حضور الإبداع الذى أنتجته الكاتبات خلال الـ25 سنة الماضية؟
- لا أبالغ إن قلت إن قراءة الكاتبات العربيات للحاضر والتاريخ العربيين من منظور العدالة «الجندرية»، هى الإضافة النوعية للرواية العربية فى الألفية الثالثة، وأعتقد أن هذه النوعية من الروايات يمكنها التأثير على مجتمع كُتاب الرواية وكاتباتها، الذين لم يقاربوا هذه المنطقة بهذا الوعى وبتلك الجرأة. هذا التصور مخالف لما تراكم من صورة نمطية عن الكتابة النسوية، فقد تم تشويه هذا المفهوم على مر عقود، حتى بات الكثير من الكاتبات يتبرأن منه، متصورات أن الدفاع عن أدبية أدبهن يكون بالتبرؤ من النسوية، وكأنها هى المسئولة عن استمرار الهيمنة الذكورية والأبوية فى الثقافة، واحتكار تمثيل الأمة باعتبارها أمة يبنيها بالسرد وفى السرد الذكوريون والذكوريات المهيمنون والمهيمنات! تشويه النسوية والانتقاص من الإبداع النسوى يحتاج لمقاومة وليس للتبرؤ من النسوية، فالعدالة فى تقييم جماليات الأدب، دون تمييز على أساس النوع البيولوجى، لا يمكنها أن تتحقق دون كشف النقاد لتجليات الذكورية والأبوية فى النصوص الإبداعية التى صارت نماذج جمالية مطلوب محاكاتها لتقديم تمثيل موحد للثقافة والأمة المُتخيّلة.








