بـدر الرفاعى: الكتاتيب مُلائمة لزمنها وإحياؤها «هزل وخطوة إلى الوراء»

- مهنة الترجمة مُهدَّدة بالاندثار قريبًا بسبب «الذكاء الاصطناعى»
- «الكاسيت» كان صوت مَن لا صوت له فى المنصات الرسمية
- أبى «الشيوعى» أحب عبدالناصر وعندما هاجمته قال لى: «أنت ساداتى»
- العشم فى يوليو وراء تأسيس «جمعية رد الاعتبار للاستعمار»
- دون «الكاسيت» لم تكن ستصل إلينا أصوات مثل الشيخ إمام وعدوية
فى سيرته الذاتية، الصادرة مطلع العام الجارى عن دار «الكرمة» للنشر، تحت عنوان «حنين إلى الدائرة المغلقة»، يستهل الكاتب المترجم الكبير بدر الرفاعى تقديمه لها بكلمات تعطى انطباعًا عن أن مسيرة حياته قد رُسِمت وحُددِت مسبقًا.
ليس أدل على هذا من كلماته المتسائلة: «ما الذى يعنيه أن تكون طفلًا شيوعيًا؟ لا شىء!.. تمامًا كأن تكون طفلًا مسلمًا. لكن على الطرف الآخر، فالدين والأيديولوجيا سواء، لكل منهما حلاله وحرامه، أوامره ونواهيه، كل منهما يحلل ويأمر بما جاء به، ويحرم وينهى عما سواه، ولكليهما طقوسه. كلاهما له كتابه المؤسس وسُنته، له فقهاؤه وسلفه الصالح، وكتبه الصفراء. ومع الأيام، وجدتنى أرتدى ثوب المناضل ابن المناضل، وأنا لست كذلك. أنا بطبعى لا أحب المسئولية ولست مقاتلًا».
عن سيرته الذاتية التى دفعته لكتابة هذه الكلمات، وكذلك ترجمته لكتاب «إعلام الجماهير.. ثقافة الكاسيت فى مصر» للمؤرخ والكاتب الأمريكى آندرو سايمون، علاوة على الترجمة والثقافة بصفة عامة وغيرهما، يدور حوار «حرف» التالى مع بدر الرفاعى.

■ لنبدأ من كتابك «حنين إلى الدائرة المغلقة»، وهو عنوان يحمل العديد من الدلالات. هل إحداها أن صاحبها طوال حياته عاش فى دوائر مفرغة؟ وكيف ذلك؟
- المقصود بـ«الدائرة المغلقة» هى تلك الحياة البسيطة التى عشتها مع أهلى فى القرية وشكلت نظرتى للحياة بعد ذلك، تلك الحياة التى تحكم منظورى لما ينبغى أن تكون عليه الحياة حتى الآن، الحياة التى لا تعرف الهدر أو الإسراف، ومع ذلك تتسم بالتنوع والحيوية.
■ فى تقديمك للكتاب عبارات تغلب عليها سمة «الإرغام» مثل: «كنا نضطر» و«أُلبست ثوب المثقف وهو ثوب يربكنى إلى الآن».. هل نفهم من هذا أن سيرتك أو مسيرتك كانت جبرًا وليس اختيارًا؟
- الإنسان فى رأيى مُسيَّر بالأساس، لا بالمعنى الدينى وإنما بالمعنى الاجتماعى والإنسانى. الإنسان ابن تربيته وبيئته وتاريخه وقناعاته، وأى اختيار هو بوحى من هذه التربية وهذا التاريخ وتلك القناعات. أضف إلى هذا أن الاختيار يحتاج إلى إمكانات، وهو ما لم يتوافر لى فى أى مرحلة من حياتى.
■ فى الكتاب أيضًا أفكار فلسفية عميقة تتعلق بالزمن والوجود.. كيف خضت تحدى البوح مع ذاتك أولًا قبل المتلقى؟
- كل ما فى الأمر أننى أدركت فى لحظة ما أن لدىّ تجربة إنسانية خصبة لها خصوصيتها وتفردها، وتستحق الإفصاح عنها وتسجيلها قبل أن تخذلنى الذاكرة ويطويها النسيان. حكاية ظلت تلح علىَّ وتطالبنى بتسجيلها. هنا أود الإشارة لدور الأصدقاء فى تشجيعى على إنجازها، وأخص بالذكر الصديق سيد محمود الذى حثنى على الكتابة فى جريدة «القاهرة»، عندما كان رئيسًا لتحريرها، ثم متابعته إياى حتى إتمام الكتاب. ثم مَن مِنا لم يواجه تلك الأسئلة الوجودية؟
■ سجلت كذلك ذكرياتك مع رسامى الكاركاتير حجازى وبهجت، والنبيل علاء الديب، والأب الروحى عبدالفتاح الجمل.. ما الذى تفتقده منهم ومن أيامهم اليوم؟
- هؤلاء مَن كان لهم فضل بنائى فكريًا وإنسانيًا، هم أبناء وصُناع زمن آخر، اتسم بالانفتاح على كل التجارب الإنسانية رغم غلق المجال السياسى، وهم تلاميذ جيل «التنويريين الرواد»، من لطفى السيد إلى لويس عوض، وكانوا أصحاب قضايا عبروا عنها بتواضع جم، وتلك ميزة نادرة.
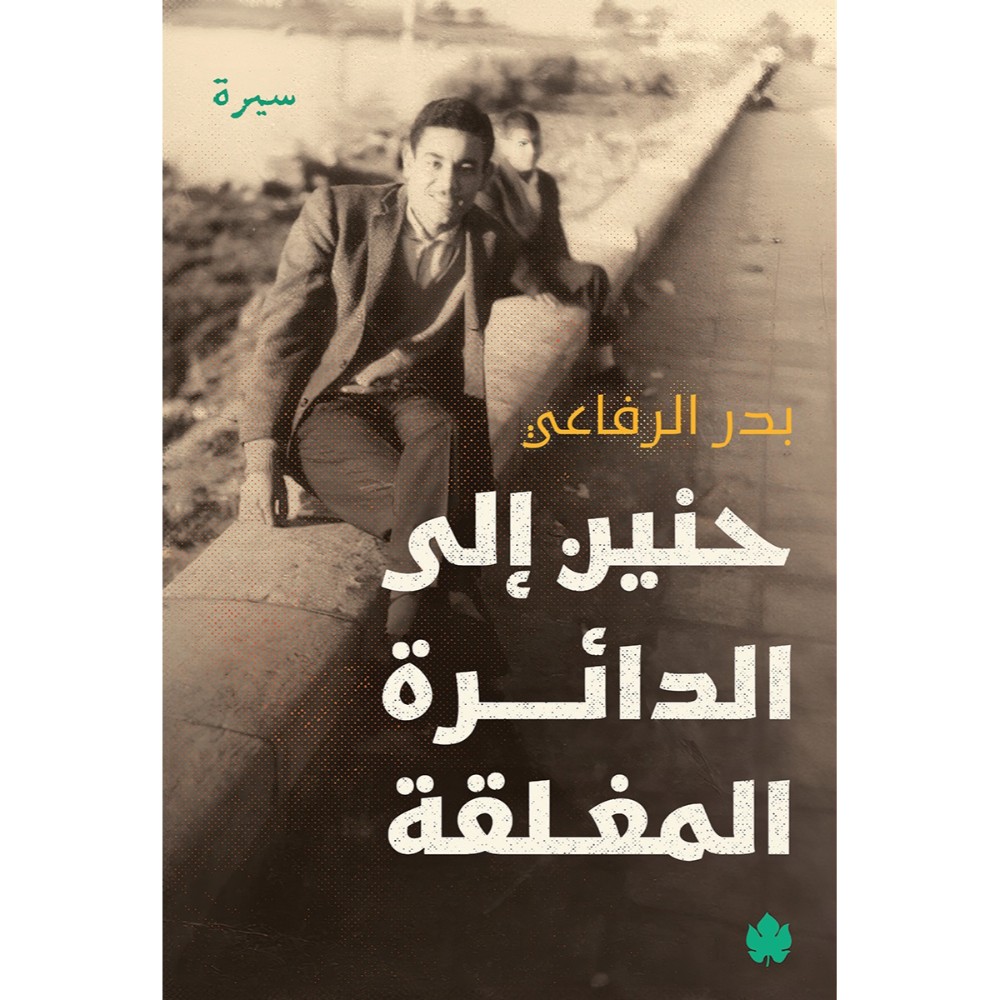
■ ما حكاية جمعية «رد الاعتبار للاستعمار»؟!
- كان من تداعيات الأزمة الوجودية التى عشتها وبلغت ذروتها أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، اهتزاز ثقتى فى كل شىء، حتى قادنى الصراع الطويل مع النفس إلى مراجعة الثوابت والبديهيات، بما فيها قناعاتى الفكرية «الماركسية»، وهو أمر بالغ الصعوبة، لأن المراجعة تجعلك تقف متحديًا بعض مكونات هويتك الذاتية، مناطق استقرت داخلك طويلًا وصارت لها منزلة «البديهية».
فكرت فى أشياء كثيرة، وكان تاريخنا الحديث بالذات على رأس الأشياء المهمة التى رصدتها للمراجعة، وهذا قادنى إلى الوقوف عند ثورة يوليو ١٩٥٢ «من ناصر فصاعدًا». نهضت أمامى فجأة سنوات الثورة كشبح بلا ملامح فى عقل مُشوَّش، واستتبع الأمر أيضًا أن أقف أمام النقيض، وأن أفكر فى نظرتى الموروثة للاستعمار والملك والنظام القديم ككل. قلت لنفسى: إنهما تجربتان اكتملتا وهكذا يصبح الحكم بالنتائج، بعيدًا عن أى أيديولوجيا أو نوايا خفية أو ظاهرة أو استنتاجات أو تبريرات.
هذا الخاطر هزنى شخصيًا، فقد عشت عمرى وكل من حولى يتحدث عن الإنجازات الكبيرة للثورة، حتى الهزائم كانت تُقدم كانتصارات. كما أن أبى، على الرغم من أنه شيوعى وطاله ما طال الشيوعيين من سجن وتشريد، فإنه كان، مثل كثير من الشيوعيين، يحب جمال عبدالناصر حبًا غير مشروط. أذكر أننى جرؤت ذات مرة على توجيه النقد للزعيم فى حضرة أبى فأثار ذلك استياءه، بل اتهمنى بأننى «ساداتى»، وهى تهمة لو تعلمون عظيمة فى بيتنا، تهمة هى إلى الخيانة أقرب!
استطلاع للرأى أجرته إحدى الفضائيات العربية حول سؤال: أيهما أكثر رحمة بالشعوب العربية: حكامها أم الاستعمار؟ جاءت النتيجة لصالح الاستعمار بنسبة كبيرة ٦٨٪، ما جعلنى أشعر بأننى لست وحدى، وعزز شرعية السؤال لدىّ.

■ كيف قادك ذلك إلى الجمعية المثيرة للجدل؟
- كنت أدرك أن الموضوع شائك وصادم. ولأخفف من الصدمة عرضت الموضوع من باب المزاح، وهكذا بين الجد والهزل، أعلنت لأصدقائى عن عزمى تأسيس جمعية هدفها «رد الاعتبار للاستعمار»، فقوبلت الفكرة باعتبارها «إيفيه»، وإن صادفت هوى أيضًا فى نفوس البعض. كنت أعرف أن الصدمة نابعة من أن الفكرة تتعلق بمكون من مكونات هويتنا، هو العداء الراسخ للاستعمار.
بلورت بينى وبين نفسى ما يُشبه «البيان التأسيسى» الشفاهى لهذه الجمعية، الذى ينطلق من محاولة إعمال المنطق والتخفف من الأيديولوجيا قدر الإمكان. كانت شائعة تأسيس هذه الجمعية مجرد حيلة أردت منها التنبيه إلى أهمية وضرورة المراجعة، والوقوف أمام البديهيات والثوابت وتأملها وإعادة النظر فيها. هناك أشياء كثيرة فى تاريخنا وحياتنا بحاجة إلى رد الاعتبار، ليس على رأسها الاستعمار الإنجليزى بالطبع. كما أن العهد الملكى لم يكن نعيمًا كله، لكن كان عشمنا كبير فى الثورة الوطنية.
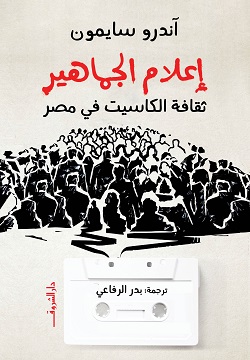
■ أشرت فى الكتاب إلى ترددك على كُتاب «الشيخ عبدالعظيم» لعدم انتظامك فى المدرسة.. هل ترى استعادة تجربة «الكتاتيب» صالحة فى الوقت الراهن؟
- كان الكُتاب وسيلة تعليمية ملائمة لزمنه، أما إحياؤه الآن فيُعد ضربًا من الهزل وخطوة إلى الوراء. المطلوب إعادة النظر فى التعليم ككل، وتطويره بما يفى بالغاية منه.
■ على النقيض من أبناء جيلك انزعجت من انتقالك إلى شبرا.. لماذا؟
- كان الانزعاج بسبب انتزاعى من حياة الدائرة المغلقة، وليس بسبب انتقالى إلى شبرا فى حد ذاته. الانزعاج كان بسبب التوق إلى تلك الدائرة المغلقة، التى صاغت نظرتى إلى العالم.
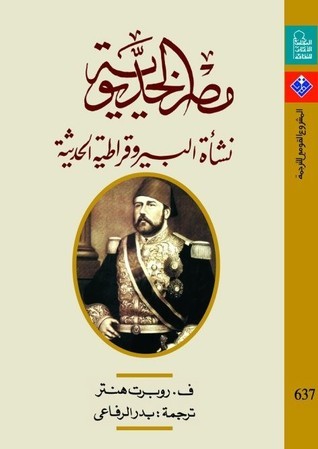
■ ما الذى تتذكره من تجربة تجنيدك قبل حرب ١٩٧٣؟
- منذ «النكسة» فى ١٩٦٧، كانت هناك مطالبة شعبية مستمرة وضغط من أجل تحرير الأرض، ومثل غيرى كنت أنتظر تلك اللحظة، والمُساهمة فيها. كانت الحرب لحظة تلاحم غريبة بين كل فئات الشعب والجيش، وساد بين الناس أخلاق وروح جديدة. كانت لحظة ملهمة تكللت بالنصر لكنها لم تمحى مرارة «النكسة».
■ متى بدأت معرفتك بالشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم؟
- تعارف جماعى فى الجامعة كان هو البداية، بحضور حشد كبير من جمهور الطلبة. لكن التعارف الحقيقى كان فى منزلهما بمنطقة «حوش قدم»، حيث كنت أتردد عليهما من حين إلى آخر بصحبة الأصدقاء، وأحيانا كنت ألتقى «نجم» فى منزل رسام الكاريكاتير حجازى.
■ ننتقل إلى كتاب «إعلام الجماهير.. ثقافة الكاسيت فى مصر».. هل ترجمتك إياه اختيار شخصى أم ترشيح الناشر؟
- الكتاب كان ترشيحًا من دار «الشروق»، وهو ما حدث معى كثيرًا. هذا الكتاب غاية فى الأهمية، لتناوله مرحلة مفصلية من تاريخ مصر فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى، من خلال رصد ظهور هذا الوسيط «الكاسيت»، وكيف أتاح وسيلة جديدة للتعبير عن الأصوات المُستبعَدة من المنصات الرسمية «الإذاعة والتليفزيون».
من خلال «الكاسيت» أصبح فى إمكان أى شخص أن يصبح مُنتِجًا ثقافيًا وليس مجرد متلق، ومن غيره لم يكن مُمكنًا أن تصل إلينا أصوات مثل الشيخ إمام وأحمد عدوية وغيرهما ممن استبعدتهم المنصات الرسمية. كان «الكاسيت» صوت من لا صوت له. كما أن الكتاب يتعامل مع «الكاسيت» كمصدر للتاريخ، فى سعيه لإيجاد مصادر بديلة غير دور الوثائق القومية، التى تعترض العقبات طريق الوصول إليها.

■ «ثقافة الكاسيت» كانت مجرد مرحلة عابرة، أم أنها تركت أثرًا دائمًا فى المشهد الثقافى المصرى؟
- كان «الكاسيت» نقلة نوعية فى تطور ما، أدى دوره ثم أخلى السبيل أمام نقلة أخرى واندثر، مثلما حدث مع «التيكرز» و«الفاكس» و«البيجر» وغيرها. لكن أثره لم ينمحِ، ويتواصل هذا الدور الآن، من خلال وسائط مختلفة، على رأسها «السوشيال ميديا» و«يوتيوب» و«سبوتيفاى» وغيرها.
■ كيف ترى تأثير «الكاسيت» على انتشار الموسيقى والأغانى فى مصر مقارنةً بالتكنولوجيا الحديثة مثل منصات البث الرقمى؟
- كل اختراع ابن زمنه. «الكاسيت» أدى دوره فى زمنه، والمنصات الرقمية تشكل نقلة نوعية أخرى فى التطور، ولا شك أن كليهما أدى دوره بنجاح. ولا شك أن «الكاسيت» لعب دورًا غير مسبوق فى الموسيقى والأغانى وطرق إنتاجها بعيدًا عن المنصات الرسمية.
■ هل هناك شخصيات أو أحداث مُحددة ترى أنها كانت محورية فى تشكيل «ثقافة الكاسيت» فى مصر؟
- هناك شخصيات كثيرة يأتى على رأسها الشيخ إمام والشيخ كشك وأحمد عدوية. الكتاب يشير أيضًا إلى الدور الكبير لـ«الكاسيت» فى «ثورة الخمينى» بإيران.
■ كيف بدأت طريقك مع الترجمة؟
- أنا خريج صحافة، ومارست العمل بها أثناء الدراسة، لكن وضع المهنة آنذاك لم يكن مُشجعًا على الاستمرار، بفعل الرقابة المباشرة، وتحويل الصحفيين إلى موظفين، فقررت الابتعاد عنها. فى نفس الوقت، كان لدىّ وَلَه قديم باللغة الإنجليزية منذ بدأت تعلمها فى المرحلة الإعدادية، فوجدت ضالتى فى الترجمة.
■ ما التحديات التى تواجهها كمترجم فى ظل التغيرات الثقافية والتكنولوجية السريعة؟
- مهنة الترجمة بشكل عام مُهددة بالاندثار فى المدى القريب، فى ظل التقدم الكبير الذى حققه «الذكاء الاصطناعى» فى هذا المجال، وقد يصل إلى ٨٠٪. لكن حتى الآن ما زالت هناك ضرورة لوجود المترجم، وإن كنت أرى أن هذا الوضع لن يدوم طويلًا.
■ كيف ترى دور المترجم فى تشكيل الوعى الثقافى المصرى والعربى؟
- المترجم وسيط بين ثقافات، ودوره يتمثل فى نقل معارف وثقافات اللغات الأخرى إلى قراء لغته، وبالتالى هى جسر لتعزيز الحوار بين الثقافات وتبادل المعارف، وهو دور مهم فى تشكيل الوعى الثقافى، دون أى شك.
■ ما نصيحتك للشباب العربى الذى يرغب فى دخول مجال الترجمة أو البحث الثقافى؟
- أهم ما يجب أن يتسلح به المترجم هو الاعتناء بتكوينه الثقافى، فهذا ما يُفِرق بين مترجم وآخر، إضافة بالطبع إلى امتلاك أدواته المتمثلة فى إتقان اللغتين اللتين ينقل منهما وإليهما.
■ بمَ تقيم حال الترجمة الراهن فى مصر؟
- ما زالت حصة الترجمة مما ينشر متواضعة، لكن الجيد هو ظهور عدد كبير من المترجمين الجيدين.

■ هل تشترط الترجمة أن يكون ممارسها كاتبًا قبل أن يكون مُترجِمًا؟
- ليس ضروريًا أن يكون مُمارسًا للكتابة، لكن من الضرورى أن يعرف كيف يكتب.
■ كيف ترى تأثير التكنولوجيا الحديثة على الثقافة والفنون فى العالم العربى؟
- لا شك أن التكنولوجيا الحديثة أثرت تأثيرًا كبيرًا فى المشهد الثقافى والفنى العربى، عبر إضافة العديد من الإمكانات والتسهيلات.








