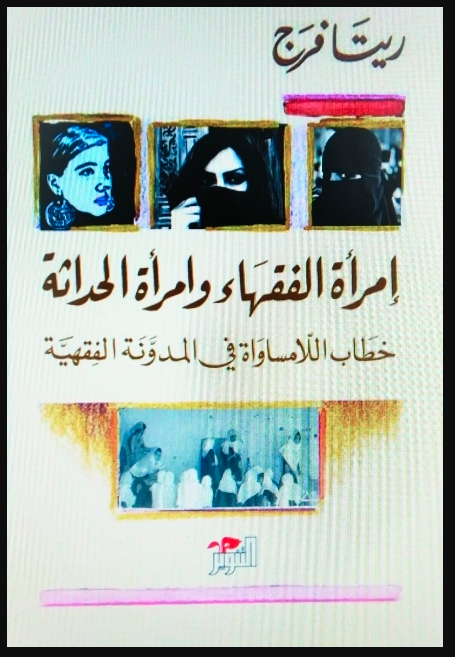ريتا فـرج: القراءات الفقهية تقيّد ما أطلقه القرآن من عدل بين الرجل والمرأة

- سطوة الفقه البطريركى تعرقل أى إمكانات لتحديث منظومة الأحوال الشخصية
- رفض المؤسسات الدينية للإصلاح الدينى تسبب فى ثبات الفقه الرجعى إلى اليوم
- المدونة التراثية تقدم لنا مؤشرات كاشفة عن النساء وأدوارهن
- لم نشهد قفزات اجتهادية كبيرة من داخل مؤسسات الإسلام التقليدى فى العالم العربى
- رواد التحديث ومشاريعهم بحاجة إلى رافعة رسمية وهذا غائب اليوم
- تجارب الدول فى تطوير قانون الأحوال الشخصية وحقوق النساء خجولة جدًا
- الحركات الإسلاموية تسعى إلى أسلمة قوانين الأحوال الشخصية وتعطيل مسارات الإصلاح
- أى مشروع حداثوى يحتاج إلى تبنى الدولة وإلا بقى رهين النخبة
تركّز أبحاث الكاتبة والأكاديمية اللبنانية ريتا فرج على الحركات النسوية، والأديان والجندر، والحركات الإسلاموية، والعنف الدينى، فقد حصلت على دبلوم الدراسات العليا فى علم اجتماع المعرفة عام 2004 من الجامعة اللبنانية عن أطروحتها «المثقف العربى بين ظاهرة الإرهاب الفكرى والمحاكمة». وفى عام 2008، نالت درجة الدكتوراه فى الدراسات الإسلامية من كلية الدراسات الإسلامية فى بيروت، عن أطروحتها «العنف فى الإسلام المعاصر: معطى بنيوى أم نتاج ظرفى؟».
ونشرت فرج أبحاثًا بعدة لغات فى كتب جماعية ومجلات محكّمة فى العالم العربى وأوروبا، وشاركت بأوراق بحثية فى مؤتمرات وندوات علمية فى مصر وتونس والمغرب ولبنان والصين وألمانيا ورومانيا وبلجيكا. وقد صدر لها عام 2015 كتاب «امرأة الفقهاء وامرأة الحداثة: خطاب اللا مساواة فى المدونة الفقهية»، كما أسهمت فى تنسيق كتاب جماعى حول تدريس الفلسفة فى العالم العربى، الذى صدر عن المركز الدولى لعلوم الإنسان برعاية اليونسكو، بالإضافة إلى ذلك، كانت لها مساهمة فى كتاب «القيم الديمقراطية فى الفكر العربى والإسلامى الحديث والمعاصر».
ومع تصاعد وتيرة العنف ضد النساء فى المجتمعات العربية خلال السنوات الأخيرة، تحت وطأة أفكار مجتمعية مغلوطة تتستر برداء الدين، يأتى هذا الحوار مع الأكاديمية اللبنانية، التى كرست سنوات من البحث حول خطاب اللا مساواة ومرجعياته، لمناقشة الخطابات المنتجة لتهميش المرأة وإقصائها، ولفهم المنظومات الفكرية التى رسخت التمييز وعدم المساواة.

■ فى كتابك «امرأة الفقهاء وامرأة الحداثة» تحدثت عن التناقض بين مكانة المرأة فى النصوص القرآنية وفى التفسيرات الفقهية.. فما تفسيرك لثبات التفسيرات الفقهية وديمومتها حتى اليوم مقابل تراجع التفسيرات الأكثر انفتاحًا للنص الدينى؟
- ترتبط العلاقة بين النص القرآنى والواقع فى الإسلام التاريخى، بجدلية الثابت والمتغير، وبمدى انفتاح العقل الدينى التقليدى والرسمى على الحداثة؛ بمعنى أن القول بجوهرانية التفسير الفقهى وجموديته، يرتبط بشكل أساسى بمستوى انفتاح المؤسسات الدينية التقليدية على العالم، وبدورها فى التأويل والتفسير والتعامل مع النصوص؛ فإذا اتجهت هذه المؤسسات إلى السير بالإصلاح فى مختلف جوانب الدين، ومنها ما يتعلق بمكانة النساء المسلمات فى المجتمعات المعاصرة، وتبنت خطابًا متنورًا وحداثيًا، فهذا يؤدى بالضرورة إلى تقديم تفسيرات حداثوية فى مجال فقه المرأة.
تحتاج هذه المؤسسات إلى دعم من الدولة التى تقود عملية الإصلاح، والمثال الأبرز والأهم عمّا أتحدث عنه هو التجربة التونسية، أى مجلة الأحوال الشخصية الصادرة سنة ١٩٥٦، فى فترة حكم الرئيس التونسى الحبيب بورقيبة، والتى لقيت دعمًا من المؤسسة الدينية التى يمثلها محمد بن عاشور.
لماذا استحضر هذه التجربة الرائدة التى تطورت لاحقًا بتطوير مجلة الأحوال الشخصية وتمكين التونسيات بعد سنة ٢٠١١؟ أقول هذا من أجل التنويه بأهمية الإصلاح الدينى الذى تقوم به الدولة بالتشاور مع المؤسسة الدينية، مما يؤكد أن ثبوتية التفسيرات الفقهية الكلاسيكية، يمكن تجاوزها، إذا تمّ السير بموجبات التحديث الدينى.
لكن التجربة التونسية استثنائية، فسطوة الفقه البطريركى الكلاسيكى فى مجال حقوق المسلمات وأدوارهن، وحضوره القوى والمتجذر فى الوعى العام المدنى والدينى، وفى التاريخ المعاصر، تعرقل أى إمكانات لتحديث منظومة الأحوال الشخصية فى العديد من الدول العربية، كما هو الحال على سبيل المثال فى الصراعات الدائرة حول حضانة الأطفال فى لبنان ومحنة الأمهات اللواتى يعانيِّن من فصل أطفالهن عنهن فى سن مبكرة نتيجة غياب قانون مدنى عادل ومُنصِّف، وسيطرة النزعة الأبوية المتشددة على قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف المسلمة فى لبنان.
إن ثبات التفسيرات الفقهية إلى اليوم، فى مجال فقه المرأة، يرتبط بالدرجة الأولى بغياب الإصلاح الدينى ورفضه من قبل المؤسسات الدينية، أما إذا سارت الدولة به وأدركت أهمية تحديث القوانين وتكريس المساواة بين الجنسين، وذلك حين يكون لها مشروع إصلاحى، فإن هذه التفسيرات تصبح جزءًا من الماضى، وهذا يحتم علينا اعتبارها عتبة علينا تجاوزها لبناء فقه حداثوى يتأسس على تجاوز اشتراطات الفقه الكلاسيكى، فيأخذ فى الاعتبار موقع المرأة ومركزيتها فى المجتمع والدين والسياسة.
اليوم، هناك جهود مهمة فى الدول العربية يقوم بها المختصون فى الدراسات الإسلامية والنسوية لتحرير فقه المرأة فى الإسلام من التفسير الفقهى البطريركى، والأمثلة على ذلك كثيرة، فهناك أطروحات المفكر المصرى الراحل نصر حامد أبوزيد صاحب «دوائر الخوف، قراءة فى خطاب المرأة»، وهناك أطروحات الأكاديمية التونسية ألفة يوسف، وهى رائدة فى مجال التفسيرات الحداثوية للمدونة التراثية والقرآنية وموقع النساء فيها، وهناك أطروحات فاطمة المرنيسى التى عملت على النص التاريخى والأحاديث النبوية أكثر من عملها على النص القرآنى. طبعًا ثمة دارسون آخرون بحثوا فى هذا الموضوع الحيوى، وقد تطورت المكتبة العربية بإنتاجهم لا سيما فى الخمسين سنة الأخيرة مع دخول النساء إلى الجامعات واشتغالهن على فضاء النصوص الدينية، وتنامى وعيهن بحقوقهن وحق المرأة فى الاجتهاد.

■ هل هناك لحظات تاريخية يمكن القول إنها شهدت تحولات فى رؤية الفقهاء للمرأة.. أم أن الهيمنة الذكورية استمرت بسياقات مختلفة؟
- شهد تاريخ الإسلام على مرّ العصور ظهور اجتهادات وقراءات وتفسيرات فقهية تخالف الاتجاه التقليدى السائد داخل المؤسسات الدينية، لكن هذا الاتجاه الإصلاحى الذى تبلور مع عدد من رموز الحركة الصوفية والفلاسفة لم تتقبله المجتمعات المسلمة التى يسود فيها التقليد والمحافظة.
ثمة خاصية مهمة طبعت العلاقة بين المجال الرمزى الدينى والمرأة المسلمة؛ وهى الصلة التاريخية المبكِّرة بين النص الدينى وتفسيره وشروط إنتاجه، يمكن أن ندلل على تجربة المسلمات فى زمن النبوة، ويتضح ذلك من خلال جدلية العلاقة بين النص المقدس والتاريخ، حيث كان للمرأة فيه موقع وفعل تفسيرى وتأويلى، بدءًا بالسؤال التاريخى التأسيسى الذى أطلقته أم سلمة زوجة النبى محمد: «ما لنا لا نذكر فى القرآن كما يذكر الرجال؟».
وتعد السيدة عائشة التى جمعت إلى جانب نقل الأحاديث وحفظ القرآن وتفسيره، من المنتسبات إلى مدرسة الرأى، فهى لم تبادر بالأخذ من كل ما ينقل لمجرد أنه مروى ومنقول، وقد وصفت بأنها رَجُلة الرأى، ويدرجها التراجمة فى طبقات الفقهاء؛ وهنا أحيل إلى كتاب فاطمة المرنيسى «الحريم السياسى، النبى والنساء»، حيث تذكر فيه خوض عائشة حربًا ضد أبى هريرة بعد وفاة الرسول وهو أحد ممثلى الغلبة الذكورية، فردت على العديد من الأحاديث النبوية التى تحط من شأن المرأة.
فى المقابل، من الضرورى لفت الانتباه إلى أن كتب التراجم والمصادر الإسلامية، تقدم لنا معلومات غنية عن النساء ودورهن فى حقول المعرفة الدينية فى الإسلام، فابن حجر كتب عن عدد كبير من العالمات المسلمات فى القرن الثامن الميلادى، وهذا ما فعله الخطيب البغدادى فى كتابه تاريخ بغداد، والعديد من النساء المحدثات أصبحن شيخات وتتلمذ عليهن الرجال، فالشيخة فاطمة بنت عياش بن أبى الفتح «أم زينب البغدادية الحنبلية» كانت من شيخات ابن تيمية «ت ٧٢٨هــ/ ١٣٢٨م»، وقد ذكرت فى طبقات الحنابلة.
لماذا أشير إلى هذه الأمثلة مع أن سؤالك يطرح حول إمكان أو عدم إمكان التحولات فى رؤية الفقهاء للمرأة فى لحظات تاريخية معينة؟ لأقول إن المدونة التراثية لا سيما كتب التراجم والطبقات تقدم لنا مؤشرات كاشفة عن النساء وأدوارهن، دون نفى أنها اتّخذت أشكالًا مختلفة من التعبير، تتراوح بين الغياب والتغييب والحضور. ولأقول أيضًا وعلى المقلب الآخر، إن الرؤية التقليدية الفقهية ما زالت حاضرة، وتؤثر بشكل كبير فى حيوات المسلمات، وتعرقل حركة المساواة، فنحن لم نشهد قفزات اجتهادية كبيرة من داخل مؤسسات الإسلام التقليدى فى العالم العربى، تحاول بناء فقه جديد فى مجال حقوق المرأة، ولهذه المؤسسات قوة تأثير فى العقل الجمعى المسلم، وإذا لم تقم بالإصلاح الجاد، فإن التجارب الفردية خارجها تبقى محدودة وتقتصر على النخبة.
لنعطى مثالًا على ذلك خارج قضية المرأة، فمشروع محمد أركون حول علم الإسلاميات التطبيقية، وهو مشروع ضخم وحداثوى، ترك تأثيرًا فقط لدى عدد من الجامعات الأوروبية والعربية وبعض المثقفين، لكن تجنبته المؤسسات الدينية فى الدول العربية، كما أنه وللأسف لم يؤثر فى الوعى العام العربى الذى يميل إلى المحافظة، ولأنه وعى غير ثقافى، أى لا يهتم بالثقافة.
إن رواد التحديث ومشاريعهم بحاجة إلى رافعة رسمية، وهذا غائب اليوم، إن لم أقل مرفوضًا، فى ظل موجة المحافظة المتشددة السائدة راهنًا؛ فالمجتمعات العربية تعاند التحديث ولا تريده، وهذا يطرح مشكلة أخرى.

■ تذكرين أن الفقهاء أسسوا صورة المرأة باعتبارها «وعاءً للمتعة» و«فضاءً للتلقى».. إلى أى مدى يمكن القول إن تأويلات الفقهاء التقليديين كانت وما زالت تعبيرًا عن بنية اجتماعية وسلطة سياسية؟
- تُعد التأويلات الفقهية التقليدية انعكاسًا للمجتمعات والظروف التاريخية التى ظهرت بها، فالوعى الدينى الذى طبع العصر الكلاسيكى فى الإسلام، والذى تشكلت فيه المذاهب ودُونت فيه الشريعة الإسلامية، كانت له خصائصه، وقد ترك الفاعل السياسى أثره فيه، وهو فى الواقع مرحلة أساسية وحيوية فى التاريخ الإسلامى، وكان فقه المرأة جزءًا منه، وهذا الفقه يعبر عن السمات العامة للمجتمعات البطريركية السائدة.
وفى المقابل كانت النساء المسلمات مؤثرات وفاعلات فى المجالين الدينى والسياسى، أى فى الدين والسلطة. تقدم لنا الأطروحات الحديثة التى درست هذه القضية نتائج مهمة، لننظر مثلًا إلى كتب فاطمة المرنيسى لا سيما كتابها «سلطانات منسيات»، وأحيل على مؤلف آخر «المرأة فى العصور الإسلامية الوسطى» لجافن هامبلى.
إن فقه المرأة فى العصر الكلاسيكى- بشكل عام- طغت عليه الرؤية الأبوية التمييزبة، على الرغم من أنه حتى القرن الثامن للهجرة وقبل إغلاق باب الاجتهاد كانت التأويلات الدينية تضع الآيات القرآنية فى سياقها التاريخى، وكان يدور حولها نقاش بين العلماء دون حرج؛ ولكن بعد ذلك بدأ المسلمون يكتفون بما قاله القدماء، وأصبحت سلطة الفقهاء أقوى من النص والتاريخ. إن الجوهر فى النص القرآنى، قائم على العدل بين الرجل والمرأة، لكن القراءة الفقهية عطلته.
■ هل يمكن القول إن النسوية الإسلامية هى الحل لإصلاح أوضاع المرأة فى المجتمعات الإسلامية.. وهل يمكن أن تطرح هذه القراءة نفسها بديلًا فعليًا داخل المؤسسات الدينية؟
- إن المشتغلات على النص الدينى فى الإسلام وتمثلات النوع الاجتماعى فيه، يأخذن بمناهج مختلفة، وليست النسوية الإسلامية وحدها، فيما لو اعتبرناها، اصطلاحًا متفق عليه، تمتلك مفاتيح أو فرص الإصلاح، فقبل ظهور هذا الاتجاه وما يُثار حوله من سجالات وإشكاليات، وما فيه من تفاوت فى قوة التأويل على خلفية المنتسبات إليه، فإن العديد من الأكاديميات والباحثات العربيات، كانت لهن الأسبقية فى دراسات الإسلام والمرأة، وهن لا يحبذن- كما أشرت إلى ذلك فى عدد من مقالاتى- أن يُدرجن فى اتجاه نسوى محدد، فهن يذهبن إلى دراسة الظواهر الاجتماعية والسياسية والدينية وموقع وأدوار النساء فيها، انطلاقًا من خلفية بحثية وأكاديمية مدفوعة بتحرير النص الدينى من أحادية القراءة والتفسير.
يمكن ملاحظة أن ثمة ميلًا فى السنوات الأخيرة لتكريس المنتسبات إلى النسوية الإسلامية، بوصفهن من يمتلكن أصول التفسير الفقهى النسوى، بحيث يتم إقصاء المناهج والاتجاهات النسوية الأخرى. إن بعض المنتسبات إلى النسوية الإسلامية، يملن إلى التقليد، ولا أجد لديهن خطابًا أو خلاصات حداثوية، لا سيما فى المجال العربى؛ مع أهمية التمييز بين المجموعات المختلفة فى مجالات بحثهن، بين ما أسميه الاتجاه العالى للتأويل والاتجاه المحافظ، مع الأخذ بالاعتبار مستوى انفتاحهن على العلوم الاجتماعية والإنسانية.
ثمة تحديات كثيرة تواجه النسوية الإسلامية أشرت إليها فى مقالى «الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات»، وأخطر تحدى برأيى هو تطويعها الأيديولوجى ومصادرتها، فقد سعت المنتسبات إلى الحركات الإسلاموية، لا سيما الإخوانية، إلى مصادرة مناهج وأدوات الحركة النسوية الإسلامية، وادعاء انفتاحهن على المناهج الحديثة، وتوظيفهن لصالح الحركيين، وأسلمة الجندر والتمكين، وإضفاء الطابع الحركى على المدونة الفقهية التقليدية، وسكوت الإسلاميات الحركيات عن قضية الحجاب وقمع النساء فى الأنظمة الدينية، كما حدث فى إيران مع قضية مهسا أمينى؛ إذ إننا لم نلحظ طوال الفترة التى انشغل فيها الرأى العام العالمى بهذه القضية، أى موقف واضح من الإسلاميات الحركيات لا سيما الناشطات فى مجال الكتابة. وصفوة القول إنهن يوظفن مناهج النسوية الإسلامية لصالح الحركيين فى عدد من الدول الأوروبية والعربية، ما يؤدى إلى كسر المشروع الأساسى للنسوية الإسلامية، وهو الحق فى الاجتهاد ومواجهة المنظومة الدينية الأبوية وتفكيك خطابات القمع.
ليست ممثلات النسوية الإسلامية وحدهن القادرات على الإصلاح، فهن جزء من حراك نسوى وأكاديمى أوسع، فالعديد منهن يقدمن قراءات مهمة فى تفسير النص الدينى وموقع النساء فيه، لكن أصواتهن مثل بقية الباحثات الأكاديميات غير مسموعة، وحتى مرغوب فيها داخل المؤسسات الدينية، التى تخشى على سلطتها ورموزها ومصادرها. وكما أشرت سابقًا، أى إصلاح أو مشروع حداثوى فى أى ميدان أو مجال يحتاج إلى من يتبناه، أى إلى دولة تؤمن بضرورة التحديث، وإلا بقى رهين النخبة.

■ هل تعتقدين أن هناك إمكانية أو استعدادًا فكريًا اليوم فى المجتمعات العربية لإحياء قراءة جديدة للنصوص الدينية تعيد الاعتبار لمكانة المرأة لا سيما مع هيمنة الفكر الذكورى الذى يستمد من الدين مبرراته؟
- أىُّ إصلاح سياسى أو دينى أو اجتماعى، خصوصًا فى المجتمعات العربية، يحتاج بالضرورة كما أشرتُ سابقًا إلى رافعة سياسية، فالدولة برأيى هى التى تقود عملية الإصلاح، فى حال كان لديها مشروع تحديثى.
ثمة العديد من الدول العربية، انخرطت إلى حد ما فى تطوير المنظومات الحقوقية وتحسين قوانين حماية النساء من العنف الأسرى، وعدد منها أجرى إصلاحات فى مناهج التعليم وأسسَ لمسارات دستورية تأخذ بالاعتبار قيم التعددية الدينية والإثنية.
أما بالنسبة لإشكالية المرأة والإسلام وإمكانات تقديم قراءات دينية جديدة، وإذا نظرنا إلى هذه القضية خارج إطار مؤسسات الإسلام التقليدى، فتجارب الدولة فى تطوير قانون الأحوال الشخصية وحقوق النساء فيها، خجولة جدًا، وأكاد أقول إننا أمام نكسة حقوقية، لا سيما إذا نظرنا إلى عدد من الحالات العربية، مثل العراق، فقد أقر البرلمان العراقى فى يناير الماضى تعديلًا على قانون الأحوال الشخصية، اعترض عليه الحقوقيون وحذروا من إمكان أن يمهد لزواج القاصرات. وفى المقابل يتجه المغرب إلى إدخال تعديلات على مدونة الأسرة لكى تواكب الإصلاح، فى موضوعى تقييد تعدد الزوجات، وعدم إسقاط حضانة الأم المطلقة لأطفالها عند الزواج مرة ثانية، صحيح أن هذه التعديلات جزئية وغير شاملة، كما ترى الجمعيات النسائية المغربية، لكنها مهمة وتأتى لصالح النساء.
من المهم لفت النظر إلى مسألة أساسية وهى سعى الحركات الإسلاموية، لا سيما تلك التى لها تمثيل فى البرلمانات العربية، إلى أسلمة قوانين الأحوال الشخصية وتعطيل مسارات الإصلاح فيها، فهذه الحركات تخشى على رصيدها الاجتماعى والرمزى، والنساء جزء أساسى من هذا الرصيد، وهى تتبنى أيديولوجية رجعية، ليس فى نظرتها إلى المرأة فحسب، بل وإلى الدولة وسيادتها وحدودها الوطنية.
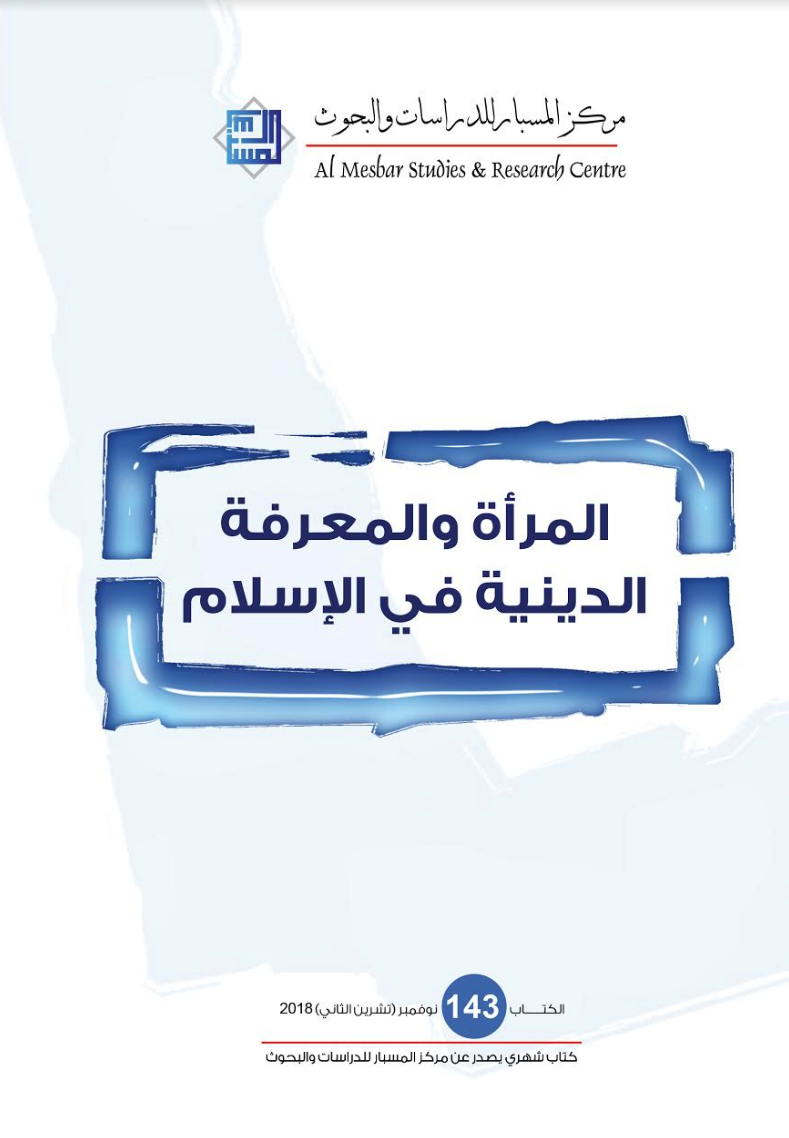
■ تحدثتِ فى كتابك «العنف فى الإسلام المعاصر» عن دور الاستشراق فى ترسيخ الصورة النمطية عن الإسلام باعتباره دينًا عنيفًا.. إلى أى مدى يمكن الحديث عن استمرارية هذه الصورة حتى اليوم؟
- الكتاب فى الأساس أطروحتى للدكتوراه تحت إشراف البروفيسور رضوان السيد، وكانت تحت عنوان «العنف فى الإسلام المعاصر معطى بنيوى أم نتاج ظرفى». فيما يخص موقف الاستشراق من إشكالية الإسلام والعنف، فهناك اتجاهات وآراء عدة قدمها المستشرقون حول هذه الإشكالية، ولم يرَ كل الاستشراق أن الإسلام عنيف فى جوهره. كلنا يعرف أطروحة إدوارد سعيد فى نقد الاستشراق والخطاب الاستعمارى، والتى تركت تأثيرًا كبيرًا فى الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية، سواء فى أوروبا أو الولايات المتحدة، فقد اعتبر بعض من يسميهم رضوان السيد بـــ«المراجعين الجدد» سعيد وطلال أسد وزاكارى لوكمان، أنهم كانوا من بين أسباب فشل السياسات الخارجية الأمريكية فى الشرق الأوسط، وصعود الأصوليات الإسلامية. ولكن علينا ألا نتجاهل أن الاستشراق قدم إسهامات مهمة فى مجال الدراسات الإسلامية وتحقيق المخطوطات، لا سيما الاستشراق الألمانى.
بكل الأحوال لقد دخل الاستشراق الكلاسيكى فى مرحلة الأفول منذ سبعينيات القرن الماضى، وانتهى بوفاة برنارد لويس. اليوم تشهد الجامعات الأوروبية تطورًا لافتًا وكبيرًا فى دراسات الإسلام، وأظن أن القرن الحادى والعشرين سوف يكون قرن الدراسات الإسلامية فى أوروبا، فالمناهج التى تتطور داخل هذا الحقل الأكاديمى كبيرة وضخمة، ونحن فى العالم العربى وفى الأكاديمية العربية لا نوليها اهتمامًا كافيًا أو نأخذ من هذه التجارب.

■ ما تفسيرك لهذا الاهتمام المتزايد بدراسات الإسلام فى الغرب؟
- تقف عوامل عدة وراء اهتمام الجامعات ومراكز البحوث فى أوروبا بدراسات الإسلام: أولها، السعى الأكاديمى والرسمى الأوروبى لإدماج الجاليات المسلمة فى المواطنية الأوروبية؛ ثانيها، تطوير برامج تأهيل الأئمة وصناعة المرشدين/ المرشدات والقادة الدينيين ضمن مناهج تواكب الثقافية الأوروبية، وتقف حائلًا دون سيطرة المتشددين والإسلامويين على المساجد؛ ثالثها، بناء الدراسات الإسلامية بمناهج جديدة تأخذ من العلوم الإنسانية، وتختلف عن الدراسات الكلاسيكية، وتعمل على تبيِّئَتها فى التقاليد الجامعية الأوروبية.
لقد أشرفت على كتاب تحت عنوان «الإسلام فى الجامعات الأوروبية: المساقات، الفرص، الثغرات»، بمشاركة مجموعة من المؤلفين صدر عام ٢٠٢٢، حيث غطى عددًا من الجامعات فى النمسا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وغيرها من الدول، وأجاب عن مجموعة من القضايا التى أشرتُ إليها هنا.

■ وما تفسيرك لتبنى مثقفين عرب هذه الوجهة الاستشراقية؟
- لا يمكن لنا إنكار أن العنف سمة من سمات الإسلام المعاصر، خصوصًا إذا نظرنا إليه من ناحية ما تفعله الحركات الإسلاموية منذ ثلاثينيات القرن الماضى. هناك العديد من المثقفين يعتبر أن الإرث الدينى الإسلامى بمختلف مصادره هو الذى يقف حائلًا دون أخذ الإسلام بالحداثة، لأنه بطبيعته غير قادر على السير فى مسارات التحديث، مما يؤدى إلى ظهور العنف باسم الدين وانفجار الإرهاب. وعلى الرغم من التشظيات التى يعانى منها الإسلام بسبب عنف الإسلاميين وتنامى التطرف فى العقود الأخيرة، فإن دولًا عربية عدة بنت استراتيجيات لمكافحة الإرهاب وإعادة تعريف المفاهيم الإسلامية، وأظن أن الحد من العنف المعاصر الذى يرتكب باسم الإسلام، يحتاج إلى جهود كبيرة من مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية لاستعادة الدين من الإسلاميين أولًا والمُضى بالإصلاح الدينى والسياسى ثانيًا.

■ ترين أن الدين أساسى فى أى عملية إصلاح جادة.. فما هى حجتك فى تبنى هذا الرأى؟
- لأن الدين يأخذ الحيز الأكبر من الوعى الجمعى المسلم فى العالم العربى، ولأن مجتمعاتنا، مجتمعات دينية، فالجمهور عندنا جمهور دينى ومتدين، اشتد وعيه بدينه وهويته الدينية منذ أكثر من خمسة عقود، وذلك لأسباب عدة: تضخم أنماط التدين اللا عقلانى، وانتشار الحركات الإسلاموية وتوسعها، والتى تقوى بالفشل، والنكسات السياسية، ومشكلات الدول الوطنية، وفشل مشروعات الإصلاح السياسى والدينى. كل ذلك وغيره يحتم علينا أن نجعل الدين جزءًا أساسيًا من أى عملية إصلاح جادة. ولكن السؤال الأهم لماذا تعثر الإصلاح؟ ولماذا حين تحدث قفزة كبيرة فى الإصلاح الدينى نشهد ردّة أو موجة جديدة من التشدد؟ أظن أن هذين السؤالين مهمان وقد طبعا مئة عام من تاريخنا.

■ هل هناك مشروعات بحثية أخرى تعملين عليها لمواصلة هذا الجدل الفكرى؟
- بعد نشر كتابى «امرأة الفقهاء وامرأة الحداثة» نشرت مجموعة من الأبحاث فى مجال دراسات المرأة وفى لغات عدة بينها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، كان آخرها ما نشرته العام الماضى فى اللغة الإنجليزية فى جامعة جراتس فى النمسا تحت عنوان «Women As Imams: Gender Equality in Mosques»، والدراسة الثانية فى العربية حملت عنوان «إليزابيث شوسلر فيورنزا: رقصة الهرمينوطيقا وإعادة البناء»، وقد نشرت فى مجلة مونستر للدراسات الإسلامية والفلسفية، كما شاركت فى معجم الفجيرة الفلسفى فى مادة تحت عنوان «المسألة الجندرية».
طبعًا هناك أبحاث أخرى نشرتها فى مجال دراسات المرأة، كما أننى أشرفت على مجموعة من الكتب كان آخرها «مكانة المرأة فى أفغانستان من عهد أمان الله خان إلى طالبان». إلى ذلك نشرت أبحاثًا عدة فى مجالات أخرى، سواء فى الحوار الإسلامى المسيحى أو علم الاجتماع. منذ عامين تقريبًا أعمل على كتاب جديد فى سياق المرأة والدين ولكن ضمن الفضاء المسيحى، أعتمد فيه على مناهج العلوم الاجتماعية الحديثة، ومن المقرر أن أنهى العمل به نهاية هذا العام.