أحزان روائى سورى.. سومر شحادة: لا يوجد الآن قانون لضبط مخالفة مرور

- لا أسعى لتحويل «الآن بدأت حياتى» إلى عمل درامى لكن لا أرفض المبدأ
- السوريون يعيشون حالة فراغ دستورى بشكل مطلق
- النظام السابق «أكل» الدولة بشكل كامل خلال سنواته الأخيرة
- السوريون لم يتصالحوا حتى الآن مع القضايا الإشكالية التى قد تضيع البلد
- ما زلنا محكومين بالخلاء مثل أيام بشار الأسد خاصّة مع فوضى القتل والانتقام
لا يكتب الروائى السورى سومر شحادة، عن الحرب كحدث عابر بل ينقّب فى أعماق الشخصيات التى تبحث عن بصيص ضوء وسط الدمار، فهو يرى أن ظلال الموت هى التى تنجب الأدب الأكثر صدقًا وقوة.
فى روايته الأخيرة «الآن بدأت حياتى»، التى وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2025، يصنع الروائى السورى عالمًا سرديًا استثنائيًا يمسك بتلابيب اللحظة الفاصلة بين اليأس والأمل، وبين النهاية والبداية، ليكون صعود العمل تتويجًا لمسار إبداعى حافل، ظلّ خلاله وفيًا لأسئلة الذاكرة والهوية والمنفى.
وأجرت «حرف» حوارًا مع سومر شحادة، حول عوالمه السردية التى تتحرّك على خطوط التماس بين الواقعى والرمزى، وبين التاريخى واليومى، وكيف يكتب عن الحرب دون أن يسقط فى فخ الوصفية المباشرة، وكيف يصوغ لغة سردية قادرة على حمل هموم جيل عاش التحوّلات الأكثر دراماتيكية فى التاريخ السورى المعاصر.
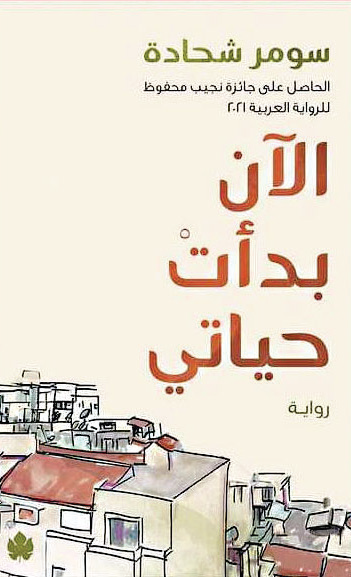
■ دعنا نستهل الحوار بالحديث عن الرواية المدرجة فى القائمة الطويلة لجائزة البوكر، ونبدأ باسم العمل «الآن بدأت حياتى». وفى الحقيقة عندما عرفت بأن الموت حدث أساسى فيها، شعرت بالمفارقة بين الحدث والعنوان، ما ذكرنى بفيلم كان عنوانه «ستموت فى العشرين» لكن البطل وقتها والمتوقع موته من الجميع، بدأ يحيا فى العشرين.. فهل كان اختيار العنوان إشارة إلى بداية جديدة أم تصحيحًا لماضى كل شخصية؟
- العنوان يشير إلى بداية جديدة. إلا أنَّها بداية حدثت فى سياق الشخصية نفسها، وهى بداية منسجمة مع مقولات الرواية ككل. بالنسبة إلى «إياس»، تركته زوجته، واتهم بجريمة قتل صديقه. والبداية بالنسبة إليه كانت إعادة تعريف لنفسه فى ثلاثة أسئلة: أين أعيش، ومع من، ولأجل ماذا؟
والرواية تجيب من أجله عن هذه الأسئلة الثلاثة، كما تكشف له عن الأوهام التى رسمت جزءًا من حياته، فيشعر أن بوسعه البدء من جديد. ولحظة قوله لنفسه «الآن بدأت حياتى» كانت لحظة قاسية، لم يعد يمتلك فيها مصيره. إلا أنه بات يعرف نفسه، وهذا مسعى الرواية وطموحها.
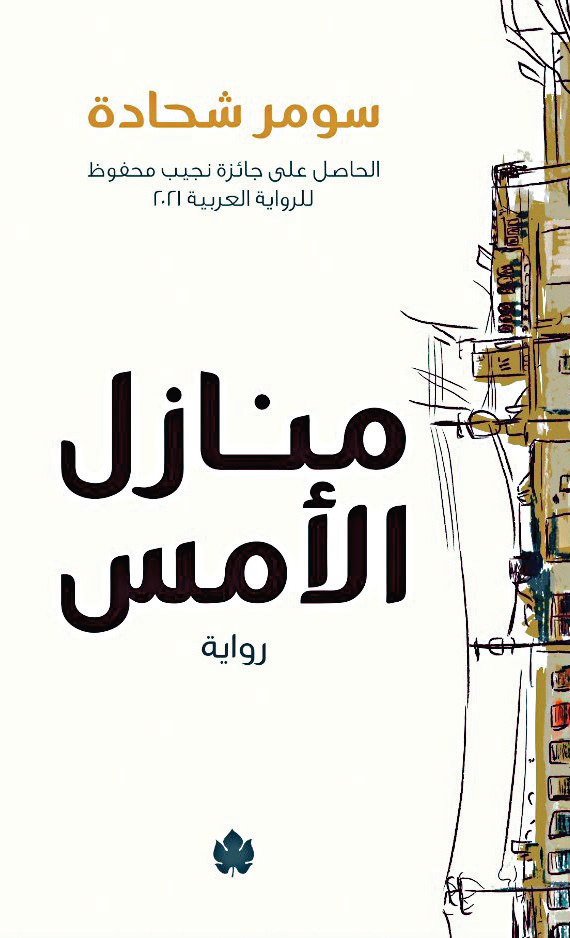
■ المجال المكانى للرواية هو «بيت إياس» الذى دارت فيه كل الأحداث.. هل يمكن اعتبار البيت نقطة عزل للشخصيات عن الخارج أم مكانًا يعكس قيودهم النفسية والاجتماعية؟
- جميع الشخصيات عالقة فى بيوتها، وفى عالمها النفسى الذى صنعته سنوات الحرب. فالشخصيات التى تشعر بنفسها معزولةً كانت جزءًا من المكان، وهو مدينة اللاذقية، التى استمرت تعانى فقدان أبنائها خلال سنوات الحرب، إما موتًا، أو سعيًا محمومًا للرحيل. والرواية تصور مكانًا يرحل، يتفكك، يفقد ناسه، والبيت فيها إلى حد كبير، يعانى ما تعانيه هذه الشخصية الممتلئة بشعور التخلّى.
■ الرواية يمكن وصفها بمزيج من عدة تصنيفات، فهى بوليسية وغامضة واجتماعية ونفسية.. كيف مزجت كل هذه الأنواع معًا؟ وهل كان هذا المزيج ضمن خطة كتابة الرواية أم أن السياق أخذك إلى حيث انتهى؟
- لم أصنع هذا المزيج بنفسى، وإنما استلهمته من واقع سوريا فى السنوات الأخيرة للنظام السابق. حيثُ أكل النظام الدولة بشكل كامل، ما يفسر سقوطهما معًا. وكانت الحياة مسرحية عبثية يحدث فيها كل شىء. مَن يلجأ إليه المواطنون فى الدول الطبيعية، مثل القانون أو جهاز الشرطة؛ أصبح السوريون بحاجة إلى اللجوء منه، ما كرّس فكرة غياب العدالة فى سوريا وهى عدالة وظيفيّة تهدف إلى خدمة النظام نفسه. حتى التحقيق فى الرواية كما فى الواقع، كان نوعًا من الخدمة التى يؤديها النظام لنفسه. إنها مسرحية تامَّة.
أما عن الاعترافات، فقط حصلت بضغط لحظة الجريمة الغامضة فى وقتٍ كان فيه القتيل يتحضّر للهجرة. ربما نهايته الجارحة، حرَّرت الآخرين من مخاوف القول، وتحدثوا بما صمتوا عنه طويلًا.
■ غالبًا ما تكون الروايات التى تدور فى مكان ويوم واحد مغرية للتحول إلى عمل درامى أو سينمائى.. هل تسعى لذلك؟
- لا أسعى. لكنى لا أرفض بالمبدأ. كما أننى كتبتها مخلصًا لفنّ الرواية، ويحدث أن يتّسع هذا الفنّ إلى ممكنات فنون أخرى، مثل السينما أو المسرح.
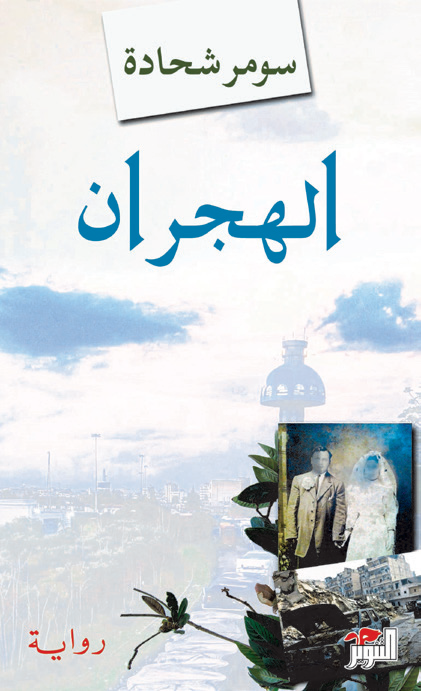
■ روايتك «ناس صنعتهم الحرب وزرعت بداخلهم الألغام» تدور فى سياق مشابه.. كيف ترى سوريا وأهلها فى ظل النظام الجديد؟
- لم يتشكّل بعد نظام جديد، السوريون يعيشون حالة فراغ دستورى بشكل مطلق. هذا مفهوم. إلا أنّ الخطير أنهم لم يتصالحوا مع الكثير من القضايا الإشكالية التى قد تضع هذا البلد فى مهب المحو كل مرة. هذه الأيام، أرى أننا محكومون بالخلاء الذى كما فى أيام النظام السابق؛ يحدث فيه كل شىء خاصّة مع فوضى القتل والانتقام. كأننا قوم بدائيون.
لا يوجد قانون يضبط حتى مخالفة سير فى الطريق، فما بالك بأمور أعقد. مع ذلك، المهم، أن يبدأ سياق ديمقراطى يتيحُ للدولة المزمع بناؤها أن ترمّم نفسها بالآليات الديمقراطية التى صنعتها نضالات البشر. وكى لا نعيد المآسى السورية من جديد. هذا ما نأمله، ونتمناه، ولست متأكدًا من حدود تأثيرنا فيه.
■ روايتك «منازل الأمس» تحدثت أيضًا عن سياق الطغيان والظلم.. كيف يواجه الروائيون فى أنظمة الاستبداد هذه التحديات؟ وكيف تعالج الرواية موضوع التمييز الطائفى؟
- فى «منازل الأمس» حرصت على إيضاح الصورة التى شوّه بها النظام العلويين، لكن جوهر العمل، لم يصل بالأبعاد التى قصدتها إلا لمن قرأه من السوريين، وهم قلّة، لأن الرواية لم تصل إلى سوريا، إلى جانب من قرأها من اللبنانيين لأنهم يعرفون النظام السابق المعرفة ذاتها التى عرفها السوريون.
فى المحصلة، لم أسمِّ الأشياء بمسمياتها، بل اكتفيت بإشارات طقسيّة تدل على هوية الجماعات. وما منعنى عن تسمية الأشياء ليس فقط عيشى فى ظل نظام استبدادى، إنما اعتقادى أن الفن لا يجب أن يكون تعميميًّا بالصورة التى تحدث فى ظل نظم الاستبداد. خاصة أن التشويه الذى أحدثه النظام لم يقتصر على طائفة بذاتها، إنما شمل الجميع، وقد أراد حافظ الأسد من خلال حزب البعث ومقولة «قيادة المجتمع»، أن يصنع دولةً- مجتمعًا على قياسه كفرد وحالة، واستخدم للوصول إلى هذا الغاية كلّ شىء، وكل أحد.
وأرى الخشية فى مواجهة أنظمة الاستبداد؛ أن نتشبّه بأدواتها فى التعميم والسعى إلى التنميط، والقول بالانسجام المطلق للفرد ضمن الجماعة التى ينتمى إليها.
لذلك لم أكن أريد أن أعمِّم التشويه على مجموعة بشرية حتى فى إطلاق تسمية واضحة، لأنَّ هذا التعميم لم يحدث فى الواقع أصلًا، ولا أزال أرى الواقع أحد معايير الفن، خاصة عندما يكون واقعًا متهتّكًا يفوق المخيلة فى مآله.
ودائمًا هناك بشرٌ يقاومون التخريب، ويعيدون الحياة إلى طبيعتها، ويبحثون عن طرق للنجاة من تشويه النظام، نراهم فى الرواية عبر نماذج عديدة مثل الجندى فى سرايا الدفاع، ومثل المعتقل، ومثل شخصيات معارضة عديدة، والأهم، مجموع البشر ممن لم يشترك بأدوات النظام.
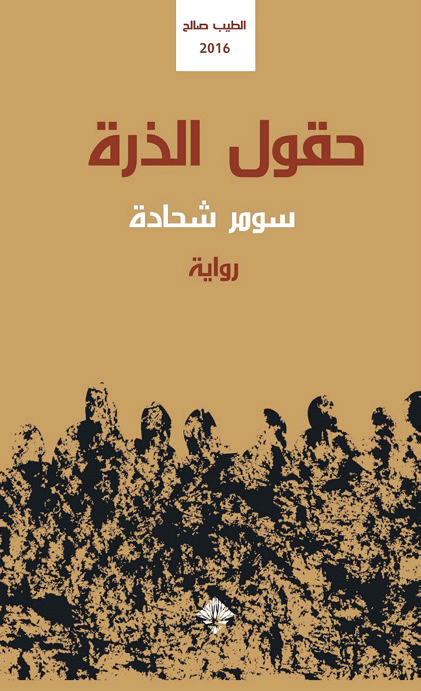
■ كيف تتناول الرواية موضوع الانتماء والاغتراب من خلال شخصية «نسرين وكارم»؟
- حددته أيضًا تحديدًا سياسيًّا، لأنّه فى سوريا؛ الزمن لشدّة قمع النظام السابق؛ تحوّل إلى زمن سياسى فقط. لذلك، رسمتُ انتماء الشخصيات عبر الشعور بموت الرئيس، أو استقبال خبر موته.
«نسرين» خافت. فيما «كارم» لم يشعر بالأمر لأنّه كان سورى الهوية فقط، إلا أنه لم يكن يعيش فى سوريا، وجاء إليها فقط كى يدرس فى الجامعة. قد يبدو هذا مبالغًا به. أقصد، أن نقرأ انتماء فرد واغترابه عبر الشعور بموت الرئيس. ربما. لكن الفن، كما أراه، تدخّل الفنّان فى الواقع، وتحديده للواقع. وهو عنف الفنان ضد الواقع أساسًا.
■ عانى الأبطال من تأثير الماضى فى تشكيل حاضرهم.. كيف صغت ذلك فى الرواية؟
- أيضًا أسوة بـ«الآن بدأت حياتى»، لم أصنع هذا فى الرواية، إنما أخذته من الواقع. حيث تأملت حياة العديدين، ورأيتُ ميلهم إلى إعادة إنتاج أنماط العلاقات التى نشأوا بها. والرواية ترصد بالضبط، الآلية التى تؤثر بها علاقتنا مع آبائنا وأمهاتنا فى سلوكنا العاطفى مع الشركاء. أو حتى علاقة الآباء مع الأمهات أنفسهم بمعزل عن علاقتهم بالأبناء.
أمور تظهر فى سلوك الأبناء العاطفى، وهذا موجود فى الواقع. أنا فقط، تأمّلته. وصنعت معادلًا له فى السرد. فى النهاية، ليستَ الرواية أكثر من انزياح فنى عن الواقع.
■ كيف تؤثر التغيرات السياسية على مصائر الأفراد من خلال قصص الحب والانفصال؟
- تؤثر فى شكل الحياة نفسها، ليسَ التأثير الذى يصدّره السؤال. إنما الرواية كانت عن عائلة سوريّة، ومن البداهة أن يظهر أثر الحرب السورية فى علاقاتها. لكن من غير مبالغة، فهم كانوا يعيشون فى الإمارات. والحرب السورية أطالت أمد العلاقة الميّتة أساسًا. أجّلت الاعتراف. ربما شعور «نسرين» أنها فقدت المكان الذى تشعر بالانتماء إليه، دفعها إلى الرهان بالانتماء لعائلتها فى الاغتراب. لكن العائلة تفككت، وقد فكّكتها هى، بعد أن أدركت أن لا مناص من حدوث الانفصال. وهذه لحظة ترد فى الكثير من العلاقات الزوجية بمعزل عن ظروف الحرب. هذه أمور تحدث. حضور الحرب رمزى وبعيد، لم يحسم خيار نسرين، العلاقة انهارت من الداخل. لأقل؛ احترقت.
■ فزت باثنتين من الجوائز المرموقة فى بداية حياتك الإبداعية عن العملين «حقول الذرة»، و«الهجران».. كيف أثر فوزك على رؤيتك الذاتية ككاتب؟ هل زادت ثقتك فى قدراتك الأدبية أم أنك أصبحت تشعر بعبء إضافى على عاتقك؟
- طبيعى، شعرت بكل ما فى سؤالك. لكنى اعتدتُ أن تنتهى فرحتى بالجائزة مع إعلانها. فأنا لا أصدّق الجوائز، وأراها جزءًا من صناعة النشر، لا أكثر.
■ هل بإمكانك منحنا فكرة عن الروايتين؟
- كتبت رواية «حقول الذرة» فى فترة كانت سوريا فيها مشتعلة، خطاب الكراهية والإقصاء كان فى ذروته، وحوادث الاقتتال الأهلى كانت تأخذ بعدًا خطيرًا قبل أن تصهر سنوات الحرب السوريين جميعًا فى شعور عامٍ ومشترك بالهزيمة والفقد والخسارة.
- أتحدث هنا عن البشر العاديين، لا عن النخب التى استمر العديد منها يقرأ الواقع السورى حتى عام ٢٠٢٤ بمعادلات عام ٢٠١١ نفسها بلا أى تغيير، وكأن الزمن متوقف عن النمو لديها.
المهم، فى حينها كنتُ أشعر بأن الموت قريب منى. لذلك، خطاب الرواية عنيف، يشبه أحدًا يستنجد كى يرفع أحدهم السكين عنه، وخطابها مباشر إلى حد أنى أقف عنه مسافة نقدية اليوم.
أما الهجران، فقد كانت بداية مشروع استمر فى منازل الأمس والآن بدأت حياتى. إذ بدأت أعى مع الهجران؛ كيف أن المهم فى ظل الحياة تحت الاستبداد، ليسَ الاستبداد نفسه، ليس النظام، وإنما علاقات البشر معًا؛ كيف تتغير وتتطور، وما الذى يبقى منها وما الذى ينهار، خاصة أنها تحدث بين زمنين، الثمانينيات والوقت الراهن حين كتابتها. شعرت مع الهجران، أنى مشيت خطوة تجاه فن الرواية بالصورة التى أحب أن أقرأها فيها.
■ هل يمكن أن تُحدث الجوائز فارقًا حقيقيًا فى الأدب العربى؟
- لست مع إعطاء الجوائز هذا الدور الكبير. فى الحقيقة، لا يغير الأدب العربى أكثر من تغير الواقع نفسه، وفتح آفاق الحريات. أن يقدر الكاتب أن يفكر بحرية ويتأمل بحرية ويكتب بحرية من دون خوف من السجون، ومن دون اضطراره إلى الإذعان لرقابة المجتمع نفسه أحيانًا. أيضًا لا يغير الكتابة تغييرًا فعليًا أظن سوى تغير حضور القراءة فى حياة الإنسان العربى، وهذه عملية معقدة وشاقة سياسيًا واقتصاديًا، تحتاج حكومات جادّة، لا جوائز من هيئات.
الجوائز بالنسبة إلى، ساعدتنى على الاستمرار والنشر، لأننى كنتُ أعيش فى بلد مغلق بالكامل، فى ظل نظام أغلق التاريخ من جهة، وزرع نوعًا من الإقصاء العنيف بين السوريين أنفسهم، خاصّة لدى نخبتهم. لذلك، كانت الجوائز العربية حدثًا أنقذنى. استطعت أن أنشر كتابى، وكانت لى نافذة على القارئ.







